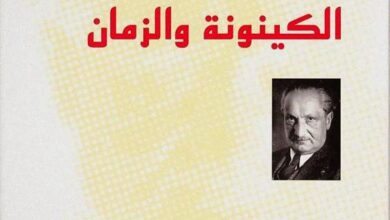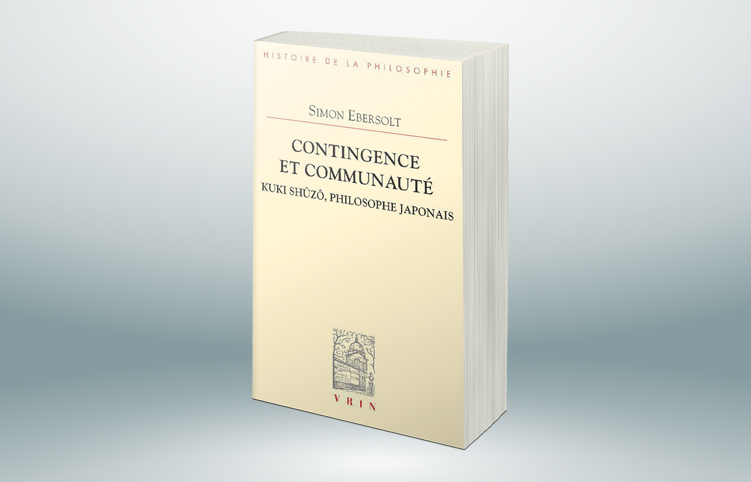الانتقال إلى الاشتراكية .. التحول إلى الديمقراطية

عندما تنبري ثُلَّةٌ أو جماعة للمناداة بالتغيير ورفع شعار الديمقراطية، فلأن الوضع الذي تعيشه هذه الجماعة أو هذه النخبة وضعٌ غيرُ ديمقراطيّ، أو كما يُصطلح عليه في العلوم السياسية “باللاديمقراطي” وإذْ اقتصرنا في ذِكرنا على النخبة؛ فلأن (السواد الأعظم من الناس لا يمتلك المقومات والوسائل والأدوات التي تؤهله للوعي بهذه الحاجة المُلحة للتغير، فكيف برفع شعارِه).
هذا المطلب الجديد القديم (التحول إلى الديمقراطية)، هو حتما بديلٌ مُرادٌ ومرغوبٌ عن وضعٍ قديمٍ (الديكتاتورية/ النظام الشمولي) أثبتَ عدم نجاعتِه، أو على الأقل لم يَعد ناجعا الآن، أو هو حالة من الإكراه المفروض الذي لم يَعُد يُطاق، ولَمْ يعد مُمكنا التأقلم معه.
بالتالي وجبَ التخلصُ منه واستبدالُه بوضع أفضل منه، أو على الأقل؛ بِوضعٍ تتوفر فيه الحدود الدنيا من المقبولية.
والوضع القديم الذي نتحدث عنه هنا (بالنسبة للحالة العربية) هو الاشتراكية (كشعار تبنته قوىً وظفتْهُ للوصول إلى السلطة، ولم يتم العمل بها كنظام سياسي قط)، وكان السؤال المُلح يومَها هو “ما السبيل إلى إقامة الاشتراكية ؟”، في بلدانٍ مُتخلفة وخارجة للتو من نَيْرِ الاستعمار، فكان الجواب هو “الثورة” وبقي السؤال الصعب هو “مَن سيقوم بهذه الثورة ؟”.
وإذا رجعنا للنُّظم الاشتراكية العريقة، فسنجد الجواب ظاهرا وبيِّنا وجليًّا، فنظرية كارل ماركس القائمة أساساً على صراع الطبقات وحتمية هذا الصراع (بين البرجوازية والبروليتارية)، إذ يستوجب قيام هذا الصراع؛ وجودَ بروليتارية؛ أي وجود قوة عمالية كبيرة ومنظمة، وهذه الفئة (العمال) هي أهم عناصر الصراع والثورة،
فوجود البرجوازية لوحدِها أو مع تكتلات عمالية مشتتة، غير واعية بحالتها وغير منظمة وغير مؤثِّرَة على الحياة الاقتصادية. (في الدول التي لا تشكل الصناعة فيها عصب الحياة / الدول البورية التي تعتمد على التساقطات المطرية أساسا لاقتصادِها) لن يشكل فارقا.
إذ لابد حسب ماركس أن تكون المجتمعاتُ صناعيةً بامتياز؛ حتى يتوفر الشرط الأساسي لقيام الثورة وهُم العمال، فحيث ما وجدتْ الصناعة فتم عمال؛ وبالتالي ثمة إمكانية قيام الثورة وتأسيس مجتمع اشتراكي، ستقود حتما إلى قيام نظام شيوعيّ.
فمثلا في أوربا وبالضبط في أواخر القرن الـ19، كانت الطبقة العاملة (البروليتاريا) هي من احتضتْ ورعتْ أفكار ماركس وإنجليز إلى أن تبلورتْ في صورتها الناضجة. ثم انتقلتْ الشرارة إلى روسيا بعد تحالف العُمال المتحدين والمنظمين مع الفلاحيين المتحدين والمنظمين كذلك.
ليتمخض عن هذا التحالف الـمُـنظمِ ثورةً (لينينية) أنهتْ الحكم القيصري في روسيا، وأعلنتْ بدأ قيام الاتحاد السوفياتي، وفي الصين قام ماوتسيتونغ بتوحيد وتنظيم القوى العاملة (في الصناعة والفلاحة) ثم قاد هذه القوة المنظمة ليُشعل ثورةً قضتْ على النظام الصيني العتيق.
من خلال هذه المحطات التي استعرضناها نستطيع الإجابة عن السؤال الذي طرحناه قبلاً، وهو كيف نقيم هذه الثورة ؟ والجواب المباشر هو؛ ضرورة وجود قوة منظمة قادرة على القيام بـ “الثورة”.
وفي بُلداننا العربية ومَن شاكلَها من الدول المتخلفة أو الدول النامية كما يُحب البعض أن يسميها، وهنا نُوردُ مقولة ساخرة لعابد الجابري يقول فيها “.. وإنما توصف بكونها بُلدانا نامية أو (في طريق النمو) تأدبا فقط، إذ يجب معرفة ماذا ينمو فيها؟ هل هو التخلف نفسُه أم غيرُه ؟!”
وفي رأينا أن الذي ينمو فيها حقا هو الفساد ولا شيء غيرَ الفساد، فالأسماء مهما اختلفتْ لا تُغير من الواقع شيئا. ففي هذه البلدان (العربية) لم يكن للعمال تكتلٌ ولا تنظيم، والحال نفسُها بالنسبة للفلاحين،
فنظرية ماركس تقوم على وجود بروليتاريا منظمة ومتطورة، وفي عالم عربي لم تتوفر فيه شروط الاشتراكية بالأمس، (مثلما لم تتوفر فيه شروط الليبيرالية اليوم)، القوة الوحيدة التي كانت مُنظمة في هذه الدول (المتخلفة) الخارجة من الاستعمار كانت هي الجيوش.
فكانت هذه الجيوش هي الأقوى والأقدر على أخذ المبادرة والقيام بالثورة والاستيلاء على الحُكم، (العراق – سوريا – اليمن – مصر – السودان – الجزائر، موريتانيا …) وأقامتْ في كل قُطر من هذه الأقطار العربية حِزبا واحدا ووحيدا لا شريك له، وتَم الإجهاز على فكرة التحول إلى الاشتراكية التي تبناها الجيش للوصول إلى السلطة،
وقبلَها الإجهاز على مشاريع ديمقراطية حقيقية ناشئة وواعدة (تجربة الملك فاروق في مصر – وتجربة الملك إدريس السنوسي في ليبيا – التجربة الديمقراطية في الجزائر … ) أقبرَتْها الانقلابات العسكرية، ورُفع شعار جديد اسمه الإصلاح ومحاربة الفساد، وبدأتْ مرحلة جديدة يحارِب فيها الفسادُ الكبيرُ الفسادَ الصغير، لتدخل فيه الأنظمة حالة من الهدنة مع شعوبِها.
هذه الفترة ازداد فيها الجيش قوة وتغوّلا وسطوا على مقدرات الوطن، وزاد فيها الشعب فقرا وتخلفا وجهلا وأمية، فاتسعتِ الهوة بين النظام (نظام الفساد/ إذ الشيء الوحيد المنظم في الأنظمة الشمولية هو الفساد) والشعب، وزاد الرَّتق إلى أن انفجرَ الوضع سنة 2011م مع الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي.
رغم أن الانقلابات التي رفعتْ شعار الاشتراكية ولم تطبق منها شيئا، وظلت مجرد شعار لتلك الأنظمة، إلا إن الاشتراكية كنظام سياسي لم يكن الخيار الأفضل ولا الأمثلَ لتجاوز المشاكل التي كانت الاشتراكية تَعِدُ بحلّها، والشاهد على ذلك؛ هو حالُ وبُؤسُ الدول التي كانت مهدا للاشتراكية، أو التي عمرّتْ فيها الاشتراكية عقودا طويلة.
ففي أوربا نجد الفروق واضحة وجلية بين الغرب (القوة والمهيمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفكريا والرائد ديمقراطيا وعلميا) والشرق التابع في كل شيء، وكأن الزمن توقف في تلك الدول حتى على مستوى التنمية والبنى التحتية، والأمر نفسُه ينسحب على دول شرق آسيا، فكوريا الشمالية والفيتنام وكمبوديا وكوبا وغيرها من الدول الاشتراكية؛ لم تتطور بتاتا.
التقدم الوحيد الذي يمكن أن نُسجله في هذه الأقطار؛ هو تغول الجيش وتضخم الفساد على حساب الشعوب والتنمية، بخلاف دولٍ كـ(كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وهونكونغ وماليزيا وتايوان التي صارتْ أيقونات مِعمارية، وصارتْ من بين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، والحال نفسُها في البلدان العربية.
فالأنظمة التي لم ترفع الاشتراكية كشعار، أو التي تحولتْ عنها إلى اقتصاد السوق، أو التي تماهتْ مع الرأسمالية منذ البداية (المغرب، الكويت، السعودية، تونس، الإمارات، لبنان، سلطنة عمان ..) أفضلُ حالا نسبيا على مستوى التنمية؛ مِن الدول التي ترفع شعار الاشتراكية (ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، الجزائر، والسودان) ..
رغم التطور الهائل الذي شِهدَه ويَشهَدُه العالم في مجالات التواصل والاتصال المختلفة التي أفضتْ إلى عولمة العالَم في كل شيء، إلا أن الأنظمة السياسية البدائية والشمولية لم تتصدع ولم تتأثر كثيرا بهذه الموجات المتعاقبة من ثورات الاتصال التي فتحتْ العالم على مصرعيْه،
وظل الانتقال إلى الديمقراطية، أو بتعبير أدق إلى بعض الديمقراطية في الدول الشمولية؛ ضربا من الهذيان. وكان الثمن الذي دفعَتْه هذه الأنظمة (الديكتاتورية/ الشمولية /أللايمقراطية المعادية للحداثة السياسية والاجتماعية) كبديل عن الديمقراطية (كنظام سياسي).
هو التبعية المطلقة للخارج (قوى المهيمنة في العالَم). الذي لا يطالبُها سوى بمواصلة ضخ النفط وباقي الثروات الطبيعية والحفاظ على مصالحِه ومصالِح شركاتِه وفقط.
وبعد عقود من هذه التبعية للخارج، التي وازاها كَبْتٌ وقهر وظلم في الداخل، وصولا إلى الحالة سالفة الذكر (الانفجار الثوري في البلدان العربية سنة 2011م)، والذي حدى ببعض الديكتاتوريات المتوحشة إلى استعمال القوة الغاشمة (الحديد والنار) في إسكات الشعب.
فيما اضطر البعض الآخر من هذه الأنظمة الشُّمولية ولو نسبيا إلى تقديم بعض التنازلات الرمزية، والسماح بتجريب بعض سُنن وراتِبِ الديمقراطية، مثل بعض حرية التعبير وهامشٍ ضئيل للتظاهر.
وظلتْ فرائض الديمقراطية من المحرمات في هذه الأقطار. وإذا كانت الديمقراطية فعلا هي الحل لمشكلة الفقر ولمشكل البطالة ولمشكل حقوق الإنسان ولمشكل الحريات العامة ولمشكل التعسف في السلطة ولمشكل استغلال النفوذ،
فهل يُفيد تطبيق بعض الديمقراطية وتعطيل بعضها الآخر؟ وهل يمكن حقا الانتقال إلى الديمقراطية بوسائل غير ديمقراطية؟ إذ (كل وسيلة غير ديمقراطية توصل حتما إلى أللاديمقراطية، أو بتعبير أبسط توصل إلى الفساد).
فكما لا يمكن أن يوصل العطش للارتواء، فإن الاستبداد لا يمكن أن يوصل إلى الديمقراطية، بل إلى استبدادٍ مثلِه إن لم يكم أشدَّ منه.
وسنعرِّج هنا سريعا على موضوع التبعية باعتباره المشكل الأساس في تأخر البلدان المتخلفة في تحقيق التنمية والالتحاق بركب الديمقراطية، إذ تعتبر التبعية العربية، تبعيةً متأخرة أو مفضوحة (ويمكن أن نَصطلحَ عليها بتبعية الذيل) على اعتبار أن التبعياتِ درجات،
ويتم حساب وتصنيف درجات هذه التبعية وِفق مجموعة من المقومات والمعايير (اقتصادية، فكرية، سياسية، عسكرية)، فعلى سبيل المثال الدول الأوروبية لها تبعية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية ماريشال.
كما أن الدول الأوربية بعضها تابع لبعض كتبعية دول شرق أوربا (بولونيا هنغاريا اليونان…) لدول الغرب (فرنسا ألمانيا انجلترا هولندا بلجيكا..) وتبعية دول جنوب أوربا (اسبانيا إيطاليا اليونان قبرص..) لدول شمالِها ( الدنمارك السويد النرويج هولندا فيلندا).
هذه الدرجة من التبعية سنُسَمِّيها اصطلاحا “تبعية الرأس” وهناك تبعية أخرى أعلى درجة من تبعية الرأس وهي تبعية النِّـد، ونُمَثِّل لها بعلاقة (بريطانيا العظمى بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة اليابان بأوروبا وعلاقة دول أمريكا اللاتينية بالصين الشعبية والهند).
والمصيبة الكبرى والطامة العظمى هي في تبعية الذيل التي تعاني منها الدول العربية؛ ومعها الدول المتخلفة في إفريقيا وآسيا (دول العالم الثالث) أو ما يُصطلحُ عليه بالدول السائر في طريق النمو (الهلاك). وذلك لأن التابعَ يحصل على الأشياء بعد تجاوزِها وانتهاء مدة صلاحيتها (طبعا بحسب درجة تبعيته).
لقد قطعت الديمقراطية أميالا ضوئية مِن التطور في الدول التي نشأت فيها، في حين أن تبعية الذيل هذه لم تُمَكِّن العرب إلى الأن مِن سنة واحدة قمريةٍ أو شمسيةٍ من هذه الديمقراطية التي بدأتْ تَهرَم وتَشيخ،
في حين مازالتْ النُّخَبُ في الدول العربية (وفي باقي الدول المتخلفة بصفة عامة) تُناضل منذ عقود مِن أجل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الأحزاب وحرية الاحتجاج، ويعتبرون تحصيلَ هذه المطالب كاملةً، انتصاراً عظيما للديمقراطية الناشئة في بلدانِهم أللاديمقراطية.
الحقيقة أن هذه الحقوق من رواتب الديمقراطية وسُنَنِها كما سبق وأشرنا، أما الديمقراطية الحقيقة المنشودة هي الانتقال من الحُكم العسكري إلى الحُكم المدني؛ والسماح بتداول السلطة بالمفهوم السياسي للديمقراطية.
وذلك بعودة الجيوش إلى ثكناتها (الدول التي يحكمها العسكر / مصر – سوريا – اليمن- الجزائر- موريتانيا – السودان- ليبيا ..)، والانتقال من الحزب الواحد والوحيد إلى التعددية السياسية والحزبية، تمهيدا لفتح أوراش ديمقراطية أخرى واعدة.
أما غير هذا، فرأيي أنه لن يتحقق هذا التحول إلى الديمقراطية في البلدان العربية، حتى تموت الديمقراطية في البلدان التي نشأتْ فيها، أو تتطورَ إلى نظامٍ جديدٍ يُراعي سُننَ التطور الكونية، إذ لا يوجد نظام وحيد ناجع وصالح لكل زمان ومكان.
فالـمُتطلبات تتغير بتغير ظروف وأحوال الناس، والحاجة تفرض على الناس اختراع وسائل وقوانينَ جديدة لتكييف الوضع، وهذا النموذج المتطور للديمقراطية المستقبلية قد يكون “الجَمعُ بين الديمقراطية كنظام سياسي والاشتراكية كنظام اجتماعيّ”،
والاشتراكية الاجتماعية هنا حسب عابد الجابري؛ هي ديمقراطية أيضا. “.. أي إعطاء هذه الديمقراطية المضمونَ الاجتماعي الاشتراكي الذي يُخفف من غلواء الليبرالية، ويُحقق الحد الأدنى من العدالة”.
- هوامـش
[1] محمد عابد الجابري، ندوة “الديمقراطية والتحولات الاجتماعية بالمغرب”، مجلة فكر ونقد، العدد 31، سبتمبر 2000م ص 11.