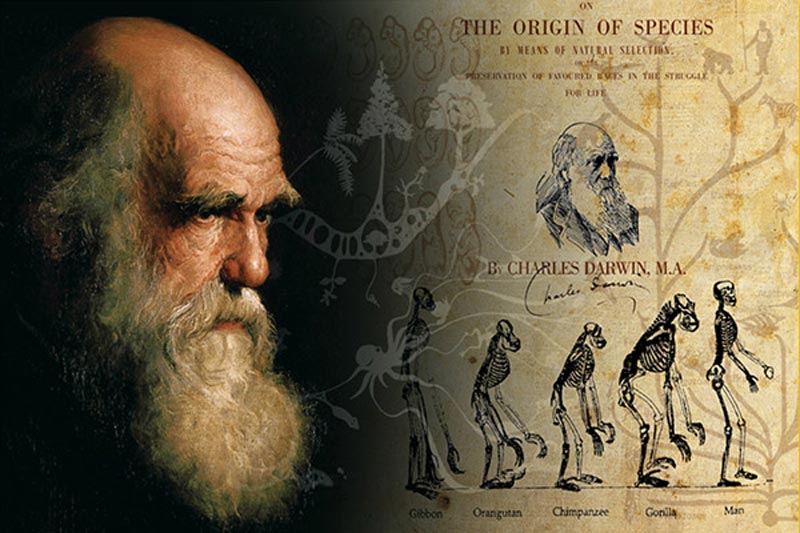عصر الأنوار .. بداية الثورة الفكرية

شكل عصر التنوير منعطفًا تاريخيًا حاسمًا في تاريخ الحضارة الأوروبية، وهذا ما أكده “دالمبير” الذي يقول: “لقد حصل تغيير هائل في أفكارنا وسرعة هذا التغيير تعد بالمزيد منه لاحقًا. لقد حصلت ثورة فكرية حقيقية ولن تستطيع إلا الأجيال اللاحقة أن تقيس حجمها وأبعادها أو إيجابياتها وسلبياتها. فنحن لا نزال غاطسين فيها.
وبالتالي فغير قادرين على رؤية كل ملابساتها وتنقصنا المسافة الزمنية الكافية لذلك، ولكن يمكن القول كتشخيص أولي بأن عصرنا هو عصر الفلسفة فإذا ما تفحصنا الحالة الراهنة للمعرفة عندنا لا نملك إلا أن نلاحظ التقدم الكبير الذي حققته الفلسفة”.
بما أن الاشكالات المتعلقة بعصر الأنوار غير قليلة، فإنه يمكن الاقتصار على بعضها من قبيل: ما المقصود بعصر الأنوار؟ وما مضمون فلسفته؟ ولماذا سمي بهذه التسمية؟
“يبدوا أن المصطلح كان في البداية ديني المنشأ قبل أن يتعلمن على يد الفلاسفة في عصر العقل: أي في القرن الثامن عشر بالذات”. غير أنه يطرح سؤال هنا، كيف انتقل هذا المصطلح الشهير من المعجم الديني القديم إلى المعجم الفلسفي الحديث؟
يبدو أن “ديكارت” “1596-1650”، كان أول من استخدم مصطلح التنوير، بالمعنى الحديث المفصول عن المعنى الديني أو الإنجيلي، بمعنى: “قدرة الإنسان على التوصل إلى مجموعة من الحقائق عن طريق العقل فقط، غير أن مصطلح التنوير لا يوظفه كسلاح ضد الدين أو بالأحرى ضد رجال الدين كما سيفعل في ما بعد “فولتير” أو “ديدرو”، وإنما يستخدمه ضمن سياق الاحترام الكامل للقيم الدينية”.
إن فكر الأنوار قد درج على التأريخ له بمقدم القرن 18م، وسمي هذا العصر بالأنوار تمييزًا عن عصر الظلمات التي كانت قد عاشتها أوربا في عصورها الوسطى، والتي كان للكنيسة فيه، والجانب الديني موقع الصدارة الذي جعل منها المتحكم في كل دقائق الحياة الانسانية،
أما فلسفة الأنوار فهي ما نحاول دراسته عبر بعض ممثليها في هذه الفقرة من البحث بينما ندع الإجابة عن سؤال: ما الأنوار لأحد أبرز فلاسفة هذا العصر “كانط” في أشهر مقالة له “ما هو التنوير؟”
“هو تحرر الفرد من الوصاية التي جلبها لنفسه، الوصاية هي عدم قدرة الفرد على استخدام فهمه الخاص دون توجيه من الآخر ليس القصور العقلي سببا في جلب الوصاية بل السبب، هو انعدام الإقدام والشجاعة على استخدام عقله دون توجيه من الآخر، تشجع لتعلم فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك الخاص هذا هو شعار التنوير؟”
امتدادا لذلك نجد لإيجابية تفكير روسو حول الأنوار، على الرغم مما عرف عليه من نقده للفكر الأنواري يقول، في أحد أشهر كتبه “العقد الاجتماعي” ما يلي: “يجب إلزام الأشخاص بأن توافق إرادتهم للعقل الذي لهم، ويجب إلزام العموم بأن يعرف ما الذي يريدونه.
وهكذا بفضل الأنوار التي للعموم يحصل إذ ذاك اتحاد الفهم، والإرادة داخل الجسم الاجتماعي ومن هنا يتأتى تعاضد الأجزاء بعضها مع بعض تعاضدًا صحيحًا، أي تتأتى في نهاية المطاف، قوة الكل العظمى. ذلك هو إذا ما عنه ينشأ وجوب وجود مشرع.”
ويجدر التنويه في هذه الفقرة إلى أننا ترددنا في دراسة جون لوك “john lock” كأحد أعلام فلسفة التنوير، “وذلك بعد ما تبين أن أغلب الدراسات لا تدرج لوك ضمن الحقبة الأنوارية أو ضمن فلاسفة عصر النهضة، فضلا عن أن تحديد الحقبة الأنوارية بالقرن الثامن عشر.
زاد من هذا التردد بالنظر إلى أن لوك لم يعش من القرن 18م إلا أربع سنوات حيث توفي سنة 1704م” مما لم يبق لنا سوى خيار وحيد هو دراسة جون لوك ومقارنتها بنصوص روسو مثلا، ليتبين لنا أن نصوصه تكشف عن أبعاد أهم مما طرح من خلال الفترة الأنوارية.
- المبحث الأول: التمييز بين المجال الدنيوي والحكم المدني: جون لوك
يقول أحد الوجوه البارزة في الموسوعة “Encyclopédie” جان دالمبير”J.dalembert” أنه “إذا كان نيوتن قد أبدع الفيزيقا، فإن لوك قد أبدع الميتافيزيقا في إشارة منه إلى كتاب جون لوك المعنون “محاولة في الفهم البشري”.
فما هو السياق الفكري لجون لوك؟ وكيف أسهمت أفكاره في تأسيس المبدأ العلماني؟
إن الفترة التي قضاها جون لوك على قيد الحياة “1632- 1704م” هي نفسها تقريبا المرحلة التي أسست مستقبل إنجلترا فيما بعد. “خلال هذه الفترة عرفت إنجلترا أهم ثوراتها وحروبها الداخلية، حيث كان الصراع على أشده بين الملكين “جيمس الأول” و”تشارلز” و”البرلمان”،
وهو الصراع الذي ترك تأثيره على الطفل جون لوك بفعل انخراط والده في الثورة الطهاروية “Puritanism” التي جرت بين السنوات “1603- 1649” بسبب تمسك الملكين بالحق الإلهي”، وهي الثورة التي انتهت بإعدام الملك تشارلز سنة 1649م وهي كلها أحداث أثرت في لوك الطفل ولوك اليافع، وجعلته يندفع إلى البحث والمعرفة.
ترك لوك أثرًا كبيرًا في الثورة الأمريكية لا سيما كتابه “رسالتان في الحكومة” الذي أسس فيه الكثير من المفاهيم والمبادئ.
يستخدم جون لوك قرب بداية كتابه “رسالتان في الحكومة” الكلمات الآتية لكي يصف النظرية السياسية عند “سير روبرت فيلمر” وهو مؤلف اختلف معه لوك بقوة.
“إن مذهب فيلمر لا يعدو أن يكون سوى القاعدة: كل أشكال الحكومات في ملكية مطلقة والأساس الذي يبنى عليه هذا القول هو ما من إنسان يولد حرًا”.
يجب ألا تفهم الحرية الطبيعية للإنسان على أنها تعني أن الناس لا يردعهم أي قانون لأنه حسب جون لوك: “في كل حالات الكائنات المخلوقة التي لديها القدرة على الأخذ بالقانون تنعدم الحرية إذا انعدمت القوانين”. فالدولة في فلسفة لوك ليست في يد الحاكم المطلق كما نظر إليها “توماس هوبز”،
وليس من شأنها مراقبة إيمان الناس والحد من الفتن كما ارتآها “سبينوزا”، فوظيفة الدين الحق مختلفة تماما حسب لوك: “فالدين الحق لم يتأسس من أجل ممارسة الطقوس ولا من أجل الحصول على سلطة كنسية ولا من أجل ممارسة القهر، ولكن من أجل تنظيم حياة البشر استنادا على قواعد الفضيلة والتقوى”
“يعتبر لوك أن الإلزام من حق السلطة المدنية وحدها، بينما إرادة الخير “الدين/الإيمان” هي سلطة البشر الوحيدة”. ويضيف: “فسلطة الحاكم لا تمتد إلى تأسيس أية بنود تتعلق بالإيمان، أو بأشكال العبادة استنادًا إلى قوة القوانين،
ذلك أن القوانين تفقد سلطتها إذا لم تقرن بالعقوبات، والعقوبات في هذه الحالة تصبح منعدمة انعداما مطلقا لأنها عاجزة عن إقناع العقل فلا أي بند من بنود الإيمان ولا أي التزام بأية عبادات برانية ولا الالتزام بأي مظهر من مظاهر العبادة، يفضي إلى خلاص النفوس،
إلا إذا كان هؤلاء الذين ينتمون إلى هذا الإيمان ويمارسون هذه العبادات على قناعة تامّة، بأن هذا الإيمان حق وهذه العبادة مقبولة من الله، ولكن العقوبات لا تفضي أبدًا إلى بزوغ هذا النوع من الإيمان”.
وعلى هذا الأساس كانت الدولة عند المدافع عن الحكم المدني وفصله عن المجال الخاص الكامن في الجانب الإيماني للأفراد هي: “عبارة عن مجتمع من البشر يتشكل بهدف توفير الخيرات المدنية والحفاظ عليها وتنميتها، وأنا أعني بالخيرات المدنية، الحياة والحرية والصحة وراحة الجسم. بالإضافة إلى امتلاك الأشياء مثل المال والأرض والبيوت والآتات وما شابه ذلك.”
على ذلك، “إن الحكم المطلق، الذي يقبض فيه أفراد قليلون على السلطات كافة، لا يمكن أن يقوم بجانبه مجتمع مدني، ومن تمة لا يأخذ شكل الحكومة المدنية، إذ إن ميزة المجتمع المدني تكمن في تجنب التحيز الذي كان يسيطر على الفرد في حالة الطبيعة،
عندما يفصل في قضاياه الخاصة إلى جانب علاج هذا التحيز وذلك بإيجاد سلطة عامة يلجأ إليها كل فرد وتتولى عنه مهمة فض المنازعات والفصل في الخصومات، وفي الوقت نفسه تلزمه بالخضوع لأحكامها”.
إن واجب الحاكم المدني هو: “تطبيق القوانين بدون استثناء لتوفير الضمانات الغائية في حالة الطبيعة والتي تسمح لكل الناس على وجه العموم وكل فرد على وجه الخصوص بالامتلاك العادل للأشياء الدنيوية دونما احتكار سلطة التحكم فيها ولو بشكل نسبي من طرف الحاكم،
فإن حاول أحد أن يغامر وينتهك قوانين العدل والمساواة التي تأسست من أجل الحفاظ على هذه الأشياء فإن مثل هذا المغامر يجب أن يمنعه الخوف من العقاب الذي هو عبارة عن الحرمان من الخيرات المدنية أو من الخيرات التي من حقه أن يتمتع بها،
وحيث إنه لا يوجد إنسان يقبل بإرادته أن يوقع على نفسه العقاب بالحرمان من أي من ممتلكاته أو من حريته أو من حياته، لذلك ينبغي أن يكون الحاكم مسلحًا بسلطة رعاياه وقوتهم من أجل معاقبة من ينتهكون حقوق الغير، وحيث إنه يتحتم على جميع إرادات الحكم أن تنشغل بالشؤون المدنية.
وأن تكون السلطة المدنية والحقوق والسيادة محكومة بهدف واحد، هو رعاية هذه الشؤون المدنية وتنميتها، بحيث لا تمتد هذه الرعاية، بأي شكل من الأشكال إلى خلاص النفوس”.
وهنا يظهر المدلول المغاير للعقد الاجتماعي الذي سبق أن تعرض له كل من هوبز وسبينوزا، حيث، “لم يعد التعاقد قائما على التسليم لصالح الحاكم المطلق، أو السلطات العليا مما نفهم جيدًا تخوف جون لوك من تأييده بأن يتنازل الانسان عن حالة الطبيعة لصالح حكم مطلق لا يؤمن بالحرية.
فهذا يعني أنه لا يمكن أن تتفق السلطة المطلقة التعسفية التي تحكم بدون قوانين قائمة ومتفق عليها مع غايات المجتمع والحكومة، التي لا يتخلى الناس عن حرية حال الطبيعة من أجلها، وينضوي تحت لوائها لولا حرصهم على حماية حياتهم، وحرياتهم وثرواتهم وإقرار السلام والطمأنينة عن طريق قواعد راسخة للعدل والملكية، ولا يمكن افتراض أنهم يقصدون، إذا كانت لديهم سلطة لأن يفعلوا ذلك،
أن يعطوا لأي شخص أو أكثر سلطة مطلقة تعسفية على أشخاصهم وأملاكهم، وهذا يعني أنه يجب عليهم أن يضعوا أنفسهم في حالة أسوأ من حالة الطبيعة التي يتمتعون فيها بحرية دفع عدوان الآخرين على حقوقهم ويتساوى قواهم في صيانتها”.
وهنا يتمايز لوك عن هوبز الذي يخضع هذا الأخير حياة الناس للدولة الوحش في مقابل لوك الذي لا يتصور أن يخرج الانسان من حالة الطبيعة إلا إلى مجتمع مدني يحكمه نظام ديمقراطي يتمتع بالرضا الشعبي. مما يكشف عن ثورية جون لوك عن سابقيه في التنظير السياسي، لكن هل يفهم من هذا أن لوك بفعل ثوريته يحرض على عصيان الحكم المدني؟
ينكر لوك أن يقدم أي سبب جديد للثورة فهو يبرهن على أنه ليس هناك حق قانوني أو دستوري لفعل أي شيء يعرض للمحافظة على المجتمع وعلى الحكومة للخطر إذا ما كانت هناك حكومة. إنه ينكر أي حق لمقاومة السلطة، حيثما يكون اللجوء إلى القانون ممكنا. يقول، “عندي أن القوة الغاشمة غير المشروعة هي وحدها التي يجوز معارضتها بالقوة”.
ولهذا يؤكد أن “الأخطاء الجسيمة للطبقة الحاكمة والقوانين الخاطئة للغاشمين وهفوات الضعف البشري الواهنة، قد يتحملها الشعب دون لوم أو تذمر جراء تجنب الفتن” ولوك شديد العنف في لومه لأولئك الأفراد الذين يثيرون الثورة ضد حكومة عادلة فهم كما يقول: “عندي يرتكبون أعظم جريمة، يستطيع المرء أن يرتكبها.”
إن رفض لوك تسويغ الأفعال الثورية ليس مطلقا بل هو مشروط بأسبقية الحوار الأكثر تهذيبا واللجوء إلى القانون من أجل تفادي الفتن ودفع المفاسد البسيطة فإذا استجاب الحاكم لتلك المطالب فإنه لا مجال لاستعمال العنف.
لكن إذا انصرف الحاكم عن هموم الشعب وحماية حقوقهم وحرياتهم ولم يواجهه بحب وحوار جاز للمواطن أن يغير الحاكم وتنصيب شخص آخر يحل محله، يكون أقدر على القيام بواجباته السياسية، بطرق الحوار والمساواة والديمقراطية.
بعدما أوضح لوك معالم مشروعه السياسي، وأساس التعاقد الاجتماعي راح جون لوك يهتم بما أطلق عليه بالحكم المدني، وأول ما وجه إليه نظره مُنظر التسامح، هو أنه قام ببحث ماهية الكنيسة قائلا: “وفي تقديري أن الكنيسة عبارة عن جماعة حُرّة من البشر الذين يجتمعون بمحض إرادتهم بهدف عبادة الله وبأسلوب يتصورون أنه مقبول من الله وكفيل بخلاص نفوسهم.”
ويضيف: “إن الكنيسة مجتمع حر ذو إرادة فلا أحد يولد عضوًا في أيّة كنيسة، وإلا فإن الدين في هذه الحالة، ينقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء تمامًا مثل الأرض طبقا لحق الإرث، وبناء على ذلك فإن كل فرد يحتفظ بإيمانه بنفس الطريقة التي يحتفظ فيها بأراضيه.”
لم يكتف لوك هنا بتحرير الإنسان من وصاية الكنيسة كما هو شأن هوبز بل إن تحرر الانسان قد طال علاقته بالدولة نفسها، “فالعناية بخلاص نفوس البشر ليست من مهام الحاكم بأي حال من الأحوال وذلك راجع على أن سلطة الحاكم لا تمتد إلى تأسيس أية بنود تتعلق بالإيمان أو بأشكال العبادة استنادًا إلى قوة القوانين.
ذلك أن القوانين تفقد سلطتها إذا لم تقترن بالعقوبات، والعقوبات في هذه الحالة تصبح منعدمة انعدامًا مطلقا لأنها عاجزة عن إقناع العقل.”
هل هذا العجز الخطير من قبل الدولة في فرض وصيتها على إيمان الأفراد، يعني أن لوك يدعو الحاكم إلى الدخول في نزاع مع الدين أو مع الكنيسة؟
كان همَّ لوك الأساس هو تحرير الدين من سلطة البشر وجعله علاقة خاصة ومباشرة بين الله وعباده، لذلك فهو حريص جدا على ألا تظهر سياسته كأنها معادية للدين يقول: “فسلطة الحكم لا تفرض على الحاكم أن يتغاضى عن إنسانيته أو عن مسيحيته ولكن يجب التفرقة بين الاقناع والأمر،
فأن تلزم بالحجج شيء وأن تلزم بالعقوبات شيء آخر والأخير إلزام من حق السلطة المدنية وحدها، بينما إرادة الخير هي سلطة البشر الوحيدة”، فتمييز مهمات الحكم المدني والدين واضح جدًا عند جون لوك، وتأسيس الفصل العلماني بينهما،
وكما درج القول سبينوزا أيضا فلوك يؤكد أنه إذا لم تكن هناك حدود فاصلة بينهما )الدين والدولة( فلن تكون هناك نهاية للخلافات التي ستنشأ على الدوام بين من يملكون الاهتمام بصلاح النفوس من جهة ومن يهتمون بصالح المجتمع المدني من جهة أخرى.
إن ثورة لوك الإيجابية واضحة جدًا من خلال، “منحه هوية جديدة للعقد الاجتماعي وعلمنة الدولة، وذلك من خلال تموضع العقل في هذه الفلسفة، “صوت الله في داخل الانسان”، وهذا هو جديد لوك، لأن الرغبة، أي الرغبة القوية في المحافظة على حياة الانسان ووجوده،
قد غرسها الله نفسه فيه “الانسان” من حيث إنها مبدأ للفعل، فإن العقل الذي هو صوت الله بداخله لا يستطيع سوى أن يعلمه ويؤكد له أنه عندما يتعقب هذا الميل الطبيعي الذي لديه للمحافظة على وجوده فإنه يتبع إرادة خالقه.”
هناك ميزتان تميزان فلسفة لوك السياسية أولها: تشجيع المواطن على سماع صوت العقل بداخله وتوظيفه بشكل جيد ضمانًا لعبادة عقلانية صحيحة من جهة، وتحريره للإنسان من العبودية والوصاية من جهة أخرى.
تكمن قيمة الإنسان في حرية عقله وتوظيفه توظيفًا جيدًا، ولا يصح ذلك إلا بفسح المجال للحرية، ولا يجوز هنا كبح الرغبات الانسانية مادام الانسان قادر على توجيه رغباته، بالعقل. “لقد درج التقليد لدى الفلاسفة السياسيين القدماء، على أن الانفعالات هي تعسفية وطغيانية، ومعتقدين أن الميل إلى الانفعالات هو فضلًا عن ذلك لاستبعاد الناس،
لقد تعلموا بالتالي أن الانسان لا يكون حرًا إلى الحد الذي يكون فيه العقل قادرًا على أن يكبت انفعالاته ويحكمها بطريقة أو أخرى؟” غير أن لوك عرّف الانفعالات بأنها القُوّة الأسمى في الطبيعة البشرية، وبرهن على أن العقل لا يستطيع أن يفعل سوى أن يخدم الرغبة الكلية والأكثر قُوّة،
ويوجهها إلى تحقيق غرضها وعندما يفهم هذا التنظيم للأشياء ويقبل بوصفه التنظيم الطبيعي والحقيقي، يكون هناك نجاح لكفاح البشر من أجل الحرية والسلام والرخاء وهذه قبل كل شيء آخر، هي تعاليم لوك السياسية.
هذا هو مضمون الحكم المدني اللوكوي، فكيف استقبله روسو؟ هل نقدًا أو نسجًا على منواله؟
- المبحث الثاني: جون جاك روسو: الدين الطبيعي
لم يحذ روسو كثيرًا حذو النقاش الدائر عن سياق عصره والأحداث التي تكتنفه حول ماهية العقد الاجتماعي، على الرغم من الاجماع الكلي حول مضمون التعاقد المجتمعي وماهيته بين مختلف فلاسفة العقد الاجتماعي. بينما “يرى هوبز آلية لنقل الفرد من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني،
وما يقابل ذلك من تخلي الانسان عن جانب من حريته لصالح الحكم المطلق، فإن لوك يؤسس لحكم مدني مبني على الديمقراطية وحق الفرد في عزل الحاكم إذا لم يفلح في ضمان حقوقه الأساسية وحرياته. في هذا السياق جاءت نظرية روسو لتعزز النقاش، وتقترح حلولا”. ؟
“فالعقد الاجتماعي عند روسو، ليس عقدًا بين الأفراد كما هو عند هوبز، ولا عقدًا بين الأفراد والحاكم، وإنما هو عقد يتّحد بموجبه كل واحد مع الكل، العقد معقود مع المجموعة والحاكم، فنظرية العقد الاجتماعي عند روسو، تدور حول وحدة الجسم الاجتماعي وتبعية المصالح الخاصة للإرادة العامة، وحول السيادة المطلقة غير المنفصلة عن الإرادة العامة، التي هي إرادة الأعضاء الذين يؤلفون المجموعة”.
من مواصفات العقد الاجتماعي عند روسو، أن السيادة لا يمكن التصرف بها ولا تنتقل بالتوكيل، ومن ثمة فإن نواب الشعب ليسوا، ولا يستطيعون أن يكونوا ممثليه، وإنما هم مجرد مفوضين، والسيادة لا تتجزأ، إنما هي مطلقة، إذ أن العقد الاجتماعي يعطي الجسم السياسي سلطة مطلقة على جميع أتباعه.
غير أن العقد لا يكون دائما في صالح المواطن وإنما قد يضر به في بعض الأحيان ما دام روسو يؤكد أن العقد الاجتماعي ليس كله خيرا بالنسبة إلى المواطن يقول: “فالذي يخسره الانسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية وحق مطلق في كل ما يحاول وما يمكن أن يحصل والذي يكسبه هو الحرية المدنية وتملك ما يجوز ويجب، لعدم الخطأ في هذه المعارضة،
أن تماز الحرية الطبيعية التي لا حدود لها غير قوى الشخص، من الحرية المدنية المقيدة بالإرادة العامة، وأن تماز الحيازة التي ليست سوى نتيجة قوة المستولي الأول أو حقه، من التملك الذي لا يمكن أن يقوم على غير صّك إيجابي”.
هذا يعني أن الفرد في العقد الاجتماعي، يخسر حريته الطبيعية في مقابل كسبه الحرية المدنية وملكية كل ما في حوزته، يقول روسو “وما يمكن حدوثه أيضا بدء الناس بالاتحاد قبل حيازة شيء وأنهم إذ يستولون، فيما بعد على أرض كافية للجميع يتمتعون بها مشاعًا أو يقتسمونها فيما بينهم بالتساوي أو على حسن النسب التي يضعها السيد ومهما يكن الوجه الذي يثم به هذا الاكتساب.
فإن حق كل فرد على عقاره الخاص يكون تابعًا دائمًا لحق الجماعة على الجميع، ولولا هذا لم توجد متانة في الرابطة الاجتماعية ولا قوة حقيقية في ممارسة السيادة”.
لكن، ما تبعات هذا التعاقد على مستوى العلاقة بين الدين والدولة؟
لقد بدا لروسو أن التطبيق الأفضل هو: “التربية المدنية على مدى الحياة، عن طريق دين الدولة وهو الدين المصمم بالتحديد لأغراض المدينة، وقد تصور روسو هذا الدين ليس من أجل تعليم اللاّهوت وإنما بغية التشجيع على القيام بالواجبات وعلى هذا الأساس أوجب روسو الصرامة الحاسمة التي تصل إلى درجة مطالبته بنفي كل من لا يؤمن بدين الدولة.
وذلك ليس لعدم التقوى، بل لكون الذي لا يؤمن بمبادئ دين الدولة غير اجتماعي أي أنه كفرد غير قادر على أن يحب القانون والعدالة بإخلاص، أو أن يضحي بحياته في سبيل واجبه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك،
أما إذا عمد أي شخص بعد تسليمه بهذه المبادئ إلى ألا يبالي بها فهو يستحق الإعدام، لأنه يكون، بذلك قد ارتكب أفظع الجرائم وهي الكذب أمام القانون” ويضيف: “ربما يرضع الأطفال حب الوطن من أمهاتهم لكن روسو لم يكن على ثقة بأن التأثير يدوم من دون تعزيز طوال الحياة.
فقد صرح بأن المدارس يجب أن تضمن فهم تلاميذها لقواعد المجتمع ومبدأ المساواة والاحساس بالإخاء. لكنه آمن أن المدارس نفسها لها فعالية محدودة في هذا المضمار، فإن التطبيق الأفضل للتربية المدنية على مدى الحياة “أو التربية الاجتماعية بالتعبير الحديث”.
يتم عن طريق دين الدولة مصمم بالتحديد للأغراض المدنية، وقد تصور روسو دينًا مدنيًا كهذا ليس من أجل إذاعة ودعم معتقد لاهوتي، بل من أجل تعليم عقيدة تختص بالأخلاق والواجبات، كما أوضح أن الصرامة الشديدة كانت مطلبًا في فرض الانضباط.”
فالمواطن الذي يكذب أمام القانون لا يكون حرًا في الحقيقة بالمعنى المدني للعيش في حرية مجتمعية من خلال القيام بالواجبات المتبادلة، “إن الحرية بالغة الأهمية ومكفولة بالإرادة العامة، لذلك جاء التأكيد المشهور “من يرفض إطاعة الإرادة العامة”…”، يرغم على أن يكون حرا”.
لكن هل هذا يعني أن على صاحب السيادة في نظر روسو التدخل في حرية الضمير كي يفرض الالتزام بدين الدولة؟ والسماح أيضا بالتدخل في الشؤون الدينية للمواطنين؟
يجيبنا روسو بالقول “…بيد أنه من شأن الدولة أن يكون لكل مواطن دين يحبب إليه واجباته، ولكن عقائد هذا الدين ليست من شأن الدولة ولا من شأن أعضائها إلا بقدر ما لهذه العقائد من صلة بالأخلاق والواجبات التي ينبغي على معتنقيها أن يؤديها تجاه غيره، عدا ذلك يمكن لكل شخص أن يتخذ لنفسه من الآراء ما يروقه من دون أن يحق لصاحب السيادة العلم بها.”.
بل ويُحمّل روسو صاحب السيادة مسؤولية فشله في الأمر على الرعايا وتوجيههم في أمور الآخر إذا تدخل في هذه المسألة، مبررًا قوله روسو “أن صاحب السيادة وهو الذي لا كفاءة له البتّة في الآخرة، كائنًا ما كان مصير الرعايا في الدار الآخرة، لا شأن له بأمرهم شريطة أن يكونوا مواطنين صالحين في الحياة الدنيا”.
“فإعلان إيمان مدني خالص يعود لصاحب السيادة أن يضبط بنوده لا على جهة أنها بالتدقيق عقائد دينية، بل على أنها شعور بالأُلفة الاجتماعية “sociability” من دونه لا يمكن للمرء أن يكون لا مواطنا صالحا ولا رعية من الرعايا المخلصين.
ولئن لم يكن في مستطاع صاحب السيادة أن يلزم أيا من الأشخاص بالتصديق بتلك البنود، ففي مستطاعه أن ينفي إلى خارج الدولة شخصا، كائنًا من كان لا يصدق بها، بإمكانه أن ينفيه لا على أنه كافر وإنما على أنه غير قابل للاجتماع، وعاجز عن حب القوانين والعدل بإخلاص وعن نذر حياته لواجبه إذا دعا الداعي”.
“بيد أن روسو يرفض ما ذهب إليه “واربورتون” “William Warburton”، “مؤكدًا أن كلا من السياسة والدين موضوعًا مشتركًا عندنا، لأنهما حسب روسو كليهما كان إبّان أصل الأمم وانبعاثهما أداة يستخدمها الآخر”، ولذلك وجب على الدولة من منظور روسو أن تراعي التوافق دائمًا بين العلاقات الطبيعية والقوانين على المسائل نفسها.
وذلك من أجل ضمان الأُلفة الاجتماعية أما الذي يرجع إليه الحق في وضع القوانين والتشريعات فهو الشعب نفسه يقول روسو، “لقد رأينا أن السلطة التشريعية تعود إلى الشعب ولا يمكنها إلا أن تعود إليه هو بالذات وعلى العكس من ذلك، من اليسير أن نتبين بالمبادئ المقررة أعلاه أن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تدخل في باب العمومية وكأنها مشرعة أو ذات سيادةّ.
وذلك أن هذه السلطة إنما تشتمل على أفعال جزئية لا تدخل البتّة، لا في نطاق القانون ولا بالاستتباع في نطاق صاحب السيادة، وهو الذي لا يسع جميع أفعاله إلا أن تكون قوانين، “…”، ومن ثم لابد أن يكون للقوة العمومية عامل مخصوص عليها يوحدها ويحركها بحسب اتجاهات الإرادة العامة.
ويصلح أداة اتصال بين الدولة وصاحب السياسة، ويفعل على نحو من الأنحاء في الشخص العمومي ما يفعله اتحاد الروح والجسد في الانسان، ألا إن هذا هو السبب في قيام حكومة داخل الدولة”.
فالعقد الاجتماعي “يشكل صاحب السيادة، وعندما يتكلم روسو عن لفظ صاحب السيادة “sovereign” فلكي يشير إلى أن مصدر كل مشروعية هو الشعب بوجه عام من حيث إنه يقابل الملك أو الأرستوقراطيين، أو أي قطاع آخر ولابد أن تكون هناك حكومة وقد تكون ملكية أو أرستقراطية أو ديمقراطية، غير أن حثّها في الحكم يستمد من الشعب ولا يمارس إلا طالما أن يرضيه وطالما أن الطبيعة والدين الموحى به مستبعدان.
فإن صوت الشعب هو وحده الذي يمكن أن يؤسس القانون، أي لابد أن يرجع كل تشريع إلى الشعب، أي إلى إرادته، فإرادة الشعب هي القانون الوحيد. ولا تطيع الحكومة سوى القانون فقط، وكل مواطن هو، باستمرار عضو من أعضاء المجموعة التي تسن القانون.
إنّ كل مواطن يجد نفسه في علاقة مزدوجة مع الدولة بوصفه مشرعًا من حيث إنه عضو من أعضاء صاحب السيادة ومن حيث إنه يخضع للقانون أي بوصفه فردًا لابد أن يطيع”.
ينبغي ألا تفهم الديمقراطية التي نادى بها روسو، أو مناداته بسيادة الشعب، على أنها ديمقراطية تمارس بالطريقة المعهودة لأن هذا الأمر مستهجن حسب روسو فلم يكن روسو من دعاة التحرر بالمعنى الحديث للكلمة، حيث لا يستطيع كل إنسان أن يعيش كما يجب لأن ذلك “يقضي على إمكان الاتفاق، ويحطم مصادر الطاقة الأخلاقية الضرورية لضبط الذات.
ويزدري روسو الديمقراطية كما تمارس عادة، لأنها تعني فوضوية متوحشة للمصالح الخاصة والإصرار الصوري على تصويت الشعب ليس له معنى بدون تأسيس شروطه الأخلاقية المسبقة.”
نفهم مما سبق أن مفهوم الديمقراطية مفارق لتلك النظرة التي لا ترى في الديمقراطية غير كونها آلية إجرائية تنظم عملية التداول على الحكم وإنما هي ديمقراطية قائمة على أخلاق، مخطط لها مسبقا، أي أنها أخلاق من شأنها تجنيب الدولة من فتن الطائفية الدينية وفوضى روادها.
غير أنه، لماذا يُصّر روسو على دين الدولة، وما الفرق بينه وبين دين الفطرة؟ ولماذا ربط روسو هذه الديمقراطية بأخلاق مخطط لها سابقا؟
يجيبنا روسو، “المسيحية دين روحي بتمامه وكماله وهي منشغلة بشؤون السماء حصرا، أما وطن المسيحي فليس من دنيانا هذه. صحيح أن المسيحي يؤدي واجبه، ولكنه يؤديه وهو لا يبالي مبالاة عميقة أن يلقي انشغاله للنجاح أو للفشل. وشريطة ألا يأتي شيئا يلوم عنه نفسه، فسواء عنده أن يجري كل ما في هذه الدنيا بالخير أو بالشر.
فإما إذا كانت الدولة مزدهرة، فقل إنه لا يجرؤ على الاستمتاع بالنعيم العمومي، أو يكاد وهو على خيفة من أن يتفاخر بمجد بلاده. وأما إذا صارت الدولة إلى الفناء، بارك يد الله التي هوت بثقلها على شعبه”.
فعلى الرغم من وصف روسو للمسيحية بأنها دين روحي بتمامه وكماله، إلا أنه، “يسجل عليها، أنها منشغلة بشؤون السماء حصرًا، أما وطن المسيحي فليس من دنياها هذه. وهذا في نظره يجعل المسيحي لا يؤدي واجباته الدنيوية كما ينبغي، فهو لا يعرف كيف يتمتّع حينما تكون الدولة مزدهرة، وعندما يصيبها الخراب، فإنه يبارك يد الله التي هوت بثقلها على شعبه”.
يؤاخذ روسو المسيحية، لأنها، “لا تساعد المؤمن بها على أداء واجباته الدنيوية، وتجعله زاهدًا في تطوير سبل العيش الكريم، بل إنّ المسيحية لا تعظ إلا بعظة العبودية والتبعية، ولها روح ملائم للطغيان غاية الملائمة فلا يسعها إلا أن تربح من جرائه دائما، لقد قيّض المسيحيين الحقيقيين بأن يكونوا عبيدًا وهم يعلمون ذلك ولكن لا يحركون له ساكنًا، فقيمة هذه الحياة القصيرة الضئيلة عندهم ضآلة مفرطة.”
أما دين المواطن، فمن شأنه، أن ينتج رعايا مخلصين عبر تقديس الدولة والأمة. يقول روسو: “لأجل أن يكون المجتمع وديعًا، وأن يدوم الانسجام لزم أن يكون المواطنون، جميعهم من دون استثناء، مسيحيين صالحين على حد سواء”.
إن الامتياز الوحيد في دين المواطن، هو أنه إعلان إيمان مدني صرف يقرر الحاكم مواده لا بالتحديد كعقائد دينية، بل كمشاعر مجتمعية يستحيل من دونها أن يكون المرء مواطنًا صالحًا أو من الرعايا المخلصين، لكن ما نوع هذا الدين الذي يدعو إليه روسو؟
نبدأ من تساؤل روسو حيث يقول: “أستغرب أن يدّعي أحد أننا في حاجة إلى دين آخر من أين لي أن أعرف تلك الحاجة؟ ولم أُلام إن عبدت الخالق حسب التعاليم التي بتّها في ذهني والمشاعر التي أفعم بها قلبي؟ أي سلوك أنصع، أي معتقد أنفع للمخلوق وأكتر تشريفًا للخالق.
أنا لهما من اعتناق شرائع منزلة ولا أكتسبها أبدًا إن اكتفيت باستغلال مواهبي؟ بين لي ما يمكن أن يضاف حمدًا للرب، خدمة المجتمع ولمصلحتي الخاصة، إلى الواجبات التي حددتها لي الطبيعة؟ أيّة فضيلة تنشأ عن مناسك مستحدثة ولا تنتج عن مناسكي أنا؟ أسمى صورة نكونها عن الخالق ندركها بالعقل وحده.
لننظر إلى الكون، لننصت إلى صوت الوجدان، أولم يقل لنا الرب لبصرنا، لضميرنا، لعقلنا، كل ما أراد؟ ماذا يمكن للإنسان أن يضيف إلى ذلك؟ مكاشفاته لم تفعل سوى الحط من قدر الخالق إذ تنسب إليه نزوات البشر”.
يحاول روسو أن يجد أجوبة شافية عن أسئلته المطروحة من خلال وصوله إلى تحديد معين لمعنى مفهوم دين الفطرة، وهو يحدده في هامش كتابه بالقول “دين الفطرة هو وقاية ضد انتشار الزندقة المؤدية إلى الإباحية والفوضى الأخلاقية، في ظروف أوروبا القرن الثامن عشر، لم يعد الخيار بين الكاثوليكية والعلمانية بقدر ما أصبح بين دين الفطرة “عقيدة القس” والإلحاد”.
إن جوهر أسئلة روسو مفادها، أن دين الفطرة من شأنه الوقاية من انتشار الزندقة المؤدية إلى الإباحيةوالفوضى الأخلاقية في ظروف أوربا القرن الثامن عشر.
في إطار توضيح روسو لمذهبه، يدعو إلى أنه، “ما من حاجة إلى عبادة الله بالوحي، لأن تلك التعاليم الخاصة بالشرائع لا توضح أسرار الكائن الأعظم بقدر ما تزيدها غموضا حيث لا تصورها صورة أسمى بل أكثر ابتذالا، وتضفي عليها طابع من التناقضات السخيفة ناهيك، عن كونها تعلم الناس الغرور والتعصب والقسوة، لا تقيم السلم على الأرض بقدر ما تنشر فيها الخراب بالحديد والنار”.
فتلك العبادات الشاذّة في نظر روسو ما هي إلا صنع البشر، فالبشر هم من يتكلمون بصيغة الخالق، حتى أنطقه كل واحد على هواه، يقول روسو: “كان لابد من الوحي لكي نعرف على أية صورة يريد الخالق أن نعبده، ويستشهد على ذلك بعدد الطقوس الشاذة البشعة التي سنّها الانسان.
بدون انتباه إلى أن مرده الاختلاف هو بالضبط تعدد الوحي، ما إن بدا البشر أن ينطقوا الخالق حتى أنطقه كل واحد على هواه وضمن كلامه ما أراد من معان لو اكتفوا بما أملاه الخالق على قلب كل فرد، لما وجد على الأرض سوى دين واحد”.
إن العبادة حسب روسو، هي واجبة في كل ملّة، غير أنه يرفض مسألة تعدد العبادات التي تجلب الفوضى. يقول: “انتصب أيها الإنسان بكل قامتك، إنك في كل الأحوال ستظل لصيق الأرض يريد الخالق أن نعبده بحق وبصدق، هذا واجب في كلّ ملة، في كل بلد، على كل فرد، أما عبادة الظاهر، حركات الأعضاء، إن كان لابد أن توحد تفاديا للتناثر والفوضى.
فتلك مسالة نظام وسياسة، ولا تستلزم أي وحي”. بمعنى أن المغزى هو العبادة الروحية أما لو تعلق الأمر بعبادة ظاهرية فيجب إخضاعها للنظام والسياسة.
يمكن القول أن دين الدولة عند روسو هو مجموعة من المبادئ التي يقررها الشعب باعتباره صاحب السيادة الكبرى، “العليا”، وفي حالة عدم طاعة أحد المواطنين مبدأ دين الدولة فإن مصيره سيكون العقاب، الذي قد يصل إلى درجة النفي.
أما دين الفطرة فهو ذلك الدين الذي يغيب فيه الوحي والشعائر وكثرة الطقوس، واستحضار في مقابل ذلك الاتصال الروحي بالمراد الإلهي دون واسطة، وإذا كان الدين الأول إجباريا يفرض على صاحب السيادة، فإن الدين الثاني اختياري حر، فأساس الإيمان الصادق مع روسو ومع من سبقوه، هو القائم أساسا على الاقناع الروحي، ما دام الله قد تواضع وخاطب البشر مباشرة في القلوب دون تدخل أحد.
يمكن تلخيص مقولات روسو، كما جاءت في ترجمة الأستاذ العروي “دين الفطرة”، على الشكل التالي: “الإيمان في خدمة النفس، الدين في خدمة المجتمع، المجتمع في خدمة الفرد، واضح أن هذا المنطق يصدم الفلسفة والكنيسة معا، لكنه في الوقت نفسه قابل للتوظيف من قبل كلا الطرفين”، ويضيف: “فردانية روسو مطلقة.
إذ يقول إن الفرد لا يسعى إلا إلى ضمان سعادته، وأعلى صورة للسعادة هي رضى النفس على ذاتها، هذا هو أهم أركان الحداثة، لكن تعامله مع الدين كظاهرة اجتماعية سياسية يمثل أيضا ركنا أساسيًا من الحداثة نفسها تلتقي عند روسو النظرتان، الفلسفية والشعبية “العامة” للدين لأنه كان بحق فيلسوف العامة”.
- المراجع والمصادر المعتمدة
– صالح، هشام، مدخل للتنوير الأوربي، دار الطليعة، بيروت ط 1، 2005م، ص 145
Emmanuel Kant « Réponse à la question: qu’est-ce que les lumières ? » 1784 p2
– جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1 ، 2011م
– عبد الرحيم العلام، العلمانية والدولة المدنية، تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط1، 2016م
– جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1 ، 2011م
– عبد الرحيم العلام، العلمانية والدولة المدنية، تواريخ الفكرة سياقاتها وتطبيقاتها، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط1، 2016م
– ليو شتراوس، جوزيف كروبسي، “تاريخ الفلسفة السياسية”، من جون لوك إلى هيدغر، الجزء 2، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمام عبد الفتاح، المشروع القومي للترجمة ، القاهرة، 2005م
– جون لوك، “رسالة في التسامح”، ترجمة منى أبو سنة، تقديم ومراجعة، مراد وهبه، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، مصر، ط 1، 1997م ص 19
– جان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط 2، 1995م
هيتر، ديريك، موجز تاريخ للمواطنية، ترجمة، آصف ناصر ومكرم خليل، دار الساقي، بيروت، ط 1، 2007م.
دين الفطرة، نقله إلى العربية، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1 ،2012م.