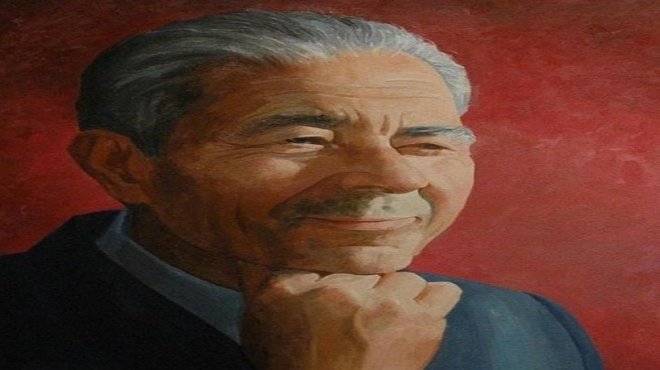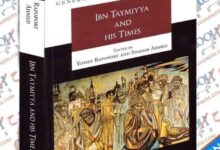أُسدِل الستار قبلَ أسابيعَ عن النسخة الـثانية عشرة من الجائزة العالمية للرواية العربية. فكان لا بد أولاً أن نُبارك للقاصة اللبنانية هدى بركات فوزَها بالجائزة، عن روايتِها “بريد الليل” مع التنويه بمجهودِها الكبير في الكتابة الروائية وبتجربتِها شديدة الخصوصية؛ بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي وقدرتها على تصوير العمق الإنساني.
كما كان لا بد من الوقوف قليلا لتقييم هذا السيل الجارف من الأعمال الروائية التي تتناسل علينا كالفِطر طيلة العقدين الماضيين وإلى اليوم. وافتحاص الحالة الراهنة للإبداع الثقافي العربي؛ خاصة ما تعلق بالإبداع الروائي؛ وما آل إليه من ضعف وتراجع، والوقوفِ على مكمن المشكل.
إن الإبداع الثقافي؛ انعكاسٌ للمجتمع، يتطورُ تبعاً لتطوُّرِه، ويتراجع ويَجمُد تبعاً لما يعتريه من جُمودٍ ورُكود. إلا أن هذا الإبداع؛ سواءً أكان شعراً أو نثراً، وَجَبَ أن يظل مُحتفظا بمقوماتِه الذاتية التي ينهض بها كجنسٍ أدبيٍّ ليكون إبداعاً حقيقةً لا عنواناً فقط.
كانت الجودة حاضرةً دائما؛ بل ومُهيمنة في الإبداع الأدبي العربي إلى زمن قريب وإنْ بدرجاتٍ مختلفة، وكانت تضْمَنُ للقارئ والناقد معاً؛ مادةً أدبية حقيقيةً متينةً، فيها روح الإبداع؛ وجمالية النسج؛ وأُفق الخيال؛ ورحابة التأويل والتذوُّق. إلا أن الحالة الثقافية والأدبية العربية قد تغيَّرت في العقديْن الأخيريْن تغيُّراً كبيراً، بسبب الانفتاح العالَمي الذي أعقب العولمَة الشامل.
هذه العولمة التي قرعتْ أبوابَ ونوافذ العالَم العربي؛ وجدتْ حالة من الجمود والركود والتراجع على كلٍّ المستويات وعلى جميع الأصعدة؛ فكانت نتائجُها علينا سيئة للغاية؛ خصوصا في المجال الثقافي؛ بخلاف ما أحدثَتْهُ في الغرب. حيث استطاعَ الإبداع الثقافي في العواصم الأدبية الغربية أن يتطور ويتقوى وينفتح تبعاً لما استجدّ ويستجدّ.
ويجدَ لنفسِه باستمرارٍ؛ أداوتٍ ووسائل وموضوعات تعبيرية جديدة؛ بل وثوريةً؛ مُتماهيةً ومُنسجمة غاية الانسجام مع الألفية الجديدة. فأصبحنا نتحدث عن الرواية الرقمية (النص المترابط)، الذي يضم مساقات عديدة ومختلفة تحمل القارئ إلى عوالم كثيرة متنوعة ومختلفة.
بخلاف ما اعتادَهُ في الروايات الكلاسيكية والمعاصرة، حيث الأحداث تدور في فضاءات مألوفة ومغلقة ومعلومة كالمقهى والزقاق والشارع والمحطة والمواصلات و…
على المستوى العربي؛ يُمكننا أن نُعاين السوء الذي تردى إليه الإبداع الثقافي عموما، والإبداع الروائي العربي الجديد على وجه الخصوص. وذلك من خلال خمسة عناصر أساسية هي:
– المبدع
– الناشر
– الناقد
– الإعلام الثقافي
– الجوائــز
الرواية؛ هي الصورة الدقيقة والصميمة للمجتمع ومرآتُه، وبالتالي؛ وجب على المبدع أو الروائي أن يُحقق هذه الرؤية وهذه الصورة. لكن للأسف؛ الغالبية الساحقة من طوفان الروايات التي صدرتْ وتصدُر منذ 2004م إلى اليوم؛ لا تُحقق هذا الشرط البتة، بل لا تأبَه به أصلا.
لقد استطاعت الرواية العربية أن تحُوزَ لقب ديوان العرب؛ بعد أن أزاحت الشعر من على عرشِه وتربعت مكانه، لكنها لم تستطع أن تُعزز الكم بالكيف، فامتلأت رفوف المكتبات بالغث منها قبل السمين، وظلت نقط الضوء في الرواية العربية قليلة جداً ومعدودة؛ بل ونادرة.
وإذا ما حاولنا أن نُدقق أكثر في عينة من هذه الإنتاجات الروائية (طبعاً؛ دون أن نذكر عناوين بعينِها احتراما للذوق العام)، أمكننا أن نصنِّفَها إلى ثلاثة أقسام؛
- القسم الأول: يمكننا أن نُدرجه تساهُلا ضمن جنس الرواية، ولكنه لا يحمل روح الرواية العربية الجديدة، ولا تكاد تجد فيه إبداعا أو خيالا حقيقياً.
وتظلُّ هذه العينة من الإنتاجات تُكرر النماذج التأسيسية، وتحوم حول نفس الموضوعات القديمة، بأدوات تعبيرية هزيلة؛ فتجد شخصيات الرواية محبوسة في فضاءات مألوفة بين البيت والمقهى والمحطة، والمواصلات و..، يُمارس بها الكاتب عملية السرد دون أن يُجاوزَه إلى فعل روائي حقيقي يَكتنه موضوعاتٍ كبيرة ويَستحثُّ القارئ على المشاركة في نبش تفاصيلِه والنفوذ إلى مضامينِه.
- القسم الثاني : وهي أعمالٌ؛ يتوسَّل من خلالِها الكاتب إلى طرْقِ باب المحرَّمات أو الطابوهات أو المقدس، (لغاية في نفس كاتِبها). أوْضحُها؛ أن يطفو عنوان عملِه إلى السطح في زحمة الموضوعات المستنسخة والمستهلَكة، دون أن يُفلح في ذلك لا موضوعاً ولا سرداً.
- القسم الثالث : هي تلك الكتابات التي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن نُدرجَها ضمن جنس الرواية. إذ لا تتوفر فيها شروط الرواية الحقيقية. وإنما هي محاولات سردية تجميعية؛ أكثرُ منها عملاً أدبياً مُنسجماً ومتآلفاً من حيث الحبكة والبناء والموضوع.
ساهم في ظهور هذا النوع الأخير وانتشارِه؛ تجرّؤُ غير الروائي على الرواية، فأصبح الناقد يكتب الرواية؛ ومعه السياسي والصحفي والحرفيّ والفنان، وسائق سيارة الأجرة، وكلُّ من هبَّ ودب صار يتصدى للرواية كتابةً وتأليفا.
ولَّـدَ هذا الانفلاتُ وهذه الفوضى الروائية تراجعَ وانحصارَ جودة الرواية العربية، أعقبَهُ ضُعف التلقي تبعاً لِضعف هذه النصوص، انتهاءً إلى تراجع الدراسات النقدية بسبب ضعف وهَزالة المادة الأدبية (الرواية).
- المبدع
أ- المبدع المبتدئ
تعتري المبدعَ المبتدئ عادةً؛ حالةٌ من فرط التفاؤل بأنه يستطيع أن يُنجز عملاً غير مسبوق، لكن هذه الحالة سرعان ما تتلاشى عندما يتعمق الكاتب المبتدئ رويدا رويدا في الاطلاع على الأعمال الكبيرة والمهمة ولمدة طويلة من الزمن، فيكتشف بنفسِه عَجزَه ومحدودَ قُدراتِه. عند هذه النقطة بالذات؛ يولد الكاتب والمبدع الحقيقيّ.
هذه الخاصية؛ انقرضت مع الجيل الجديد من كُـتاب الرواية العربية، فكلٌّ يُغلق على نفسِه باب غرفتِه أو مكتبِه ويُنفق الساعات الطوال في الكتابة أكثر مما يستثمر منها في القراءة.
وهو بذلك يُوقن في قرارة نفسِه أن ما يكتبُه عملٌ جبار يستحق أن يُنشر، فيُحيلُ المسودة مباشرة إلى الناشر، دون أن يُكلف نفسَه عرضَ هذه المسودة على أساتذتِه أو زملائه لتقييمِها؛ ضماناً للحد الأدنى من الجودة، أو على الأقل؛ تقويم لغتِها وتهذيب أسلوبِها؛ وذلك أضعفُ الإيمان.
- ب- المبدع المُتمرّس
انخرط مؤخرا كثيرٌ من كُتاب الرواية في موجة “الإكثار”، استجابة للمنافسة والظهور، في ظل تسونامي الروايات الذي أغرق المكتبات العربية. فلا نكاد نتلقف خبرَ صدورِ روايةٍ جديدة لكاتب؛ حتى نُدهش بنبأ صدور رواية أخرى جديدة لنفس الكاتب. حتى صار من الصعب تتبع ما يجِدُّ من روايات للكاتب الواحد، فضلا عن مواكبة ما تَعتملُ به رفوف المكتبات العربية.
هذه الظاهرة؛ فرضها الإعلام بشكل عام؛ والإعلام الرقمي على وجه الخصوص وما يُتيحُه من فُرص للتسويق والمنافسة، واقد استجاب لهذا كثير من الكُتّـاب العرب. لأغراض مادية بحثة تبدأ برفع مستوى مبيعاتِهم من الرواية؛ ثم لفتِ أنظار النقاد، انتهاءً بمضاعفة حظوظهم في الحصول على جائزة.
الجائزة هي من تسعى للمبدع وليس العكس
الجائزة تتويج لمسار طويل وحافل للأديب وليست أجرةً على كتاباتِه
لقد قضى نجيب محفوظ عقودا يخطُّ مشروعَه السردي ويكتب عن مصر والقاهرة؛ زقاقا زقاقا؛ وحارة حارة، مُديراً ظهرَهُ للجوائز لا يلتفتُ إليها. إلى أن طرقت نوبل بابه. أما اليوم فقد عشنا ورأينا كيف يسعى الكاتب والروائي للجائزة سعيَه في لقمة العيش.
إن الأدب والكتابة بالنسبة للأديب والمبدع؛ شيءٌ آخر يختلف تماماً عن السلع والبضائع. فالذي يكتب إنما يكتب استجابة لحالة وجدانية وشعورية ونفسية تعتريه.
فالروائي الحقيقي على (سبيل المثال)؛ هو ذاك الذي يقول لنا وعنا وعن نفسِه كل شيء بالأدب، وهذا ما لا يستطيعُه كلُّ الناس. والقارئ في المقابل مُحتاج إلى أن يعرف نفسَه وواقعَه ومجتمَعَه من خلال مرآة الأدب؛ وليس من خلال شاشة الأخبار دائما. وهذا ما يجعل الأديب والمبدع متفردا ومتميزا.
وذلك أدعى لأن يبقى كذلك دائما. فالإكثار ليس دليلا على الجودة، كما أنه ليس معيارا للعالمية كما يتوهم كثير من كتاب الرواية العربية الجدد. فالروائي الحقيقي والناجح؛ قد يكتب عملا واحدا في حياتِه؛ لكن يبقى خالدا، ويستمر إشعاعُه الأدبي والنقدي لعقود طويلة؛ بل لقرون.
- الموضوع قبل الكتابة وليس العكس
الموضوع؛ هو ما يستحث الكاتب على الكتابة وليس العكس. فالفكرة أو الموضوع الواحد؛ قد يأخذ من الروائي الحقيقي وقتا طويلا جدا من التأمل والتفكير والقراءة والبحث والتحضير. ومِثلهُ من الوقت في الكتابة والتنقيح والتجويد.
وهذا ما يفتقدُه المبدعون وكُتاب الرواية العربية الجدد للأسف الشديد. فلا تكاد تجد موضوعاً حقيقيا ذا قيمة وذا حمولة دلالية فيما يجدُّ من روايات، وإن وَجَدْت فموضوعاتٌ أُنهِكَتْ وأُفنِيـت كتابةً واجترارا.
- الناشر
ليست المشكلة في الازدياد المهول في عدد الروايات العربية المطبوعة والمشورة، وإنما أُمُّ المشاكل في الكم الهائل من الرداءة والتفاهة التي تُطبع وتنشر تحت اسم ((روايــة)). فغالبية دور النشر العربية (إلا بِضعٌ منها معدودٌ على رؤوس الأصابع)، تعتبر أي شيء وكلَّ شيء رواية.
فتسربت الكثير من الإنتاجات الرديئة والتافهة إلى سوق الكتب بعناوين مغرية وبمحتوى فارغ وتافه، فأصبح القارئ العادي نهبا لهذه الرداءة التي ترقى إلى عملية نصب مُمنهجة؛ يتحمل فيها الناشر النصيب الأكبر من المسؤولية إن لم تكن كلَّ المسؤولية في إفساد الذوق الأدبي والثقافي العربي، بسبب عقلية التاجر التي تَحكُمُها.
فالناشر عندنا “تاجر”، أو في أحسن الأحوال؛ “وسيط” أو “ساعي بريد” كما يسميه سعيد يقطين. وليس مؤسسة تضطلع إلى جانب النشر؛ بتمحيص ومراجعة وفرز المواد قبل إجازتها للإصدار؛ لضمان النزر اليسير من الجودة، فضلاً عن التقدم بها للمسابقات والجوائز.
إن غياب مؤسسةِ نشرٍ عربيةٍ حقيقيةٍ تجمع بين المهام الأدبية والفكرية، إلى جانب البعد التجاري. جعل القارئ العربي نهبا للرداءة التي تساهم دور النشر في طباعتِها وإغراق الرفوف والمكتبات بها. فصار من الصعب الوصول إلى الأعمال الجيدة للروائيين والمبدعين الحقيقيين.
- الناقد:
عطفا على الناشر، فقد طبعت الحالة الثقافية والفكرية العربية في السنوات الأخيرة وبشكل لافت حالة من التسيب النقدي. فعل غرار الصحفي المأجور؛ ظهر الآن ما يمكن أن نصطلح عليه بـ “الناقد المأجور”، أو ما يمكن أن نُسميَّهم تجاوزاً بـ” نُـقّـادٌ تحت الطلب”.
وهم أولئك الذين يُنجزون دراسات نقدية على أعمال بعينِها لكُتابٍ مخصوصين بهدف إشهارِهم والدفع بأعمالِهم نحو حصد الجوائز. بغض النظر عن كون هذه الأعمال إبداعاً حقيقيا !؛ وعن كون أصحابِها كُتابا ومبدعين حقيقيين !؟.
لقد رصدنا ونرصد في محطات القراءة؛ الكثير من الأعمال التافهة التي يُتوِّجُها كاتبُها بعناوين ضخمة تحمل نفَساً تجاريا؛ أكثر مما تحمل روحاً إبداعية أدبية. ويكفي أن تقرأ الجمل التي باتت تتصدر أغلفة الروايات بالخط العريـض؛ وتملأ حيزاً أكبر من عنوان الرواية نفسِه من قبيل؛ (أول رواية عن الثورات العربية / أول رواية عن تنظيم الدولة – داعش / أول رواية عن المِثلية / …،).
ورغم تفاهة غالبية هذه الكتابات؛ إلا أنها لا تَعدِمُ من النقاد من يشحنُها بالكثير من اللغط النقدي الزائف؛ أشبهَ ما يكون بالدعاية والإشهار منه إلى قراءة وتحليل موضوعي.
لقد كانت القاعدة أن يسعى النُّقاد إلى الأعمال الجيدة والممتازة لنقدِها وتحليلِها وقراءَتِها. واليوم؛ صار الكاتب هو من يسعى إلى الناقد ليكتب له عن عملِه.
فصرنا نرى تجييشا مفضوحا للنقاد للكتابة حول أعمالٍ روائية بعينِها للإعلاء من شأنها والدفع بها نحو الجوائز. حتى صرنا نشك فيما يُكتب؛ وفي مَن يكتُب عن هذه الروايات. وصرنا اليوم لا نتحرج أن نقولها صراحة وبكل وضوح: هناك نُـقادٌ تحت الطلب يُشجعون الرداءة ويصفقون لها.
وهم من حيث يشعرون؛ يُفسدون الذوق الأدبي للقارئ بمساهمتِهم في إظهار الرداءة وإعلائها. ومن حيث لا يشعرون؛ يُساهمون في هدم النقد الأدبي العربي وإضعافِه. وهذا ملاحظ عيانا بيانا؛ فهذا الضعف والهزال الذي يعتري الإبداع الثقافي العربي؛ ما هو إلا نتيجةٌ طبيعية لضُعف النقد وتراجعِه. وقد لا نبالغ إذا قلنا؛ إننا صرنا نعيش حالة انحطاط أدبي ثقافي ونقدي عربي جديد.
ليس من حق الناقد أن يتصدى بالنقد للكتابات التي تنتهك قوانين الكتابة الروائية؛ وتخرج عن مقتضيات تقنياتِها الفنية والجمالية
- الإعلام الثقافي العربي:
منذ سنة 2005؛ برزت الكثير من الكتابات ((الروائية)) وطفت إلى السطح؛ لا بسبب جودتِها. وإنما بسبب ما نالتْه من تضخيم إعلامي غير مشروع وغير مبرر. بدءاً بتوالي الطبعات وحفلات التوقيع، والإشهار الورقي والالكتروني، حتى صارت بعض هذه الكتابات؛ الأكثر مبيعا؛ بل وتُرجم بعضُها إلى أكثر من لغة.
وبالرجوع إلى هذه الكتابات لتقييم مستواها؛ نجدُها في الحقيقة أعمالاً ضعيفة لا تستحق كل هذا الاحتفاء وكل هذا التضخيم. وإنما شفعَ لها تداخل العلاقات وتضارب المصالح بين الكاتب والنقاد والمؤسسات الفكرية والثقافية والأدبية وسلطة الإعلام.
هذه الحالة السلبية أورثتنا إعلاما ثقافيا عربيا ضعيفا جدا؛ منحازا؛ وغير موضوعيٍّ البتة. وفي غمرة الحملات الإعلامية الممنهجة التي يُسلط فيها الضوء على أعمال لأشخاص بعينِهم، صار من الصعب تمييز غث هذه الإنتاجات من سمينِها وجيدِها من رديئِها.
فعلى مدى سنوات راكمت المكتبات العربية من المحيط إلى الخليج مئات الروايات، منهم بِضعُ روايات فقط؛ هي من تحمل نفسا روائيا حقيقيا كالذي تحمِله رواية “رجال في الشمس” أو “وليمة لأعشاب البحر”، أو “مدن الملح” أو “الحي اللاتيني” أو …، كما تم الاحتفاء بعشرات الروائيين طيلة الثلاثة عقود القليلة الماضية.
لكن إلى الآن لا أحد منهم استطاع أن يلمَع بأعمالِه وإنتاجاتِه مثلما لمع؛ عبد الرحمن منيف، أو بهاء طاهر، أو غسان كنفاني، أو حيدر حيدر، أو أبراهيم جيرا، أو يوسف إدريس أو …،
- الجوائـز:
الجوائز تقليد ثقافي له أسسه وشروطُه وضوابطه. والهدف منها هو؛ الارتقاء بالإبداع بشكل عام، وتحفيز الكفاءات والمواهب والدفع بها إلى الظهور.
إلا أن الجوائز في عالمنا العربي عموما، وجوائز الإبداع الثقافي على وجه الخصوص، نسخة مُصغَّرة عن الجوائز والحوافز والترقيات والامتيازات والمناصب التي تُمنح في كل الحقول والمجالات، قاسمُها المشترك هو غياب النزاهة والمصداقية والفساد والمصالح والعلاقات. وغالبية الجوائز العربية التي تُمنح للرواية؛ ليست بِدعا من ذلك؛ إلا ما نَدَر.
تتمثل أزمة الجوائز العربية أساسا في غياب معايير حقيقية ودقيقة لقراءة النص الروائي، حيث تتأثر لجان التحكيم بالكتابات النقدية المشبوهة حول الأعمال المرشحة للجائزة دون تثبت أو تمحيص.
كما أن غياب معايير دقيقة وصارمة في فرز الأعمال الحقيقية من الكتابات التي لا ترقى إلى مستوى الرواية؛ يَحُدُّ من مصداقية الجوائز العربية؛ ويجعلُها تمنح اعترافا وهميا وغيرَ مستحقٍ لأشباه المبدعين.
- ملابسات جوائز الإبداع الثقافي العربية
إن ما يَخرج للعلن؛ هو الإعلان عن الأعمال الفائزة فقط، في حين يتم التستر على كواليس اللجنة العِلمية وعمليات التحكيم. وبالتالي؛ عدم إمداد لا المبدع ولا الناقد ولا القارئ؛ بمحاضر لجنة التحكيم، وعلى أي أساس تم الاستناد في إجازة هذا العمل؛ وعدَمِ إجازة الأعمال الأخرى ؟!
إن من المفيد جدا طباعة محاضر وتقارير لجنة التحكيم، لأنها ستساهم بلا شك في تبصير المبدع بالأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ قبل وأثناء وبعد عملية الكتابة. كما تعطي للناقد فكرة مبدئية عن العمل الفائز؛ وعن الأعمال التي لم يتم إجازتُها. ويفتح له ذلك الباب واسعاً أمام اقتحام النص تذوقا وتحليلا.
من المفيد للقارئ العربي معرفة ملابسات اختيار لجنة الجائزة، فهذا سَيُمكِّنُه من الحسم في اقناء العمل لفائز (رواية) مِن عدمِه؛ بدلَ تركِه في مَهبِّ المجازفة والمغامرة باقتناء عملٍ قد يجدُه جيداً وقد لا يجد. وما يستنزفُه ذلك من مالٍ ووقتٍ في قراءة عملٍ رديءٍ وتافه.
- الخلاصة
إننا بحاجة إلى إنتاجات روائية حقيقية لنقرأ واقعنا العام من خلال الأدب. إن هذا يمحنا إلى جانب التذوُّق والمتعة الأدبية؛ قدرةً على قراءة ما بين السطور والتحليل والتأويل والإبحار في لُجج الخيال، كما أننا نحتاج الرواية أيضا؛ في تقويم لغتِنا وتعزيز معجمنا اللغوي وتحسين مستوانا في الكتابة والتعبير.
ولكن عندما يعجز كاتب الرواية الجديد (المبدع) عن مُجرد إمدادِنا بمادة سليمة من حيث اللغة. فهنا يجب أن نقف ونطالب بإعادة تقييم معايير النشر التي تسمح بمثل هذه الإنتاجات الركيكة والضعيفة بالتسرُّب إلى الحقل الثقافي والأدبي والعربي.
عموماً؛ مازلنا نفتقر في عالَمنا العربي إلى تقاليد ثقافية للإبداع والنشر والتحكيم والتتويج. ويبقى الفساد هو الطاغي في تدبير أمورِنا الثقافية، على غرار ما يتم به تسيير المرافق الأخرى كالاقتصاد والصحة والتعليم و…،
إن كُتَّاب الرواية الجُدد الذين يتوسَّمون العالَمية من خلال ما يكتبون؛ يجدر بهم أن يُثبتوا العربية أولاً؛ قبلَ أن يخوضوا بحر الكتابة الروائية.
أما النُّقاد؛ فهم سدنة الحقل الإبداعي والفكري وحراسُه. فلا يجدُرُ بهم أن يَزِنُوا التراب بميزان الذهب. وإلا فَسَدَ الذوق؛ وتَجَرَّأ على الأدب من ليس بأديب؛ وحُقَّ بذلك لِغيرِ الناقد أن يتجرَّأ على النقد.