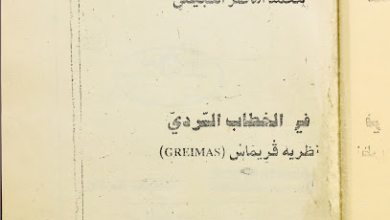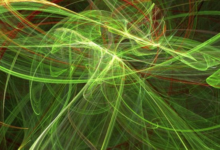تنازع “بروميثيوس” و”هرمس” على رسم شقاء “سيزيف”

في عصر ما بعد الحداثة عودة إلى الميثولوجيا، بوصفها نوعًا من بناء العمق، بعد التشكيك في قدرة العقل على السّير بركب الحضارة، فغدا حائرًا أمام الفهم؛ هذا العقل الذي كان سيّد عصر التّنوير.
الميثولوجيا بنية ذات مقطعين: ميتوس/ما يتنافى والعقل، ولوغس/ العقل، تُعنى بدراسة الأساطير ووظائفها النّفسيّة والفكريّة والاجتماعيّة، وبمعرفة بواعث نشوئها وتفسيرها. ما يهمّ الفكر الإنسانيّ رمزيّة أيّ نتاج فكريّ، والحفر المعرفي في الأثر الأدبي وليد التّجارب الإنسانيّة المغرقة في التّاريخ.
هكذا بدأت رحلة التّأويل بوصفه “فنّ الفهم”، من التأويل الّلاهوتي إلى التأويل الفلسفي الإنساني؛ “فما نفهمه نصيره” على ما يذهب سورين كييركيغارد، وما يتكشّف لنا من معانٍ هو في الوقت نفسه تكشّف الذّات، وفهم معاني العمل الفنّي هو أيضًا فهم الذّات.
نجد جذور التأويليّة أو الهيرمينوطيقا في الأساطير القديمة؛ إذ يعود لفظ المصطلح في أصله إلى الكلمة اليونانيّة “Hermeneus”، وتعني “المفسّر أو الشارح الذي يكشف عن شيء متوارٍ ومستور داخل النص. وهي مرتبطة بهرمس رسول الآلهة؛ يروح ويغدو بين زيّوس والآلهة الأخرى، أو بين زيوس والبشر.
فالتّأويل، تاليًا، هو الرّسول الّذي يتجوّل في منطقة “المابين”. والهيرمينوطيقا فلسفة التّجوّل في هذه “المابينيّة”. عملها هو حمل الرّسالة، وإظهار الكلمة، وكشف غير المقول، وتعرية ما يقبع تحت السّطح.
بيد أنّنا نجد من يجادل هرمس، ويقف على الحدّ الآخر/ النقيض من دوره، وهو بروميثيوس في جوابه إليه، معلنًا رؤيته: “تأكّد أنّني لن أستبدل عبوديّتك بمصيري البائس”. إن كان هرمس خادم الآلهة، فمن يكون بروميثيوس؟
يُعدّ بروميثيوس واهب الفكر والحكمة. تنسب الأساطير اليونانيّة إليه خلق الإنسان من تراب، وتجهيزه بما يلزمه لمواجهة الطّبيعة ومشقّات الحياة على الأرض. قام بروميثيوس بسرقة النّار الإلهيّة، وإفشاء سرّها للإنسان وكيفيّة توليدها واستخدامها؛ فنال من جرّاء ذلك غضب الآلهة، وعقاب كبيرها “زيّوس” الّذي كبّله إلى صخرة، جاعلًا نسرًا يأكل كبده… إذًا، برمزيّته، هو الحافظ الذي يعطي الإنسانيّة كل الفنون والعلوم ووسائل البقاء في الحياة، وهو محرّر الإنسان من الجهالة.
إنّ شهادة بروميثيوس هي شهادة الفلسفة الّتي تقف ضدّ الآلهة جميعهم الّذين لا يعترفون بالوعي الإنسانيّ إلهًا أسمى، على ما يذهب محمد الزّايد.
أشار إلى أسطورة بروميثيوس هزيود في كتابه “الأعمال”، ثم كتبها الشاعر المسرحي إسخيليوس في مسرحيّته “بروميثيوس مقيّدًا”، ثم أعاد صياغتها عام 1820 برسي تشيللي، الشاعر الإنجليزي، في مسرحية “بروميثيوس طليقًا”… بروميثيوس المتمرّد، سيّد الصّنّاع، ارتبط اسمه بالنار وبخلق الإنسان، يتجلّى صورة “للكلمة” أو تعبيرًا عنها. ليس ذلك وحسب، بل إنّ “اللغة تتكلّم عبر النّار والانفجار” بتعبير جاك دريدا.
بالخلق والإبداع الفنّي، وبالنّار صارت الكلمة طليقة فعّالة، بعد تحرّرها من عبوديّة الآلهة ويقينيّة معارفها الممنوحة؛ ترسم مسارها التّساؤلي، وتبحث، في شكّها، عن يقينها الخاص. “فالأنطولوجيا هي الأرض الموعودة لفلسفة تبدأ باللغة؛ والذات المتكلّمة بإمكانها وحدها أن تكشفها/ تدركها” كما يرى بول ريكور.
ما زال التّرحال سِمة الكلمة الماثلة في نتاج الإنسانيّة، والمكرّسة في تجاربها. تروح وتغدو في فضاء بَينيّ من قيد وحرّيّة؛ منذ كان تمرّد بروميثيوس، كان عهد الكلمة… بدأ عهد الكلمة! أليس من رابط بين الأسطورة، بوصفها نتاج الحضارة الإنسانيّة وتفكّرات الإنسان الوجوديّة، وبين الدين، إذا ما تتبّعنا ما جاء في العهد الجديد: “في البدء كان الكلمة”*؟
صراع الإلهين، بالتعبير الميثولوجي، هرمس وبروميثيوس، لمّا يزل ماثلًا في تنازع ذات الإنسان “الفاني” بين الخلود والفناء، وبين الشك واليقين. خير تعبير عن هذا الوضع الإنساني الشّقي شخصيّة سيزيف الأسطوريّة. فسيزيف كان أشدّ الفانين حكمةً وحصافةً. هو رمز البطل الّلامجدي؛ ذلك عبر عاطفته المتحمّسة للحياة، وكرهه للموت، واحتقاره الآلهة التي سرق أسرارها.
ويخبرنا هوميروس بأنّ سيزيف قد وضع الموت في الأغلال… أدّت تلك الأمور إلى ذلك العقاب الّذي يكرّس فيه الكيان كلّه من أجل تحقيق الّلاشيء؛ إذ حكمت عليه الآلهة بأن يرفع صخرة بلا انقطاع إلى قمّة الجبل حيث تسقط الصّخرة بسبب ثقلها ثانيةً. عمله العبثيّ سمته الّلاإنجاز.
تصوّرالأسطورة مأساة الكائن الفاني، غير أنّ بطلها الثائر مدرك تمامًا مدى حالته الشّقيّة. الوساطة التي تنجزها الكلمة تجعلنا نختبر العالم بوصفه لحظة وجوديّة حاضرة متدفّقة في شكل سيلان لانهائي.
* جاء في تفسير العهد الجديد أنّ “البدء” هو المطلق. فالكلمة كائن على نحو سامٍ أزلي… يُسمّى المسيح “لوغس”. قد يُترجم هذا اللفظ ب”كلام”، لكن يبدو أننا أمام كلمة تأثرت بطرق تعبير الأدب الحكمي… فالمسيح صورة الله الذي لا يُرى. (مقدمة إنجيل يوحنا).