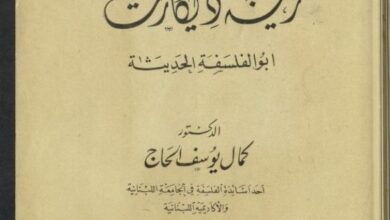العرب والتقدم

مفهوم التقدم مفهوم حديث، فهو يقوم على نظرة مقارنة ضمنية بين درجات تطور المجتمعات على خط تاريخي واحد هو الخط (الافتراضي) للتطور العالمي الذي يتضمن ويفترض تفاوتات على الخط العام، وتفاوتات قطاعية أيضًا.
مجالات التطور التي يفترضها هذا المفهوم هي التطور التاريخي عبر مفاصل أصغر هي التطور الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، والتطور السياسي، والتطور التقني.
يمكن أن نرى كل هذه المفاصل إما من المنظور الكمي أو من المنظور الكيفي. فالتطور أو التقدم الكمي هو حساب درجة التطور الاقتصادي مثلًا من خلال عوامل أو مفاعيل كالناتج الخام الوطني، ومنسوب كل فرد سنويًّا، ومستوى الاستهلاك والإنتاج والتصدير، ومؤشر النمو الاقتصادي.
كما يمكن أن تقاس درجة التطور أو التقدم التقني من خلال مستوى التصنيع إنتاجًا واستهلاكًا ونسبة توزيع واستعمال الآلات على المستوى الوطني.
بل إن القياسات الكمية للتطور بدأت تطول المجالات كافة، فالتقدم السياسي يقاس اليوم بدرجة الاندراج في السيرورة الديمقراطية التي بدورها تقاس بمعيار الحريات والحقوق السياسية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والمؤسسات التمثيلية السياسية المحلية والوطنية…
حتى التقدم الثقافي على الرغم من سمته الكيفية الأساسية فقد أصبح قابلًا للقياس من خلال حرية الصحافة ومستوى القراءة والإنتاج والتوزيع الثقافي للكتب والمجلات والصحف، وقد أضيف إليه اليوم الاطلاع على المصادر الثقافية في الشبكة العنكبوتية، إلى غير ذلك من المؤشرات.
من المؤكد إذن أن علاقة العرب بالتقدم يمكن أن تخضع لتقديرات كمية كما يمكن أن تخضع لرؤية كيفية، تتطلب النظرة الأولى تجميعًا للمؤشرات الكمية القُطْرية والقطاعية إلا أنها تظل في حاجة إلى رؤية شمولية على مستوى من التعميم والتجديد، ومن خلال الاعتماد على رؤية دينامية تاريخية شاملة لا تخلو من افتراضات وتقديرات كيفية.
يشكل العرب اليوم كتلة بشرية يجمعها تاريخ يلحمها تجمع مكاني وروابط تاريخية ومعنوية كثيرة، أهمها وحدة اللغة وهيمنة معتقد ديني يأخذ تلوينات مختلفة، وثقافة مشتركة ذات جذور تاريخية متجذرة.
- دينامية الصراع
تاريخ العرب الحديث هو تاريخ تحكمه دينامية قوية هي دينامية التحديث أو على الوجه الأصح دينامية الصراع بين التقليد والتحديث، وذلك منذ أن هبَّت أول رياح التحديث على المنطقة العربية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد منذ غزو نابليون لمصر.
فالقانون الأساسي الذي يحكم تاريخ العرب الحديث هو بندول النهوض والسقوط، والمراوحة بين هذين الحدين: إرادة النهوض وعوامل السقوط.
تعود إرادة النهوض عند العرب إلى إرث تاريخي قوي يتمثل في أن العرب صنعوا فترة من التاريخ العالمي، وبلغوا ذروة التاريخ بين القرنين التاسع والثالث عشر عبر علومهم وآدابهم وتمددهم الجغرافي. لكن التاريخ مدٌّ وجزر.
وظل هذا الحلم التاريخي يراود حسهم ووعيهم رغم كل الانكسارات والخيبات. يتمثل الامتحان التاريخي العسير الذي تعرض له العرب في العصر الحديث في سيرورة الحداثة التي انطلقت من أوربا وانتشرت عالميًّا خلسة وقوة، وأصبحت تمثل شرطًا أساسيًّا للوجود في العالم وللانتماء إلى العصر.
ورغم ما للعوامل الخارجية المتمثلة في الاستعمار والإمبريالية وإرادة الهيمنة الغربية، فإن المآلات السلبية يمكن أن تفسر بدينامية وأهمية الكوابح الداخلية التي يتحايل الوعي العربي على نفيها أو تذويبها وإنكارها؛ لأن الوعي التاريخي وعي ماكر من حيث إنه يمارس ويؤسِّس للتضليل الذاتي بإسقاط ما هو داخلي على ما هو خارجي، أو ما هو رُوحي على ما هو عقلي.
وما هو ذاتي على ما هو موضوعي أو تاريخي في مراوَحة حادة بين الاستهداء والتيه. اكتشف العرب العصر الحديث تدريجيًّا عبر مسلسل اكتشافات كانت كلها صدمات خادشة وجارحة للشعور بالذات أو بما سمِّي بالنرجسية وبالجروح النرجسية المؤلمة.
مر اكتشاف الحداثة عبر صدمات متلاحقة معالمها الحديثة والتاريخية الكبرى هي صدمة غزو نابليون لمصر (1799- 1801م) وصدمة الاستعمار ابتداءً من 1820م، وصدمة سقوط الخلافة 1928م، وصدمة احتلال فلسطين 1948م، والهجوم الثلاثي 1956م، والهزيمة 1967م، واحتلال العراق 2003م… وهي كلها صدمات ذات وجهين: العنف والتحديث، صدمات مزدوجة أو مركبة، سطحها حداثي وتاريخها، وعمقها فكري وثقافي.
ردود الفعل المختلفة التي واجهت هذه الصدمات هي أشكال متباينة من الوعي المراوح بين الوعي المغلوط أو المماوه والوعي التاريخي الحاد والجارح، وكذلك ردود أفعال من إرادة النهوض لدرجة تسمح بالقول بأن تاريخ العرب الحديث هو تاريخ النهوض والسقوط المستمر.
وهو القانون نفسه الذي يحكم أشكال حركية الوعي العربي المراوح بين الارتداد والانفتاح، بين النكوص والاستجماع؛ ولعل الوعي التاريخي العربي الحديث هو وعي ظل يراوح بين استلهام الأصولية الإسلامية، أو استنشاق بعض هواءات الحداثة كما تمثل ذلك النزعة القومية في صيغتها الليبرالية والاشتراكية،
بل إن المنحنى التاريخي للوعي العربي ظل بمنزلة حركية جيبية تراوح بين النزعة الإسلامية (أوائل القرن التاسع عشر في مصر والجزيرة) والنزعة القومية/ الاشتراكية (ابتداء من أربعينيات القرن العشرين إلى سبعينياته).
ثم العودة القوية للتيارات الإسلامية بعد هزيمة 1967م وبداية الثورة الإسلامية الإيرانية (1979م)، أي في مراوحة مستمرة بين وعي تقليدي ووعي تحديثي تتخلله مزاوجات وتطعيمات، تسويات وتطرفات ذات اليمين أو ذات الشمال.
ورغم أن التضخم التدريجي لتيارات التطرف والعنف التي استمر تدرجها في سُلَّم تبنِّي العنف الداخلي والخارجي بوصفه في نظرها السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف التي تبلورت في الوعي العربي الإسلامي، وتحوَّل ذلك إلى مشكل عالمي.
فإن بإمكان القيادات الثقافية والسياسية للوعي العربي استعادة التحكم في هذا التوجه المتطرف بإعادة تدوير الدفة الثقافية للنواة الأصلية نحو الانفتاح والقبول بالاختلاف والتعدد على المستويات كافة، واستيعاب تغيرات العالم فهمًا وتعاملًا، وذلك في اتجاه التصالح مع تحولات العصور الحديثة والقبول ببعض سياقاتها ودلالاتها ومنظوراتها.
تدخل كل هذه المخاضات ضمن ما يمكن تسميته مخاضات الحداثة والتحديث التي هي دينامية أو ديناميات تفرض نفسها بشكل موضوعي بعدّ العالم كله قد ركب قطار الحداثة منذ انتشار آلية التحديث عالميًّا التي بدأت مع مرحلة الاستعمار، واتخذت بعد ذلك أشكالًا أكثر شبكية.
- رعاية مخاضات التحديث
لقد عهد إلى المؤسسات الدولية المختلفة السياسية والتقنية والثقافية الوصية برعاية مخاضات التحديث على المستوى العالمي بمتابعة ومراقبة سيرورات ومؤشرات النمو على مستويات التطور كافة ابتداء من المؤشرات الثقافية (نِسَب الأمية والإنتاج والاستهلاك الثقافي) إلى المؤشرات الاقتصادية (نسب النمو، والموازنة المالية.
وتقليص الحصة الاجتماعية في الإنفاق العام، والناتج الوطني الخام…) والمؤشرات السياسية (نسب المشاركة، والتمثيلية، وفصل السُّلَط، وحقوق الإنسان، وحرية المعتقد) إلى المؤشرات الاجتماعية، ونسب الفقر، وعتبة الفقر، وتوزيع الثروة الوطنية، والأمل في الحياة، وحقوق الإنسان (النساء، والأطفال، والعمال، وذوي الاحتياجات الخاصة) والبطالة، والسجون، والإجرام، والتمدرس، والخصوبة.
فقد أصبحت المؤسسات الدولية هي الساهرة ضمنيًّا على عملية التحديث التي اتخذت بالتدريج طابعًا كونيًّا.
من المؤكد أن العرب يتقدمون، وإن كان هذا التقدم بناء على المؤشرات الكونية، تقدمًا سلحفاتيًّا على وجه العموم، وبسرعة مختلفة داخل البلد الواحد، وغير متكافئ بين الدول (22) المكوّنة للمجموعة العربية. إذا كانت مشكلات التقدم ومشكلات التحديث أو وتائره (وهما متداخلتان في المؤشرات الكونية) متفاوتة داخليًّا،
فهي أيضا متفاوتة بَيْنيًّا. فعلى العموم إذا ما ميَّزنا بين مستويات ثلاث للتحديث أو التقدم، فإننا نلحظ أن سرعة التحديث التقني هي ذات وتيرة متسارعة قياسًا إلى غيرها، في حين نلحظ أن التقدم التنظيمي في وجهيه التقني (المعمار وتنظيم المدن والطرق…) والتنظيمي (السياسي: الدسترة والتمثيلية السياسية والمأسسة والديمقراطية) يسير بخطًا أكثر بطئًا؛ لأنه يصطدم بمقاومات ثقافية ومؤسسية عضوية أو أهلية.
أما على المستوى الثالث (المستوى الثقافي) فوتائر التقدم تتباطأ أكثر؛ إذ «تسير» بسرعة سلحفاتية في أحسن الأحوال لأن المستوى الثقافي الكوني هو الأكثر تشعبًا وتمثلًا للبنية الثقافية والفكرية للحداثة، ومن حيث إن التحديث الكوني هو تعريف للمقولة المركزية للحداثة والمتمثلة في فصل الديني عن الدنيوي، والروحي عن المادي، والمقدس عن التاريخ،
أو ما يصطلح عليه بالتمييز الواضح بين السياسة والدين مؤسسيًّا وفكريًّا. هذا إضافة إلى شحنات الحرية والأنسنة التي تحملها الشرعة الكونية لحقوق الإنسان فيما تتضمنه من حقوق (فئوية ونوعية) أهمها (حقوق الإنسان) والحريات (لعل من أبرزها حرية الرأي والمعتقَد).
فعلى هذا المستوى يبدو بندول التقدم العربي أكثر بطئًا وترددًا؛ لأنه يدخل في احتكاك حاد مع المكونات الميتافيزيقية للبنية الثقافية التقليدية، ويفرض ممارسة نوع من العقل التأويلي على العقل الجوهري، ويفترض تحويل النواة الثقافية من نواة جامدة وحيدة المعنى إلى سلسلة تأويلات وتكيفات وقوى تاريخية دافعة.