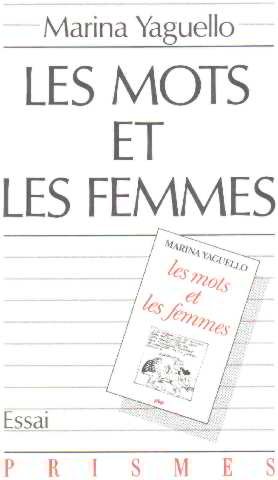سيادة اللغة ومشكل النوع، في كتاب؛ الكلمات والنساء

- تعريف الكتاب:
صدر كتاب “Les mots et les femmes” للكاتبة “Marina Yaguello” عن “Editions Payot” في سنتي 1982،1978.
وعن “Editions Payot et Rivages” سنتي 2018،1992.
ثم في ترجمة إلى اللغة العربية للدكتور سعيد بنكراد، عن المركز الثقافي للكتاب سنة 2021، تحت عنوان: “الكلمات والنساء، دراسة سوسيولسانية للشرط النسوي”، جاءت في 340 صفحة. يضم الكتاب مقدمة للمترجم، متبوعة بمقدمة للكاتبة، يليها الجزء الأول بعنوان: “لغة الرجال لغة النساء” الذي اشتمل على خمسة فصول، وقد حمل الجزء الثاني عنوان: “صورة النساء في اللغة” وانقسم إلى سبعة فصول، ثم خاتمة.
- مقدمة المترجم:
عرف سعيد بنكراد الكتاب بأنه بحث في قضايا النوع والقاموس والهوية الثقافية والتباينات الدلالية والنحوية والاستعارات الجنسية ولغة الذم والتحقير، وهي قضايا يعتبرها من جانبه أنها تعود في مجملها إلى عمليات التذكير والتأنيث التي تعتمدها اللغة لمواكبة حضور النوع في النحو والوظائف وفي الحياة الاجتماعية أيضا.
يرى بنكراد أن اللغة لا تخلص دائما للعالم الذي تقوم بتمثيله، حيث تصنف كائنات العالم وفق إكراهات ثقافية، فهي تعلم أيضا كيف تنتزع الكلمة من معناها الأصلي لكي تصبح وعاء لمضاف دلالي، حيث إن ثنائية التذكير والتأنيث لم تعد موجهة للتعبير عن حاجة أملاها النوع النحوي في اللغة فقط، بل تحولت إلى مستودع لقيم وأحكام وتقديرات خاصة بموقع النساء والرجال داخل المجتمع.
لاحظ بنكراد أن مداخل القواميس العربية تسم المذكر والمؤنث منذ البداية، فهما لا يعنيان في الأصل ذكرا وأنثى يشيران إلى خاصية بيولوجية تقتضي تكاملا بين رجل وامرأة، بل يحيلان –كما جاء في لسان العرب مثلا- على سلسلة من القيم تنتشر في اتجاه الضعف واللين والسلبية في الأنوثة، وفي اتجاه القوة والشدة والصلابة في الذكورة.
يوضح بنكراد أن معركة المساواة تقتضي أكثر من إعادة النظر في التوزيع اللغوي لدوائر المذكر والمؤنث، فهذه المساواة لا تقتضي تغييرا في قواعد نحوية أو قواعد لها علاقة بمنطق المطابقة، إنها تفرض علينا تغيير تصوراتنا عن الحياة والموت والمرأة والرجل، وكذلك إعادة النظر في طبيعة علاقاتنا الاجتماعية، وموقع المؤنث والمذكر داخلها.
يختم المترجم بأن هذا الكتاب لا يزال محتفظا براهنيته، رغم مرور أزيد من أربعين سنة على صدوره.
- تقديم الكاتبة ونوعية الإشكالات:
تعرف مارينا ياغيلو هذا المؤلَّف بمحاولة لتقديم نظرة سوسيولسانية حول الشرط الأنثوي، نبهت فيها إلى أنه يجب التخلي عن الفكرة القائلة بأن اللغة “محايدة”، مع وجوب التأكيد على الروابط الصدامية داخلها، لكونها نظاما رمزيا لا يمكن فصله عن العلاقات الاجتماعية.
فاللغة هي مرآة ثقافية تبرر التمثلات الرمزية (من خلال بنيتها أو من خلال لعبة الإيحاءات أو الاستعارة داخلها)، وعد التمايز الجنسي –في المقام الأول- واقعة من طبيعة اجتماعية ثقافية تنعكس على اللغة بصفتها نسقا سيميائيا من بين أنساق أخرى.
يقدم هذا الكتاب -في شكل مبسط- عناصر من البحث الذي تقوم به اللسانيات الاجتماعية، هذه العناصر هي التي يقوم عليها الحجاج النسوي، حيث إن مشكل النوع يرصد السلب أكثر من الإيجاب، هو متساءل أكثر مما هو مجيب في كل الأبعاد الدلالية
والنحوية والتداولية، فمما ترصده الكاتبة من إشكالات صاغتها في الأسئلة التالية:
- هل هناك حقا لغة خاصة بالنساء (أي ممارسة لغوية خاصة بالنساء وحدهن)؟
- إذا كان الكلام مرادفا للسلطة، فهل معنى هذا أن ممارسة الكلام تقود إلى امتلاك للسلطة؟
- بما أن “لغة” “المرأة” لا قيمة لها في المجتمع، فهل على النساء تعلم الكلام كما يمارسه الرجال؟ أم عليهن عكس ذلك، الرفع من شأن خطاب أنثوي، والمطالبة به باعتباره مساويا لكلام الرجال أو مختلفا عنه؟
- ما النوع، ما وظيفته، هل هناك رابط بين النوع والجنس، وإلى أي حد يؤثر النوع في التمثلات الرمزية الجماعية؟
- يجب أن نطرح قضية علاقة اللغة بالواقع في اللغات التي تتوفر على النوع، هل النوع انعكاس لرؤية كونية؟
ترى الكاتبة أن الوقت قد حان لكي نحدد ماذا نعني بلغة الرجال ولغة النساء، رغم تعذر تفسير كل الظواهر، إلا أن إمكانية تأويلها بطريقة موحدة هي متاحة، وذاك مسعى الكاتبة من خلال تصنيف كل المعطيات التي تم جمعها، حسب معايير منمذجة: اختلافات صوتية وصرفية وصرفية-صوتية، وتركيبية ومعجمية، أو مجموعة من هذه السمات.
تجلي الكاتبة إلى أي حد تعكس تعريفات القواميس –التي هي صنائع إيديولوجية في الغالب- الذهنية المتخلفة لمستعملي اللغة، وتعد الأنتروبولوجيا هي أول من أثار قضية العلاقة القائمة بين اللغة والجنس عند المجتمعات البدائية التي إبان اندثارها تندثر سمة التمايز الجنسي في اللغة، حيث يقوم التمييز اللساني في هذه المجتمعات أساسا على الطابو والزواج الخارجي، فالطابو اللساني ضمانة على الحفاظ على النظام الاجتماعي (كمنع نطق اسم الزوج وغيرها)
تعزو الكاتبة اختلاف نطق بعض الحروف –عند أقوام سابقة- إلى تمييز بين لهجة مهيمنة مرتبطة بالتعليم باعتباره مفتاح السلطة، وبين لهجة خاضعة تتكلمها الجماهير ومن ضمنها النساء، وتضيف أن دور النطق باعتباره مؤشرا وضمانة على الانتماء الطبقي معروف من قديم، وقد تحدث أغلب الإثنولوجيين عن لغة النساء، وهي اللغة المشتقة من الشكل الطبيعي أو اللغة الحقيقية التي يتحدثها الرجال، فلا أحد يشكك في أن المؤنث مشتق من المذكر، وهذا جلي في اللغة المكتوبة، حيث تضاف “علامة” un – e، علاوة على أن اللسانيات ليست دائما محايدة في علاقتها بموضوع درسها، الذي هو اللغة.
تتبعت الباحثة الاختلاف بين كلام الرجال وكلام النساء في اليابان مثلا، فوجدت أنه يعكس بنية اجتماعية قائمة على التراتبية، أما على المستوى المعجمي، فإن الاختلافات جلية بشكل صريح، كونه الميدان الذي يسمح بأقصى حد في عدد الصيغ دون أن يشكل خطرا على التفاهم بين المجموعات الفرعية للمتكلمين، إذ لا يمكن فصل المتغير “جنس” عن متغيرات أخرى من قبيل الطبقة الاجتماعية ومستوى التعليم والسن ونمط العيش، وخلصت إلى أن أصل هذه الاختلافات متنوع وفي كثير من الحالات غير معروف، وبالتالي وجب تواصل الجنسين بينهما، ووجود لغة مشتركة تجمع بينهما.
وفي ظل وجود طابوهات لسانية، تتساءل الكاتبة عن وظائفها، وترصد استناد الطابو في المجتمعات البدائية، إلى معتقدات سحرية-دينية، وإلى ضرورة الحفاظ على نظام اجتماعي قائم على التراتبية، وبالانتقال إلى المجتمعات الحالية، فهي في نظر الكاتبة تضع طابوهات لسانية مصدرها الخوف الدفين في لاوعي الناس، كالخوف من اللفظ.
وتقوم التورية في مجتمعاتنا بدور بارز في هذا المجال، من خلال لغة مواربة، أي مجموعة من الصيغ التي تمكن صاحبها من التكلم عن الأشياء غير القابلة للوصف، وغير المقبولة اجتماعيا بطرق ملتوية، وتضرب لذلك مثالا بمعاينة الكم الهائل من الكلمات التي يستعملها الرجال (في اللغة السوقية خاصة) من أجل تعيين النساء، وخاصة المومسات، للقول إن هذا الأمر يُخفي في مكان ما خوفا عميقا من المرأة، وتجدر الإشارة من لدن الكاتبة إلى أن التخلص من الطابو عامة يرافقه نوع من التحرر، فمما يتيح لصاحب الغرافيتي التعبير الحر عن نفسه، كونه مجهول الهوية.
وبالتالي لا تعوقه الطابوهات الاجتماعية، وكذلك الفكاهة أو المزحة البذيئة تخرق كل الطابوهات، فهي لا تُستخدم فقط من أجل الحط من المرأة، بل أيضا للحط من “السلطات”.
تشير الكاتبة إلى أن الطابع “الفحولي” للتعبير البذيء، والذي يكون في الغالب جنسانيا، فإنه لا يسمح به إلا إذا صدر عن المومس، أما الفتيات الصغيرات فتصحح لغتهن أكثر مما يفعل مع الأطفال الذكور، فهو ترويض منذ الصغر.
وكذلك تعد الشتائم من خصوصيات الرجال، كما يُفترض في المرأة أن تكون مؤدبة أكثر من الرجل، إذ يرتبط الأدب بعدم القدرة على إثبات الذات، وقول المرء ما يفكر فيه بشكل صريح، والمطالبة بالحق وإعطاء الأوامر، ويعد احترام الطابوهات اللفظية واستعمال التورية واللغة المهذبة هي جزء من بنيان الآداب.
وتضيف الكاتبة أن النساء يُلزمن أنفسهن العناية بالنطق ويراقبن أنفسهن، أو يصبغن على أنفسهن وضعا مثاليا، وتتساءل عن تفسير هذه الظواهر.
تسلط الكاتبة الضوء على ظاهرة المتحذلقات، وتتساءل عن دلالتها الاجتماعية، باعتبارها حركة أدبية نسائية نشأت في القرن السابع عشر في أوروبا، تميزت بالعناية الفائقة للغة إلى درجة الإسفاف، وقد تبنى موليير الميز الجنسي بتهكمه من المتحذلقات، بأن هاجم ادعاء النساء القدرة على أخذ الكلمة، والتمكن من السلطة الإيديولوجية، وذلك بجعله من التحذلق كاريكاتورا مضحكا.
أوردت الباحثة شواهد مختلفة حول ازدواجية اللغة والمحافظة اللسانية، خلصت من خلالها إلى أن الوضعية الاجتماعية هي السبب في هذا، وليس “الطبيعة الأنثوية”، ولا علاقة للمحافظة مع الجنس.
تدعو الكاتبة إلى توسيع حقل التحليل من أجل إقامة ترابطات بين كل السمات التي تُستخدم من أجل الفصل الجنسي، سواء كانت هذه السمات “طبيعية” أو كانت “ثقافية”، وذلك بغية تحديد السلوك اللغوي للرجال والنساء، للكشف عن مواقفهم تجاه اللغة، ودرجة الأهلية عندهم.
حيث تؤكد الحكمة الشعبية، في كل ثقافات العالم، من خلال الأمثال أن المرأة تتكلم كثيرا أكثر بكثير مما يفعله الرجل، إن كان صحيحا حسب الكاتبة، فإن الثرثرة تعبير عن العجز، وبديل عن السلطة، أو تعويض عن الكبت الذي يحدثه غياب السلطة.
انطلاقا من الأفكار التي عرضتها الكاتبة، ولكون لغة الرجل هي النموذج المهيمن الذي يتمتع بالحظوة داخل المجتمع، تتساءل إن كان على النساء تبنيها، علما بأن الانسياق وراء المعايير المذكرة معناه ضمنيا الاعتراف بتفوق الرجال، مما قد يجعل النساء محاصرات داخل نسق ما زال جنسانيا ويناقض نضالهن، وعليه تعين لنا الكاتبة معالم حركة واسعة للمطالبة بخصوصية أنثوية مستوعبة كليا داخل الميدان الثقافي عامة وميدان اللغة خاصة.
تستشهد الكاتبة برؤية سيمون دوبوفوار التي تنص على أن اللغة المتداولة رغم ادعائها الكونية إلا أنها تحمل آثار الذكور الذين بلوروها، فهي تعكس قيمهم وادعاءاتهم ومسبقاتهم.
وتتساءل من جديد: هل تستعمل النساء اللغة بطريقة تختلف عن استعمال الرجال لها؟ لأنهن نساء؟ هل يتعلق الأمر بإحالة ضمنية على “طبيعة أنثوية” تطالب بها المرأة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك؟
تعرض الباحثة معطيات للإجابة، من قبيل أن المرأة تحس بطريقة مختلفة، وتبعا لذلك سيكون قولها مختلفا، إن لها علاقة أخرى مع الكلمات، ومع الأفكار التي تعبر عنها، وعليه فإن المطالبة بالاختلاف والخصوصية هو الموقف السليم الذي يمكن اتخاذه، ونبذ موقف كل من يستعمل هذه الخصوصية من أجل تبرير الوضع الدوني للمرأة، والتنديد به في مقابل رفض الترويض والامتثال.
وتذكر في هذا السياق ما تتميز به الحركة النسوية –باعتبارها حركة هامشية تنتمي إلى أقلية- من طابع نضالي، ومستوى عال من الوعي الإيديولوجي، مستشهدة بقولة شهيرة للنساء: “لا يكفي أن نعي حالة القمع، يجب أن نتوفر على كلمات من أجل تسميته”.
تعرف الكاتبة النوع بأنه –من زاوية نحوية خالصة- نسق من التصنيفات الخاصة بالأسماء، ويتجلى على المستوى التركيبي في ظواهر مطابقة، لماذا إذن يجب القيام بتمييز في النوع؟ من البداهي أنه لا يصلح لأي شيء وفق رؤية وظيفية للغة، فقد حذفته الإنجليزية نهائيا، ولم يلحقها أي ضرر، كما أنه ليس من طبيعة كونية، فبالإمكان التخلي عنه، فهو منبوذ من كل الجهات، ولا يتمتع بأية وظيفة عدا أنه يجعل الأشياء صعبة في كلامنا،
وقد أعلى سابير ضمنيا من الإنجليزية التي عرفت كيف تتخلص من أغلال التمييز المفرغة من دلالتها البدائية، ثم تتساءل ما إذا كانت للنوع وظيفة هي التي تفسر استمراره رغم وجود مبدأ الاقتصاد، ألا يكون للنوع وظيفة استعارية كما يؤكد ذلك رومان ياكبسون.
تنتقل المؤلفة للحديث عن القضية التي يجب إثارتها من وجهة نظرها، والتي تجدها شبيهة بقضية العلاقة بين اللغة والفكر، هل ندرك الموت والبحر والقمر الخ باعتبارهم من طبيعة مؤنثة لأن مصادفة تصنيف اسمي أعمى وضعتها ضمن النوع المؤنث فقط؟ (إنها مذكرة أو مؤنثة في الفرنسية لا في كل اللغات حسب المترجم) أم هي على العكس من ذلك، مؤنثة لأنها مرتبطة بقيم رمزية قد تكون وثيقة الصلة ببنيات ذهنية واجتماعية وبقيم ثقافية؟
تحذر الكاتبة من مغبة السقوط في سيكولوجية مفرطة ستؤدي بنا إلى تأويل كل وقائع اللغة استنادا إلى حدود ذهنية، كما استعرضت حالات التماهي بين الأرض والمرأة الموجودة في كل الثقافات وفي كل الحقب، الأم الأرض، الأم المغذية، فالأرض هي المصفوفة والمنبع والحضن، والملاذ والأصل ونهاية كل حياة (العودة إلى الأرض)، أما السماء فهي مرادف للإله الأب القوي المزمجر والسلطوي والمخصب.
تطرقت الكاتبة إلى فكرة القوة والسلطة عند الساميين وارتباطها بالمؤنث، والانتقال من مرحلة “الإيحائي” إلى “الدين” بحصر المعنى، مصحوبا على المستوى اللساني، بتحويل للنوع المؤنث نحو النوع المذكر الذي أصبح مهيمنا، وعليه فقد صار ميدان الدين الرسمي هو ميدان مذكر، على أساس أن المرأة دنسة، أي شريرة، وذلك بسبب وظائفها الطبيعية في المقام الأول، وهي الحيض والنفاس، وهذا مصدر الموقف السلبي لليهودية تجاه الجنس عند المرأة، وهو الموقف الذي ورثته المسيحية.
تخلص الكاتبة إلى أن الميل التشخيصي قد دفع الإنسان إلى جنسنة الطبيعة والواقع الذي يحيط بها، وذلك عندما يستغل بنيات لسانية من أجل تبرير هذا الموقف وعقلنته، وإعطاء أساس ملموس للتمثلات الرمزية، وتضرب مثلا بلغة لا تتمتع بنوع كالإنجليزية، تكون غربلة القيم الرمزية أكثر وضوحا، لأن التطابق النحوي لا يحجبها، كما هو الحال في الفرنسية مثلا، إلا أن هذا النوع موجود في أذهان الذوات المتكلمة، هو نوع خيالي أو مختلق، لكنه معيش.
تعيب الكاتبة على فرنسا توفرها على تقليد ثقيل ورقابة على اللغة، وذلك بسبب تاريخ إنشاء الأكاديمية الفرنسية، مما جعلها تعرف جمودا مطلقا جراء خوفها من التجديد، كتحقير التوليد ورفض استعمال البنيات المورفولوجية الموجودة، وتوضح مسألة أسماء الفاعل -التي خصصت لها الكاتبة أربعة وعشرين صفحة- التناقض بين لغة سابقة على الأكاديمية وبين لغة لاحقة لها، والنحو التاريخي يبين ذلك، وقد ميزت الكاتبة على مدار هذه الصفحات بين ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: نموذج (eur/euse,teur/trice,ier/iere) ومع ذلك يُرفض الشكل المؤنث المتوفر في بعض الحالات لأسباب اجتماعية.
- الحالة الثانية: عديم الجنس بشكل مطلق، لا وجود لأي مشكل عدا أننا مضطرون لإضافة كلمة امرأة.
- الحالة الثالثة: النهائي ب e صامت، كلمات تكون نظريا بلا جنس، وتتوزع في الممارسة على المذكر والمؤنث استنادا إلى تقاسم الأدوار في المجتمع.
تعيد ياغيلو طرح سؤال سابق بصيغة أخرى، هل يجب المطالبة بخصوصية أنثوية ضمن احترام المساواة في الحقوق، أو الانصهار في رحى مذكرة؟
تعزو الكاتبة هذه القضية إلى كون الكثير من النساء هن أول من يقف في وجه تأنيث أسماء الفاعل، فالمقاومة تأتي في جزء منها من حالة الجمود اللساني، وفي أغلب الحالات من النساء أنفسهن، ومن الجسم الاجتماعي كله الذي يحدد للمرأة موقعا منفصلا، وتطالب من جانبها بتغيير الذهنيات، وإلا ستظل اللغة متخلفة، فاللغة الفرنسية في نظرها متخلفة عن المجتمع الفرنسي، وذاك مصدر الصراع الدائم، وتتساءل: ماذا تنتظر الأكاديمية – وهي حارسة اللغة- لكي تعطينا بعضا من (e)؟
ومن ناحية دلالية فإن استعمال كلمة “امرأة” يمكن أن يعادل امرأة تعيش حياة سيئة (الذهاب عند النساء، أفلس من أجل النساء)، في حين لا يمكن لكلمة رجل –في معناها المطلق- أن تكون سوى مدحية: “كن رجلا”، كما تختلف دلالات ساحر/ساحرة في الكثير من اللغات، حيث يثير الساخر الخوف، ويتلقى الاحترام باعتباره مالكا لمعرفة، أما الساحرة فتوظف سحرها في خدمة الشر، فهي شريرة ومنفرة.
ترى الكاتبة أن انطلاق حركة تحرر النساء قد تأخر كثيرا، وأنه كان يتوجب علينا سابقا أن نعي “أنثويتنا”، والتشكيك في كل صيغ الأنثوية التي قدمت لنا، وهو ما خالفته الفرنسية، لأن الزوج ذكر/أنثى متباين أيضا، وتعتبر أن المهمة الأصعب –وتأسف لذلك- هي تخليص اللفظ “مؤنث” من كل إيديولوجية جنسانية تحيط به.
تخلص الكاتبة إلى أن التباينات الدلالية تتحقق دائما على حساب المرأة، كما هو الشأن مع التباينات المورفولوجية، حيث تندرج ضمن “لغة الاحتقار”، وهي أداة الحط الدائم من شأن النساء.
اللغة من منظور الكاتبة تعطينا صورة عن المجتمع، وعن علاقات القوة التي تحكمه، وترى أن تحقير المرأة دائم الحضور في اللغة وعلى جميع المستويات وجميع السجلات.أما بالنسبة للدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة فإنه ينحصر في اثنين: الأم أو العاهرة، ويرتفع الشعار النسوي الإيطالي خلافا لذلك أو مناهضا: “لا قديسة ولا عاهرة”.
تسند الكاتبة الغنى المعجمي للكلمات التي تعين المرأة –في جزء كبير منه- إلى التورية أو الخوف من الكلمات التي تعود إلى الرغبة في إقصاء ما نخافه من خلال تجنب تسميته أو من خلال ذمه باستعماله بشكل مستفز يقلب المعنى أو بالاستعمال الاستعاري، وذاك ما أكده بيير غيرو عندما عدد في كتابه “Le langage de la sexualité” سبعة آلاف كلمة لكي يغطي خمسين مفهوما، فيها أكثر من خمس مائة خاصة بالجهاز التناسلي للمرأة، وخمس وخمسين للقضيب.
حظي موضوع “المرأة” بعناية الكاتبة، فالمرأة ليست فقط مذمومة ومشتومة ولا قيمة لها، بل إنها تُشتم عبر أعضائها التناسلية التي توصف باستمرار بأنها وسخة وقبيحة وعار وسلبية الخ، علاوة على وجود عدد كبير من الشتائم التي مرجعيتها المرأة أو العضو المؤنث تنطبق على الرجل، حيث ترمي الشتائم ذات الطابع الجنسي إلى احتقار المرأة، لكنها في العمق تعبر عن الخوف من المرأة، أو بالأحرى عن الضعف.
تشدد الكاتبة على الدور الذي يقوم به القاموس باعتباره صناعة إيديولوجية ومرآة للمجتمع والإيديولوجيا، فهو أداة ثقافية وسلطة لا راد لقضائها، وكذلك هو الكابح للغة والمحافظ عليها، وتستشهد بقولة فيكتور هيغو: “يجب أن تُرفق كل ثورة بإصلاح للقاموس”، معتبرة أن قاموس “Petit larousse” يكشف الشيء الكثير عن ذهنية الذين أعدوه.
كما توضح الدور الذي يلعبه صاحب القاموس في التعبير عن الإيديولوجيا والترويج لها، فخلف القاموس –الذي يبدو كأنه إبداع مجهول- يختفي مؤلفون، أي أفراد، حيث إن القاموسي وهو يقدم تعريفا ل “رجل” أو “امرأة” يقع تحت طائلة ما تمليه عليه القوالب الثقافية والإكراهات الاجتماعية.
استعرضت الكاتبة قراءة لمجموعة من القواميس، حيث لاحظت أن التعريفات التي قدمت للفظ “امرأة” –وهي ذات الطابع البيولوجي جميعها- تستند إلى مبدأ القدرة على الإنجاب، وبذلك تصنف المرأة باعتبارها أما، في حين لا يحدد الذكر باعتبار قدرته على الإنجاب، فهو رجل حتى ولو كان عاقرا أو عنينا، أما بالنسبة للكلمات التي تحط من شأن المرأة، فقد وجدت أن عددها يتجاوز بكثير تلك المحايدة أو التي تُعلي من شأنها.
تخلص الكاتبة إلى أنه سيكون من الخطأ تطهير القواميس، فحذف الكلمات أو التصورات لن يفيد في شيء، ما دامت موجودة، فعلينا أن نقر صراحة بوجودها، وفيما يخص امتلاك المرأة لاسم، فهو لا يكون انعكاسا لوضعها في المجتمع، وإنما هو سبيلها إلى استعادة هويتها الاجتماعية وهويتها عامة، وعلى هذا فليس للمرأة اسم ولا صوت، فهي محددة بالضرورة من خلال زوج أو أب.
تناولت الكاتبة في الفصل الأخير قضية الروابط الممكنة بين السلطة واللغة، والتي تطرق لها جورج أورويل في”1984″ حين بيَّن أن الذي ينصب نفسه سيدا للغة سيكون سيدا للفكر، وسيكون بالضرورة متحكما في أفعال الناس، فمن أجل جعلهم يستبطنون إيديولوجيا ما، يكفي في ذلك حذف كل ما يناقضها في اللغة، وتبعا لذلك ما يناقضها في الوعي، وبدل ذلك يفرض استعمال أسناد لفظية خاصة هي التي تدبر أمر هذه الإيديولوجيا وتدعمها، فاللغة بحسب الكاتبة هي أداة للهيمنة، ولكنها أداة للتحرر أيضا.
وعليه فقد أكدت الكاتبة أن خيار الأمريكيات القائل بضرورة تغيير اللغة بهدف التأثير في الذهنيات، واستباق تسريع تطورها، سيكون خيارا مثاليا، أما وإن توقفنا عن اغتصاب اللغة، فسيكون بالإمكان الحصول على نتائج مهمة، ومن المؤكد أن تأنيث أسماء الفاعل في الفرنسية هو مطلب معقول، بالنظر إلى السيرورة الخاصة بإصلاح لساني كبير أُطلق منذ سنوات في الولايات المتحدة حول شعار “ساعدوا على التخلص من الجنسانية، غيروا لغتكم” وهي المطالب التي حظيت بمساندة الكثير من المؤسسات الرسمية، إذ إن الإصلاحات اللسانية التي دافعت عنها النسويات بقوة في أمريكا لا تواجه مقاومة سلبية هي نتاج قوة جمود فقط.
وعلى سبيل الختم، تطالب الكاتبة بالنضال في ميدان المدرسة والمؤسسات الإعلامية، وليس ضمن الدوائر الضيقة، وبوجوب الحصول على قواميس غير جنسانية، وكتب مدرسية غير جنسانية، ومطبوعات إدارية غير جنسانية، وبعدم التوقف عن النضال شريطة معرفة حدود الفعل الممكن.
تختم الكاتبة في أربع نقاط:
- تعرقل استقلالية السجلات والأسنن المتميزة الحوار مع المضطهِد
- تغذي طريقة الكلام التمييز وتصنف الأفراد
- تفرز السلطة سوء فهم الآخر، فمطمح الدوني هو شيء غامض
- يتطلب النضال من أجل المساواة والحرية والهوية الثقافية من النساء ومن المجموعات المضطهدة والأقليات والمهمشين، تجاوز أشكال النضال من أجل الحق في التعبير والكلام وفي تحديد الهوية، والحق في امتلاك اسم، إلى نضال ضد لغة الاحتقار.