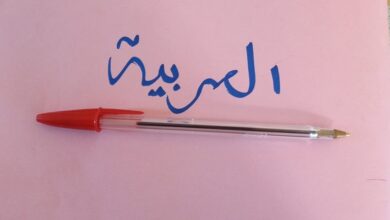في فلسفة اللغة: اللغة والعقل والتسلّط

في مادة سابقة حول فلسفة اللغة [1]، كنتُ قد ذكرت أن اللغة ليست مجرّد أداة للتفكير، بل هي الأداة التي تصنع الفكر، ترسم حدوده ومضامينه، وتحدد توجهاته في فهم العالم والتعامل معه. ولكن اللغة لا تشير فقط إلى الفكر وحده، بل لطالما دلّت اللغات المستخدمة في عصر معين على علاقات الإنتاج ووسائل الإنتاج في ذلك العصر.
وبمعنى آخر، لا تشير الدالات اللغوية المستخدمة في مرحلة تاريخية ما إلى نمط التفكير السائد في تلك المرحلة فحسب، بل تأخذ دلالات ماديّة “غير لغوية”، وتلعب دورا إرشاديا يقود الباحثين إلى فهم التفاعل والتداخل السائد، بين نمط الإنتاج الاقتصادي ونمط العلاقات الاجتماعية وشكل النظام السياسي.
وعندما ننظر إلى اللغة العربية الفصحى، ضمن تلك المعايير، أي عندما نراها بوصفها جهازا مفاهيميا يحيل إلى دلالات غير لغوية، أو ما بعد لغوية، قد نرى مدى استقرارها ومكوثها ضمن نمط الإنتاج الإقطاعي، حيث تكون الأرض هي مصدر الإنتاج ومصدر الثروة، في الوقت الذي تكون فيه مصدر القيم المادية والروحية أيضا، فالدفاع عن الأرض هو دفاع عن العرض والكرامة، ومن يتخلّى عن أرضه يتخلّى عن عرضه، وعندما يغزونا الاستعمار فهو يطمع بثرواتنا الطبيعية وينهب خيرات بلادنا، وتحرير أنفسنا يساوي تحرير أرضنا “المغتصبة”. تلك عبارات لغوية تحكم العقل، وتحكم النظرة إلى العالم.
أما في ما يخص النظام الاجتماعي، فالعائلة هي الخلية الأولى التي يقوم عليها المجتمع، ومركز العائلة هو الأب صاحب السيادة والملكيّة، وكثرة الأولاد “الذكور حصرا” تعني قوّة أكبر لمركزية الأب، وتحصينا لاسم العائلة من الاندثار، ووسيلة للانتشار في الأرض، وحفاظا على نمط التوريث الذي يديم النظام العائلي “البطريركي” ويجذّره في المجتمع. وأخيرا، تنتصب الهيراركية الاجتماعية للعائلات تحت سقف الإقطاعي، وهو المالك الأكبر للأراضي، وبالتالي للثروة والسلطة.
وبتوسيع تلك الدائرة الخلوية من العائلة إلى الدولة، ليس غريبا أن يتم التعامل مع رئيس الدولة بوصفه أبا للجميع، “إقطاعيّ الأمة”، وحامي الحدود، والذي لا يفرّط بذرّة من تراب أرض الوطن، ومثلما لا يرى الإقطاعي الفلاح إلا بوصفه عاملا أو “مرابعا” في أرضه، لا يرى رئيس الدولة الشعب إلا بوصفهم عمّالا أو “مرابعين” في أرضه الكبرى على مساحة الوطن.
عندما ننظر إلى اللغة العربية آخذين بعين الاعتبار تلك التراتبية المتفرّعة في المجتمع والاقتصاد والسياسة والتي تجسّدها اللغة، سنجد أن لغتنا ما زالت لغة إقطاعية بامتياز، على الرغم من الخلخلة والتغيير الذي حصل في المجتمعات العربية في العقود السابقة، حيث تبدو اللغة العربية الفصحى ثابتة وأبدية ومقدسة، ولا يمكن تجديدها من الداخل أو اختراقها من الخارج، نظرا لقداستها المرتبطة بكونها لغة القرآن، ونظرا لحمايتها للنظام الاجتماعي السياسي، لكن أيضا نظرا لانغلاقها البنيوي الذي ارتبط بنظام التقاليب الستّة الذي اخترعه الفراهيدي قبل أكثر من ألف عام.
إن ثبات عالم اللغة العربية الفصحى، ورسوخها في أرض القواعد والنحو والصرف، يبدو تماما مثل ثبات عالم النظام الإقطاعي ورسوخه في أرض الرموز المقدسة والمعايير المغلقة والأصول الثابتة، حيث يبدو كل مصطلح أجنبي دخيل على اللغة من خارجها، وكأنه احتلال لأرض المعنى الذي يجب احتكاره للعربية وحدها، وتبدو سلطة القائمين على اللغة، سلطة مركزية، هيراركية، متجّذرة، مثل سلطة السادة الإقطاعيين الذين يستمدون سلطتهم من النظام المتعالي للعادات المتوارثة، والمرتبطة بدورها بالقداسة والتقديس.
بالمقابل، وبالمقارنة مع اللغة الإنكليزية مثلا؛ تبدو الإنكليزية كلغة ناطقة بلسان النظام الرأسمالي، فهي لغة تزامنية وحركية وسريعة التغيّر والتجديد، مرتبطة بالزمن وبحركة السوق المتغيرة، وتتزامن فيها المصطلحات الجديدة مع حركة العلوم وابتكاراتها المتنوعة، وهي لغة “ديمقراطية” قابلة للتجدد الدائم والتغيير المتواصل والتبنّي السلس لمصطلحات اللغات الأخرى “الأجنبية”، ودمجها في السياق الاجتماعي السياسي واللغوي.
وهي أيضا لغة لا مركزية، ولا سيطرة عليها من مركز واحد؛ بريطاني أو أميركي مثلا، بل يكفي أن يظهر مصطلح جديد من عالم الشعر أو الفلسفة أو الفيزياء أو السياسة أو أي علم آخر، حتى يتم مباشرة دمجه وإضافته إلى القواميس الجديدة دون أي قداسة، ودون أي تثبيت “طفلي” على مصدر تلك المصطلحات الجديدة، سواء كانت عربية أو فرنسية أو ايطالية أو غيرها، فيكفي أن يصبح المصطلح دارجا في سوق الكلمات الاجتماعي والسياسي، أو سوق المراكز العلمية المتخصصة، حتى يتم إدراج ذلك المصطلح في القواميس دون النظر إلى الأصل والنسب والموقع الاجتماعي لمخترع الكلمات الجديدة.
عندما تترسمل اللغة، تتخلّى عن مطلقاتها، وتصبح هي ذاتها مليئة بالتنوع الاصطلاحي، في الوقت الذي توحّد فيه جميع التنوعات داخلها. وتغدو قادرة أكثر على الدمج والالتقاط والتأقلم، وتغدو تابعة بمعنى ما لقوانين العرض والطلب الاجتماعي على الكلمات والمصطلحات والتعابير، فتموت الكلمات التي لم تعد تفي بأغراض التعبير المعاصرة من دون مراسم دفن، وتُخلَق الكلمات الجديدة من “العدم” لتنصب لنفسها مكانا في الفضاء الرمزي والإشاري للمجتمعات دون معمودية كنسيّة، ولا مباركة إكليروسية.
إن ذلك الانفصال الذي يعيشه العالم العربي بين اللغة العامية؛ الحيوية والغنيّة بالإشارات والتحولات، واللغة الفصحى؛ الأكثر ثباتا ومحافظة وتعاليا والأبطأ تحوّلا، دون اختراع لغة متوسطة تدمج العاميّة بالفصحى وتبدع قواميسها التي تنطق بلسان المجتمع وتحولاته، هو انفصال يشبه، إلى حد بعيد، انفصال الأنظمة السياسية العربية عن شعوبها، حيث تبدو الأنظمة غارقة في التقليد والتوريث والتعالي والقداسة والهيراركية الإكليروسية، بينما تبدو المجتمعات حيوية وشبابية ومتنوعة ولا تكفّ عن التبدل والتحوّل، من دون أن تجد لها تمثيلا في الأنظمة التي تمثّلها قسرا وجبرا.
كما أن التحالف القائم والمتجذّر بين الديني والسياسي في العالم العربي؛ ذلك التحالف الذي يقف كحائط سدّ أمام نمو المجتمع المدني بتعابيره وحرياته الصحفية والمدنية والسياسية، ويدفع تلك المجتمعات نحو خيارين ديني وسياسي، أحلاهما مرُّ، هو أشبه بالتحالف القائم بين قداسة اللغة المرتبطة بالقرآن ورسميّتها المتعالية المرتبطة بالفصحى.
وفي كلتا الحالتين، فإن فكفكة تلك التحالفات القائمة بين السياسي والديني، أو اللغة والتراث المقدّس، هو فعل تحريري للسياسة وللغة معا، وفعل تحرري للمجتمعات الراغبة في التغيير والمعاصرة.
تبدو المجتمعات العربية بمعنى ما، كمجتمعات رأسمالية محكومة بأنظمة إقطاعية، مجتمعات متحوّلة ومتغيّرة ولا مركزية، محكومة بأنظمة ثابتة وأبدية وعصيّة على التغيير، وهمّها الوراثة والتوريث وتوسيع أرض سلطتها فوق جسد المجتمع. هذا لا بد من تغييره، واللغة إحدى عقباته.