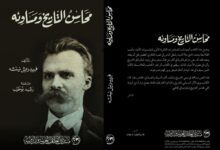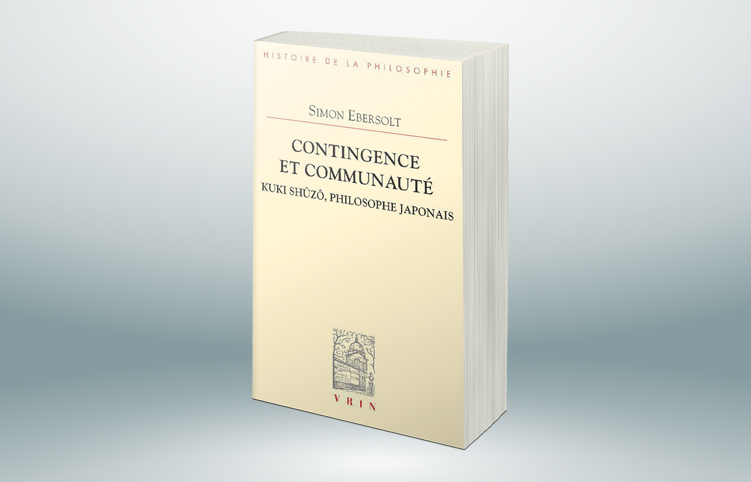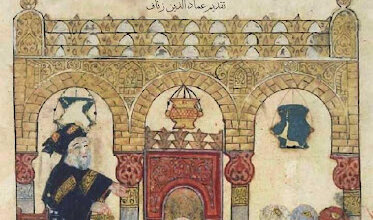مفهوم «التعددية» وتجديد الخطاب الديني

- في ضرورة التجديد

ففي السياق الغربي تسببت الأزمة التي خلفتها حداثة «البعد الواحد» unidimensionnelle في افتقاد الإنسان المعاصر «للمعنى»، وفي الزج به في صراع الثنائيات الإقصائية: «العقلي» بديلًا من «الديني»، و«النفعي» بديلًا من «الأخلاقي»، و«الاستقطاب» بديلًا من «التعدد» المشروع.
لكن -بفضل المراجعة المستمرة التي يقوم بها الفكر الفلسفي «المابعد حداثي»- ظهر تصور جديد رفع الوصم عن «الديني» وراهن عليه في دعم قيم «الخير العام»، وأكد أن العقل العلماني بانفتاحه على الدين يكسب ثراءً ويتدارك ما ينقصه.
وأن الدولة إن لم تستمع إلى كل الأصوات بما فيها صوت الدين، ربما تتسبب في حرمان المجتمع من مصادر ثمينة تضمن المعنى والهوية. هكذا اعترف الفكر «المابعد علماني» للخطاب الديني بدور قِيَميّ متميز، نقله من التهميش إلى احتلال مكان ذي بال في إثراء القيم الهادفة إلى إعادة الاعتبار للإنسان.
وفي السياق العربي، تحول الفشل في إدارة التعدد والتنوع إلى أزمة مزمنة، أوضحُ مظاهرها تواصلُ التنافر بين مكونات المجتمع العقدية والمذهبية والعرقية،
وتواصلُ الصراع التقليدي بين خطاب ديني كلاسيكي ثابت على إرادة الهيمنة على كل المجالات معتقدًا أنه وحده القادر على تحقيق المصلحة العامة، وبين خطاب علماني كلاسيكي ثابت على إقصاء الدين من الشأن العام، غير آبه بقدرة الخطاب الديني على توجيه قسم مهم من المواطنين.
والطريف أن الفكر العربي السريع التأثر بالمستجدات الفكرية في الغرب، تناسى هذه المرة التوْليفة الخلاقة التي أوجدها الفكر «المابعد حداثي» للتكامل والتعاون بين «الديني» و«العلماني» من أجل «الخير العام». ولعل الأمر عائدٌ إلى ضعف المراجعات وغياب النقد الذاتي في كل من الخطابين.
ونهتم في هذا المقال بالنظر في جانب من شروط تجديد الخطاب الديني وتأهيله لدور أخلاقي يتفرد به دون سائر الخطابات، وهو القدرة على التأثير في وعي «المواطن» المؤمن وترسيخ قيم التعددية في ضميره، من أجل تأهيله للعيش المشترك والممارسة الديمقراطية.
والجدير بالملاحظة بدءًا أن عدم اهتمام الخطاب الديني المعاصر بتطوير مقارباته، تسبب في عدم تخليص «النص الديني» من التوظيف الأيديولوجي الرافض للتعدد والمشحون بدعوات التدافع والتناحر، وهو الأمر الذي ساعد على تأبيدِ التمييز التفاضلي بين الإنسان والإنسان في المجتمع العربي، وتواصلِ التشريع الأصولي لفكرة العنف والصدام الحتمي بين الأديان، وبين المذاهب، وبين الثقافات.
صحيح أن الخطاب الديني الجديد الصادر من المؤسسات الدينية التابعة للدولة، حريص على الرد على أفكار الصدام بين مكونات المجتمع، لكن دائرة تأثيره ما زالت محدودة بحدود العلاقة المتوترة بين المواطن العربي والدولة، وبحدود الرصيد الهزيل من التمثل النقدي للتراث الديني.
ونظرًا إلى أن الاعتراف بالتعدد، وما يقتضيه من ضرورة العدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية، هما شرطا القضاء على أسباب التنافر الاجتماعي وخلق الاندماج اللازم لأية تنمية، فإنه من المهم أن نراهن على تجديد الخطاب الديني اليوم، وعلى إكسابه مقومات النجاح في المساهمة الجادة في الفعل التنموي.
- في مفهوم «التعددية»
يمكن النظر في كيفية حضور مصطلح «التعددية» في المعاجم العربية المعاصرة، من الكشف عن عامل من عوامل الضعف الذي يعانيه هذا المفهوم في الثقافة المتداولة. ففي الوقت الذي تعتني فيه المعاجم في سائر اللغات العالمية بالتوسع في عرض مصطلح Pluralisme وتطوره الدلالي، يتواصل إهماله في المعاجم العربية العامة والمختصة.
ويعكس هذا النقص المعجمي والمفاهيمي أزمةً في تعامل الفكر العربي مع جانب مهم من المفاهيم الكونية التي يختزلها مصطلح «التعددية».
وتفيد التعددية تصورًا يشرع لوجود مشترك وعادل للمختلفين في الآراء وفي العقائد وفي المذاهب وفي السلوك، وفي الأعراق، وغيرها… ولها أبعاد عدة: فلسفيًّا، ودينيًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا. ويعكس كل بُعْد منها تنوع الذوات البشرية وتنوع نوازعها، والجامع بينها هو أنها ائتلاف بين «خصوصيات» كل منها في حاجة إلى الأخرى ليحصل الوعي بوجودها.
من هنا تتحول التعددية إلى ضرورة وجودية، وإلى مصدر إثراء وإبداع دائمين: ترى حنا أرندت أن المجتمعات التعددية تفضل نكهة التنوع في جميع أشكاله، على أن يحكمها التماثل الباهت. والديمقراطية تعددية أو لا تكون. ولا يعني قبول التعددية تخلي القابل بها عن قناعاته والدفاع عنها والعمل على نشرها، بل يعني أن عليه أن يمتنع عن فرض قناعاته على غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه.
التعددية إذن، هي إطار للتفاعل الإيجابي بين الذوات المتعددة حتى تستطيع أن تتعايش وأن تبني مجتمعًا يكون فيه «الاختلاف» سببًا «لائتلاف» خلاق. ولِضعف هذا المفهوم في الثقافة العربية المعاصرة، وتواصل انعكاساته المتمثلة في التنافر بين «المختلفين» في المجتمعات العربية، كان لازمًا أن تتضافر كل الخطابات في بحث أسباب هذا الضعف، وفي ترسيخ ثقافة التعدد.
- «التعددية» بين الخطاب الديني التقليدي والجديد

وتوافقت مع هذه الدلالات المواقفُ التي عبر عنها الخطاب الفقهي القديم والمتمثلة في عدّ الاختلاف شكلًا من أشكال الانحراف عن الحقيقة ووجهًا من وجوه النقص غير القابلين للتدارك إلا بالقضاء على أسباب الاختلاف نفسها؛
وذلك إما عن طريق إجبار المختلف على التماهي مع «الذات»، أو عن طريق إقراره بالدونية وبالتبعية لها.
ولذلك كان حرص هذا الخطاب على محاربة التعدد مبررًا، لِعدِّهِ وضعًا مُشكِلًا ومخالفًا للصورة المثالية التي يرسمها لمجتمع خاضع لسلطة «الواحد» في كل الأبعاد، وكانت حربه لكل المغايرين لاختياراته تحت اسم الدفاع عن «المعتقد الصحيح»، ومشروعية «العنف المقدس».
ولو نظرنا إلى الكم الهائل من النصوص التي تدافع عن هذا التصور وتستدل عليه بتأويلات دينية موجهة وانتقائية، وإلى ما تتمتع به من إعادة إنتاج مستمرة، لوقفنا على سبب مهم من أسباب التهميش الذي يعانيه مفهوم التعددية اليوم، وعلى سبب التعثر الذي يلاحَظ على تناول هذا المفهوم في الخطاب الديني الساعي إلى التجديد.
وسنكتفي بالإشارة إلى نموذجين من هذه النصوص: واحد قديم، تصورُه للتعدد والاختلاف متوافق مع ثقافة عصره المحكومة بالصراع «المشروع»، والثاني معاصر وتقليدي، يوهم بالانفتاح على ثقافة العصر، لكنه لا يفعل إلا أن يعيد إنتاج التصور القديم.
يمثل النموذجَ الأول، الراغب الأصفهاني في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»: فهو يرسم طبوغرافيا للاختلاف عمادها «العقيدة» و«المذهب» و«الجماعة» بين حقيقةٍ مطلقة، وانحرافٍ خطير عنها.
ويرى أن هناك اختلافًا مشروعًا وآخر غير مشروع، توضحهما أربعُ مراتب: المرتبة الأولى هي الاختلاف بين «الأديان النبوية» والمعتقدات الإلحادية حسب رأيه. وهذا يراه اختلافَ متنافيين لا وجه للجمع بينهما.
المرتبة الثانية هي الاختلاف بين أهل الأديان النبوية، حسب عبارته. وهذا الاختلاف أقل حدة عنده. المرتبة الثالثة هي الاختلاف داخل الدين الواحد في الأصول: «كالاختلاف في الكثير من صفات الله تعالى وفي القدر وكاختلاف المجسمة».
وهذا -كما يقول- «جارٍ مَجْرى آخذيْن وجهة واحدة ولكن أحدهما سالك للمنهج والآخر تارك للمنهج، وهذا التارك للمنهج ربما يبلغ وإن كان يطول عليه الطريق».
المرتبة الرابعة هي الاختلاف في «فروع المسائل كاختلاف الشافعية والحنفية»، وهذا «جارٍ مَجْرى جماعة سلكوا منهجًا واحدًا لكن أخذ كل واحد شعبة غير شعبة الآخر»، وهذا اختلاف محمود في نظره.
تعكس هذه المراتب الأربع للاختلاف، عقليةً مسكونة بمركزية ثيولوجية تصنف «الآخر» وفق حظوظه في الاقتراب من عقيدة «الأنا». لذلك وفق هذا المنطق -يُعَدّ الاعتراف بالتعدد والتنوع، وبتعايش متساوي الحظوظ بين الجميع، من قبيل «المستحيل التفكير فيه».
وتكون علاقة «الحرب» هي المتحكمة في الجميع وفق عبارة ابن قيم الجوزية «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية»، وهي المقسمة للوجود الاجتماعي إلى مواقع متقابلة إن لم تكن متقاتلة فعليًّا،
فهي في حكم «المتقاتلة»؛ لأنه لا مجال للتعدد والاختلاف، بل كل المجال «للواحد الصحيح» الذي يوجب على «حامل الحق» أن يلغي أو أن يخضع الجميع من أجله.
ولئن ظل الإلغاء مطلبًا صعب التحقق؛ لأن الواقع الاجتماعي والعقدي متعدد بطبيعته ولا يمكن اختزاله في أحادية موهومة، فإن خطورته تكمن فيما يحدثه خطاب من هذا القبيل، اليوم، من تأثير في نفوس المؤمنين حاملًا إياهم على رفض التعدد والاحتراز من الذي لا يشاكلهم.
فهو خطاب كان متناسبًا مع عصره ومع أفق التفكير السائد فيه، لكن استحضاره اليوم أو إعادة إنتاج أفكاره، ستؤدي إلى إحداث نشاز كبير، المسؤول عنه ليس الخطاب الأصلي، بل الخطاب المقلد له المكتفي بالسير على خطاه على الرغم من اختلاف الرهانات من عصر إلى آخر.

النموذج الثاني يمثله محمد عمارة في كتابه «التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية». يشرع عمارة في هذا الكتاب الصغير للتعدد إسلاميًّا، معتمدا مقاربةً «تراثية» تمجيدية تخاطب الوجدان أكثر مما تخاطب العقل والضمير.
واكتفى فيها بالعموميات دون أن يغوص في المعالجة النقدية لكيفية حضور التعددية في إسلام «النص»، وإسلام «التاريخ»؛ ولكيفية حضوره في غرب «الاستعمار»، وغرب فلسفات التحرير و«الحقوق الكونية».
فانتهى إلى الحكم للمسلمين فيما عدّه ميزة لهم، وهو قبولهم بالتعددية؛ وإلى الحكم على الغرب عامة متهمًا إياه برفض التعدد وبالتجني على غيره.
وتصل به المقاربة الوجدانية، إلى عدّ اليهود والمسيحيين العرب «عملاء» للغرب، و«ثغرات بدأت منها جهود الغزو الفكري والتبعية الحضارية والتغريب». فهو يتهمهم جميعًا بالخيانة الحضارية بسبب الاختلاف في الدين، متناسيًا أن قانون التأثر والتأثير يتجاوز العقيدة إلى السياسة والاقتصاد والثقافة عامة.
إن هذا الكتاب المخصص لموضوع التعددية، لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج للتصور القديم للتعدد القائم على مركزية «الذات» في علاقتها بغيرها. ولئن كانت المقاربة الوجدانية المنحازة، مبررة بالنسبة إلى «مسلم» العصور الوسطى،
بمحدودية المشترك الإنساني وغلبة الصراع بين العقائد، وبين المذاهب، وبين الأعراق، فإنها لم تعد كذلك بالنسبة إلى واقع المسلم المعاصر المحكوم بإجماع كوني على منظومة القيم الإنسانية، وبالتنافس في توفير شروط العيش المشترك.
- شرط الوجود البشري
من هنا غدا تأسيس خطاب ديني جديد يطور سُبُلَ إقرارِ التعدد والاعترافِ به شرطًا للوجود البشري وتجليًا لحكمة إلهية، رهانًا دينيًّا تنويريًّا، ورهانًا تنمويًّا للمجتمع في مختلف أبعاده. ومن مقومات هذا الخطاب، التمثل النقدي لموضوع التعدد في التراث الفقهي، والتفاعل إيجابيًّا مع روح العصر وثقافته.
وهي مقومات يساعد على توافرها تجديدُ المقاربات المنهجية المعتمدة: فقد غدت الاستفادة من المكاسب التي حققتها علوم الإنسان والمجتمع ضرورة يمليها الانتماء إلى العصر.
فالمناهج والمفاهيم التي توفرها اللسانيات الحديثة، والأنثروبولوجيا، وتحليل الخطاب، وعلم الأديان المقارن، وغيرها.. من شأنها أن توفر أدوات تحليل قادرة على الكشف عن تاريخية الأحكام والمواقف التي تنهض بها خطابات فقهية صيغت في ظروف تاريخية محددة، تختلف بالضرورة عن ظروف عصرنا.
وذلك عن طريق تفكيك الأبنية الخاصة بهذه الخطابات، وتأويل وظائفها، والوقوف على دوافع كتابتها، بشكل يسمح بتنسيب «حقائقها».
إنها استجابةٌ لمشكلات ومشاغل متناسبة مع واقعٍ مضى، ولا معنى لمواصلة الاحتكام لها في حاضر المجتمع وفي مستقبله؛ بل كل المعنى لخطابٍ ديني جديد يساهم في نسق تطور المجتمع، ويضمن الإضافة الحافظة لكيانه، والضامنة لقدرته على إثراء المشترك الإنساني.
إن الخطاب الديني الجديد في انطلاقه من مبادئ: التعدد حكمةٌ إلهية غايتها التعارف والتعاون بين البشر، والتعدد حكمةٌ اجتماعية سبيلها التكامل الضروري لاستقامة الاجتماع البشري،
والتعدد حكمةٌ فلسفية قائمة على أن «الخاص» لا تُفهم خصوصيته إلا بمغايرته للمتعدد من حوله، يمكن له أن يبدع تصورًا للعيش المشترك ينهل من «الإسلامي» الخالد، مثلما ينهل من «الإنساني» المعاصر.
وعندما ينخرط هذا الخطاب في المنظومة المعرفية التي صاغتها علوم «الإنسان والمجتمع» اليوم، سيتميز بشكل واضح عن الخطاب الديني التقليدي المنخرط في منظومة معرفية ماضية أصبحت ناشزة عن قيم العصر.
حينئذ، يمكن أن نتحدث عن دوره الناجع في ترسيخ قيم التعددية في ضمائر المؤمنين وعقولهم، وفي التأسيس للثقة في جزء مهم من مكونات الهوية الحضارية، وهو الدين، وفي تعزيز إرادة النهوض نحو المستقبل.
- هوامش:
(١) Jürgen Habermas, Qu’est – ce qu’une société «post-séculière»?, Gallimard/ Le Débat, 2008/5- n° 152 & L’Avenir de la nature humaine, Paris, Gallimard, 2002
(٢) انظر المعجم الوسيط، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2004م؛ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2000م؛ معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، تونس، دار الجنوب، 2004م.
(٣) Qu’est- ce que la politique?, Seuil , 1995
(٤) Bernard Guillemain, Tolérance, Encyclopædia Universalis
(٥) ابن منظور، لسان العرب.
(٦) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2007م.
(٧) نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1997م.
مجلة الفيصل