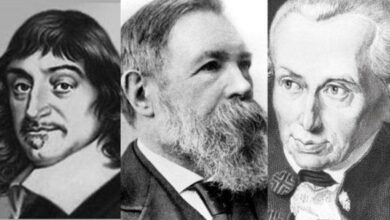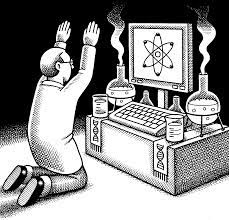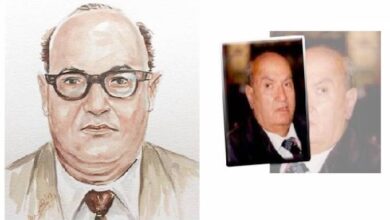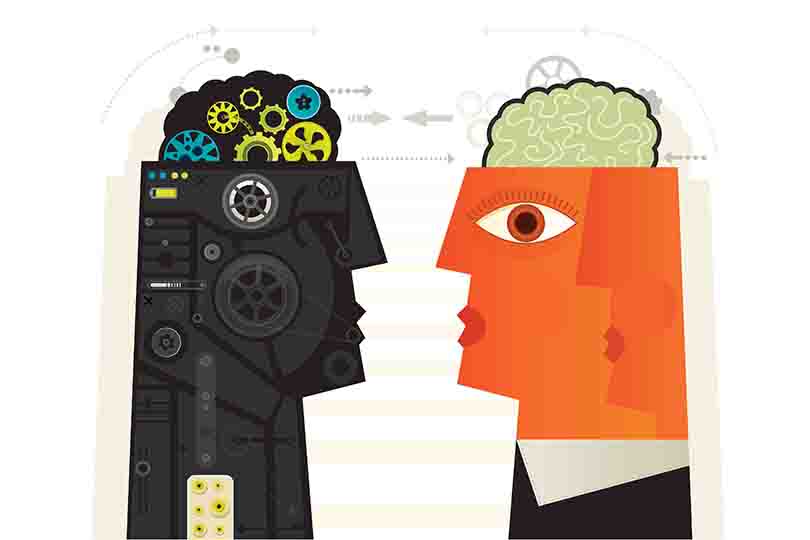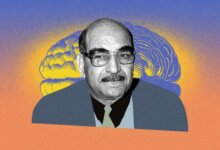الأصول الفكرية والدينية لخطاب طه عبد الرحمن
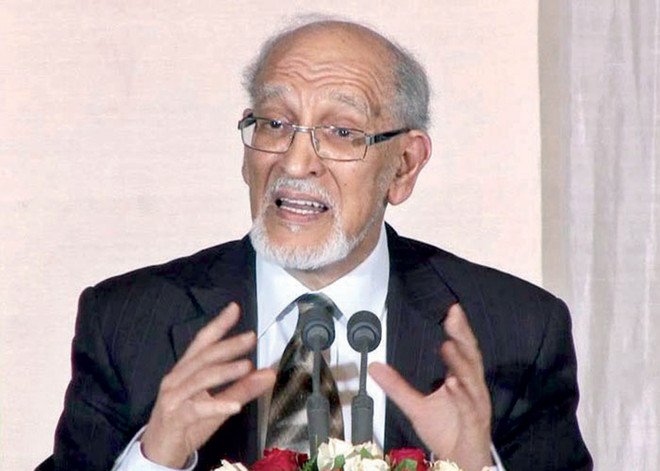
انتقد عبد الله العروي طه عبد الرحمن، في الحوار الذي أجراه معه موقع “بالعربي” الإلكتروني بتاريخ: 12/09/2021، بأن ما لم يأخذه طه بالاعتبار، في الوقت الذي يبحث فيه عن أصول أفكار الآخرين، أنه لا يبحث عن أصول تفكيره هو، ولا يعلن عنها، وأن جل مفاهيمه الإجرائية، أي آليات فكره وتفكيره ليست مأصولة كما يدعي؛ وإنما منقولة.
لم يقبل مريدو طه ما قاله الأستاذ العروي عن فكره وآلياته ومفاهيمه، فانهالوا عليه بالتهم في شخصه؛ بلغت درجة تجريده من العلم والمعرفة.
ويدل هذا النمط من المواقف على طبيعة وخطورة ما ينتجه فكر الأستاذ طه في عصر الحداثة وحقوق الإنسان والعلم والمعرفة، وما يقتضي ذلك كله من سيادة ثقافة الاعتراف، والإنصاف في النقد والتقييم.
وقد تأكد لنا، ونحن ندرس المشروع الخطابي للرجل، أن أغلبه مستمد من أصول ومصادر؛ فكان نقد العروي وهجوم المريدين عليه سببا لتخصيص هذه المقالة للكشف عن تلك الأصول والمرجعيات.
إذ أغلب مقولات طه ومفاهيمه وآلياته، مسبوق إليها، وقد يعود إليه منها ما يتعلق بالصناعة اللغوية، التي تعتمد آلية التشقيق اللغوي، والصناعة الصورية التي يتيحها المنطق؛ وهو ما يعترف به.
يقول في سياق نفي وجود فلسفة ذات طابع كوني، واتباث بدلها ما يسميه “المشترك المتنوع”: “ليس هذا التنوع في المشترك الفلسفي نقصا في الفكر الفلسفي (…) بل إنه يصير كمالا في هذا الفكر متى استطاع المفكر أن يستثمر الجوانب اللسانية والدينية التي تلازم فكره في ابراز هذا المشترك الفكري“. (المفاهيم الأخلاقية 1/ ص، 11)
ويعترف أيضا بأن وسائله منقولة؛ يقول: “وقد استمددنا وسائلنا المنهجية ومفاهيمنا النظرية من علمين دقيقين عرفا منذ زمن يسير انقلابا في أدواتهما ومبادئهما ومضمونهما” وهما اللسانيات وعلم المنطق. (في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: 19)، ويبدو أنه نسي ما اعترف به هنا، في كتبه اللاحقة بعد، إذ اتهم فيها مخالفيه من أنصار الحداثة باستهلاك الآليات المنقولة من الغير.
فما هي الأصول الفكرية والدينية لفكر طه؟ وما هي الطريقة التي يوظف بها المنجز الفكري الذي يقرأه ويتعامل معه؟
تحضر في خطاب طه عبد الرحمن ثلاث مصادر هي مرجعيات فكره؛ وهي الفكر الفلسفي والديني القديم، والموروث الفكري والديني الإسلامي، وأخيرا المنجز الفكري والفلسفي الحديث. ويسلك في التعامل واستهلاك معطيات كل مصدر من المصادر طريقة معينة؛ نضيء عليها تباعا، معتمدين منهج التوثيق تاركين للقارئ المقارنة واستخلاص النتائج.
لقد صرح طه عبد الرحمن في كثير من كتبه، بالطريقة التي يتعامل بها مع منجز الغير، والتي تقوم في الغالب على أسلوب الصناعة وإعادة البناء؛ ولا شك أن إعادة الصناعة لما هو منجز تختلف عن الابداع الذي به تتحدد أصالة الفكر.
إذ إعادة الصناعة والبناء تحصر المنجز بهذه الصفة في نطاق “القراءة”؛ غير أن طه يرى، عكس ذلك، أن منهج إعادة بناء ما هو منجز، سواء كان قديما أو حديثا، يعتبر عملا “فلسفيا” ابداعيا.
يقول في سياق تأكيد ما يسميه: “فتنة مفهومية كبرى” تواجه المسلمين اليوم، عن أحد الخيارات التي يتعين على المسلم العمل عليها إزاء تلك “الفتنة” إما: “ابداع مفاهيمه أو إعادة ابداع مفاهيم غيره، حتى كأنها من ابداعه ابتداء”. (روح الحداثة: 11) ويقول مؤكدا: “إذ لا نعمد إلى تغطية المفاهيم المنقولة بالمفاهيم المأصولة، وإنما نعيد إبداعها بما يجعلها تحمل جديدا ليس في أصلها“. (نفسه: 14)
يعتمد طه في التعامل مع منجز الحداثة، منهج “البدل” و “الاستبدال”؛ ففي سياق تفضيل “العمل” الذي لا يقصد به إلا “العمل الديني”، على النظر والعقل والقول، كما تقول به الحداثة؛ إذ يرى أن النظر ليس شرطا للعمل، فوضع في مقابل القول بازدواج الحقيقة الإنسانية بين النظر والعمل، الصيغة العملية.
يقول إنه يمكن: “أن نستبدل بهذا الافتراض افتراضا يضاده، وهو أن الحقيقة الإنسانية (…) حقيقة عملية”، وانتهى في هذا السياق إلى وضع ما يسمى في الأدب العرفاني “الجوانح الداخلية” في مقابل “الجوارح” التي بها يتحقق العمل. (سؤال العمل: 79-80)
يقول، معترفا باعتماد ما نصطلح عليه “منهج منطق الضد”: “ولما كان التملك-أو الحيازة-مفهوما مشتركا لاينفك الفلاسفة ينظرون له، فقد لزم أن يكون ضده هو الآخر، مفهوما مشتركا، حتى ولو لم ينظر له هؤلاء، فما يصدق على المفهوم من الاعتبار العقلي، يصدق على ضده؛ وضد الحيازة هو الأمانة، فيسعنا من جانبنا إلى أن ننظر له كما نظروا للحيازة”. (المفاهيم الأخلاقية 1: 16)
ويقول في نفس السياق؛ سياق وضع المفاهيم باعتماد آلية “المقابلة”، حيث وضع مفهوم “العقل المؤيد”، كمقابل “للعقل المجرد”: “فقد ذكرنا أن العقلية المجردة تأخذ بمسلمتين هما: “الاستغناء عن الأساس الإيماني”، و “التوسل بالنقد والشك”، أما العقلية المؤيدة، فتأخذ بضدهما، وهما: “الاحتياج إلى الأساس الديني”، و “التوسل بالتسليم واليقين” “. (المفاهيم1 الأخلاقية: 229)
ورغم تصريحه باعتماد ذلك المنهج، لم يجد مانعا من اتهام الفلسفة الحديثة؛ وتحديدا فلسفة العقد الاجتماعي، بأنها أخذت جميع عناصر “نظرية العقد الاجتماعي” من “الميثاق الديني”، معتمدة منهج “مقابلة الضد لضده”. (نفسه: 44)
وعن المنهج الذي تعتمده “الإئتمانية” في تأسيس بدائلها يقرر ما يلي: “وقد دعاها هذا التأسيس إلى القيام بتبديلين جوهريين، يدفع عنها الآفات التي تعرضت لها “الإئتمارية” و “العلمانية”؛ إذ بدلت بالعلاقة الإئتمارية، العلاقة الإئتمانية، كما بدلت العلاقة التعاقدية، بالعلاقة التواثقية”. (نفسه: 37) ويعتمد منهج الاستبدال لما هو مقرر في “النظريات الأخلاقية الحديثة” بقوله: “ومتى ظهر أن هذه الأخلاقيات تخل بالتناسب المضموني(…) احتجنا إلى طلب أخلاقيات تستبدل بالتعقل والتنكر خلقين آخرين”.
(سؤال الأخلاق: 132) ورغم ذلك يعتبر “بديله” المدعى “نظرية أخلاقية” خاصة به: “إنما هي نظرية تستبدل مكان صفة التعقل مبدأ “التخلق” الجالب للحكمة المؤيدة، وتستبدل مكان صفة التنكر مبدأ “التعرف” الجالب للبصيرة المسددة”. (سؤال الأخلاق: 133)
تفرض مجموعة من الأسئلة نفسها، في هذا السياق، بعد اعتراف طه بالطريقة التي يعتمدها في بناء “البدائل” التي يدعيها، منها هل بإمكانه تأسيس “البدائل” المدعاة لولا وجود فكر جاهز ومنجز؛ فكر الغير، مفاهيم وقيما ونظريات؟
ألا يقتضي منه ذلك الشكر والاعتراف لمن مهدوا له الأرضية للبناء عليها؟ هل اعترف طه وشكر، أو أنه بدل ذلك هاجم وسلك طريق الاتهام؟ ماذا لو لم يكن هذا المنجز الإنساني، الحداثي والديني جاهزا؟ هل ستظهر “بدائل” طه فعلا وواقعا؛ “بدائله” الإئتمانية، و”الحداثة الإسلامية”، و”الحداثة الروحية”؟
لجأ الأستاذ طه، عوض الشكر والاعتراف، إلى الاتهام وإصدار الأحكام (البؤس، الشرود، المروق…)؛ فإلى أي ثقافة تنتمي هذه الأحكام-“الشتائم”، هل تنتمي إلى ثقافة يبنيها الفكر أم الضغينة؟ بل اعتمد أكثر من ذلك أسلوب الهدم والنقض (وهو ما يعترف به في: أصول الحوار وتجديد علم الكلام: 19-وروح الحداثة: 15).
الذي توهم أنه نجح فيه، جاهلا أو متجاهلا أن محاولته في الهدم مستحيلة، وأن ما نجح فيه أو يمكن أن ينجح فيه هو إعاقة الحداثة في حياتنا نحن الذين نتقاسم معه الانتماء إلى جغرافية هذه الحياة والثقافة، مكرسا وضع الصغار الذي نحن فيه غارقون أصلا. أما المنجزون للحداثة، المبدعون لها فلن تمتد معاول هدم طه إلى حياتهم، التي ترفل في منجزاتها.
لقد سبقت الإشارة في المقالة السابقة، إلى تمييز طه بين روح الحداثة وواقعها، وهو تمييز سبقه إليه واحد من مفكري الحداثة ونقاد واقعها، ويبدو أنه سكت عن هذا المصدر؛ إذ لم يورده ضمن مصادر كتابه “روح الحداثة”؛ ونورد مزيدا من الأمثلة، في حدود ما يسمح به المقام.
وتبقى مجرد أمثلة، ولتكن البداية من فكرة “الإئتمانية” نفسها، التي يعتبرها “بديله الفلسفي” عن الفلسفة كلها، القديمة والحديثة، فقد رأينا فيما سبق أنه ولدها بمنهج “منطق الضد”؛ إذ أخذ بها كمقابل لفكرة “الحيازة” في نظرية العقد الاجتماعي.
وبعد ذلك عمل على تأسيسها على النص القرآني، وتحديدا على آية الأمانة (الأحزاب: 72)؛ ورغم هذا التأسيس الثاني، لم يغب التأسيس الأول في البناء الطهائي “للإئتمانية”؛ فجميع عناصرها التي فصلها، ترجع أصولها إلى فكرة العقد الاجتماعي كما أسسها فلاسفته.
وننبه في هذا السياق إلى أن طريقة تعامل طه مع هذه النظرية في الفلسفة السياسية، وموقفه منها تطور عبر ثلاث مراحل؛ فقد اتخذها في البداية أصلا للقياس؛ إذ قاس عليها فكرة “الميثاق” الديني على العقد الاجتماعي (المفاهيم الأخلاقية 2: 16).
ثم بعد ذلك انتقد فكرة العقد وحكم عليها بأنها مجرد وهم وخيال (سؤال الأخلاق: 159)، وأخيرا قرر أن العقد مقتبس بشكل متنكر من الميثاق الديني. (دين الحياء 1: 20-سؤال الأخلاق: 160)
تتأكد مرجعية “العقد الاجتماعي”، لميثاق طه الإئتماني، من خلال اتخاذه أصلا للقياس، بعدما اعترف باعتماد “منهج منطق الضد” في تأسيسه، يقول: “ولما كانت النظرية الإئتمانية نظرية تواثقية، فقد شابهت، من حيث البنية العامة، النظريات التعاقدية (…).
فكما أن النظرية التعاقدية تتصور حالتين: “حالة الطبيعة” والحالة المدنية، فكذلك النظرية الإئتمانية تتصور حالتين، “حالة المواثقة و”حالة المعاملة”؛ وكما أن النظرية التعاقدية تتصور الإنسان، في “حالة الطبيعة”، بأوصاف وأوضاع خاصة تحتم عليه الخروج منها إلى “الحالة المدنية”.
فكذلك النظرية الإئتمانية تتصور الإنسان، في حالة المواثقة، بأقوال وأفعال خاصة توجب عليه تفريغ ذمته منها في “حالة المعاملة””. (المفاهيم الأخلاقية 2: 16) ويتأكد أيضا بوضع مقابلات للعناصر التي تتكون منها نظرية الاجتماعي، وأهمها “حالة ما قبل الطبيعة”، و”الحالة المدنية”.
فقد عمل طه على افتراض مقابلات لتلك العناصر؛ فأصبح ل “الميثاق الديني”-الإئتمانية عناصر هي: ما قبل الرسالة، أو “حالة الجاهلية”، وحالة المواثقة، و”حالة المعاملة”. يقول: “ولما كان هذا المشترك يجعل العقد الاجتماعي بنية مزدوجة مؤلفة من حالة الطبيعة والحالة المدنية.
فقد أبرزنا هذه البنية في التواثق الإلهي، فجعلناه، هو الآخر، مكونا من حالتين: إحداهما سميناها “حالة المواثقة” (…) والثانية أسميناها “حالة المعاملة””. المفاهيم الأخلاقية 1: 14)
فهل كان بإمكان طه تفصيل “ميثاقه الإئتماني” بالصورة التي فصله بها، لولا وجود نظرية العقد الاجتماعي التي أرساها فلاسفة الحداثة؟ يساعد غياب فكرة “الميثاق” كما حاول طه تأسيسه، في الموروث الإسلامي، على الإجابة، فيبقى أنه مجرد ابدال لعناصر العقد الاجتماعي، بعناصر أخرى مستقاة من الثقافة الإسلامية، كما صرح به في النص السابق (المفاهيم 1: 55)
تحول المنجز البشري، فكرا وقيما ومعرفة، إلى عقدة لدى طه؛ إذ يدل ويعكس قدرة الإنسان على التشريع الروحي لنفسه، فاجهد نفسه في سحب هذا الاقتدار من الإنسان، فحكم على منجزه بأنه مجرد “اقتباس متنكر” من “الدين” (انظر مقالة: الفلسفة دين متنكر في نظر طه عبد الرحمن).
فعمل على الكشف عن الأصول الدينية لذلك المنجز، فاعتمد أسلوب الادعاء، ثم “منهج منطق الضد”، الذي يكتفي فيه طه على افتراض مقابلات للمنجز الإنساني، فيصبح المقابل المفترض “بديلا” طهائيا.
يأتي، في سياق هذا الصنيع، تحديده للإنسان بأنه “مخلوق عابد”، أو “مخلوق عامل” (فقه الفلسفة 1: 282ن وسؤال الأخلاق: 77)، فهو مجرد رد فعل والرغبة في إيجاد مقابل لتعريف الفلسفة الإغريقية للإنسان، ويندرج في إطاره أيضا محاولة تحديده الذات “بالإحساس والروح”، فهي مجرد رد فعلن وإيجاد بديل “للذات” كما عرفتها الحداثة، وكذلك ترجمته للكوجيطو ب “انظر تجد”. (فقه الفلسفة 2)
نكتفي بهذه الأمثلة فيما يتصل بالفكر الحديث، ونأتي الآن إلى القضايا المتصلة بالفكر الديني والفلسفي القديم؛ وهي قضايا وجودية ميتافيزيقية مثل: الجسد والروح، والحياة والمعرفة والتاريخ (…) ويتأكد بالبحث أنها ترجع إلى أصول فلسفية قديمة، وغنوصية، ودينية، مستمدة منها بشكل مباشر، أو بالواسطة عبر العرفان الصوفي الإسلامي.
يؤكد طه، بخصوص الإنسان، على ثنائية “الروح-الجسد” (روح الدين: 181-182)، فيقرر ما هو مقرر في الفلسفة الفيتاغورية والأفلاطونية الجديدة؛ ثم في المذاهب الغنوصية، التي ترجع أصولها إلى الكتابات الهرمزية؛ المنسوبة إلى “هرمز” مثلث العظمة؛ فهي مصدر ثنوية الروح-الجسد، والنظر إلى الجسد بوصفه يمثل الظلام، والروح ممثلة للنور والحقيقة.
(الوجه الآخر للمسيح: 76) وهو الإرث الذي نقل إلى الثقافة الإسلامية عبر قناة العرفان الصوفي والفلسفي، خاصة عبر مؤلفات الحارث بن أسد المحاسبي، وذو النون المصري (التيار الإشراقي).
وأبو يزيد البسطامي (تيار الفناء الروحي)؛ والتياران يلتقيان حول فكرة “أن قهر الجسد يحرر النفس”. (أعلام الفلسفة العربية في العصر الوسيط: 272-271)؛ فأعلامه: “يعتقدون بأن النفس من أصل طاهر شريف، تلوثت بأدران المادة.
إذ حلت في الجسد وخضعت له فأشغلها في أغراضه الحيوانية”. (نفسه: 267) وللتحرر من عبودية الجسد، واستعادة الروح لطهارتها السابقة، لابد من قهره واذلاله وحرمانه من رغباته، فإذا نجح الإنسان في ذلك، سمت روحه نحو الله واستمدت منه المعرفة الصحيحة. (267)
يقول مقررا لما رسمه أولئك: “لقد وجد الإنسان في عالم الغيب روحا مجردة قبل ان يوجد في عالم الشهادة روحا مجسدة، وشاهدت روحه، ومهي في غاية نقائها وصفائها، من جلال الألوهية وكمال الوحدانية وحقائق الغيب ما شاء الله أن تشاهده (…).
لكن لما جاء أجل ظهورها في عالم الشهادة (…) متلبسة ببدنها الذي يظهرها ويميزها، كادت أن تنسى الميثاق الغيبي الذي أخذه منها، كما لو أن تلبسها بالبدن يحجب عنها ذاكرتها؛ وما ان شرع صاحبها يلبي لازم حاجات بدنه، مقيما بنيته، حتى استدرج إلى قضاء زائد شهواته، خاضعا لراسخ عوائد مجتمعه (…)”. (روح الدين: 277)
لا تخرج “إئتمانية” طه ومقولاتها عما رسمته الفيتاغورية والأفلاطونية والغنوصية، والعرفان الإسلامي، حول الجسد، والروح، والمعرفة، والعقل، والقلب، والذاكرة، ودور ومكانة الشيخ أو المعلم؛ فهو ينيط المعرفة بالقلب بدل العقل، مثل التصوف الذي يؤسس موقفه على نظريته في الوجود القائمة على أن الله هو الموجود الحقيقي.
أما العالم فمجرد عدم؛ لذا يتعذر، بناء على ذلك، إدراك الحقيقة بما هو غير حقيقي؛ أي بالعقل، ولهذا أخذ المتصوفة بالقلب بديلا، الذي تفيض عليه المعرفة بالإلهام، وبفضل هذا الإلهام ترتسم الصفات الإلهية ومعانيها في القلب. (277-278) (روح الدين:288)
تتفق التيارات السالفة في القول بتميز النفس-الروح، وبأنها كانت تعيش في عالم آخر، ولما اتصلت بالجسد أصبحت حبيسة لمطالبه، وفي احتقار الجسد-المادة، واعتباره عائقا للروح نحو العودة إلى عالمها الأصلي، وخسرت، بسبب ارتباطها بالجسد ما كانت تعرفه من الحقائق.
لذا كانت وظيفة الفلسفة في نظر أفلاطون تذكير الروح، ووظيفة المرشد أو المعلم هي تسهيل طريق التذكر. (أعلام الفلسفة العربية في العصر الوسيط:349) وهي الوظيفة التي أنيطت للرياضات الروحية في العرفان الصوفي، وللطرقية في التصوف الطرقي، الذي يتبناه طه، والتي يسميها “العمل التزكوي” برئاسة الشيخ، أو بعبارته الأثيرة “المخلق”.
يلتقي طه مع نظرية التذكر الأفلاطونية في اشتراط المعلم، ويختلف مع التصوف العرفاني، ومع الغنوص وكنائسه اللذين يسقطان الوساطة التي يدعيها رجال الدين؛ إذ ترى أن من حاز العرفان، يبلغ، بنفسه، المعرفة التي هي شرط الخلاص. (الوجه الآخر للمسيح: 57)
تلك هي رؤوس أقلام لأهم المقولات وأصولها التي تتأسس عليها إئتمانية طه، سيتضح أن كل ما عمله هو إعادة انتاجها بلغة صناعية حديثة؛ إذ يقرر في كثير من مؤلفاته أن الإنسان كان، قبل ظهوره في العالم، مجرد روح في عالم الغيب (روح الدين: 277).
وبعد ظهوره في هذا العالم يملك القدرة على الحضور في العالمين معا؛ فيكون بجسمه في عالم، وبروحه في عالم آخر (دين الحياء 1: 16، روح الدين: 31) ويقرر ذات النظرة إلى الجسد بوصفه سجنا للروح، والقول بأن النفس تلوث الروح، واعتبار الطرقية الصوفية هي طريق خلاص الروح (روح الدين: 278-282)، بتوجيه واشراف من الأوصياء والشيوخ (دين الحياء 1: 19-20)
ويرى أن الروح تحفظ علاقتها السابقة بعالم الغيب، وتحمل ذكريات هذا العالم، لذا تحتاج إلى الذكر و”التذكير”، وهو ما يقوم به العمل الطرقي والشيخ المخلق. (روح الدين: 51-52) فواجب الإنسان في الحياة، هو أن يتذكر ما شاهدته روحه من غيبيات (روح الدين: 278) وفي سياق ابراز قدرة الروح على الرؤية بالبصيرة.
كما يرى الجسد بالبصر، والعقل بالاستدلال أو الاعتبار، قرر أن هذه الرؤى غير منقطة الصلة؛ بل هي تتبادل التأثير، غير أن أنه تأثير يختلف باختلاف درجة وقيمة مصدر كل واحدة منها. يقول: “إلا أن تأثير الأعلى عبارة عن تزكية، وتأثير الأدنى عبارة عن تدسية”.(روح الدين: 282)
وهذا الموقف يستبطن احتقارا للعقل وللجسد؛ وهو ما يتضح فيما حدد به “التدسية”، التي يضعها في مقابل “التزكية” التي هي أثر الروح؛ إذ تفيد معنى “الإصلاح” اصطلاحا، كما يقول. وبعدها يقول مبينا معناها: “إن التدسية (أثر العقل والجسد)، تفيد لغة الإخفاء، واصطلاحا الإفساد؛ والإفساد لا يكون إلا بموت الروح، بينما الإصلاح لا يكون إلا بحياة الروح”. (روح الدين: 276-277)
يبقى أن نشير، فيما يتصل بالأصل التراثي لخطابه، إذ يأخذ به كما هو، محاولا إعادة ترتيبه وفق نظام، يمنح للتصوف سلطة التأطير والاشراف والتوجيه، التي كانت للفقه في الماضي، إلى أمرين؛ أولهما أن طه يركز ويحتفل في المعرفة التراثية بما يعتبره تفوقا للتراث في جانب الآليات.
خاصة الآليات اللغوية والمنطقية الجدلية، لكنه يتجنب الخوض فيما يتصل بالمضامين والمحتويات؛ إذ يعتبرها مسلمات، والغريب أن سبب اتهام قراءة خصمه عابد الجابري بالتجزيئية، يرجع إلى أنه ركز في قراءته التراثية على مضامين التراث دون آلياته وأدواته المنهجية.
وثانيهما أنه يوظف الصناعة اللغوية، خاصة الصناعة المفهومية والمصطلحية في إعادة انتاج المادة التراثية، بشكل يوحي للمتلقي أنه ينتج جديدا؛ مثال ذلك مفهوم “الإئتمانية”، الذي صاغه من مصطلح “الأمانة” القرآني، ومفهوم “التفقيه”، والذي نحته من مصطلح “الفقه”، ومفهوم “الإئتمارية” الذي ولده من مصطلح “الأمر”.