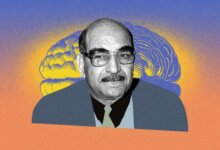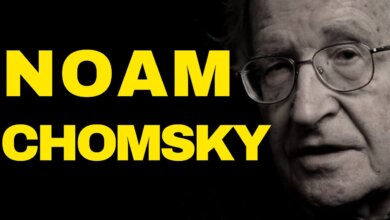دورة المعرفة وقلق العبارة

قديمًا قالوا إن الفلسفة هي أم العلوم، فصارت إلى لسان جميع الأمم، بحيث لا توجد أمة لا تشتغل بالفلسفة وفنونها، لإدراكها بارتباطها بأصل التفكير، إذ كل إمعان في موضوع ما ماثل أمام العين، فهو نوع من الدهشة الفلسفية، تكبر أو تصغر بالنظر إلى حجم العمق الذي نفذ إليه ذلك النظر.
ولكونية الفلسفية وعدم مركزيتها في جغرافية ما، فقد حصل لها الذيوع والانتشار في كل أقطار المعمورة، فتحدثت بها ألسن الخلائق وتفلسفت هي بدورها بمنطق لغات العالم، فهي كالنحلة تحط في كل الحقوق والأزهار والمدائن، تحلق عاليًا وتنزل لتأخذ الرحيق من العلوم والفنون، وتلقح بها الحياة والوجود، وفي ذلك شراب للناس تهذيبا للنفوس وتغذية للعقول.
مما يدل على عدم مركزية جغرافيا الفلسفة، فهي كالقسمة العادلة بين جميع الشعوب والحضارات، وهي كالنهر الجاري الذي له روافد كثيرة ومنابع مختلفة تمده بالتنوع والقوة والدفقة، لكي يصل المدى ويحقق المبتغى، فلما ينقطع أو يجف أو يقل صبيب منبع منه يعوض بنبع آخر، فهم جميعًا إلى مصب واحد وهو “الحقيقة الوجودية“.
قصدنا من هذا السرد أن المعرفة تراكم إنساني تساهم فيها البشرية على تعدد أجناسها واختلاف ألسنتها، ولا تستطيع أمة أن تدعي الملكية الفكرية الحصرية لصنف معرفي وتسقطه عن بقية الأمم، لأن المعارف تنمو وتتلاقح ويعطف بعضها على بعض، كأنها بنيان مرصوص يعمل كل شعب وكل حضارة على وضع لبنة منه بحسب جهده وإبداع أفراده، إلى أن يحقق الطفرة المنشودة والوضوح المطلوب.
وقد ساهمت الترجمة في وصل المعارف والحضارات، بل وفي هجرة الأفكار وتزاورها، لأنها ليست فحسب شروحًا وتعبيرًا عن جمل وألفاظ بأخرى، بل هي عملية تتجاوز النقل إلى البرهنة والاستيعاب والضبط، وهي على نحو ما تلخيص وتخليص، بحيث يتفاعل المتن مع الشرح في صورة يكون فيها المترجَم وافدًا والمترجِم رافدًا.
إن العبارة المشتهرة والموجزة عن الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف المولع بالفلسفة والمحب للحكمة: ”رفع قلق عبارة أرسطو”، تمثل الخلاصة النقدية والتوصيفية لمشكل النقل والتداول المعرفي بين اللغات المختلفة، وهي عنوان التحدي الذي تواجهه الترجمة من لسان إلى آخر، بفعل غياب الوعي بأغراض الترجمة وضعف فهم أغراض المتكلم.
لأن من طبيعة النص الذي يراد نقله إلى لغة أخرى أن يكون متلبسًا بتُربته الخاصة ومأخوذًا إلى سياقه الثقافي، لذلك تكون المفاهيم مشبعة ومثقلة بجذورها التداولية، بحسب ما يضاف إليها من مواضعات وتواطؤات الاستعمال، فحينئذ تكون الترجمة التي تعتمد تقابُل المفردات أكثر جناية في حق النص الأصلي، وتكون مضرة بالتواصل والنقد لأنها تشوه المعاني والمقاصد.
وعيوب الترجمة الحرفية أو البكماء يختصرها “الصلاح الصفدي”، كما ينقل عنه العاملي في “الكشكول” والسيوطي في “صون المنطق”، في نقده لمناهج التراجمة العرب، من خلال رصده لاتجاهين في تعريب النصوص، أحدهما ينطلق من تعريب الكلمات مفردة بحسب ما يرادفها في اللسان العربي.
وهذه الطريقة رديئة في نظره لوجهين اثنين: أولاً لعدم وجود كلمات عربية تقابل كل الكلمات اليونانية، وثانيًا لاختلاف البنية التركيبية بين اللغتين ومجازهما، أما الطريقة الثانية فهي تعتمد الجمل من خلال تتبع المعنى الكلي لها وتحصيله ذهنيا، ثم يعبر عنها بما يناسبها من المعاني ولو اختلفت الكلمات المستعملة، وهذا الطريق أجود كما يقول.
وثمة نوع آخر من الترجمة ينحو منحى التوسط بحيث يراعي إظهار ما عند الآخر من فنون ومآثر فكرية وحضارية، فيكون غرضه تحقيق التوصيل وتبليغ المعلومة، لكنه لا يبدع في لغة النقل والترجمة، لأنه مدفوع بالتوصيف دون التشويق.
مما أوجد نوعًا جديدًا من الترجمة التوليدية التي تتوخى إحداث لقاء جديد مع النص الأصلي مع المتلقي الغريب، بحيث تندفع شبهة الغربة بينهما، وكأن النص ولد من لحظته تلك، سيما إذا كان النص ينشد أغراضًا نهضوية وإصلاحية، يراد منه أن يضطلع بها من خلال الخدمة الفنية المضافة التي أنجزت عليه، وهذه من المقاصد التي يلوذ بها التراجمة الإصلاحيون.
وهذا هو ديدن العلاّمة ابن رشد حين عكف على نصوص أرسطو في المنطق، وعمل على تبسيطها وشرحها وتقريب معانيها إلى القارئ العربي، وهو يعي تمامًا المأزق اللغوي الذي يمارسه نشاط الترجمة، فالتفاوت بين لغة وأخرة في التعبير والاكتناز والفصاحة والاستعارة والمجاز، كلها عوامل تفضي إلى عقبة لسانية تحول دون تجسير الهوة بين حضارة وأخرى من خلال مدخل اللغة.
لكن غرض ابن رشد هذا مواجه بعقبة لغوية سببها كونه ليس قارئًا لنصوص اليونان، فهو مطلع عليها من خلال المرور عبر الترجمة العربية الأولى، التي أنجزها أولاً قراء مسيحيون عرب للتراث الفلسفي اليوناني عبر الترجمة السوريانية.
والتي قام بها كل من حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين ويحيى بن عدي وآخرون، لكنها ترجمات غير مختصة لعدم إلمام التراجمة بالغتين العربية واليونانية بشكل جيد، ثم لعدم اختصاصهم في مجال الفلسفة والمنطق.
وهو الأمر الذي تنبه إليه الخليفة الموحدي، وعبر عنها بقلق عبارة أرسطو وغموض أغراضه، وطلب أولاً من الفيلسوف ابن طفيل أن يقوم برفع هذا القلق وإزالة هذا الغموض المحير، لكنه لم يصادف في ابن طفيل الرغبة الجامحة والاستعداد الكامل.
فحوّل هذه المهمة العلمية إلى صديقه الفيلسوف ابن رشد، لكي ينوب عنه وهو محل ثقته وإعجابه، لما سيكون لهذه المهمة من أثر نافع على مستقبل الثقافة العربية والإسلامية.
وكما ينقل المراكشي في “المعجب في تلخيص أخبار المغرب” عن تلميذ ابن رشد أبو بكر بندود، فقد ترجّى ابن طفيل من ابن رشد بعد شكوى من أمير المؤمنين من سوء الترجمة عن أرسطو -وهو على ما يبدو اطلع عليها ويفهم مضامينها- أنه “لو وقع لهذه الكتب من يُلخّصها ويُقرِّب أغراضها بعد أن يفهمها فهمًا جيدًا، لقرُب مأخذُها على الناس: فإنْ كان فيك فضلُ قوةٍ لذلك فافعلْ”.
هكذا يرمي ابن طفيل على ابن رشد المسؤولية الأدبية والعلمية، ويُحمّسه إلى ركوب مخاطرها وهو الأمل المنشود لدفع هذا الاضطراب، بعد أن تحمست الإرادة السياسية للخليفة إلى ذلك، بما يفيد دور السلطة السياسية في تدعيم السلطة العلمية، في خدمة التنوير لا التزوير، سيّما إذا اجتمعت في رجل السلطة الحنكة السياسة والحذق الفكري.
وهذا ما توفر في الخليفة الموحدي، الذي نوّه إلى ضرورة إعادة التفكير في الترجمة العربية للنصوص اليونانية، وبالخصوص كتابات أرسطو طاليس، فنبّه أهل الاختصاص إلى إيجاد الترجمة الدقيقة للمتن الأرسطي، بلسان عربي غير مخل بمقصود الكلام، ولا مثير للاضطراب والغموض في العبارة.
وهو وعي منه إلى أهمية الترجمة في الدورة الحضارية للمعرفة، وفي تشوفها إلى بناء الفهم المزدوج بين الأمم، فمن طبيعة الترجمة إذا أسيء استخدامها أن تعرقل جهود التفاهم والتواصل والتلاقح، لأنها موقف حضاري وثقافي، وليست فقط فن لغوي لنقل نص من لغة إلى أخرى.
إن الترجمة وعي نقدي واستيعابي، تعود إلى الأصل لكي تواجهه بدون وساطة، لكي تستنطقه وتحاوره، لكي تفهم عنه وتدافع عنه، لأنه لقاء مع الغريب المختلف، الذي يستدعي نوعًا من التسامح والتعددية الفكرية والقبول بالآخر.
لذلك لا تُخفي الترجمة إقرارها بالاختلاف فلسفة وموقفًا، وهذا هو عنصر تميزها، فهي إبداع حضاري وثقافي وإنساني، تؤمن بالتعارف والاختلاف ثم النقد والتجاوز، لأنها ليست تقليدًا أو جمودًا، بل تستوعب لكي تمارس حقها في الاختلاف الواعي.
وذلك بحسبانها طاقة فكرية تعمل على إدخال الغريب إلى متن الأصيل، لتناقشه وتستوعبه، ثم لاحقًا لكي تُنقحه وتعيد تركيبه، عبر صهره في بوثقة الذات الناقدة وإعادة صياغته بشروط أكثر تقدمًا وانفتاحًا.
فهذا هو نشاط الترجمة الحية التي رام تحقيقها السلطان المتنور، لكي يواكب بها تحقيق الإنجازات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها العصر الموحدي، ولتكون مشروعًا موازيًا للإصلاحات التي دشنها الموحدون، في الفكر والسياسة والاجتماع.
حيث إن المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية عزم على تجديد الفكر، من خلال الدعوة إلى الأصول وطرح الفروع، ومن هنا نفهم الإرادة التي دفعت بالخليفة أبي يعقوب يوسف إلى العودة إلى نصوص أرسطو للتفاعل معها مباشرة، وتحقيق التواصل مع الفلسفة التأسيسية التي ظهرت مع المعلم الأول أرسطو.
وهو الأمر الذي تولاه ابن رشد، فنقل تصانيف أرسطو إلى الثقافة العربية بل وإلى ثقافات العالم من خلال عمل الترجمة التي أنجزها، ومن خلال التلاخيص والشروح والتعليقات التي قام بها، من باب توضيح مشكلات نصوص أرسطو، ومن باب تصويب بعضها والتعليق عليها، لأنه كما عبر هو في تلخيص مستصفى الغزالي يضع المختصَر في قالب المخترَع.
وهكذا يكون ابن رشد محطة فريدة وأساسية في تاريخ الفكر الإنساني، وفي تاريخ الفلسفة والمنطق بالخصوص، حيث أن ما نقله إلينا من نصوص أرسطو وأفلاطون (كتاب الضروري في السياسة)، يعد لحظة مهمة حيث انعطف فيها مسار الفلسفة نحو الشرق العربي.
وتحول مجرى نهرها إلى موطن جديد تفاعلت فيه حكمة الغرب مع روح الشريعة الإسلامية، بما ينقض فكرة “الجغرافية الفلسفية الخيالية” بتعبير جورج طرابيشي، التي روجت لها القراءة النرجسية لتاريخ الفلسفة.
فما قام به الفقيه ابن رشد استحق به لقب الشارح، دون غيره من فلاسفة الغرب، مما يؤكد على تراكم العطاء الإنساني في حقل الفلسفة، وينفي بشكل حاسم فكرة المركزية الغربية التي ادعاها فلاسفة مرموقون، وجحدوا بها جهود المسلمين والعرب في رفد الفكر الفلسفي وتنميته.
وما ادعاه “إرنست رينان” في زعمه بعدم وجود تفلسف عربي، وما وجد ما هو إلا فلسفة مكتوبة باللسان العربي على سبيل الاستدانة من اليونان، يفنده وجود فلسفة عربية قائمة الذات، فإذا كان أرسطو يعتبر المعلم الأول، فالفارابي يعد المعلم الثاني الذي طور مفهوم السعادة والمدينة الفاضلة، واهتم بأفكار أرسطو وأفلاطون وشرحها واختصرها في رسائله.
أما العمل الجبار الذي قام به ابن رشد الذي عرف في الأوساط اللاتينية بالشارح، وسماه الشاعر دانتي بالشارح الأكبر، فهو المَعبر الذي مرت به الفلسفة وعطفت من جديد في اتجاه عربي بعد أن ولدت في مهد اليونان وترعرعت في أحضان أثينا، وتطورت على يد فلاسفة مصريين وسوريين وفارسيين ناطقين باليونانية.
مثلما كتب فلاسفة غير عرب بالعربية في الفلسفة الإسلامية، أمثال الفارابي وابن سينا والرازي والشيرازي وابن باجة وابن طفيل، وغيرهم كثير ممن ليسوا عربًا وبرعوا في العربية وعلومها، حتى قال ابن خلدون إن أكثر علماء الإسلام من العجم.
فما دونه فيلسوف قرطبة ابن رشد في مجال الترجمة والشروح والتعاليق بالعربية، انتقل من جديد إلى لغات أخرى من خلال عمل الترجمة، فقد حفظت الترجمات العبرية واللاتينية تراث ابن رشد، حيث إن أصله العربي فقد، وانبرى اليهود أساسًا إلى ترجمته وشرحه، حتى نال مكانة مرموقة إلى جانب كتاب التوراة.
إلى الحد الذي يشكل فيه التراث العبري ضرورة لفهم تراثنا العربي الإسلامي وبخاصة التراث الرشدي، كما ينوه إلى ذلك الباحث المتخصص الدكتور أحمد شحلان، في كتابه “ابن رشد والفكر العبري الوسيط”.
أما المسيحيون فقد وصلتهم أصداء ابن رشد، من خلال إعادة فتح السؤال حول علاقة الإيمان بالعقل، كما هو صنيع اللاهوتي الفيلسوف “توما الأكويني” في المزج بين تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والمذهب الأرسطي.
وهو المشروع الفكري الذي ناضل من أجله ابن رشد في “تهافت التهافت” وفي “فصل المقال”، ألا وهو التوفيق بين الحكمة والشريعة، إذ الصلة الطبيعية بين الدين والفلسفة تتأسس على أن الحق لا يضاد الحق.
مما يؤكد على الامتداد الفكري لابن رشد في الغرب، حيث ظهرت مدرستان في تلقّي الفكر الرُّشدي: الرشدية العبرية اليهودية والرشدية اللاتينية.
فمن خلالهما عبَرت الفلسفة إلى القارة الأوروبية المسيحية/ اليهودية، ووضعت المنجز الفلسفي الأرسطي بالخصوص في سياق عالمي، بعد أن فقدت أوروبا الاتصال بالتراث الأرسطي لقرون عدة، بسبب موقف الكنيسة الذي يعتقد بتعارضه مع تعاليمها.
مما كان له بالغ الأثر في مجال التقدم العلمي المتجلي في إنشاء جامعات باريس وأكسفورد، ومن خلال الإسهام في النهضة الغربية والتمهيد لظهور عصر التنوير والعقلانية الحديثة، وهنا تشهد دورة المعرفة تحولاً جديدًا وعميقًا، حيث تمر رحلة العقل إلى منعطف جديد عرف بالفلسفة الحديثة، استطاعت فيه أن تتخلص من عوائق التفكير في العصور الوسطى، وأن تكون أكثر وفاء لشروط الحرية.
ومن تم أن تجاوز نظرة الفكر الأرسطي للعالم، والانفتاح حتى على المدارس المندثرة كالشكوكية والأبيقورية، اللتان فتحتا الفلسفة على رؤى جديدة وفلسفات جديدة، تحاول تفسير الطبيعة والكون.
وبهذا استعاد الفكر الغربي قوته وعافيته، التي فقدها في نهاية العصور القديمة، عندما آوت الفلسفة إلى أحضان التقوى والورع، على حد تعبير “أنتوني جوتليب” في كتابه “حلم العقل”.

مجلة فكر الثقافية.