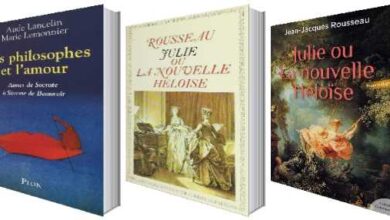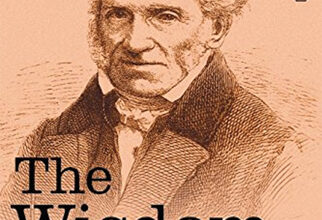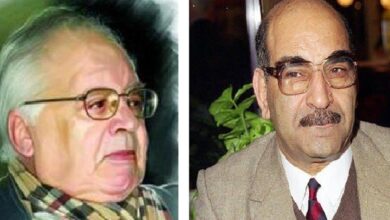القطيعة بين الفكر المغربي والمشرقي – قراءة حول مشروع محمد عابد الجابري

هذه الدراسة هي بصدد تزييف الزعم القائل بأن هناك قطيعة معرفية بين الفلسفة في المغرب العربي والمشرق. فقد وضع المفكر محمد عابد الجابري فوارق حاسمة حددها بكون الفلسفة في المشرق العربي «محكومة باشكالية التوفيق بين الدين والفلسفة، أي اشكالية علم الكلام،
أما في المغرب والأندلس فلم يكن هناك علم كلام ولا فرق ولا تعدد»، وهذا ما جعل فلاسفة المشرق يأخذون الميتافيزيقا «لأنهم كانوا يحتاجون اليها في التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام.
أما في المغرب والأندلس فقد أخذوا الرياضيات والطبيعيات والفلك والطب والمنطق، وأصبح أرسطو هو الأصل وأصبح الفكر الفلسفي أرسطياً محضاً خالياً من الافلاطونية المحدثة والتأثيرات المشرقية من فارسية وغنوصية وهرمسية وغيرها»[1].
فهذا التحديد الإجمالي للفارق العام بين الفكرين في المشرق والمغرب؛ هو الحد الفاصل لما أُطلق عليه القطيعة المعرفية. فهي تبدأ بدايتها العميقة مع إبن باجة كأول فيلسوف محترف في المغرب والأندلس، إذ كانت فلسفته «علمية الابيستيمي، علمانية الاتجاه بفعل تحررها» من إشكالية التوفيق بين الدين والفلسفة التي أتخمت المشرق، إذ إن فلسفته ظلت دائماً «لاهوتية الابيستيمي والاتجاه»[2] .
- إبن باجة والقطيعة المزعومة
إن التفاصيل التي وضعها الجابري لإثبات القطيعة المعرفية بين فلاسفة المغرب والأندلس من جهة، وفلاسفة المشرق من جهة أُخرى؛ تبدأ من نقاط القطيعة التي رسمها لإبن باجة في علاقته السلبية بفلسفة أهل المشرق وإشكاليتهم الدينية التي أغرقوا عقولهم بها، وهي باختصار كالتالي:
1 ـ التحرر التام من شاغل التوفيق بين الفلسفة والدين.
2 ـ رفض الطرق غير العقلية لبلوغ الحقيقة وتحقيق السعادة، كالمشاهدات الصوفية.
3 ـ اعتبار النبوّة موهبة إلهية نادرة دون تفسيرها فلسفياً كما حصل في المشرق عند الفارابي وأتباعه.
4 ـ السعادة القصوى هي السعادة العقلية وذلك بالإتصال بالعقل الفعّال عن طريق العقل المستفاد، بحيث يصبح هذا هو عين ذاك.
5 ـ إن فكرة الفيض غائبة عن مجال تفكير إبن باجة تماماً. ففي عدم معالجته لمسألة العقول الفلكية وإبعادها عن إهتمامه؛ يجعل من طريق الإتصال بالعقل الفعّال صاعداً لا نازلاً، وذلك بارتقاء الإنسان في مدارج الكمال العقلي وليس بفيض إلهي.
6 ـ للفلاسفة وحدة عقلية خالدة يتم فيها اللقاء العقلي والإلهي، وهي تتجاوز حدود الزمان والمكان[3]
ومع أن إبن باجة لم ينشغل بالفعل بإشكالية الفلسفة والدين، سوى إشارات خاطفة يؤكد فيها ما للغيب أو الوحي من دور في إكمال المعرفة الفلسفية[4] ، لكن حتى مع افتراض عزوفه كلياً عن الإنشغال بهذه الإشكالية؛ فإن ذلك لا يعني القطيعة من الناحية الإبستمولوجية.
فإبن باجة هو كأي فيلسوف يفكر بروح لا تختلف عن الروح التي يفكر فيها غيره ومن ضمنهم فلاسفة المشرق العربي والإسلامي، ما دام هناك جامع يجمعهم. لذلك كان كثير الإعتماد في طرحه على كل من أرسطو وافلاطون والفارابي. مما جعل أثر ذلك واضحاً في صياغته لعلاقات الوجود، حيث إنها مستمدة من هذا المزيج الثلاثي المركب، مع ما أضاف إليه من طابع صوفي.
وإذا كان إبن باجة في رسائله القليلة التي وصلتنا لا يتحدث عن نظرية الفيض؛ فهذا لا يعني أنه لا يلتزم بها بشكل ما من الأشكال. فعلى الأقل لو إننا اعتبرناه أرسطياً خالصاً في هذا المضمار، مثله في ذلك مثل إبن رشد؛ لكان يكفي أنه يعترف بها ضمنياً.
خاصة وإن النظرية الأرسطية تقرّ بقاعدة (الإمكان الأشرف) التي تتضمنها كلياً، بل وإن نظريته في العقل الفعّال لها دلالة خاصة على طبيعة هذا الفيض الذي يخرجها عن الصيغة الأرسطية، بل وعن الطريقة الفارابية السينية الشائعة؛ ليدخلها في الدائرة الصوفية الخاصة.
فإبن باجة ينظر إلى العقل الفعّال بأنه عقل مفارق بريء من المادة، وهو موجود في حد ذاته، وكما يقول: «إننا لا نراه بذاته، بل نراه مع غيره، كما نرى الشمس مثلاً ونحن في الماء، ثم نراها ونحن في الهواء، والهواء قد يغلظ ويكدر ويكون أصفى، فإن هذا العقل لا نقدر أن نراه بذاته بل نرى أثره في غيره،
فلذلك نراه في بعض المعقولات رؤيةً هي أقرب من ذاته، وفي بعضها رؤية هي أبعد، ويراه الراؤون برؤية متفاضلة على بصائرهم كما تُرى الشمس على تفاضل الأبصار. فأما رؤيته بذاته، وهي ممكنة، فكرؤية الشمس بدون متوسط إن أمكن ذلك، أو بمتوسط لا يؤثر في رؤيتها إن وجد ذلك»[5] .
بل أكثر من هذا إن إبن باجة يزيد الفلاسفة (من الشعر بيتاً)، فهو لا يقول بمجرد اتصال العقل المستفاد بالفعّال، بل يجعل الأول يصير نفس هذا الأخير من دون اختلاف، فحينها يكون «النظر من هذه الجهة هو الحياة الآخرة وهو السعادة القصوى الإنسانية المتوحدة.
وعند ذلك يشاهد ذلك المشهد العظيم»[6] . وكدلالة على مثل هذا الإتحاد الصوفي عرض مثال المغارة الافلاطوني، الأمر الذي جعله يتجاوز فعلاً كل الذين سبقوه من فلاسفة المشرق.
وهو يدرك هذا جيداً، حيث يشير إلى أنه قد انفرد بتوصله إلى تلك النتيجة التي وصفها بأنها «أجلّ الأُمور التي وقفتُ عليها وهي صفة الغاية التي ينتهي الطبع بالسلوك إليها». فبرغم أن هناك من تقدمه في بحث هذه المسألة وإطالة النظر فيها.
ومنهم الفارابي الذي «مكانه من هذا العلم مكانة» لكنه لم يجد في كتبه التي وصلت الأندلس مثل هذا النحو من النظر الذي وقف عليه، ولا عند غيره من الفلاسفة سوى ما جاء في بعض مقولات أرسطو في الأخلاق، ومع ذلك فإن ما جاء به هذا المعلّم هو «مجمل جداً لا يمكن الإكتفاء به»[7] .
هكذا ندرك أن ما رامه إبن باجة ليس سوى التصوف العقلي. فهو الجديد الذي تفرّد به، والذي فيه أقام (الحبل السري) المتصل مع العرفان. مما يعني أن الجديد عنده هو سحب البساط من (العقل) بالعقل.
إذ ليس لديه مؤاخذة يؤاخذ الصوفية عليها سوى عدم التزامها النظر العقلي الذي يراه شرطاً للمعرفة الإتحادية أو (الصوفية)، أي أنه شرط للمعرفة التي تتجاوز حفظ المراتب لعلاقة السببية ونظام الوجود، والتي تحقق حالة ما يطلق عليه (اللا معقول العقلي) أو الفلسفي في الوحدة العقلية.
لذلك فإنه يعدّ الوحدة هي «أكمل في التوحد من جميع أنواع التوحد المشهورة التي تُطلب في بادئ الرأي»[8] ، ملوّحاً بهذا إلى المؤاخذة التي يؤاخذ عليها الصوفية، إذ بدون الشرط العقلي تصبح المعرفة الصوفية عنده عبارة عن خيالات توهم بأنها حقائق (إتحادية) الأمر الذي سيستقطب نقد إبن طفيل له، دفاعاً عن المسلك الصوفي وطريقته الذوقية في الاتحاد والسعادة.
ومن الجدير بالذكر إن اعتبار إبن باجة لشرط النظر العقلي في تحقيق حالة الاتحاد بالعقل الفعّال لا يعني أن الفيض عنده صاعد من حيث الأساس، بل ان جميع الفلاسفة بدون استثناء يرون أن الفيض نازل، على الرغم من أن عملية النزول قد تتحقق في عالمنا ضمن شروط لا غنى عنها.
فحسب النظرية الأرسطية كما يطرحها إبن رشد: إن الفاعل للعقل البشري هو عقل مفارق يُخرجه من القوة إلى الفعل، وإن سائر الصور الهيولانية تتكون من خلال فيض النفس السماوية المنحصرة في حرارة الكواكب. أي إنه سواء في الصور العقلية أو الهيولانية فإن الفيض يكون على الدوام نازلاً، إذ العالي هو الذي يؤثر في السافل وليس العكس.
على ذلك نفهم أن إبن باجة ليس ذا قطيعة إبستمولوجية مع فلاسفة أهل المشرق، بل ولا هو أرسطي خالص. ولو أننا طبقنا عليه بعض أحكام الجابري الذي حكم بها على فلاسفة المشرق؛ لكان فيلسوفنا في دائرة خارجة عن دائرة البرهان الأرسطي، وهي دائرة العرفان كثمرة لهذا البرهان.
ذلك أن قوله بنظرية الإتحاد مع العقل الفعّال تجعله أسوأ حالاً من حال الفارابي الذي صوّره ـ صاحبنا ـ بأنه يرى العرفان ثمرة ونتيجة للبرهان، لكونه «جعل المعرفة البرهانية تنتهي في أسمى درجاتها إلى الاتصال بالعقل الفعال»[9] .
بل قد لا يكون أقل حالاً من المعلم الثاني الذي اتهمه بأنه «توّج نظريته في المعرفة بفكرة (السعادة) العرفانية الهرمسية الأصل»[10] . مع أن ابن باجـة يقـول بهذه الفكرة على نحـو أشد إمعاناً في العرفان والتصوف. بل ما من فليسوف إلا ويقول بفكرة السعادة من خلال الكمال العقلي، بمن فيهم أرسطو.
على أن تنظير إبن باجة للوحدة بين الفلاسفة من خلال اللقاء العقلي الإلهي، وذلك بتحليله للعقل، يجعله يكرر ما سبق أن سعى إليه الفارابي بطريقة مختلفة. وبالتالي فإن إبن باجة لا ينظر إلى فلاسفة المشرق نظرة خارجة عن هذه الوحدة واللقاء الخالد غير الخاضع للزمان والمكان،
فهو لا يرى بين الفلاسفة قاطبة من فرق إلا في المظهر، مشبّهاً ذلك بمثال يقول فيه: «لو أنه أقبل إلينا ربيعة بن مكرم وقد لبس درعاً وحمل بيضة حديد واعتقل قناة وسيفاً، فرأيناه في هذا الزي، ثم غاب عن أبصارنا وأقبل وقد لبس جوشناً وفي رأسه الجلة المصنوعة من الريش، وقد عمل مزراقاً ودبوساً فسبق إلى الظن أنه غير ربيعة بن مكرم» مع أنه هو بالذات[11] .
وهو حتى في هذا اللقاء الخالد يكاد يكرر ما سبق إليه الفارابي، مع أخذ اعتبار الفارق بينهما، وهو أن فليسوف المشرق جعل لقاء الفلاسفة يقوم على الاتصال (الفلسفي)، بينما عمل الآخر على جعله قائماً على الاتحاد (الصوفي). فالفارابي قد سبق إلى الاعتقاد بأنه حين تمضي طائفة من طوائف المدينة الفاضلة، بأن تبطل أبدانهم وتخلص نفوسهم بالمفارقة؛
فإن هناك من يأتي ليقوم مقامهم في المدينة، ثم إن هؤلاء حينما يلحقون بأولئك بنفوسهم بعد الموت؛ فإنهم يصبحون في جوار منهم، فتتصل نفوسهم المتشابهة بعضها ببعض، باعتبارهم ينتمون إلى طائفة واحدة، وكلما زاد عدد هذه النفوس المفارقة زاد اتصالها ببعضها، فتزيد بذلك لذّاتها وسعادتها،
وهكذا باضطراد، إذ كل نفس تعقل نفسها، وتعقل ما يشابه ذاتها بحسب تكثرها، مما يجعل لذّات كل واحدة منها بغير نهاية «فهذه هي السعادة القصوى الحقيقية التي هي غرض العقل الفعال»[12] .
- إبن طفيل والقطيعة المزعومة
ولو انتقلنا إلى إبن طفيل فسنجد من الغرابة حقاً أن يجعله الجابري فيلسوفاً أرسطياً ومغربياً على نمط إبن باجة وإبن رشد، مشيراً إلى أن هناك لبساً وهو «أن إبن طفيل يقول في مقدمة حي بن يقظان إنه سيعرض الحكمة المشرقية كما رواها الشيخ الرئيس إبن سينا، فرسالة حي بن يقظان مكتوبة بقلم إبن طفيل،
لكن مضمونها، بتصريح إبن طفيل، هو مضمون الفلسفة المشرقية السينوية. والذين يحكمون على إبن طفيل من خلال حي بن يقظان مخطئون. إن رأيه هو رأي النظرة المغربية الرشدية»[13].
من العجب حقاً أن يكون تقدير الجابري بهذا الشكل، إذ فيه مكابرة وتجاهل لكل ما قاله إبن طفيل في مقدمته لقصة حي بن يقظان. فالمقدمة شاهدة بجميع أجزائها وتفاصيلها على أن فيلسوفنا هذا يتبنى الفلسفة المشرقية ويراها الحق الذي يجب إتباعه، بل وينتقد كل من لم يغص في غمار الروح الصوفية من أصحاب العقل والفلسفة… وإلا فما الداعي لأن يكلّف نفسه في بحثها والكشف عن أسرارها؟
وكشاهد على ما ذكرنا يبدأ إبن طفيل مقدمته بعد الحمد والصلاة بالإعلان عن أحقية الفلسفة المشرقية فيقول: «سألتَ أيها الأخ الكريم.. أن أبثّ إليك ما أمكنني بثّه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الإمام الرئيس أبو علي بن سينا.
فاعلم أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه، فعليه بطلبها والجد في اقتنائها»[14] . ثم أنه يجعل من سؤال السائل محركاً له إلى أن يكون من أصحاب الشهود كالصوفية تماماً، لذلك فهو يواصل حديثه السابق قائلاً: «ولقد حرّك مني سؤالك خاطراً شريفاً أفضى بي ـ والحمد لله ـ إلى مشاهدة حال لم أشهدها من قبل وانتهى بي إلى مبلغ هو من الغرابة، بحيث لا يصفه لسان، ولا يقوم به بيان لأنه من طور غير طورهما، وعالم غير عالمهما.
غير أن تلك الحال؛ لمّا لها من البهجة والسرور واللذة والحبور لا يستـطيع من وصل إليها وانـتهى إلى حـد مـن حدودها أن يكتم أمرها أو يُخفي سرها.. وإن كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصيل»[15] .
وفي موضع آخر من المقدمة يصف حاله بمن ذاق شيئاً يسيراً من المشاهدة الصوفية التي جعلته أهلاً لبث كلام يؤثر من خلال تلك القصة، فهو يقول: «ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة. وحينئذ رأينا أنفسنا أهلاً لوضع كلام يُؤثَر عنّا»[16] .
بل إن فيلسوفنا (المستشرق) هذا ينقد منتحلي الفلسفة في قبال أهل الذوق والولاية، ومن هؤلاء إبن باجة الذي يعرضه إلى نقد شديد. فمع أنه يُثني عليه مدحاً في حذاقته وصحة نظره وصدق رؤيته؛ لكن مع ذلك فقد عدّه ممن «شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائـن عـلمه وبث خفـايا حكـمتـه»[17].
بل هو يؤاخذه على انتـقـاصه للـصوفية لكـونه اعـتـبر إلتذاذهم ومشاهدتهم قائمة على القوة الخيالية، في الوقت الذي وعد أن يكون حال السعداء ضمن شروط أوجبها تتعلق بجانب النظر. فعلى هذا اعترض عليه فيلسوفنا بحزم وشدة، قائلاً في حقه: «وينبغي أن يقال له ـ ها هنا ـ لا تستحل طعم شيء لم تذق، ولا تتخط رقاب الصدّيقين»[18] .
ومما له دلالة ومعنى على صوفية إبن طفيل وسينيّته؛ اغفاله ذكر ابن رشد تماماً على الرغم مما كانت بينهما من صداقة معروفة؛ وذلك حينما اورد ذكر رجال الحكمة، فقد نصّ على إبن باجة واعتبره فريد عصره برغم بعض مؤاخذاته عليه،
لكنه حين تطرق إلى فلاسفة عصره فإنه لم ينص على صديقه إبن رشد، بل قال: «وأما من جاء بعدهم من المعاصرين لنا، فهم في حد التزايد أو الوقوف على غير كمال، أو ممن لم تصل إلينا حقيقة أمره»[19] .
كما من العجب أيضاً أن يتصور الجابري أن إبن طفيل لم ينطلق في تفكيره ولا في إشكاليته من منطلق إبن سينا الذي دمج الدين والفلسفة ببعضهما البعض، مستدلاً على ذلك بفشل بطل القصة حي بن يقظان في إقناع سلامان وجمهوره الديني بأن معتقداتهم هي مجرد مثالات ورموز للحقيقة المباشرة، الأمر الذي يعني عنده هو أن إبن طفيل كان يرمي في ذلك إلى فصل الدين عن الفلسفة[20] .
فلو أمعنا النظر فيما كان يريده إبن طفيل من خاتمة قصته في العلاقة التي تربط بين حي وأبسال وسلامان وجمهوره؛ لوجدنا أنه يصل إلى النتيجة نفسها التي كان يرمي إليها إبن سينا ومن قبله الفارابي، خاصة في علاقة أبسال بسلامان، أي علاقة الفلسفة بالدين.
فالقصة تؤكد على أن الحقيقة تظهر مباشرة وبالذوق لأصحاب الكشف والمشاهدة من العرفاء، كما هو الحال لدى بطل القصة حي بن يقظان، كما تؤكد على أن أصحاب الفلسفة والعقل الكسبي يصلون أيضاً إلى المعطى المعرفي أو المفهومي عينه الذي يصل إليه أهل الكشف، كما هو الحال عند أبسال،
بدلالة أنه عندما يلتقي أبسال بحي يرى كل منهما أن ما عنده من حقيقة معرفية هو عين ما عند الآخر، في حين إن القصة تنظر إلى أن أهل الدين هم الجمهور من العامة الذين تستهويهم الحجج الخطابية والإقناعية.
فهم ليسوا من أصحاب البرهان ولا من أهل العرفان، بل نفوسهم غير مستعدة لأن تتقبل سوى تلك الحجج، وهي ما تقدمه لهم الشريعة من الظواهر التي يحتجّون بها، وهذا ما أدركه حي بفطنته، فعلم به وجه الحكمة في كون الشريعة ليست مصدراً للبرهان والحقيقة، بل هي مصدر التمثيل والرمز.
وهو جوهر ما يؤكد عليه إبن سينا كما في رسالة ( أضحوية في أمر المعاد)، ومن قبله الفارابي، بل وقبلهما الاسماعيلية. فهم جميعاً ينظرون إلى الشريعة بأنها مصدر التمثيل والرمز لا البرهان والحقيقة، وأن وظيفتها جاءت لمخاطبة الجمهور والعامة على النحو الإقناعي، من حيث إن نفـوسهم لا تتـحمل الحـقيقة والبرهان[21] .
وبالتالي فليس هناك من فرق بين إبن سينا وإبن طفيل، وأن هذا الأخير ليس كما صوّره الجابري من أنه كان بطلاً في كشفه عن «فشل المدرسة الفلسفية في تحقيق مشروعها في إنشاء فلسفة يندمج فيها الدين، ثم يقرر واقعاً يفرض نفسه، وهو أن لكل من الدين والفلسفة طريقه الخاص وإن كانا يلتقيان عند الهدف»[22] .
فما وصل إليه إبن طفيل إنما هو تأكيد لما قد سبق إليه الفارابيان. فالإندماج بين الفلسفة والدين، من حيث إن الفلسفة هي القائدة والمؤولة وصاحبة البرهان؛ متحقق في شخص أبسال الفيلسوف، أما الجمهور فهم يظلون بعيدين عن فهم الحقيقة والباطن، وليس لهم من الدين إلا القشر والظاهر.
وأخيراً فإن ما كان يريده الجابري فعلاً من الموقع الذي يحتله إبن طفيل، ليس معرفة (الحقيقة) كما هي، لأننا نعتقد بأن قرارة نفسه تشهد بمثل ما نراه، إذ ليست مقدمة (حي بن يقظان) بتلك المقدمة الغامضة التي يعسر فهمها على مفكر كبير ولامع من أمثال الجابري، وعليه فإن ما كان يريده إنما هو محض (الآيديولوجيا) التي آثرها على (الحقيقة) المعرفية.
الأمر الذي ظهر في (فلتات لسانه) عندما كان يحاور الأستاذ فهمي جدعان. فهذا الأخير استشكل عليه لضمه إبن طفيل ضمن لائحة الفلاسفة المغربيين، وذلك من حيث النقد الذي وجهه إبن طفيل لإبن باجة والذي فيه اعتبر هذا الأخير مقصّراً في بلوغ غاية الفيلسوف من الإتصال.
وهو في جوابه عن هذا الإشكال ارتكب خطأً معرفياً حاول تسديده بذريعة آيديولوجية كانت على حسابـ (الحقيقة) ذاتها.
ذلك أنه قام بتأويل ما قصده إبن طفيل قالباً حقيقة الوضع الذي هو عليه، حيث إنه رام أن يُفهم ما عناه ذلك الفيلسوف بنقيض ما أراده بالضبط، فاعتبر أن إبن طفيل كان «يعني أن إبن باجة مقصّر في أن يكون مشرقياً في فلسفته، أي أنه لم يتبن نظرية الإتصال الفيضية».
في حين إن واقع نقد إبن طفيل لإبن باجة كان على العكس تماماً، فهو كما سبق أن عرفنا يؤاخذه على كونه لم يصل إلى تحقيق حالة الإتصال الفيضية لإنكبابه على مشاغل الدنيا، لا أنه يؤاخذه على مشرقيته وتبنيه لنظرية الاتصال الفيضية، كما هو واضح من مقدمته من دون أدنى شك.
ومع ذلك فإن الجابري قد انساق إلى الكلام فيما لا يريد التكلم عنه، اذ إضطر لأن يضرب أحد الفيلسوفين المغربيين بالآخر، فضحّى بأحدهما وأوقعه فيما كان ينفيه عنه في السابق، لنفض الشكوك عن الآخر. ويبدو أنه أحس بالمأزق،
إذ كان طرحه غير متسق ولا مقنع، فلجأ إلى الإقرار بغرضه الآيديولوجي الذي يفرض فيه أن يكون فلاسفة المغرب ومنهم إبن طفيل في خندق واحد مضاد للخندق الذي يجمع فلاسفة المشرق بأجمعهم، وذلك من أجل تحقيق ما يصبو إليه من تقدم، فهذا التقدم لا يكون عنده إلا بمقاطعة الثقافة التي عليها أهل المشرق، والإكتفاء بما لدى أهل المغرب والأندلس.
هكذا فهو بعد قلبه للحقيقة والمعنى الذي مرّ علينا يعلن قوله مباشرة: «والمهم هو إما أن تكون الثقافة العربية الأندلسية قد تحركت في الساحة المشرقية نفسها، أو أنها قد تجاوزتها.
والحقيقة أننا إذا أردنا أن نجد تاريخاً حقيقياً للفلسفة العربية الإسلامية، فيه شيء من التقدم، وشيء من الانتقال إلى ما هو أبعد، فهذا التاريخ لا يمكن أن نجده إلا إذا بنيناه على أساس أن النظرة الأندلسية المغربية قد تجاوزت منهجياً النظرة المشرقية»[23].