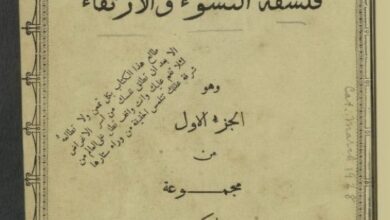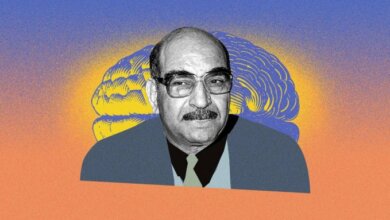لقد سعى كيركغارد في فلسفته الإشراقية إلى نحت تجربة دينية متفردة، تدين بالولاء للنفس في غورها المطلق الذي يحتفي بإرادة الذات واختيارها وقدرتها على اكتشاف الحقيقة الإيمانية، التي لا تدرك بإعمال مفهوم التاريخ أو العقل.
بل على تفسير الوجود تفسيرًا مختلفًا عن التنميطات اللاهوتية التي زعمت تملك الحقيقة داخل تقاليدها الكنسية، وأفرغت الإيمان من حقيقته الذاتية؛ فالإيمان الحقيقي داخلي لا جواني، ذاتي لا موضوعي؛ يتحقق خارج الأنساق التصورية المجتثة من الواقع والمرتبطة بالتوقع.
إنها عملية لاستعادة الذات من الأنساق التي نحتتها وفق قالب جامد، وهي إجراء لإخراج الكينونة الجوانية من هشاشتها، واسترجاع لسلطة الحماسة التي تقود إلى الإيمان الحق؛ فالإيمان لا يمكننا تذوق حلاوته إلا من الداخل.
أما محاولة التفسير التي تركن لما هو خارج نسق الذات، فتؤول، لا شك، إلى الفشل في إدراك حقيقة الإيمان؛ ومن ثم العجز عن ترميم الذات وإشباع حاجتها الروحية، وإخراجها من وعيها الشقي.
فهل يمكن للإيمان بوصفه تجربة ذاتية أن يصمد أمام أشراط النسق الاعتقادي السائد؟ وهل يمكن للقلق والتعاسة أن يقودا إلى الطمأنينة التي هي غاية الإيمان؟
إن انكماش كيركغارد داخل الذات أفضى به إلى البحث عن المطلق الثاوي فيها، والتماس أنواره من القلق الوجودي الذي يقوده إلى العذاب الأبدي؛ لأنه يتصور الإيمان صراعًا مع المطلق.
ويعد الدين مرتعًا للمأساة الداخلية التي تستوجب الصبر والمكابدة لمواجهة الخطيئة بالإصرار والتحدي؛ لا للتخفيف من الألم الداخلي، ولا لالتماس السعادة، ولكن لتأبيد الانهمام واللايقين في علاقة الإنسان بربه؛
إذ كلما كان المؤمن منشغلًا بتعاسته الأنطولوجية المتولدة عن فقدان اليقين، كان ثمة إيمان صادق نابع من المغايرة الموجودة بين المتناهي واللامتناهي.
هذه المغايرة تحركها الخطيئة والشعور بالذنب اللذين تتحقق معهما التضحية؛ لأن الفداء لا يكون حقيقيًّا إلا إذا كان نابعًا من الذات الممزقة في ألمها المتجدد، وفي وعيها بأن السعادة تكمن في التعاسة، والبرء من الألم يتبدى في الألم ذاته.
كل شيء يقوم على اللعب على المفارقات الغريبة؛ فكلما ضحى المرء بكل شيء ظفر بكل شيء، وكان فردًا منفردًا لا تتحكم فيه العواطف والأهواء.
ولقد ضحى كيركغارد بحبه لروجينا ليبرهن على قوة إيمانه الداخلي القائم على عبادة الألم واليقين في الحب الروحي الذي يتسامى على كل ما هو مادي، ويفرّد صاحبه حتى يتجاوز صفة العادي المبتذل.
- المحبة المطلقة، بين التضحية والتهكم
يعد كيركغارد المحبة الفانية لحظية آنية، بينما يعتبر المحبة المطلقة سرمدية أبدية. وما كان لهذه المحبة أن ترقى إلى هذا المستوى النوراني إلا بتخلصها من الذات المغرقة في أنانيتها، وتجملها بالتضحية من أجل الإحساس الحقيقي بلذة الحب الصوفي الذي ينكر النفس ويجردها من لذاتها الحسية ليرفعها إلى مراقي الحقيقة التي تكون فيها الذات صافية شفافة، ليتسنى لها الغوص في كنه الوجود وتذوق حقيقة الإيمان بصفتها غاية الغايات ومناط التفكير.

إن تشتيت النظر الواحد وتشظية التفكير في متاهات خارجية يفقد الذات شفافيتها المطلقة، ويجردها من تركيزها الباطني الذي يخول لها الانطلاق لإدراك المطلق إدراكًا يقينيًّا ينكشف معه حجاب الوجود، فتتراءى حقيقة الذات.
دين الحب هذا دين للمفارقة؛ حيث تهب الذات نفسها للمطلق دون قيد أو شرط، وتحدث تلك المفارقة الفريدة مع العالم في صورته المعقولية؛ أن تحب ولا تحب، وترغب ولا ترغب، وتتوق ولا تتوق؛ تخرج من سلطان الحب الأرضي لتعود إليه في صبغته الروحية.
لقد امتزجت هذه العناصر كلها لتعمل على تشكيل شخصية قدرها القلق الوجودي والاغتراب الذاتي، ومصيرها الحتمي هو تسليم النفس للنداء الداخلي ذي الجاذبية الأقوى، وفي ذاك الاستسلام تكمن الرغبة في ملامسة المطلق المفقود في العالم الخارجي والمكنون في العالم الجواني، المطلق الذي لن يكون مستقره ومثواه الأبدي؛ وإنما هي تجربة تتجاوز هذا المفهوم ليعود إلى الذات بأنوار الإيمان، التي ستكشف له حقيقة الوجود ومعنى الأنا والأنت.
ولكن السعادة الآتية من اللامتناهي تقتضي ضرورة الاحتفاء بالألم وتمجيد القلق بوصفه القائد إلى إدراك حلاوة الإيمان وحقيقة الصلة بالله، والوصول إلى اللامتناهي بالمتناهي.
يقول في «اليوميات»: «الطريق الذي علينا أن نسير فيه: أن نعبر جسر التنهدات حتى نصل إلى الأبدية.. فالطريق إلى الله مليء بالأشواك والعذاب والدموع. وبمقدار تحملك للآلام، تكون علاقتك بالله.. إنني آمل بفضل العذاب الذي أتحمله بصبر أن أكون شوكة في جنب هذا العالم»(١).
إن الوصول إلى الأبدية دونه الشقاء والعذاب والصبر على الآلام لاستحقاق العلاقة بالحقيقة المتعالية، التي تتحقق بالكشف والإغراق في الاستبطان وأعمال المحبة.
وفي هذه المجاهدة التي لا يقدر عليها العامة تكمن حقيقة الإيمان التي تنبع من الداخل؛ أي من كوامن النفس التي استبدت بها الحرقة واللهفة لملامسة الحقيقة، وهي المشاعر المنهكة للجسم والمفنية للطاقة.
إذ في تلك الحركة والاضطراب ثمة صراع في عمق اللاشعور حول ماهية الإنسان في عالم يضيق بالإنسان ولا يعترف بوجوده الحقيقي؛ لتنطلق محاولة البحث عن الحرية لاسترداد هذا الوجود المسلوب.
- تقاطع الإيمان والتجربة الذاتية
ولما كانت دراستنا تنحو نحو محاولة البحث عن التقاطع بين الإيمان والتجربة الذاتية، كان مذهب كيركغارد في نفي الذات وإثباتها يحيل على مذهب صوفي يطلق عليه (الملامتية)(٢)، يقوم على إذلال النفس والانتقاص من شأنها والإمعان في اتهامها بالخطيئة، تضحية وإيثارًا وإخلاصًا في العبادة، مع إنكار كل ما يمكن أن يدل ظاهرًا على أحوال النفس، تجنبًا للرياء وتحاشيًا للإعلان عن هذه الحال.
هذا هو الوجود الحقيقي الذي يكون فيه كيركغارد متصلًا بالحق وحده اتصالًا جوانيًّا لا مظاهر فيه للرياء؛ وإنما تقوده المحبة الخالصة لله، بعيدًا من التلهية التي من شأنها تشتيت هذه المحبة والتأثير فيها.
ولقد كان كيركغارد (ملامتيًّا) عندما اختار التخلي عن روجينا استجلابًا للوم الناس وتعرضًا لأذيتهم، وتذليلًا للنفس، وحرمانها مما تألفه وتسكن إليه، حتى لا ينكشف السر اللدني الذي حظي به من السماء، واحتفظ به لنفسه لغزًا من ألغاز الفرد المتفرد، وحتى يجسد بحق معنى التضحية في صورتها الإبراهيمية العميقة؛ إذ يكفيه الإيمان وحده، ولا يحب أن يطلع أحد على أعماله.
لذلك؛ يستوي عنده المدح والذم، وقد يبدي الشر للناس ويضمر الخير الذي هو الأصل في الروح المتصلة بالله دون واسطة، المنفصلة عن اللاهوت، الشاهدة على نزاع العقل والإيمان بين فلسفة عقلية تنتزع الإنسان من هويته وبين فلسفة وجودية تعلي من شأن الذات.
- القلق الوجودي أو لاهوت الخطيئة
يعدّ القلق أكبر المشاعر الإنسانية في المجال التداولي الوجودي؛ حيث إنه مفهوم تعاور مختلف مؤلفات كيركغارد، وأفرد له كتابًا خاصًّا موسومًا بـ«مفهوم القلق»؛ «فالقلق مقولة وجودية، وهو الشعور الأساسي للوجود في العالم.
ينبثق من شعور الآنية أنها ملقاة هناك في العالم، ومرغمة على الاختيار، ويفترض وجود خطر يتهددنا، ويكشف الموجود لذاته، ويعرض عليه (أنا) ليحققها، ويضع الإنسان وجهًا لوجه أمام نفسه باعتباره لم يوجد بعد، وإنما سيوجد بواسطة الاختيار، والاختيار حرية ومخاطرة»(٣).
إنه إحساس بالفقد وصدمة الميلاد، وشعور باللاتوافق مع مجتمع غريب، لا معنى له وعديم الجدوى، واستسلام للشك وانفصال عن كل شيء، وخوف من حتمية الموت الذي لا نعرف وقت تنفيذه.
ومن ثم؛ يكون القلق عند كيركغارد متساوقًا مع الرغبة في المخاطرة ومواجهة العدم المهدد للحضور الوجودي، والتخلص من الخمول الذي لا يتوافق عادة مع القلق، كما ربط كيركغارد هذا المفهوم بلاهوت الخطيئة وبالضعف والتحديث(٤).
إن القلق الوجودي وسيلة لتحقيق الحرية وتوسيع دائرة الجدل، لا في شكلها الهيغلي المجرد؛ ولكن في صورتها الذاتية الوجدانية؛ أي القلق الأنطولوجي الذي مردّه إلى بنية الذات وتكوينها اللامتجانس والمركب من الأضداد، من المتناهي واللامتناهي، من الحرية والضرورة، كما أن الوجود الإنساني هو قبل كل شيء وجود في الزمن؛ لأن الإنسان يولد ويعيش مدة، ثم يموت.
ولكي يصل إلى الديمومة، عليه أن يربط علاقة بالدائم (الله). وعندما يختار الإنسان ذاته، فإنه يختار موقفه تجاه الله؛ فإما أن يُقبل عليه، وإما أن يُعرض عنه. وفي خضم الصراع والتدافع بين الأضداد أو الاختيارات المرتبطة بالموقف من الله، ينشأ القلق الأنطولوجي بين الزماني (المتناهي) والأبدي (الله)(٥).
إنه حوار مع الذات في تناقضاتها وتأملاتها، وفيما يختلج فيها من مشاعر متوترة وأحاسيس قلقة، وفي صراع الجسد العليل العاجز مع الروح النزقة المتوثبة؛ لأن الجسد المقيد بكل أنواع الإعاقة المادية والنفسية لا يسع تلك الروح المنطلقة وذاك الخيال الجامح الذي يتجاوز به نطاق الحيز البدني.
وفي ظل هذا التناقض بين المتناهي واللامتناهي، تتعزز الآلام ويتفاقم القلق في التركيبة الإنسانية المشكلة من الجسد والروح، والحس والعقل؛ مما ينسجم وخصائص العبقرية التي تحتاج إلى قدح زناد تلك الجذوة الخامدة في الذات لتتوهج من جديد.
وتنفث شرارتها لتكشف عن الإنسان الحقيقي فينا، وتفضح كل مظاهر الزيف والخداع التي تتسيد المجتمع بأطيافه وتلاوينه؛ «فلم يعد هناك شيء اسمه الفرد المتميز، وإنما هناك الشخصية المهلهلة غير المستقرة التي يسهل أن تسير مع القطيع فتحكم فيها الطغاة الذين هم الجماهير مرة، والكنيسة مرة أخرى، والمنظرون من الفلاسفة الهيغليين… فأمامنا، إذن، معارك هائلة سوف نخوض فيها صراعًا حتى الموت»(٦).
تبنى الذات وتتخلق تبعًا لعلاقتها بالقلق الذي هو ترجمة للوعي بالحاضر وإمكان مواجهة المستقبل بكل تحرر واندفاع نحو أفقه الأرحب. وفي مقابل ذلك؛ فراغ الذات من القلق يعني اللاوعي الذي ينفلت منه الحاضر، وينتفي فيه المستقبل بانتفاء فكرة الحرية التي يغذيها القلق.
وفي هذا الحضور والانتفاء لمسألة القلق توليد لثنائية الوجود والعدم؛ أن توجد، يعني أن تكون قلقًا، وأن تحيا العدم، معناه أن تعيش بلا قلق.
القلق خصيصة إنسانية ومنهج حياة يوجه مسارات الواقع الوجهة السوية ويجعلها متحررة من قيود المادة، «القلق، إذن، هو أساسًا قلق الروح. ومن ثم؛ إذا قل وجود الروح، قل وجود القلق، وإذا غاب وجود الروح؛ (أي الحرية) انعدم وجود القلق، كما هو الحال في الحيوانات»(٧).
هكذا تصبح الروح معادلًا موضوعيًّا لفكرة الحرية عند كيركغارد، ويصبح حضورها أو غيابها مؤشرًا على النزعة الإنسانية التي تقابلها النزعة الحيوانية.
ولا شك أن الإنسانية نزعة لاحقة على الميلاد؛ لأن الإنسان لا يولد إنسانًا، أو أنه يولد من دون وعي، ولكنه يسعى إلى تشكيل وعيه الأخلاقي الذي ينماز به عن الوعي البيولوجي، بما يشبه التعالي أو العبور إلى الوعي الديني.
ليكون السؤال الذي حاول كيركغارد الإجابة عنه معيدًا من خلاله التصور الهيغلي حول النشاط العقلي الذي ينتج الوعي الذاتي: كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى ذات أصيلة؟ بمعنى: كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى حالة الوعي التي يسقط فيها التعارض
بين الذاتي والموضوعي؟
- التجاذب بين النهائي واللانهائي
ولئن كان هيغل قد تحدث عن الوجود في كليته، فإن كيركغارد ركز على الوجود الفردي للذات، مع عدم إغفاله الخلفية الهيغلية في تفسيره، كما اقترح علاجًا روحيًّا لانتشال الذات من يأسها وقلقها، بإغماسها في اليأس من جديد؛ وهو ما يعبر عنه بالمرض حتى الموت(8).
فالذات عند كيركغارد تتشكل أنطولوجيًّا من مركب المتناهي واللامتناهي، ومن النفس والجسد، ومن الواقع والمثال، ومن الضرورة والإمكان، ومن الزماني والأزلي(9).
وسنركز، ههنا، على المركب بين المتناهي واللامتناهي؛ فالأول يبين أن الذات محدودة وقائعيًّا، وهو المعطى القبلي الذي تأتي به إلى الوجود. ونقصد بالوقائعية، وفق تعبير كيركغارد، الجانب العيني للذات بما هي جسد، وجنس، وصفات وراثية، وذكاء، ولون، ومزاج، ومواهب وقدرات، والبيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن توجد فيها الذات.
والذات، طبقًا لهذه العوامل، تجد نفسها منغمسة -اضطرارًا لا اختيارًا- في هذه المتغيرات التي تشكل وجودها وتتحكم فيها، وتحتم عليها الامتثال لشروط الطبيعة المادية. أما الجزء الثاني من التركيبة هو (اللامتناهي)؛ ويعني به كيركغارد قدرة الذات على التمدد والاتساع عن طريق الخيال الذي يحلق بها في مديات ممتدة.
ولإدراك اللامتناهي يتعين على الفرد المتدين أن يعيش حالة مستمرة من التعب والمشقة والجهد الجهيد حتى يصل إلى المطلق ويحيا شغف اللانهائي(١٠)، تاركًا الجزئي لصالح الكلي. وفقا لهذا التركيب؛ يكون الفرد تجاذبًا بين النهائي الذي تمثله المادة قبل المرحلة الدينية، واللانهائي الذي يعكسه المطلق.
وبلوغ هذه المرتبة، يعني أن يكون الفرد وجهًا لوجه أمام الله. نستنتج مما سبق؛ أن التخلص من الخطيئة وتجسيد الإيمان مدارهما على القلق والخوف. تلكم صوفية وجودية، أو وجودية إيمانية أعادت للذات الجوانية مثلها الحقيقية التي كانت قد تخطفتها الحياة البرانية.
وارتقت بالإنسان إلى المستوى الأخلاقي المرغوب؛ فالإنسان يولد بلا وعي بشري قبل أن يعمل على استعادته بالإيمان والانفصال عن الطبيعة الحسية في نظر كيركغارد؛ ولكن ما جدوى الإيمان إذا كان يورث في صاحبه تعاسة وقلقًا دائمين؟ وهو ما يتعارض مع جوهر الإيمان في القرآن الكريم الذي هو تحقيق الطمأنينة.
يقول الله تعالى: {فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا} الجن/13. فما قيمة الإيمان إذا كان سيغرق صاحبه في مستنقع التعاسة الأبدية.
- هوامش:
(١) كيركغارد، أعمال المحبة، ضمن كتاب، نصوص مختارة من التراث الصوفي، ص 29.
(٢) ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بمدينة نيسابور بخراسان، فرقة من فرق الصوفية أطلق عليها الملامتية أو الملامية، أسسها رجال من أصدق رجال الطريق في ذلك القرن الذي امتاز في تاريخ التصوف الإسلامي بالورع والتقوى الحقيقيين،
كما امتاز بقوة العاطفة الدينية وجهاد النفس العنيف ومحاربتها ومحاسبتها على كل ما فرط منها وما يحتمل أن يفرط منها… مسلك الملامتية مسلك عملي من أوله إلى آخره، ومجموعة من الآداب يقصد بها إلى مجاهدة النفس ورياضتها مجاهدة ورياضة تؤديان بالسالك إلى إنكار الذات ومحو علائم الغرور الإنساني، وإطفاء جذوة الرياء في القلب، أكثر من تأديتهما إلى أحوال الجذب والمحو والفناء… من مقدمة كتاب: الملامتية والصوفية وأهل الفتوة، أبو العلا عفيفي، منشورات الجمل بيروت-بغداد، ط 2015م، ص 5.
(٣) الحفني عبدالمنعم، المعجم الفلسفي، الدار الشرقية، مصر، ط 1، 1990م، ص 264.
(4) Kierkegaard Soren، Traité du désespoir, Traduit du Danoit par Knud Perlov et Jean-J.Gateau, La maladie mortelle. P 68 “Le péché est ainsi faiblesse ou défi, portés à la supreme puissance, le péché est donc un condenstation déssepoir”.
(٥) حنفي محمود علي، جدل العقل والوجود، دراسة في فلسفة هيغل وكيركغور، تقديم علي عبدالمعطي محمد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985م، ص 360.
(٦) إمام عبدالفتاح معين، كيركغارد رائد الوجودية، ص 153.
(٧) إمام عبدالفتاح إمام، كيركغارد رائد الوجودية، الجزء الثاني (فلسفته)، ص 347.
(8) Kierkegaard (1941), The sikness unto the death, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p 2.
(9) Ibid, “Man is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the iternal, of freedom and necessity, in short this is a synthesis. A synthesis is a relation between two factors” p 9.
(١٠) للتوسع في مفهوم الوجود البشري الحقيقي المركب من المتناهي واللامتناهي؛ ينظر: إمام عبدالفتاح إمام، كيركغارد رائد الوجودية (فلسفته)، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها.
وينظر أيضًا: Kierkegaard, The sickness unto death, p 68.