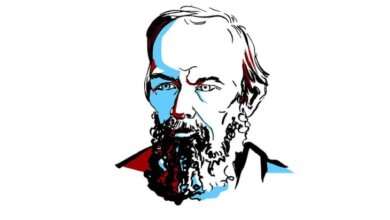الجنسانيّة: الأعجوبة والضّلال واللّغز – بول ريكور
ترجمة : عبد الوهاب البراهمي - تونس

يقال لنا، لِمَ تخصيص عدد من مجلة “فكر” للجنسانية بدل الحب؟ أليس الحبّ عبارة جامعة، و القطب الصاعد والمحرّك الروحي؟ يقينا، ولكن الجنسانية موطن كلّ الصعوبات، وكلّ التردّد، والمخاطر والمآزق، وموطن الفشل والغبطة.
عندئذ، لا شيء نخشاه أكثر من الهروب في وضح النّهار؛ ولا شيء نرجوه أكثر من أن نزيح عن القارئ عتمة غِنائية إيروسية – روحانية . لقد فضّلنا إذن بحثا في الجنسانية عن مدح للحبّ، حتّى لا نتجنّب أيّ صعوبة من الصعوبات التي تجعل وجود الإنسان بوصفه وجودا شِقِيّا، وجودا إشكاليا. يخترق الاختلاف في الجنس البَشَرِيَّةَ بطريقة أخرى غير اختلاف النوع و اختلافٍ اجتماعي، وبطريقة أخرى أيضا غير اختلافٍ روحي. ماذا يعني هذا؟
سنمنح الكلام بالدور للعالِم والفيلسوف، للنقد الأدبي، وللإنسان العادي؛ وسنشابك المساهمات المطوّلة بالأجوبة المختصرة لأولئك الذين تفضّلوا بالإجابة عن أسئلة الاستبيان الذي نجده مبثوثا طوال خلاصة هذا العدد من المجلّة؛ وسنحاول من خلال المقالات والأجوبة تتبع الخيط الناظم لتأمّلات أقرب المشاركين في المجلّة. و سأحاول من جهتي أن أكشف في مقدمة عملنا الجماعي هذا، نتوءات تساؤلنا، وأوّلا دهشتنا أمام أعجوبة وإلغاز الجنس.
قد لا يكون التمشي الذي سأسلكه هو ذات التمشي الجدّ ديداكتيكي، الذي اتبعناه في هذا العدد، والذي بانطلاقه من رؤية جامعة للمشكل( الجزء الأول)، يمرّ عبر المعرفة الخارجية، العلمية، الموضوعية للجنس (القسم الثاني )، ليصل إلى المسائل الإيتيقية (القسم الثالث)، ثمّ إلى أشكال التعبير ( القسم الرابع)، لينتهي إلى الجزء الملموس( القسم الخامس). سأتّبع هنا تمشّيا جدّ ذاتيّ: سأبدأ بما هو في نظري أعجوبة إلى ما هو لغز بالنسبة لي، مرورا بما يجعل الجنس انحرافا أو ضلالا وشذوذا.
سأنطلق إذن ممّا تغذّيت منه شخصيّا: البحث عن حركةgeste مقدّسة في إيتيقا العلاقة الزوجية المعاصرة. وسألتفت بعد ذلك نحو ما يشكّل صعوبات هذه الإيتيقا، نحو ما يمثّل تهديدا بفقدان معنى الجنسانية و سَأَصِلُ ذلك بمشكلِ الإيروسية érotisme . فسيظهر لنا حينئذ الإلغاز الكامن في إحداهما كما في الأخرى.
- الجنسانية بوصفها أعجوبة
يبدو لي أن كل مشاكلنا المتصلة بالجنسانية آتية من انهيار مقدّس قديم يمكن أن نسمّيه مقدس كوسمولوجي – حيوي، كان بإمكانه أن يضفي معنى تامّا على الجنسانية الإنسانية. وَتُمثّل إيتقا العلاقة الزوجية للمعاصرين إحدى ردود الفعل الناجحة نسبيا على هذا الانهيار.
من غير الممكن فعلا، فهم مغامرات الجنسانية بمعزل عن مغامرات المقدّس بين البشر؛ يجب أوّلا أن نكرّر في أنفسنا، في الخيال وفي التعاطف، المقدّسَ المفقودَ وشجرتَه الغنيّة أساطيرَ، وطقوسا ورموزا؛ ” تتمظهر الطقوس “في ذلك الوقت ” بفعل دمج الجنسانية في مقدّس شامل، بينما تسند الأساطير بسرديات احتفالية، إنشاء هذا المقدّسَ؛ ولا يكفّ الخيال “إذن” عن توظيف كلّ شيء من الرموز الجنسية، مقابل ما يتلقّاه من الرموز من أكبر إيقاعات الحياة النباتية، التي ترمز بدورها بالحياة والموت، إلى الآلهة، وفق لعبة غير محدّدة لتطابق متبادل.
غير أنّه لم يتبقّى من هذا المقدس القديم غير حطام؛ وقد أصبحت كلّ شبكة التطابق بأكملها، والتي أمكن لها ربط الجنس بالحياة والموت والغذاء وبالفصول والنبات والحيوانات وبالآلهة، أصبحت أكبر دمية متحرّكة مفكّكة، لرغبتنا ولرؤيتنا ولكلمتنا.
لكن لنفهم جيّدا أنّه كان لابدّ لهذا المقدّس أن ينهار، على الأقلّ في شكله المباشر والساذج. لقد ترك مكانه لفائدة وحدانية إيتيقية وذكاء تقنوي في ذات الوقت. نزع الأوّل أي الوحدانية الإيتيقية الطابع الأسطوري عن المقدّس الكوسمو- حيوي وألوهيته النباتية والجهنّمية، والهيروغامية أوالحوجديّة، وعنفه وهذيانه، وذلك لفائدة رمزية فقيرة بشكل خارق، “سماوية” أكثر منها “أرضية “، والتي يمثّل الإعجاب بالنظام الفلكي- السّماء المزيّنة فوق رؤوسنا- أهمّ آثارها فينا.
بيد أن المقدّس المتعالي هو مؤهّل لإسناد إيتيقا سياسية، مركزها العدالة، أكثر منه لإسناد غنائية الحياة. وتبدو الجنسانية، قياسا إلى النموذج المثالي الفلكي للنظام، كظاهرة شاذّة، أفرغها نزع الطابع الأسطوريdémythologisation عن الأمكنة الجهنّمية والنباتية، من مقدّسها الخاص.
لا لكون المقدّس المتعالي، مقدّس الأب السماوي مثلا، بلا معنى بالنسبة إلى الجنسانية؛ بل لكونه عاجزا عن استعادة شيطانيته الكامنة، وقوته الخلاّقة، وعنف الإيروس( أو الغريزة الجنسية )؛ فهو لا يستطيع أن يسند سوى الانضباط المؤسّسي للزواج، معتبرا إيّاه كشذرة من النظام الكلّي.
وإنّما تبرّر الجنسانية في المقدّس المتعالي والإيتيقي بوصفها نظاما وبوصفها مؤسّسة. فلابدّ على الإيروس أن يندمج فيه على أيّ حال. ومن هنا كانت الإيتيقا بصرامتها متمحورة حول أكسيوم واحد: الجنسانية وظيفة اجتماعية للتناسل؛ وليس لها معنى خارجه.
لأجل هذا كانت الإيتيقا بما هي اجتماعية بشكل بارز، وجماعية، وسياسيّة، متأتية من المقدّس المتعالي، هي بالأحرى حذرة تجاه قدرة الإيروس على التيه والضلال. و يحتفظ هذا الأخير دوما من المقدّس القديم الميّت أساس قدرة خَطِرَة وممنوعة. لقد حافظ المقدّس بوصفه مفارقا، لا نَطَاُلهُ، على بقاءه أمام مقدّس المشاركة sacré de participation، لكنّه يميل إلى تغيير الإدانة الذي تبثّها الجنسانية بما هي كذلك.
صحيح أنّ هذه الإدانة للجنسانية لدى اليهود بمعزل عن وظيفتها النفعية والجماعية في استمرارية الأسرة، ليست إدانة مشدّدة؛ فلم يعرف قانون إسرائيل العلوّ بنفسه إلى معنى الخلق، إلى مقدّس متعال محايث، تتغنّي وفقه الأرض بأكملها مع السماوات بمجد الأبدي، إلاّ بعد صراع جدّي مع الميثولوجيا الشرقيّة؛ يمكن لمتعة جديدة إذن أن تعتري اللّحم، متعة تجد تعبيرها الرائع في الصيحة التي وضعتها الوثيقة الكهنوتية في فم أول إنسان اكتشف أوّل امرأة:
“إنّه هذه المرّة، عَظْمُ عِظَامِي
ولَحْمُ لَحْمِـــي !…”
غير أن هذا المعنى الجسدي والروحي في آن واحد، والذي عثر عليه في أيامنا هذه الكاتب الفرنسي “بيقي”Péguy، لم يقدر على تعويض الانهيار العميق للمقدّس القديم الكسمو- حيوي. وقبل أن يقدر على خلق ثقافة تناسب حجمه، تلقّى هجوم موجة الثنائية، أورفيوسية ( نسبة إلى “أورفيثيوس”orphie الموسيقي والشاعر اليوناني الذي يسحر بغنائه الحيوان والنبات- المترجم) orphique وغنوصية gnostique، لينسى الإنسان فجأة أنه من ” لحم”، كلاما ورغبة وصورة، غير قابل للقسمة؛ و”يتعرّف” على نفسه كروح منفصلة، تائهة، وسجينة جسد، و”يَعْرِف” في نفس الوقت جسده بوصفه آخر، عدوّا وشرّيرا.
تتسلّل هذه “الغنوصية” للروح والجسد، هذه الغنوصية” للثنائي، في المسيحية، تعقّم معنى الخلق لديها ، تفسد اعترافها بالشرّ، وتحدّ من أملها في مصالحة شاملة في أفق روحانية ضيّق ومنزوف. هكذا يزداد، في الفكر الديني المسيحيّ، كره الحياة والاستياء ضدّ- جنسي الذي اعتقد نيتشه أنّه قد تعرّف فيه على ماهية المسيحيّة.
هاهنا تمثّل الإيتيقا الزوجية للمعاصرين، جهدا محدودا، ولكنه ناجح جزئيا، من أجل إعادة بناء مقدّس جديد، متمحور حول الرابط الهشّ للروحي والجسدي في الشخص.
إنّ الفتح الأساسي لهذه الإيتيقا هو أنّها وضعت في المقام الأوّل قيمة الجنسانيّة بوصفها لغة بلا كلام، وعضو اعتراف متبادل، وشخصنة متبادلة، وباختصار بوصفها تعبيرا. هذا ما أسمّيه بعدُ ” الحنان” tendresse أو المحبّة التي سأقابلها لاحقا “بالشبق الجنسي” érotisme.
وتندرج هذه الإيتيقا في امتداد لنزعةِ الخَلْقِ اليهودية créationnisme و”الأغَابي” المسيحي.( محبّة الله) ومع ذلك ترفض المسيحيّة هذه التوجّهات الغنوصية وترفض شبه المفارقة بين الإيروس والأغابي. سأرى في هذه الإيتيقا محاولة لإستعادة الإيروس بالأغابي.
تكرّس، هذه العودة من حيث هي كمثيلاتها، ليست مجرّد تكرار، دمار المقدّس القديم والحفاظ عليه في الآن نفسه؛ تكرّس دماره، إذ أنّ موضوع الشخصيّة، والشخصنة المتبادلة، هو موضوع غريب عن الطقس الديني الكوسمولوجي للمقدّس النباتي، وعن الدعوة التي يوجّهها إلى الأفراد للانصهار في تيّار الفعل الجنسيgénération وإعادة الفعل الجنسي.
ويظلّ التكاثر في المرحلة الماتحت شخصية infra-personnel غير مسئولٍ للغاية وخَطِرا وحيوانيا. يجب على المقدّس أن يتخطّى عتبة الشخص. وحينما يقع تخطّي هذه العتبة، يصبح الإنسان مسئولا عن منحه الحياة، مثلما هو مسئول عن الطبيعة بأكملها؛ ومراقبة الإنجاب هو العلامة التي لاجدال فيها عن موت المقدّس القديم، والمكسب الذي لا ارتداد عنه للثقافة الجنسية وقد نقول على مهل، والدلالة الإيتيقية والمخاطرَ الجديدة.
غير أنّ هذه المخاطر هي الوجه الآخر لعظمة الجنسانية الانسانية: فبمراقبة الإنجاب، لن يكون التكاثر قَدَرا، في نفس الوقت الذي تكون المحبّة، حيث يعبّر المقدّس الجديد عن نفسه، قد تحرّرت بعدُ. إنّ ما يدمّر الإيروس المقدّس القديم، هو أيضا ما يسمح في الآن نفسه بإنقاذه، في نور “الأقابي”. نميل بالمحبّة إلى إعادة تشكيل رمز البراءة، وجعل حلمنا بالبراءة طقوسيّا، وترميم طهارة الجنس في كليّته.
غير أنّ هذه المحاولة تفترض نشوء الشخص؛ ولا يمكن لها أن تكون إلاّ بين- شخصيّة interpersonnelle؛ وتظل الأسطورة القديمة للخنثى l‘androgyne ، أسطورة اللاتمييز، واللاإختلاف؛ التي يجب أن تتحوّل إلى أسطورة جديدة للتشارك، لعلاقة شهوانية متبادلة. يفترض هذا الترميم، في مستوى ثقافة وروحانية أخرى، و مقدس بدائي، أن الأغابي (أو محبّة الله) ليس محاربا للأيقونات أو للتقاليد فحسب، بل يمكن أن ينقذ كل الأساطير، بما فيها أساطير الإيروس.
ولكن، هل هذا المشروع ممكن؟ إنّه يحوي بعدُ بذرة هشاشته فقط لأنّه يجب على الرّابط الجنسي، كي يملك كثافة وديمومة، أن يُعهد بتربيته إلى انضباط المؤسسة. لقد رأينا أنّ المقدّس المتعالي هو لحظة ضروريّة في تاريخ المقدّس؛ بيد أنّ المقدّس المتعالي الذي ولّد إيتيقا القانون السياسي، والعدالة الاجتماعية، قد أَرْغَم بشدّة الإيروس الفوضوي على الخضوع لقانون الزواج.
وقد شُحنت إيتيقا الجنس، متأثّرة بإيتيقا السياسة، بحقوق وواجبات، وبإلزامات وعقود: نحن نعرف موكب الممنوعات والمحظورات والمحرّمات الذي يصاحب تهذيب الغريزة. لقد كان ثمن مَجْمَعَة socialiser الإيروس مريعا.
ومع ذلك فلا مجتمع معاصر يفكّر في التخلّي عن توجيهٍ، كيفما كان، وتثبيتِ شيطانية الإيروس بمؤسسّة الزواج. ويمكن أن نتصوّر مصائر متفرّدة لهذه القانونية قد وقع تجاوزها، ومنها ما هو عظيم جدّا، أساسا من بين الفنانين وأعظم مبدعي الثقافة، الذين لا يمكن أن نتخيلهم قطّ داخل رابط الزواج.
ولكن أيّ مشرّع سيجد في ذلك ذريعة لنزع الطابع”المؤسّسي désinstitutionnaliser ” عن الجنس، وتشييد شعار مصائره المتفرّدة في مبدأ أساسي؟ إنه لأمر واقع أن الإنسان لم يدرك إنسانيته ولم يأنسن جنسانيته إلا عبر نظام– مُكْلِفٍ من جوانب عدّة – المؤسّسة الزوجيّة.
لقد عقد بنفسه ميثاقا هشّا بين الإيروس ومؤسّسة الزواج لم يكن دون مقابل، دون معاناة وأحيانا دون تدمير للإنسانية: يظلّ الزواج التحدّي الأساسي لثقافتنا في شأن الجنس؛ تحدٍّ لم ينجح تماما.
ومن دون شكّ لا يمكن أن ينجح تماما؛ لأجل ذلك كان قرار الزواج دائما مَهمَّة ممكنة، نافعة ومشروعة وملحّة: يعود إلى الأدب والفنون شجب نفاق مجتمع يميل دوما إلى تغطية كلّ خياناته بذريعة مثله العليا؛ فكلّ إيتيقا الإكراه تولّد سوء النيّة والخداع؛ لأجل ذلك كان للأدب وظيفة لا يمكن استبدالها هي الفضح؛ إذ أنّ الفضيحة هي سوط الخداع.
وسيرافق الخداع الإنسان؛ أطول ما يمكن حتّى لن يستطيع المطابقة بين تفرّد الرغبة وكونية المؤسّسة. بيد أن الزواج هو، في حضارتنا، و دائما إلى حدّ ما، علامة على الإلزام؛ وقد حطّم الكثير؛ يريد الزواج حماية الديمومة وحميميّة العلاقة الجنسية وجعلها إذن إنسانية، غير أنّه بالنسبة إلى الكثير محطّم الديمومة والحميمية.
إنّ رهان إيتيقا المحبّة هو أنّ الزواج، وبغضّ النظر عن مخاطره، يظلّ أفضل فرصة للمحبّة. وما تحتفظ به هذه الإيتيقا من المقدّس المتعالي، هو فكرة أنّ المؤسّسة يمكن أن تَصْلُح كنظام للإيروس بنقلها قاعدة العدالة واحترام اللآخرين، والمساواة في الحقوق والتبادل في الإلزام، من دائرة السياسي إلى دائرة الجنساني.
لكن في المقابل، وباحتكارها المؤسّسة، تحوّل إيتيقا المحبّة القصد؛ فللزواج، وفق روح المؤسّسة، غاية غالبة هي التناسل، واستمرارية النوع الإنساني: تريد إيتيقا المحبّة تضمين التناسل في الجنسانية لا الجنسانية في التناسل، بجعل كمال العلاقة البينشخصية على رأس غايات الزواج. إنّ هذه المؤازرة للموضوع الشخصي والبينشخصي هو نقطة إتمام الحركة التي رجّحت أسرة الزواج على عائلة الأسلاف، أي الاختيار المتبادل للشريك على اتفاق العائلات.
ولكن، هل كان دمج المؤسّسة والايروس المتسامي في محبّة، عملية ناجحة؟ لاشيء يضمن ذلك. لأجل هذا، فإنّ فجوة سريّة تهدّد المغامرة الجنسانية كلّها بالقطيعة، مغامرة تستمرّ من خلالها عدّة مصائر متعارضة.
هذه هي الفجوة. بيد أن هذا التوجّه الطارد، الضدّ مؤسسي، الذي يُتوّج في “الإيروسية” المعاصرة، يقوم لصالح هذه التنافر، الذي يهدّد التوافق الهشّ بين الإيروس والحضارة. ويبدو لي أنّ عصرنا يشتغل على حركتين متضادّتي الاتجاه، إحداهما حركة إعادة تقديس الحبّ والأخرى تدنيسه.
- الضّلال أو الإيروسية ضدّ المحبّة
سنكرّر هذا القول لاحقا، إنّ عبارة “إيروسية” (أو التهيّج الجنسي) مبهمة : فيمكن أن تعني أوّلا مكوّنات الجنسانية الانسانية، مكوّنها الغريزي والحسّي، ويمكن أن تعني كذلك فنّ الحبّ القائم على ثقافة اللذة الجنسية: وهو بما هو كذلك ما يزال بعدُ مظهرا للمحبّة طالما يتفوّق هاجس العلاقة المتبادلة، والمكافأة المتبادلة، والهبة ، على الأنانية و نرجسية المتعة؛ غير أنّ الإيروسية تصبح رغبة ضالّة للذّة، حينما تنفصل عن حزمة الميولات التي يربطها هاجس صلة بينشخصية دائمة وقويّة وحميميّة.
حينئذ تصبح الإيروسية مشكلا. بيد أنّنا تعلّمنا من فرويد- وأساسا من كتابه ثلاث مقالات في الجنسانية، أنّ الجنسانية ليست أمرا بسيطا، وأنّ إدماج مختلف مكوّناتها مهمّة غير محدّدة.
ولا يعاش هذا التفكّك disintegration كفشل ، بل يُطلب بوصفه تقنية للجسد، تجعل من الإيروسية (أو الإثارة الجنسية) القطب المضادّ للمحبّة؛ ففي المحبّة، تتفوّق العلاقة مع الآخر ويمكن أن تُقَيَّدَ الإيروسية في معنى مُكَوِّنٍ حسيّ للجنسانية؛ بينما في الإيروسية تتفوّق ثقافة اللذّة الأنانية على تبادل الهبة.
لقد وجدت كلمة الإيروسية دائما في معناها المحدود و التحقيري ( بعض مراسلينا كما سنرى يؤكّدون حتّى أنّها في تقهقر في حضارة نفعية محورها العمل (يقصد ريكور مراسلي مجلة الفكر في عددها المخصص لموضع الجنسانية- المترجم)): تمثّل ثقافة اللذّة إمكانية أساسية للجنسانية الإنسانية، فقط لكونها تأبى أن تختزل في تناسل جنسي حيواني؛ لها تصرّف وقد أصبحت لعبة؛ إنّ ثقافة اللذّة مطلوبة من المحبّة ويمكن أن تنقلب عليها باستمرار؛ إنّها الحيّة التي تغذّيها المحبّة من ثدييها.
هكذا هو الأمر ، لابدّ من معرفته وقبوله؛ إنّ شيطانية الإيروس هي إمكانية مزدوجة للإيروسية والمحبّة؛ وما تمارسه المؤسّسة من إكراه على المحبّة ما يفتأ ينشّط الميل النابذ للإيروسية، في نفس الوقت الذي تعمل فيه المؤسّسة على إدماجه في المحبّة.
لكن إذا كانت “الإيروسية” إمكانية وخَطَرا كامنا في الجنسانية من حيث هي إنسانية، فإنّ أنماطها المعاصرة تبدو جديدة؛ وهي ما نقترح توضيحه فيما بعد، وسأقتصر هنا على توجيه النظر إلى ثلاثة مجموعات من الظواهر، هي بالمناسبة مترابطة وفي تفاعل متبادل.
يوجد أوّلا ما سأسمّيه الوقوع في التفاهة أو الحقارة والابتذال chute à l’insignifiance. لقد أحدث رفع الممنوعات الجنسية أثرا غريبا بالفعل، لم يعرفه الجيل الفرويدي، وهو فقدان القيمة بفعل السهولة واليسر : لقد أصبح الجنسيّ قريبا، في المتناول، ومختزلا في مجرّد وظيفة بيولوجية، وأصبح تافها بلا معنى. وأصبحت إذن النقطة القصوى لتفكّك المقدّس الكوسمولوجي الحيوي هي أيضا نقطة قصوى لإفراغ الجنس من إنسانيته.
ساهمت ظروف عديدة في وجود هذه الظاهرة : امتزاج الجنس بالحياة الاقتصادية وبالدراسات، واكتساب المرأة مساواة منحتها نفاذا إلى الحريّة الجنسية التي ظلّت حتّى الآن حكرا على الرجل؛ وباختصار كلّ ما يجعل اللقاء الجنسي يسيرا، ويدفع أيضا إلى الانحطاط إلى الدرجة الصفر للمعنى والقيمة.
ينضاف إلى هذا دخول الأدب الجنساني المبسّط إلى الفضاء العام. لقد أصبح الإنسان عارفا بنفسه بشكل أفضل، وفي نفس الوقت أصبحت جنسانيته عمومية؛ غير أنّها بفقدانها طابعها السرّي، فقدت الجنسانية أيضا ميزتها الحميميّة. نحن الآخرين ثديات…كما يقول بيقانBéguin. يوجد هنا شيء لا ارتدادي: فبانتشارها تصبح العلوم الإنسانية بدورها ظاهرة ثقافية جديدة تمثّل جزءا من الوضع الذي علينا تحمّله.
وأخيرا، تتلقّى الجنسانية الضربة المعاكسة من كلّ العوامل الأخرى الفاعلة في اتجاه اللاشخصنة والمجهول. تفيدنا في هذا الصدد شهادات المحللين النفسانيين الأمريكيين: فهم يشهدون زوال نمط المهووس l’obsédé بالكبت، خاصية العهد فيكتوري، وبروز أعراض أكثر حدّة: فقدان الميثاق العاطفي، وعجز عن الحبّ والكره؛ يشتكي مرضاهم أكثر فأكثر من عدم قدرتهم على الشعور بالإلتزام العاطفي لشخصيتهم كلية في الفعل الجنسي، والقيام بالعملية الجنسية دون حبّ.
إنّ وقوع الجنسانية في الإبتذال هو في الآن نفسه السبب والنتيجة لهذا الانحطاط العاطفي ، كما لو أن المجهول الاجتماعي والمجهول الجنسي أُسْتُحِثّا بشكل متبادل.
الظاهرة الثانية: في نفس الوقت الذي أضحت فيه الجنسانية مبتذلة وتافهة، أصبحت مُلْزِمة على سبيل ردّ الفعل على الإحباطات التي منيت بها قطاعات أخرى من الحياة الإنسانية؛ فتفاقم الجنسانية بواسطة وظيفتها التعويضية والانتقامية، جعلها نوعا منها مرعوبة. بأيّ إحباطات يتعلّق الأمر؟
أوّلا الإحباط في العمل؛ ستكون هناك دراسات مهمّة حول هذا الموضوع: حضارة العمل والجنسانية. ليكن العمل مهذّبا للغريزة، بطابعه المضاد لليبيدو أو الغريزة، وقد بينت ذلك بوضوح المدرسة الفرويدية لتحليل الأنا égo-analysis ( هارتمان ، إيريكسون، الخ).
فمن المؤكّد أنّ الشخصية تَبْنِي ذاتها، وأنّ الأنا يكتسب استقلاليته انطلاقا من وضعيات غير نِزَاعِية non-conflictuelles ( من زاوية غريزية على الأقلّ)؛ يكون العمل، مع اللغة ومع تعلّم العيش داخل المؤسسات، إحدى هذه الوضعيات غير النزاعية (ميدان النزاع الحرconflit-fre sphère لإيريكسون).
غير أنّ الصدمة في المقابل هي أيضا مهمّة: تجربة الإنسان المعاصر، هي كونه ليس “سعيدا ” داخل مجتمع وقع تصوّره كمقاومة منظّمة للطبيعة؛ فإحباطه أعمق من مجرّد رفض للنظام الاقتصادي والسياسي لعمله، هو محبط من العالم التكنولوجي ذاته.
إضافة إلى كونه ينقل الهدف من حياته من العمل إلى الترفيه. تظهر الرغبة الجنسية أو الإيروسية بوصفها بعدا ترفيهيا: فليست هي في الغالب سوى ترفيها بأبخس الأثمان، على الأقل ذاك الذي يمكن أن نسمّيه إيروسية وحشية.
ينضاف إلى هذا الإحباط الأوّلي، إحباط ” السياسي”. نحن نشهد بعض فشل التعريف السياسي للإنسان. فالإنسان المرهق بصنع التاريخ يتطلّع إلى اللاتاريخ؛ يرفض أن يُعَرّف “بدور” اجتماعي ويَحْلم بأن يكون إنسانا غير ذي صفة مدنيّا.
هذا فيلم يرينا مراهقين جدّ مهتمين بدورهم الاجتماعي – السياسي ( “الغشّاشون” les tricheurs) . هل هو سمة بلد عريق في القدم خُلْوُ من مهمّة عظيمة؟ لا أعرف. وعلى أي حال ، تبدو الإيروسية بمثابة انتقام رائع، لا انتقام الترفيه من الشغل فحسب، بل انتقام الخصوصي من العمومي في مجموعه.
أخيرا، تعبّرالإيروسية، بشكل أعمق، عن خيبة أمل أكثر جذرية، خيبة أمل “المعنى”؛ يوجد رابط سريّ بين الإيروسية والعبث. حينما يفقد كلّ شيء معناه، تبقى اللذّة وليدة اللحظة وَحِيَلَهَا. تضعنا هذه السمة على طريقِ ظاهرة ثالثة تقرّبنا أكثر من طبيعة الإيروسية؛ فإذا كانت الجنسانية الضالّة هي في الآن نفسه مبتذلة ومُلْزِمَة كانتقام ، فما يزال علينا جعلها ذات أهميّة.
ليست الجنسانية إذن، انتقاما من تفاهة العمل، ومن السياسة والكلام فحسب، بل انتقاما من ابتذال الجنسانية ذاتها.من هنا كان البحث عن رائع جنسيfabuleux sexuel. يفسح هذا البحث المجال لإمكانية أساسية للجنسانية الإنسانية كنا قد أثرناها: إمكانية فصل اللذّة لا فقط عن وظيفتها التناسلية (وهو ما يفعله أيضا الحب- الودّ)، بل عن المحبّة ذاتها.
ها هو الإنسان ملتزم بمقاومة باسلة للعوز النفسي للذّة ذاتها، التي لا تحتمل أبدا كمالا في عنفها البيولوجي. ستُنْشِأُ الإيروسية إذن رَاِئعَهَا في فَاصِلِ الانشطار المُتَعِي وفي حدودِ النّهائيةِ العاطفية. من هنا كان الطابعُ المفْرِطُ في اليأس لمشروعها : إيروسية كمّية لحياة مكرّسة للجنسانية؛ إيروسية رقيقة هي بالمرصاد للتبدّل،- إيروسية تخيّليّة للكشف- الإخفاء والعطاء – المنع،- إيروسية دماغية للمتلصّص الذي يلمّح بثلث نظرة في كلّ الأدوار الإيروسية: يَنْبَنِي رائع جنسي على كلّ هذه الطرق.
ويقع إسقاطه على أبطال متنوّعين للجنسانية؛ غير أنّنا نراه (أي هذا الرائع الجنسي) ينزلق ، من شكل إلى آخر من الدعارة إلى العزلة المُوحِشَة. إنّ اليأس الشديد للإيروسية – والذي هو ليس بالبرميل المثقوب كما في الأسطورة الإغريقية المعروفة- هو أن لا نعوّض أبدا فقدان القيمة والمعنى بتراكم بديل من المحبّة أو الحنوّ.
- لغز الجنسانية
لا أريد أن أنهي حديثي بهذه اللهجة المتشائمة، بل أودّ التقريب بين قسمي تحليلي. يظهر شيء ما على مَسْلَكَيْ الجنسانية ، مسلك المحبّة ومسلك الإيروسية : أي أن الجنسانية تظلّ في عمقها ربّما غير قابلة للنفاذ بالنسبة إلى التفكير وصعبة المنال على السيادة الإنسانية؛ وهذا الغموض ربّما هو الذي يجعلها لا تَرِدُ لا في إيتيقا المحبّة، ولا في لاإيتيقا non-éthique الإيروسية ؛ بل إنّها حتى لا تستطيع أن تنصهر لا في إيتيقا ، ولا في تقنية، بل أن تُتَمَثّل رمزيا فحسب لِصَالِحِ ما بقي فينا من الأسطوريّ .
وفي النهاية، حينما يتعانق كائنان، فإنّهما لا يعرفان ماذا يصنعان: لايعرفان ماذا يريدان ولا عمّا يبحثان، إنهما لا يعرفان ما قد يجدان. ماذا تعني هذه الرغبة التي تدفع بأحَدِهِمَا إلى الآخر؟ أهي الرغبة في اللذّة؟ نعم بالتأكيد. ولكن أي جواب بائس؛ إذ أنّنا في نفس الوقت نستشعر أنه ليس للذّة ذاتها من معنى في ذاتها: إنّها مجازية figuratif .
ولكن من ماذا؟ لدينا وعي حيّ وغامض بأنّ الجنس يشارك في شبكة من القوى نُسيت توافقاتها الكونية ولكنّها لم تُلغى؛ وأنّ الحياة هي أكثر بكثير من الحياة؛ وأعني أن الحياة هي أكثر من الصراع ضدّ الموت، من تأخير الموعد النهائي القاتل؛ وأنّ الحياة فريدة وكونية، كلّها ولدى الجميع، وأنّ الغبطة الجنسية تشارك في هذا اللغز، وانّ الإنسان لا يُشَخْصن، إيتيقا وحقوقيّا، إلاّ إذا قذف بنفسه من جديد في نهر الحياة- تلك هي حقيقة الرومانسية بوصفها حقيقة الجنسانية.
غير أن هذا الوعي الحيّ هو أيضا وعي معتّم، إذ أنّنا نعرف جيّدا بأنّ هذا الكون الذي تشارك فيه الغبطة الجنسية، قد انهار فينا؛ وأنّ الجنسانية هي بقايا جزيرة أتلانتس المغمورة. من هنا كان لغزها. وهذا الكون المفكّك ليس في متناول السذاجة، ولكن في متناول التأويل العَالمِexégèse savante للأساطير القديمة؛ ولا يحيا من جديد إلاّ بفضل تأويلية، أي بفنّ ” تأويل” للكتابات الخرساء اليوم؛ وأنّ فراغا جديدا يفصل بقايا المعنى التي ترمّمها لنا تأويلية اللغة وأنّ هذه البقايا الأخرى للمعنى التي تكتشفها الجنسانية عضويا، دون لغة.
لنذهب بعيدا: إنّ لغز الجنسانية هو كونها قد ظلّت غير قابلة للاختزال في الثالوث الذي يصنع الإنسان : اللغة- الأداة – المؤسّسة. وبالفعل، من جهة ، تنتمي إلى وجود ماقبل ألسني للإنسان؛ ولكنّها حينما تكون معبّرة expressive ، تكون تعبيرا مادون-، مواز- مافوق- ألسنيinfra-para-supra- linguistique؛ يقينا هي تحشد اللغة، ولكنّها تتخطّاها، تدفعها، وتتسامى بها وتُبَلِّهُها وتدقّها في همس وفي دعاء؛ إنّها تنزع عنها وسائطيتها؛ فهي إيروس أو رغبة وليست لوغوس أو عقل. ويظلّ ردّها كليّا إلى عنصر اللوغوس مستحيلا بشكل جذري.
ينتمي الإيروس من جهة أخرى إلى وجود الإنسان القبل- تقني؛ وحتّى إذا ما أصبح الإنسان عنه مسئولا وأدمجه في تقنية للجسد( سواء تعلّق الأمر بفنّ التعديل الجنسي أو بشكل أدقّ بتقنية وقائية للتناسل)، تظلّ الجنسانية مفرطة في الأداتية؛ وأدواتها يجب أن تُنسى؛ وتظلّ الجنسانية غريبة جوهريا عن العلاقة “قصد – أداة – شيء” ؛ إنّها بقايا المباشرتية غير الأداتية؛ العلاقة جسد – – جسد أو بالأحرى” شخص – لحم – لحم –شخص”- وتظلّ جوهريا غير تقنية. وحالما يركّز الانتباه ويتوقّف عند تقنية التعديل أو تقنية العقم، ينقطع السّحر والفتنة.
وفي النهاية، مهما قلنا عن توازنه في الزواج، فليس الإيروس أو الرغبة مؤسّسية. نسيء إليها لو اختزلناها في العقد، في الواجب الزوجي؛ ويرفض الإيروس أن يحلّل بوصفه واجبا – دَيْنا؛ وقانونه، الذي ليس بقانون، هو تبادل الهبة. من هنا فهو ماتحت- حقوقي، مواز- حقوقي ، فوق – حقوقي. ثمّ أليس من ماهيته أن يهدّد المؤسّسة بمتعيّته – كلَّ مؤسّسة-، بما في ذلك مؤسّسة الزواج. يتقدّم الحبّ كما شكّلته ثقافتنا بين هُوَّتَيْن: هوّة الرغبة التائهة وهوّة إرادة مُداهنةٍ بثباتٍ، – كاريكاتور متشدّد للوفاء.
ويظلّ اللقاء في الوفاء سعيدا ونادرا، بين الرغبة التي يضيق صدرها بكلّ قاعدة، والمؤسّسة التي لا يمكن للإنسان أن يحافظ عليها دون تضحية.
كتاب : ” الحقيقة والتاريخ” – بول ريكور
سلسلة ” إيديا” دار النشر سيراس 1995 ص 222 -234.