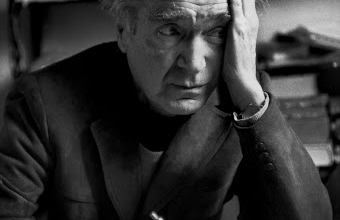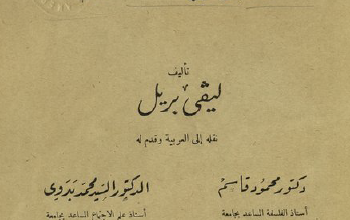الشعر والفلسفة: عزلة أم تعايش

بناء المعرفة وسيرورتها، يأتي من خلال ما نملكه وما نَتَمَلَّكه من آليات في فهم واستيعاب وتفسير كل ما يُكتب وكل ما يُنتج من إبداعٍ وفكرٍ، ولعلَّ ما يُمَيِّزُ المعرفة الأدبية عن غيرها من المعارف، هو صلتها الوثيقة مع أنماط العلوم الإنسانية الأخرى.
غير أن هذه الصلة يكتنفها نوع من التَّجاذب والتَّمايز، على اعتبار الاختلاف القائم في الجذور والمرجعيات والرؤى، والثابت على مدى قرونٍ طويلة، أن علاقة الشعر بالفلسفة -على وجه الخصوص- تنطوي على قيمٍ من التَّوالج والتَّضايف، إلى درجة أن الكثير من الشعريات سواء العربية أو الغربية، تَخَلَّقَتْ ضمن حواضن السؤال الفلسفي.
وهو أمر متحقَّق مُسْتَدْمَجٌ من خلال مزج ما لا يُمزج، حتى قيل هذا شاعر فيلسوف وذاك فيلسوف شاعر، في إشارةٍ إلى حدود التَّواشج بين الشعر والفلسفة، بيد أن هذه الصلة الخلَّاقة التي تجمعهما، لا تلغي حالات التَّمايز والتباين القائمة بينهما، مما هو قمينٌ بخلق حالاتٍ من الجدال والتناقض والعزلة.
إن علاقة الشعر بالفلسفة، تكاد تكون جوهر الكينونة ومحرك الوجود؛ ذلك أن الشعر بوصفه قضية وجودية ومركبًا كليًّا مُشَكَّلًا من كيمياء اللغة وجموح الخيالات والإيهام واللغة الموحية الإشارية، ينزع نحو الارتماء في حضن الفلسفة،
قصد الاستزادة والاسترفاد، حتى يكون هذا الشعر -الذي نقيم فيه إقامة أبدية ونسبح في مياهه أكثر من مرة- هذا الشعر الذي يجعل من سؤال الفلسفة وشواغلها ومضايقها، الحجر الأساس في أيِّ قولٍ شعريّ، صحيح أن مسارب الفلسفة تختلف في كلياتها عن التَّوجه العام للشعر، من حيث اللغةُ الخشنة، الصارمة التي تستند وتسترشد بالمنطق واللوغوس وأسئلة الكينونة والوجود في التعبير عن القضايا الكونية، وفي هذا الصدد،
يبدو التعايش بين الفلسفة بوصفها عقلانية، في مقابل الإيهام الذي يُميِّز الشعر، أمرًا غير ممكن، بل استحالة تحقق ذلك، لكن، من جهة أخرى، يُمكن من باب تقريب وجهات النظر والرؤى والتَّصورات، ملاحظة كيف استطاع فلاسفة من قبيل: نيتشه وهايدغر، وقبلهما هيروقليطس وأرسطو وأفلاطون، تطويعَ لغةِ الفلسفةِ وجعلها أقرب إلى الشعر، بل إن فريدريك نيتشه عمد إلى «شعرنة» وتشذير الكتابة الفلسفية والخروج بها عن النسق الذي نحتته كلاسيكيات الفلسفة، في أفق بناء معرفة فلسفية تستطيع النفاذ بيسرٍ إلى وجدان المتلقي قبل عقله،
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، لا بد من الإشارة في هذا السياق، إلى أن التاريخ الأدبي حافل بجمهرة من الشعراء ممن تَلَبَّسَتْ نصوصهم بلبوس الفلسفة والفكر والتأمل، حتى صاروا في عداد الفلاسفة الشعراء مثل: جورج تراكل وهولدرلين وغيرهما، واللافت –ونحن في حمأة هذا الجدال المحموم-
أنْ كَثُرَتْ في الزمن المعاصر دعاوى ما فتئت تُشير إلى «موت الشعر»، و«موت العقل»، مقابل الإعلاء من شأن التكنولوجيا ووسائل الميديا، وهو واقع بقدر ما هو متحقق كائن، بقدر ما يفتح الباب على مصراعيه من أجل إعادة الاعتبار للفكر في مختلف تجلياته وأنواعه.
- الآمال الوجودية
بين الفلسفة والشعر إذن، علاقة ضاربة في جذور التاريخ، وبين هذا وذاك تتأرجح هذه العلاقة، حتى صارت في نهاية المطاف، مشجبًا نُعَلِّقُ عليه آمالنا الوجودية العريضة، والحق، أن الكائن البشريّ لا يُمكنه أن يعيش من دون فكر، أجل، الفكر هو الحقيق بأن يُسهم في تطوير الملكات الإدراكية والحسية والتأملية للإنسان، وهو القادر أيضًا، على بلورة آفاق حرة، ممكنة للتعايش بين مختلف أنماط التعبير الإنساني.
انطلاقًا من هذه الرؤية الكلِّيانية لمسارات الفكر الكوني، ببنياته وأنساقه وأكوانه، قادر على تفتيت هذه الأسئلة المحرجة، فيما يتعلق أساسًا بِصِلة الشعر بالفلسفة، وإعادة تركيب أولياتها بمزيد من الحفر في أثر كل واحد في الآخر.
وعليه، فإن سؤال العزلة وما شابه ذلك من أسئلة، صار الآن في موضع الشك والارتياب، من منطلق أنه سؤال متاهة؛ إذ لا يمكننا الفصل في هذه المدارات على اختلاف واقعها وآفاقها ومضايقها، إننا نتحدث باطرادٍ ويقين عن صلةٍ قريبة مهما تباعدت إبستمولوجيًّا وأنطولوجيًّا، ولا بد ها هنا، من طرح الفكرة القائلة بأن العقل (الفلسفة) أعلى شأنًا من الخيال (الشعر)، ومناقشتها في ضوء المفهوم الأوسع والأرحب للعلوم الإنسانية،
ذلك أن إمكانية التعايش بين الخيالي والعقلي، بين العالم المحسوس والعالم المجرد، بين البرهان والاستدلال والإيهام والخيال العذب، بين اللغة الصلبة الصخرية واللغة العذبة الشجية، أمر ممكن ومتاح، رغم أن الأمر يتعلق ببرزخين متباعدين ومتنابذين ومتناقضين، والحالة هذه، تستوجب تفكيرًا عميقًا في ماهيتهما أوَّلًا، ثم محاولة قياس نسبة وجود كل واحد في الآخر ثانيًا، وإن كانت المسألة في كلياتها لا تستحق كل هذه الجلبة.
- سؤال الفلسفة
غير أن الشعر وهو يشتبك بقضايا الفلسفة، ينطوي على فضائل جمَّة، لا يعرف كنهها إلا من احترق قلبه بنيران اللغة الشعرية، وقد أشرنا آنفًا إلى الشعريات القديمة، وبخاصة الإغريقية، وهي تنهل من رافد الفلسفة، ثم تبني براديغمها بناءً شعريًّا تشذيريًّا،
حتى إن الشعريات الحديثة والمعاصرة، التفَّتْ وانفتحت على سؤال الفلسفة، والأمر يبدو واضحًا وجليًّا من خلال مجموعة النصوص الشعرية التي تنطرح اليوم، وقد تَلَوَّنَتْ بقضايا الوجود والكينونة والابتداع، حتى صارت مدارات القصيدة لا تنفك تقيم في حضن الفلسفة وتبني عوالمها وأفضيتها وغنائيتها ودراميتها.
إننا فعلًا نقدر هذه الصلة التي تجمع الشعر والفلسفة، بل يوليها المبدعون مكانة متميزة، في أفق بناء المعرفة الكونية التي نصبو إليها اليوم، فعالم الأدب متجدد ومتطور ومتعدد، وليس جزيرة معزولة، وإنما هو تيارات وأطياف مختلفة تسهم بلا شك في تحديد ملامح الفكر الإنساني.
وتسعى دوما إلى تقريب وجهات النظر بين العلوم الإنسانية في تجلياتها كافة، وعليه، ثمة تضايف مطلق بين هذه العلوم، يقوم مقام الدعاوى التي حاولت وتحاول أن تفصل بين هذه التيارات، وتغرقها في عزلة تامة ومصطنعة، والواقع الذي يفرض نفسه بإلحاح، هو أن القصيدة الآن تعيش حالة عزلة عن كيانها،
(وهذا واقع ينبغي أن نعترف به) نتيجة «أزمة الثقة» التي تولدت بينها وبين القارئ/ المتلقي، وهي مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بضرورة البحث عن مدارات أخرى تحتضنها، وتحتضن رؤاها الجديدة،
لكن يجب أن نعترف من باب الإنصاف على الأقل، أن الفلسفة ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تجديد الكتابة الشعرية، وأحدثت خلخلة في الشعريات الكونية، بفعل طاقاتها على تفجير ينابيع الإبداع واستيلاد طرق جديدة للتخيل والتخييل والإبداع.
لقد أظهرت الفلسفة طيلة القرون الماضية على مدى سعيها الدائم نحو خلق دينامية جديدة في روح الأدب بصفةٍ عامةٍ، فترى الشعراء والروائيين والقصاصين يذهبون إلى الفلسفة، ويغترفون –ما أرادوا- من معينها الذي لا ينضب، ولعلَّ هذا ما يجعل الفلسفة في أعلى درجات الفكر الإنساني، لذلك فإن الحديث عن عزلةٍ بينها وبين القول الشعري، هو حديث ذو شجونٍ، ويُعَبِّر عن انسدادٍ في الأفق ونضوب في المخيلة.
إن القصيدة مطالبة اليوم بضرورة البحث عن مدارات أخرى تحتضنها، وتحتضن رؤاها الجديدة، لكن يجب أن نعترف من باب الإنصاف على الأقل، أن الفلسفة ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تجديد الكتابة الشعرية، وأحدثت خلخلة في الشعريات الكونية، بفعل طاقاتها على تفجير ينابيع الإبداع واستيلاد طرائق جديدة للابتكار والتعبير الجدير بقيم الإنسان.
مجلة الفيصل