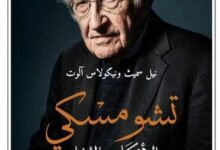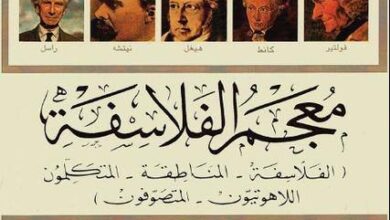في التلقي المغربي لمفهوم المثقف: عبد الإله بلقزيز نموذجاً

لم يكن تلقي الفكر الفلسفي بالمغرب لمفهوم المثقف كغيره من ضروب التلقي التي خص بها هذا الفكر غيره من المفاهيم الرئيسية في الفكر الفلسفي الغربي الحديث والمعاصر، وسيكون من باب مجانبة الصواب القول إن ما عرفه الوطن العربي من رجاتٍ سياسية أخيرة كان السبب الرئيس الذي حمل الفكر الفلسفي في المغرب على إعادة التفكير، بجديةٍ، في مفهوم المثقف ووضعه المأزوم،
بحكم الدور الباهت الذي اضطلع به المثقفون في خلق تلك الأحداث وتوجيه مسارها[1]، ما دام التعرف إلى هذا المفهوم كان سليل اكتشاف متون الفكر الغربي الحديث والمعاصر، والتفاعل مع إشكالياته الفلسفية الكبرى.
يكفي الباحث أن ينتبه إلى مقدار حضور فكرة الالتزام، والمثقف العضوي، في كثيرٍ من متون الفكر الفلسفي في المغرب، حتى يدرك أن انفتاح هذا الفكر على ذلك المفهوم ارتبط بتشكله البنيوي وتعلق بأولى لحظات اكتشاف المنظومات الفكرية والفلسفية الغربية.
أتى تلقي مفهوم المثقف يُعبر عن مقدار القلق الذي انتاب الفكر الفلسفي المغربي لحظة تفاعله مع منظومات الفلسفة الغربية الحديثة، وعبَّر، بالقدر عينه، عن بعض الصعوبات التي رشحت على سطح احتضان الحقل الثقافي المغربي لكثيرٍ من المفاهيم الرئيسة الناظمة للعقل الحديث.
ترتبط أولى تلك الصعوبات بخصوصية مفهوم المثقف نفسه؛ إذ يدرك الباحثون أنه كان سليل العلاقة المتوترة التي ربطتْ، في التجربة الغربية الحديثة، المعرفة بالسلطة، وأن ظروفاً سياسية مخصوصةً هي التي عجلت بطرح السؤال عن ماهية المثقف ودوره[2]، ولا سيّما بعد تصاعد فكرة الالتزام التي سرعان ما قررت وظيفة اجتماعية للمثقفين على نحو ما لاحظ سارتر في هذا الباب[3].
يعني هذا القول، في جملة ما يعنيه، أن أي محاولة لاستقدام مفهوم المثقف إلى بيئة ثقافية أخرى، دونما إدراكٍ لشروط ميلاده ومقتضيات تكييفه، من شأنها أن تقود إلى اسقاطٍ للمفهوم لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية تكوينه التاريخي.
والمآل الذي انتهى إليه في سياق الفكر الغربي المعاصر، الذي أخضع المفهوم ذاك لكثير من النقد والمراجعة، وعبَّر من خلاله عن مقدار محايثة الممارسة الفلسفية للواقع والشرط الإنسانيين.
أما ثانية تلك الصعوبات فتتعلق بالسياق العام للتلقي المغربي لمفاهيم الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر؛ من المعلوم أن تعامل فلاسفتنا مع المنظومات الفكرية الغربية لم يكن محكوماً، فقط، بهاجسٍ أكاديمي صرف، بقدر ما كان مُوجهاً بأسئلة الراهن التي ما انفكت تفرض ذاتها على تأويلهم لتلك المنظومات.
لذلك يصعب أن ننظر إلى ما أنتجه هؤلاء بحسبانه مجرد ترويج لهذه المرجعية النظرية أو تلك، أو محاولةً لتعريف القارئ المغربي، والعربي، بالأفكار الفلسفية التي انتدبَ كل واحٍد من فلاسفة المغرب نفسه للدفاع عنها.
يقرأ المرء كتاب عبد الله العروي العرب والفكر التاريخي، فيدرك أن الأمر لا يتعلق بمجرد التعريف بالفكر التاريخاني كما تبلور عند كبار منظِّريه في السياق الغربي منذ هيغل، بقدر ما يروم صاحبه بلورة فهمٍ معقولٍ لوضعية التأخر التاريخي التي يعيشها الوطن العربي، معتبراً أن التاريخانية فلسفةٌ من شأنها أن تفيدنا في إدراك تلك الغاية وتحصيل أسباب مجاوزتها[4].
يمكن تعميم الملاحظة عينها على جل الذين احتلوا مجال الفكر الفلسفي في المغرب[5]، وقد ألقى ذلك بظلاله على تلقي مفهوم المثقف من طرف هؤلاء الذين استقدموا المفهوم وسعوا إلى إعماله في فهم راهنهم وتراثهم.
بل إن ما يعضد هذا الرأي علاقة المثقفين المغاربة بالحركة الوطنية المغربية، ولا سيَّما أن جل الذين استأنفوا القول الفلسفي في المغرب، أو أسهموا في تطويره، كانوا على صلةٍ برموز تلك الحركة لحظتئذٍ، بل وتفتَّق وعيهم على المطالبة بالاستقلال.
وما اقتضاه ذلك من تفكيرٍ جدي في مآل المجتمعات المستعمرة في ظل الوعي بتأخرها التاريخي، وبروز الحاجة إلى المثقف ودوره في توجيه العمل السياسي[6].
ويبدو أن استحضار مفهوم المثقف في الفلسفة المغربية المعاصرة اتخذ شكلين رئيسيين كانا سليلَي التداخل بين إشكالية العلاقة بين المعرفة والسلطة من جهة، وفكرة الالتزام من جهة ثانية.
فمن جهةٍ أولى، يمكن القول إنه بعد أن كتب فوكو ما كتبه عن مسألة العلاقة بين الحقيقة والسلطة، غدا من الصعب الإعراض عن مقدار حضورها في الثقافة العربية في الحاضر كما في الماضي.
كان من الطبيعي، والحال هاته، أن يتخذ مفهوم المثقف صورة أداةٍ مفهوميةٍ الغايةُ منها إضاءة عناصر تلك الإشكالية وتكوُّنها التاريخي؛ يحضر هذا بوضوحٍ عند كل من الجابري[7] وأومليل[8] وغيرهما من الباحثين الذين اهتموا بإشكالية المعرفة والسلطة في التجربة السياسية الإسلامية[9].
ولعله من الغني عن البيان القول إن ما رمى إليه هؤلاء هو فهم طبيعة تشكل قضية العلاقة بين الحقيقة والسلطة في التراث الإسلامي وتحدُّرها إلينا منه، بما يستلزمه ذلك من استحضارٍ للعوائق التي على مقتضاها استقامتْ علاقة المثقف بالسلطة في التراث العربي الإسلامي، وبمدى استمراريتها اليوم في تضاعيف الرؤية العامة التي يصدر عنها المثقف في تصوره للسلطة.
أما من جهة ثانية، فإن حضور مفهوم المثقف في الفلسفة المغربية اتخذ، في كثير من الأحيان، صورة نقدٍ لمعنى المثقف ودوره الممكن في ضوء الشروط الجديدة التي تمخضت عن مراجعة فكرة الالتزام، والوعي بتصدع الرأسمال الرمزي للمثقف، ممثـلاً بالمعرفة، في ظل الثورة المعلوماتية التي جعلت من المعرفة مسألةً عمومية،
وكذا في ظل الوعي بمحدودية الدور الرسولي والدعوي الذي بات المثقفون يطلعون به على نحو ما بين عبد الإله بلقزيز في هذا الباب[10].
قد يرى البعض في هذا النقد مجرد صدى لما عرفه مفهوم المثقف من مراجعة في كثير من متون الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، بحكم تصدع فكرة الالتزام نفسها، وإعادة النظر في مقولاتٍ شديدة الصلة بها، من قبيل مفهوم الطبقة، والعلاقة الميكانيكية بين البنية الاجتماعية والإنتاج الثقافي الرمزي.
بيد أن تحليل النقد الذي أقام عليه الخطاب الفلسفي في المغرب مقاربته لمفهوم المثقف من شأنه أن يكشف عن الدرب الفريدة التي شقها بأن أخضع ذلك المفهوم لمقتضيات شرطه السياسي والثقافي، وللإشكاليات الكبرى المنبثقة منه.
صحيح أن كثيراً من ملامح النقد المعاصر للمثقف تحضر في ما كتبه فلاسفة المغرب عن المثقف، بيد أن ذلك لا يمثل سبباً كافياً لوصف إنتاجهم النظري في هذا الباب بأنه مجرد صدى لنظيره الغربي.
تمثل هذه الصعوبات مقدمات رئيسية لفهم سهم الخطاب الفلسفي المغربي في التنظير لمسألة المثقف، طالما أننا نلفيها عند جل الذين كتبوا في الموضوع.
في هذا السياق النظري، تحديداً، كتب عبد الإله بلقزيز ما كتبه عن المثقف والمسألة الثقافية في الوطن العربي، ونحن نعتبر كتابه العمدة في هذا الشأن؛ نهاية الداعية[11]، عمـلاً دالاً على المسار النقدي الذي سلكته الفلسفة المغربية في مناولتها مفهوم المثقف.
بل إن ما يزيد ذلك العمل أهميةً انخراطُ صاحبه في التفكير في قضايا الفكر العربي وهمومه الكبرى؛ إذ هو صاحبُ سهم ٍكبيرٍ في تحليل قضايا الفكر العربي وإرساء دعائم مشروع نقدي يجيب عن أسئلته الكبرى انطلاقاً من اتصاله الشديد بالتراثين الإسلامي والغربي الحديث[12].
وعندي أن الجهد النظري الذي بذله بلقزيز في تحليل مفهوم المثقف يمكن أن يعتبر منطلقاً لفهم مسارات الفكر العربي الحديث والمعاصر، طالما أنه قارب المفهوم ذاك في ظل اتصاله بأبرز محاور الفكر العربي ولم يتردد في تحميل المثقفين العرب كثيراً من أسباب الإخفاق الذي عاشه الوعي العربي.
- أولاً: نهاية الداعية وأزمة المثقف
توجد، في المكتبة المغربية، كتبٌ اهتمت بمسألة المثقف، وقد نهل أصحابها من مرجعيات الفلسفة المعاصرة الشيء الكثير لفهم تشكلها التاريخي وتمفصلاتها الإشكالية[13]. بعضُ تلك المصنفات انصرف إلى التأريخ لكيفية تبلور فكرة المثقف في التجربة الأوروبية الحديثة، واصفاً الحيثيات السياسية والثقافية التي عجلتْ بميلاد المثقف وبصوْغِ إشكال العلاقة بين المعرفي والسياسي[14].
فأتى عمله في صورة وصفٍ لمسار الفكرة تلك في السياق الغربي، دونما احتفال بطبيعة حضورها في الفكر العربي والمفارقات التي يطرحها على المشتغلين به. في مقابل ذلك، انصرف بعضٌ آخر، من تلك المصنفات، إلى العناية بوضعية المثقف في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، انطلاقاً من الدور الذي يمكن، أو بالأحرى ينبغي، أن يطلع به في الإجابة عن أسئلة النهضة ورهاناتها.
كانت تلك حال عبد الله العروي الذي ألف، رأساً، أزمة المثقفين العرب[15]، وانبرى يعيب عليهم رسوخهم في نزعةٍ تقليديةٍ مجافية للحداثة التي ما انفك يدعو إلى استيعاب درسها، فكان من الطبيعي أن يعتبر أن «صلاح حالنا مرتبط بصلاح حال مثقفينا»[16].
والملاحظة عينها يمكن أن تقال عن عبد الإله بلقزيز الذي انتبه، منذ كتاباته الأولى، إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة والمثقف[17]، بحكم الأدوار التي يضطلعان بها في تحديد مسار النهضة والحداثة في الوطن العربي.
لم يكن اهتمام بلقزيز بالعامل الثقافي محض مصادفة؛ إذ بمقدار ما ينم تحليلُه للمسألة الثقافية عن وعيٍ بمحدودية المقاربات التي ارتكز عليها الوعي العربي في بناء تصوره لأسباب التأخر التاريخي وسبل الخروج من خندقه، كالتحليل الاقتصادي والسياسي[18]،
بمقدار ما يعني، كذلك، أهمية العامل الثقافي في تحديد فهمنا لكثيرٍ من مفاهيم الفكر الحديث المحورية، من قبيل مفهوم الديمقراطية والمواطنة والدولة والسلطة والسياسة[19].
ويبدو أن الانتباه إلى مركزية العامل الثقافي يُمثل مقدمةً رئيسيةً لفهم تلقي بلقزيز مفهوم المثقف واشتغاله عليه، في ظل شرطه التاريخي الذي انتدب نفسه لتحليل تمفصلاته والإجابة عن كثيرٍ من أسئلته. بذلك يكون اهتمام هذا المفكر بمفهوم المثقف محطة من مسار تفكيره في السؤال الذي شغل جل مساحات متنه النقدي؛ سؤال النهضة والحداثة في الفكر العربي المعاصر.
وسيكون من باب مجانبة الصواب النظر إلى مؤلفه نهاية الداعية من دون انتباه إلى ما يربطه بغيره من المؤلفات التي ضمنها تصوره للنهضة والحداثة، طالما أننا نعثر على كثيرٍ من تصوره ذاك في تحليله للممكن والممتنع في أدور المثقفين العرب، انطلاقاً من اعتبار المثقف المسؤول الرئيس عن إنتاج الوعي التاريخي المتحرر[20].
نقرأ لبلقزيز في هذا المعرض قوله؛ «تتزايد اليوم حاجة المثقفين العرب إلى التحرر الذاتي؛ التحرر من جملة القيود والعوائق الذاتية التي تقوم بينهم وبين أداء دورهم المعرفي الموضوعي والاجتماعي الإيجابي الفعال (…) وبغير هذا التحرر، لن يكون في وسع الوعي العربي أن يعيش التوازن النفسي الضروري الذي به يكون وعياً تاريخياً فاعـلاً»[21].
واضح، إذاً، أن بلقزيز لا ينأى، بمقاربته مسألة المثقف، عن هم التفكير في قضايا الفكر العربي المعاصر وتحصيل أسباب النهضة والحداثة. وواضحٌ، كذلك، أن في تحليله وضعية المثقفين العرب كثيراً من عناصر تصوره لأعطاب الوعي العربي ومكامن الخلل في مسار النهضة العربية.
ليس نهاية الداعية كغيره من الكتب التي عقدها أصحابها في مضمار التفكير في المثقف ووضعه في الوطن العربي؛ فهو ليس عرضاً لنظريات الفلاسفة، غرباً أو عرباً، في هذا الشأن؛ ولا هو مقالةٌ في علاقة المعرفة بالسلطة التي استبدت باهتمام غالبية الباحثين المغاربة.
بل هو، بالأحرى، بحثٌ في ما تبقى للمثقف من دورٍ يضطلعُ به بعد الرجّات العنيفة التي زحزحت موقعه في العالم، وعجلتْ بطرح كثيرٍ من التساؤلات عن مقدار الحاجة إليه في ظل تصدع صورته.
وعلى مثال العروي الذي أسهب في توصيف أزمة المثقف العربي ورصد وضعه المفارق في مجتمع تقليدي، انصرف بلقزيز إلى بيان الأسباب الاجتماعية (التحتية) التي كرست، في ذهن ذلك المثقف، وظيفة خدمة قضايا الشعب والجماهير التي هيأها له مجتمعه الفقير والأمي والمقهور[22].
غير أنه لم يكتفِ برصد سهم تلك الأسباب والتماس العذر للمثقف العربي على نزعته التقليدية ومجافاته الواقع الاجتماعي الذي يتبجح بالتعبير عن همومه وقضاياه، بل أراد لمصنَّفه ذاك أن يكون نقداً ذاتياً آنَ للمثقف العربي أن يمارسه على نفسه، من أجل فضح الأوهام الكبرى التي ما انفكت تكبِّل وعيه وتسوغ، في وجدانه، دور الداعية الذي درَّب نفسه على إتقانه.
عاب بلقزيز على المثقفين العرب إثخانَهم في منزعٍ دعويٍ يضرب بجذوره في تاريخ تصورنا الحقيقة المطلقة، وما ترتب عليه من إيمانٍ بدورهم الرسولي والخلاصي[23]. ليس بالعسير على الباحث أن ينقب لذلك الدور عن جذور في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية،
ولا سيَّما عند كثيرٍ من الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم في منزلة ورثة الأنبياء[24]، وممثلي السلطة الثقافية[25]، الناهضين بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[26].
لم تكن مصادفة، والحال هاته، أن يجد الدور الرسولي للمثقف سنداً تاريخياً وثقافياً أقام عليه مشروعية وجوده في الثقافة العربية المعاصرة، واستوت، على مقتضاه، أساطير وأوهامٌ عدها بلقزيز في جملة العوائق الذاتية التي تعترض إنتاج الوعي العربي.
بل ولم يتردد في إخضاع عمل المثقفين الفكري لمقولات التحليل النفسي قصدَ الوقوف على العوائق غير الواعية التي ما انفكت تصنع وعيَهم،
معتقداً أن من يُدقق النظر في إنتاجهم النظري يَلحظُ وجودَ بعض الظواهر التي يُمكن عدُّها ضمن الأمراض والاضطرابات النفسية[27]، من نرجسيةٍ، وساديةٍ، ومازوشية، وفوبيائية مرضية[28].
كان لهذه الظواهر المرضية وقعُها الكبيرُ على وعي المثقفين العرب، وزاد وضعهَم تعقيداً ما طال رأسمالهم الرمزي (المعرفي) من تهميشٍ من طرف السلطان كما من طرف الجمهور[29]؛ إذ لم يعد المطلوبُ من المثقف، بالنسبة إلى السلطة السياسية، قولَ الحقيقة أو ترشيد عمل السياسي، بل أن يلزم الصمت، فباتت الفجوة الفاصلة بينهما غير قابلة للجسر.
وما كانتْ حالُه مع الجمهور أفضل من سابقتها مع السلطان، إذ لم تعد معرفته في جملة الأمور المطلوبة من طرف جمهوره الأمي، ولم يكل إليه أحدٌ، من ذلك الجمهور، مهمة التعبير والدفاع عن مصالحه وتغيير العالم من أجله[30].
بل إن ما زاد الفجوة بين خطاب المثقف العربي والجمهور عمقاً هو اتساعُ الثقب الاستراتيجي الفاصل بين خطابه ووعي الجماهير على نحوٍ يعيدُ إلى الأذهان الجدلية الكلاسيكية بين النخبة والعامة.
إن رصد هذه الأعطاب الذاتية في عمل المثقف كان كافياً لدفع بلقزيز إلى الاعتراف بمحدودية الدور الذي يمكن أن يلعبه في النهوض بالمهمة التي سطرها له ماركس من قبل؛ مهمة تغيير العالم بدلاً من الاكتفاء بفهمه وتفسيره.
فهل يمكن أن نقرأ في ذلك اعترافاً جهيراً بنهاية المثقف وانتفاء الحاجة إليه؟ وبأي معنى يكون وضع المثقف وضعاً مأزوماً يحتاج إلى نوعٍ من النقد الذاتي قصد تحرير عملية إنتاج الوعي من مظاهرها المرضية؟ وهل ما يزال للمثقف دور يضطلع به؟
- المصدر:
نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 452.
نبيل فـازيـو: باحث مغربي في فلسفة الدراسات الإسلامية.