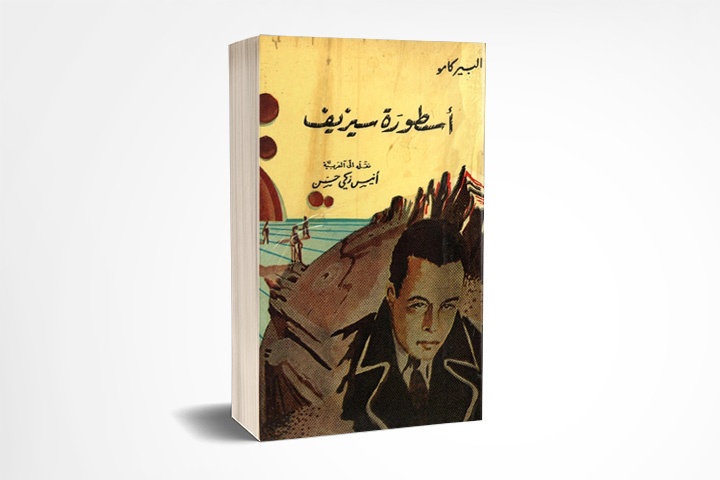قُرئت هذه الورقة في أيار 1968 في اجتماعات القسم الغربي من رابطة الفلاسفة الأمريكيين ضمن ندوة حول موضوع، الفلاسفة ودورهم في الحياة العامة.
لقد واجهت صعوبة استثنائية في الكتابة عن هذا الموضوع، لجملةٍ من الأسباب. ربما كان مفيداً أن نبدأ بالكلام عن بعض هذه الصعوبات، تمهيداُ للنقاش، بالرغم من أنني سأجد نفسي مضطراً للإطالة بعض الشيء.
تكمن المشكلة الأولى في مقاربتي لموضوع الندوة أنني أعتمد على مقدماتٍ متعددة بحاجة هي الأخرى للنقاش والتعليل، مع التسليم بأن هذا المكان ليس مناسباً للاستفاضة بشأنها. حري بتعليقي حول المسألة أن يستند، بالطبع، على تأويلٍ معينٍ للسياق الذي تطرح فيه أسئلة السياسة العامة في الولايات المتحدة في هذه اللحظة التاريخية المحددة، وهذا التأويل مثير للجدل.
إلا أنه لن يكون بوسعي شرحه في سياق هذه الندوة، وإنما فقط صياغته بوضوح كمنطلقٍ لمعالجتي للموضوع. إحدى المقدّمات هي أن البلد يواجه أزمةً خطيرةً، وبسبب الدور العالمي الذي نلعبه، تغدو أزمتنا أزمة العالم برمته. أصبحت الولايات المتحدة على نحوٍ متزايدٍ وكيلاً للقمع و”مموّلاً بقفاز أبيض للثورات المضادة” – حسب تعبير هاورد زن – حول العالم (١).
إنها، حسب كل المعايير الموضوعية التي أستطيع تصورها، الدولة الأكثر عدوانيةً في العالم، وأكبر تهديدٍ للسلم العالمي، ولا مثيل لها كمنبعٍ للعنف. يتخذ هذا العنف شكلاً علنياً أحياناً، ولا أرى حاجة للاستفاضة حول سلوكنا في فيتنام. أحياناً أخرى يتخذ هذا العنف طابعاً أقل خشونةً، العنف المفروض حالياً؛ الرعب الصامت اللامحدود الذي قمنا بفرضه على مناطق واسعةً تقع تحت سيطرتنا أو تأثيرنا.
لن يقبل الأميركيون هذه الحقيقة بشكل أكبر مما قبلها الألمان واليابانيون قبل ثلاثين عاماً. غير أن التحليل الموضوعي لا يسمح بتقييمٍ مختلفٍ برأيي. إذا فكرنا بما نفعله: بالحكومات التي حافظت على سلطتها بالقوة، أو تمت الإطاحة بها عن طريق التدمير أو التآمر، أو الاستعداد لاستخدام أدوات الفتك الأكثر رعباً على مر التاريخ لفرض إرادتنا، أو الوسائل المستخدمة لذلك.
أي القصف الجوي العنيف التمهيدي في المعارك، وضرب مناطق بأكملها بوصفها معادية لنا، والنابالم والأسلحة المضادة للأفراد، والحرب الكيمياوية؛ تتراءى لي بالتالي خلاصةٌ واحدة: ليس ثمة منافسٌ لنا اليوم في العنف الإجرامي العالمي.
علاوةً على ذلك ثمة أزمة داخلية خطيرة. مرةً أخرى لا أجد حاجةً للحديث عن مشاكل الفقر والعنصرية، فهي بالغة الوضوح. لكن ما يستحق التوقف عنده هو رد فعلنا حيال البؤس الذي نتسبب فيه. لعل أكثر ما يعبر عن ذلك هو المناهضة المتنامية للحرب في فيتنام.
لا يخفى على أحدٍ بأن الحرب لا تتمتع بأدنى درجةٍ من الشعبية. كما أنه ليس سراً بأن مناهضة الحرب تستند أساساً على كلفتها. إنها “مناهضةٌ عمليةٌ” تحرضها حسابات الكلفة والمنفعة. كثير ممن هم الأكثر صخباً في رفضهم للحرب اليوم يصرحون – أو بالأحرى ينادون – بأن معارضتهم كانت لتتوقف في حالِ تكللت محاولتنا للسيطرة على المجتمع الفيتنامي بالنجاح.
في تلك الحالة، وحسب تعبير أحد ممثليهم، سنقوم “جميعنا بتوجيه التحية لحكمة وحنكة الحكومة الأمريكية” (أرثر سليسنجر)، على الرغم من كونه أول من أشار إلى أننا نحول فيتنام إلى “أرض خربة ومدمرة.” (٢) تَعتبِر هذه المناهضة العملية أنه يتوجب علينا “اتخاذ موقفٍ داعمٍ” حيث تتوفر إمكانياتٌ أعظمُ للنجاح، وتعتبر فيتنام قضيةً خاسرةً، ولهذا السبب، يتعين علينا تعديل مساعينا أو التخلي عنها.
لا أنوي الخوض في المسألة الآن، بل أريد صياغة مقدمة ثانية فقط من شأنها أن تكون منطلقاً في نقاشي لموضوع هذا اللقاء: إن شيوع هذا الموقف العملي تجاه الحرب في فيتنام هو علامة انحطاطٍ أخلاقيٍ بالغ الشدة، يصبح معه الحديث عن اللجوء لقنوات الاحتجاج والمعارضة الاعتيادية بلا أي معنىً، وتمسي فيه أشكال المقاومة المتعددة هي الأنسب للعمل السياسي للمواطن المعني بالأمر.
ليس ثمة ما يؤكد هذا الرأي، باعتقادي، أكثر من التغيير الذي طرأ على المناخ السياسي الداخلي مؤخراً، والذي أخذ بعداً درامياً بإعلان الرئيس تخليه عن السعي لتجديد انتخابه. سيرى المعلقون السياسيون في هذا الحدث دليلاً على تمتع نظامنا السياسي بالفعالية والعافية بالرغم من كل شيء. ما فعلته الحكومة، في الواقع.
وباستخدام تعبير برلماني، هو الاستقالة في مواجهة انهيار خططها للحرب وأزمةٍ اقتصاديةٍ عالميةٍ ونزاعاتٍ داخليةٍ تنذر بالأسوأ. يُظهر هذا مدى عافية نظامنا الديمقراطي فعلياً. قياساً على هذا، يبدو نظام اليابان الفاشي قبل ثلاثين عاماً أكثر ديمقراطيةً، حيث سقط ما يزيد عن دزينة من الحكومات في ظروفٍ مشابهة.
كان حريٌ بنا تغيير سياستنا بناءً على إدراكنا لخطئها، لا لفشلها، لإظهار عافية نظامنا؛ أي أن ندرك أن نجاح سياسةٍ كهذه سيكون مأساوياً. إن الوعي السياسي الأمريكي أبعد ما يكون عن هذا. على العكس، يُنظر إلى استبعاد الاعتبارات الأخلاقية على أنها نتاج لعبقرية السياسة الأمريكية الفذة.
بالتالي، لَكَمْ هو طبيعيٌ وحسنٌ أن يكون قرار تدمير بلدٍ آخرٍ، وتشريد أهله من قراهم، وإجراء التجارب مع “التحكم ومراقبة الموارد المادية والبشرية” لإرضاء “منظّري التهدئة”، مرتبطاً باعتبارات الكلفة والمنفعة البراغماتية فحسب.
حطمت التكنولوجيا الأميركية ثلاث دول آسيوية مغلوبة على أمرها خلال جيلٍ واحدٍ. علينا حفر هذه الحقيقة في وعي كل أمريكي. يعيش من لا يُشكل هذا الإدراك هاجساً له في عالمٍ من الوهم. لكننا كأمةٍ لم نتعلم مواجهة هذه الحقيقة المركزية في التاريخ المعاصر.
لقد جرى التدمير المنهجي لليابان، الأعزل عملياً، وكأننا نتصرف وفقاً لما يلميه الصواب الأخلاقي، ولم يتم في حينه، ولا إلى يومنا، الطعن في هذا، حتى من بعيد. في الواقع، قام وزير الحرب آنذاك، هنري ستيمسون، بالتصريح بأنه لا بد من وجود خلل ما في أمةٍ بوسعها الاستماع برباطة جأشٍ إلى أخبار القصف المروع للمدن اليابانية.
كان لشكوكه هذه أصداء محدودةٌ – تم التعبير عنها قبل استخدام القنبلتين الذريتين، وقبل الوصول إلى المشهد الختامي، الذي طلب الإذن بتنفيذه الجنرال أرنولد وأقرته واشنطن، حين أغارت ألف طائرة على وسط اليابان بعد إعلان استسلامها لكن قبيل استلام الإعلان بشكل رسمي؛ وقد ترافق إلقاء القنابل مع الأخبار التي تعلن استسلام اليابان بحسب شهادات الضحايا.
أعيدت الكرّة في كوريا، مع القليل من تأنيب الضمير. بينما أجبرتنا المقاومة الفيتنامية المذهلة على التساؤل: ماذا فعلنا؟ ليس ثمة شكٌ بأنه لو قُدِرَ لهذه المقاومة الانهيار فسيتخفي معها الغليان الداخلي بشأن الحرب.
تدفع حقائقٌ كهذه، وتفاصيل كثيرة أخرى إيرادها يسير للغاية، إلى التساؤل فيما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى حركة احتجاج أم إلى تطهيرٍ من النازية. يحتمل هذا السؤال الجدل، وقد يختلف حوله العقلاء. غير أن مجرد حقيقة إثارته للجدل هي مأساةٌ بحد ذاتها.
أعتقد شخصياً أننا بحاجة إلى نوعٍ من التطهير من النازية. ليس ثمة قوةٌ أكبر منا لتحاسبنا بالطبع. على التغيير أن يأتي من الداخل. سيعتمد مصير ملايين الفقراء والمضطهدين حول العالم على قدرتنا على تحقيق “ثورةٍ ثقافيةٍ” عميقةٍ في الولايات المتحدة.
قد يُجادل البعض بأنه من السذاجة مناقشة الوعي السياسي والأخلاقي كما لو أنهما ليسا مجرد تجلٍ سطحيٍ للمؤسسات الاجتماعية ولبنية السلطة، وبأنه مهما كانت آراء ومشاعر ومعتقدات الفرد الأمريكي، فإن النظام الأمريكي سيستمر بمحاولة الهيمنة على العالم عن طريق القوة. يحمل القسم الأخير من هذا الطرح الاستدلالي كثيراً من الوجاهة. لا تشكل الحرب في فيتنام سابقة في التاريخ.
إنها، على سبيل المثال، تحاكي بشكلٍ مؤلمٍ مغامرتنا الاستعمارية في الفلبين قبل سبعين عاماً. كما أنها، علاوةً على ذلك، تنطوي على تشابه كبير مع فصول أخرى من تاريخ الاستعمار؛ كما حصل مع محاولة اليابان الدفاع عن استقلال مانشوكو (٣) ضد “التهديد الشيوعي” الآتي من روسيا و”قطاع الطرق الصينيين.” مع ذلك، يصعب التسليم بأن “التناقضات الداخلية” للمجتمع الأمريكي ستؤدي إلى انهياره ما لم يمض قُدماً في السيطرة على العالم.
لقد قامت العقيدة القائلة بأن “ديمومة النظام الأمريكي في أمريكا مرهونة بتحوله لنظام عالمي” – حسب تعبير الرئيس ترومان عام 1947 – بتوجيه سياستنا الدولية لسنواتٍ عديدةٍ بالفعل، تماماً كما فعلت العقيدة الأخرى، المصرح بها من قبل الليبراليين والمحافظين على حد سواء، بأن القدرة على الولوج إلى فرص الاستثمار وإلى الأسواق الآخذة بالاتساع ضرورية لديمومة طريقة الحياة الأمريكية.
تحمل هذه الأيديولوجية في طياتها الكثير من الخرافة من دون شك. وعلى أي حال، هذا سؤالٌ أكاديميٌ إلى حدٍ ما. سيكون علينا سواءٌ اعتزمنا الإصلاح أو الثورة اتخاذ نفس الخطوات في البداية: محاولة تغيير الوعي السياسي والأخلاقي وصياغة أشكال مؤسساتية بديلة تمثل وتدعم هذا التطور. أعتقد شخصياً، ومن منظور محدد، بأن أزمتنا الراهنة هي أزمةٌ أخلاقيةٌ وفكريةٌ أكثر مما هي أزمةٌ مؤسساتية، ويستطيع العقل والمقاومة أن يسلكا درباً معيناً، ربما يكون طويلاً، في اتجاه إصلاحها.
تبدو لي هذه الاعتبارات – والتي لم أسعَ لتبريرها وإنما لصياغتها فحسب – قادرةً على خلق الإطار الذي يتوجب من خلاله على الأمريكي أن يسأل نفسه عن مسؤولياته كمواطن. ثمة الكثير ليقال في هذا الصدد، وأكثر من ذلك ما ينبغي عمله.
إلا أنه ليس السؤال المطروح في هذه الجلسة، وهنا بشكل رئيس تكمن المصاعب التي أشرت إليها في البداية؛ أي محاولة نقاش الموضوع الأضيق وهو الفلاسفة والسياسة العامة. في وقت نشن فيه حرباً يتعذر وصف وحشيتها على فيتنام، لصالح الفيتناميين بالطبع، مثلما لم يكن اليابانيون يسعون إلا لخلق جنةٍ على الأرض في مانشوكو، وفي وقت نحضِّر وندير جزئياً “حروباً محدودة” في الداخل والخارج.
في وقت يواجه فيه آلاف الشباب، كثير منهم طلابنا، عقوبة السجن أو النفي السياسي بسبب رفضهم الأخلاقي لأن يكونوا وكلاء للعنف الإجرامي، في وقت ندفع فيه العالم مرة أخرى إلى شفير الحرب الذرية، من الصعب في وقت كهذا أن يقيد المرء نفسه بالسؤال الأضيق: ما هي مسؤولية المرء كفيلسوف؟ غير أني سأحاول الإجابة على السؤال.
أعتقد بأنه من الممكن بناء حجةٍ معقولةٍ تَخلُص إلى أنه ليس على المرء، كفيلسوف، أية مسؤولية خاصة تتعلق باتخاذ موقف حول مسائل السياسة العامة، مهما تكن واجباته كمواطن. يمكن صياغة هذه الحجة على الشكل التالي: الاعتقاد بوجود مسؤوليةٍ خاصةٍ على عاتق الفلاسفة فيما يخص هذا الموضوع يوحي بأحد أمرين، إما حيازتهم على مؤهلٍ فريدٍ للتعامل مع المشاكل التي تواجهنا، أو بأن الآخرين – مثل المختصين في علوم الأحياء أو الرياضيات – يتمتعون بقدرٍ من الحرية لتجاهل هذه المشاكل.
إلا أن كلا هذين الاستنتاجين خاطئين. ليس ثمة مؤهلٌ خاصٌ بوسع المرء أن يتحصل عليه خلال مرانه المهني كفيلسوف للتعامل مع مشاكل القمع الدولي والداخلي، أو، بشكل أعم، مع نقد وتطبيقات السياسة العامة. بالمثل، من العبث الادِّعاء أن بإمكان المختصين في علوم الأحياء أو الرياضيات تجاهل هذه المشاكل بحريةٍ بحجة أن غيرهم يتمتع بالمعرفة التقنية ويتحمل المسؤولية الأخلاقية لمواجهتها.
في اختصاصه، ليس ثمة واجبٌ على المرء سوى أداء عمله بنزاهة. تتطلب النزاهة، الشخصية والمعرفية على حد سواء، التصدي للأسئلة التي تظهر ضمن بعض مجالات الدراسة من داخل هذه المجالات، تلك المتموضعة على حدود البحث والتي تعد بدفع البحث عن الحقيقة والفهم قدماً. من شأن السماح للعوامل الخارجية بتحديد سير البحث أن يؤدي إلى التضحية بهذه النزاهة.
سيشكل هذا نوعاً من “تدمير المعرفة.” المساهمة الأبرز التي يستطيع الفرد القيام بها للوصول إلى مجتمعٍ أفضل تكمن في تأسيس مهنته على التزامٍ حقيقيٍ بالقيم المهمة، كتلك التي ترتكز عليها المعرفة الرصينة أو العمل العلمي في جميع المجالات. لكن هذا يتطلب منه كمختص أن يلتزم بمجاله.
أعتقد بأن هذا الرأي يتمتع بالكثير من الصحة. ليس لدي شكٌ بأن من كانوا يعملون في معهد غوته، المحاذي لمعسكر اعتقال داخاو (٤) النازي، وجدوا في اعتباراتٍ كهذه مبرراً لصمتهم. ما كنت لأجادل في صحة الآراء هذه قبل سنتين أو ثلاث، كما أنها لا تزال مقنعةً اليوم على ما يبدو.
بالطبع هنالك رأيٌ معاكسٌ واضحٌ، ألا وهو: يتعين على المرء خلال الأزمات أن يتخلى عن، أو أن يقيد على أقل تقدير، الاهتمامات والنشاطات المهنية التي لا تكيف نفسها بطريقة طبيعية للوصول لحل للأزمة. يتسق هذا مع الرأي الأول في الحقيقة؛ وباعتقادي، من الممكن تلخيص المسألة بأكملها في هذا الاتساق.
أعتقد بأن هذا كل ما في الأمر للعديد من المختصين في مجالات أخرى أيضاً. على سبيل المثال، لا أجد أية طريقة لجعل أبحاثي، كعالم لسانيات، مرتبطةً بمشاكل المجتمع المحلي والعالمي بأي معنىً جديٍ. الصلة الوحيدة بالموضوع بعيدةٌ وغير مباشرة، وهي عبر الفهم الذي قد يضيفه عملٌ كهذا إلى فهم طبيعة الذكاء البشري. غير أنه سيكون من النفاق الأخذ بتلك الصلة بوصفها “ارتباطاً وثيقاً”. الحل الوحيد لهذه الحالة من وجهة نظري يكمن في وجودٍ شيزوفريني يبدو لي مُلزِمَاً أخلاقياً، وليس مستحيل التحقيق عملياً.
إلا أن الفلاسفة قد يتمتعون بوضع أفضل من غيرهم إلى حد ما. ليس ثمة مجال آخر بمقدوره الادعاء بأن تركيزه منصبٌ بأصالة على الثقافة الفكرية للمجتمع أو بأنه يملك الأدوات لتحليل الأيديولوجيا ونقد المعرفة الاجتماعية واستخدامها أكثر منهم. إذا صح اعتبار أن أزمة أميركا والعالم أزمةٌ ثقافيةٌ جزئياً، فقد يكون للتحليل الفلسفي مساهمةٌ محددةٌ يضطلع بها. اسمحوا لي بفحص بعض الحالات ذات الصلة.
يقف مجتمعنا بخشوعٍ في حضرة “الخبرة التقنية”، ويُسبِغُ على من يدَّعيها هيبةً عظيمةً وحرية تصرفٍ كبيرةٍ. في الواقع، هناك اعتقادٌ واسع الانتشار بأننا في طريقنا لأن نصبح أول “مجتمع ما بعد صناعي”، يكون فيه الخبير التقني، أو حتى العالِم، هو الشخصية الأبرز وليس رجل الأعمال؛ أي هؤلاء الذين يبدعون ويطبّقون المعرفة التي تشكل لأول مرةٍ في التاريخ قوة الدفع الرئيسة للتقدم الاجتماعي.
حسب هذا الرأي، ستلعب الجامعة ومؤسسة الأبحاث دور “العين الخلاقة،” والمؤسسة المركزية في هذا المجتمع الجديد؛ وسيكون الأكاديمي المختص هو “الرجل الجديد”، حيث تسيطر قيمه ويكون هو نفسه في مركز القوة أو على مقربةٍ منها.
يتطلع كثيرون إلى هذا الاحتمال بأملٍ كبير، لكني لست واحداً منهم. يبدو لي هذا الاحتمال عديم الجاذبية ومحفوفاً بالكثير من المخاطر. أحد أسباب خلافي معهم هو افتراضهم المشكوك بصحته أن الدولة تستطيع أن تكون مصدراً للحراك الاجتماعي.
أكثر من ذلك، ما هو السبب الذي يدفع للاعتقاد بأن من تشكل المعرفة والبراعة التقنية – أو ادعاءهما على أقل تقدير – أساس مطالبته بالسلطة سيكون أكثر إنسانيةً وعدالةً في ممارستها ممن تشكل الثروة والامتياز الأرستقراطي أساس مطالبتهم بها؟ على العكس تماماً، للمرء أن يتوقع أن يكون مثل هذا الشخص متعجرفاً ومتعنتاً وغير قادرٍ على الاعتراف بالفشل أو على التكيف معه، لأن من شأن الفشل أن يُضعف مطالبته بالسلطة.
فلنأخذ في الحسبان أوضح نموذج، أي حرب فيتنام التي خطط لها بدرجة كبيرة السلالة الجديدة من “مثقفي الفعل”، والتي تُظهِر جميع هذه الصفات.
بالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي توقع أن تبني أي مجموعةٍ تتمتع بمنفذ إلى السلطة أيديولوجيا تبرر هيمنتها على أساس الرفاه العام. يغدو الخطر أكبر مما كان عليه في السابق حين تتوق النخبة الفكرية للحصول على السلطة، وذلك لأن بإمكانهم الاستفادة من هيبة العلم والتقنية، بينما سيفقدون في ذات الوقت دورهم كنقاد اجتماعيين بسبب انصرافهم إلى آليات السيطرة.
لعل أهم أدوار المثقف، منذ عصر التنوير، يكمن في كشف حقيقة الأيديولوجيات، وإماطة اللثام عن الظلم والقمع الموجود في كل المجتمعات التي نعرفها، والبحث عن سبل لإقامة صيغةٍ جديدةٍ أكثر سمواً للحياة الاجتماعية من شأنها أن توسع الإمكانيات لحياة حرة وخلاقة. نستطيع أن نتوقع بكل ثقةٍ إهمال هذا الدور حين يصبح المثقف مديراً لمجتمع جديد.
تكاد لا تأتي هذه الملاحظات بأي جديد. ما أفعله ببساطة هو إعادة صياغة نقدٍ فوضويٍ كلاسيكيٍ عادة ما يطرح الأمر كالتالي:
يقول باكونين في معرض تعليقه على المذهب الماركسي:
حسب نظرية السيد ماركس، على الناس العاديين ألا يكتفوا بعدم القضاء عليها [الدولة] فحسب، بل يجب أن يعملوا على تقويتها ووضعها تحت التصرف الكامل للمحسنين وأولياء الأمور والمعلمين، أي قادة الحزب الشيوعي، تحديداً السيد ماركس وأصدقائه، الذين سيمضون قدماً في تحرير [البشرية] على طريقتهم الخاصة.
سيعملون على تولية زمام الحكم ليدٍ قويةٍ، لأن الناس الجهلاء بحاجةٍ لوصايةٍ فائقة الحزم؛ سيؤسسون مصرفاً واحداً تابعاً للدولة يجمع بين يديه كل عمليات الإنتاج التجارية والصناعية والزراعية وحتى العلمية منها، وبعدها سيقسمون الجماهير إلى جيشين -صناعيٍ وزراعيٍ- تحت الإمرة المباشرة لمهندسي الدولة، الذين سيشكلون طبقة علمية-سياسية جديدة متمتعةً بالامتيازات (٥).
أو لننظر إلى ملاحظات المؤرخ الفوضوي رودولف روكر الأكثر عمومية:
لا تنشأ الحقوق السياسية في البرلمانات، بل تُفرض عليها بالأحرى من خارجها. ولوقتٍ طويلٍ، لم يكن تشريع الحقوق كقوانين كفيلاً بحمايتها. لا توجد الحقوق بفضل تدوينها بشكلٍ قانونيٍ على قطعةٍ من الورق، إنما فقط حين تغدو عادة محفورة عند الناس، وعندما تواجَه أي محاولة لإضعافها بمقاومةٍ عنيفةٍ من قِبَلِ الجماهير.
إن لم تتحقق هذه الوضعية فلن تجدي نفعاً المعارضة البرلمانية أو أي مطالبة أفلاطونية للاحتكام إلى الدستور. يفرض المرء احترامه على الآخرين حين يعرف كيف يدافع عن كرامته كإنسان. لا ينطبق هذا على الحياة الشخصية فحسب، بل على الحياة السياسية أيضاً (٦).
لطالما أظهر التاريخ دقة هذا التحليل، أكان حول دور النخبة الفكرية أو حول طبيعة الحقوق السياسية، كائناً من كان في سدة الحكم. ليس ثمة ما يدفعني لتوقع أن يظهر المستقبل خلاف ذلك.
إن كان صحيحاً أن المجتمع “ما بعد الصناعي” الجديد سيتميز بوصول النخبة الفكرية إلى السلطة، مستندةً في مطالبتها بها على تكنولوجيا مفترضة للإدارة الاجتماعية “خالية من القيم”، فستغدو أهمية الناقد الاجتماعي جوهرية أكثر مما كانت عليه في السابق. يتعين على هذا الناقد أن يكون قادراً على تحليل محتوى “الخبرة” المزعومة، بالإضافة إلى مسوغها التجريبي ونفعها الاجتماعي.
هذه أسئلةٌ نموذجيةٌ في الفلسفة. من الممكن الاستفادة من نفس المقاربة التحليلية التي تسعى لسبر طبيعة النظريات العلمية بشكل عام أو بنية مجال معرفي محدد أو مفهوم الفعل البشري لدراسة تكنولوجيا السيطرة والاستغلال التي تُقدم تحت عنوان “العلوم السلوكية” والتي تشكل أساس أيديولوجية “كبار الموظفين الجدد”.
علاوةً على ذلك، وفي المستقبل المنظور، ستكون لهذه المهمة أهميةٌ إنسانيةٌ أعظم من استقصاء أسس الفيزياء أو إمكانية اختزال الحالات العقلية إلى حالات دماغية – أسئلة لا أنوي التقليل من شأنها عرضاً؛ آملُ أن يكون ذلك واضحاً بما فيه الكفاية.
أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الجامعات بتأمين إطار عملٍ لمهمة حساسة من هذا النوع. تتعدى هذه المسألةُ تماماً السياسةَ بمعناها الضيق. هناك أخطار متأصلة في قضايا التخصص والتأهيل الاحترافي في بينة الجامعات، لا تحظى باهتمام كاف. حين يغدو المجال احترافياً فعلاً، يظهر ميلٌ لتحديد المشاكل التي تُناقش بدرجة كبيرة من خلال توفر أدواتٍ معينةٍ جرى تطويرها مع نضج الموضوع، وبدرجةٍ أقل لاعتباراتٍ تحفزها مشاكل أخرى أكثر جوهرية للفرع المعني نفسه.
ليست الفلسفة خالية من هذا الميل، بالطبع. لدرجة ما، ليس هذا حتمياً فحسب، بل أساسي للتقدم العلمي كذلك. إلا أنه من المهم إيجاد طريقةٍ، تستهدف التدريس أكثر من البحث نفسه، تجعل بعض الأسئلة تستحق المتابعة دوناً عن غيرها، بحيث يوجّه العمل المجدي والمنتج في لحظة بناء على صلته بالشأن العام.
من السهل إيراد أمثلةٍ تُظهر تشوه بعض المجالات بسبب فشلها في مراعاة وجهة النظر هذه. على سبيل المثال، أعتقد أن تجاهل أفكار تجريبية معينةٍ، بسيطة ومفيدة للغاية، في سيكولوجية التعليم، سبب ضرراً لهذا الفرع على المدى الطويل.
أعتقد بأن طالب الدراسات العليا في جُل الفروع الأكاديمية سيستفيد للغاية من تجربة الدفاع عن أهمية العمل الذي ينخرط فيه، ومن مواجهة تحدي وجهة النظر والنقد اللذان لا يُقرَّانِ تلقائياً بفرضيات وقيود الفرع ذاته؛ ولكن قلما تتيح أي من البرامج الأكاديمية مثل هذه التجربة. أعلم أن طرحي يتخذ طابعاً تجريدياً مكثفاً، إلا أني أعتقد أن الفكرة واضحة، كما أعتقد أنها تشير إلى خلل يصيب كثيراً من التعليم الجامعي.
من الممكن لهذا الخلل أن يغدو كارثةً في حالة علوم الاجتماع والسلوك في “مجتمع ما بعد صناعي” على وجه الخصوص، حيث تشكل الجامعة مؤسسةً مركزيةً للبحث والسلطة. بإيجاز، تتطلب الجامعة ضميراً متحرراً من القيود الضمنية التي تفرضها أية صلةٍ بأجهزة السلطة، ومتحرراً من فكرة لعب أي دور يُعنى بتشكيل وتطبيق السياسة العامة.
أعتقد بأن على كل جامعةٍ رصينةٍ أن تفكر بكيفية استحداث برنامج للبحث الاجتماعي الجذري يضطلع بفحص فرضيات السياسة العامة وبمحاولة إجراء تحليلٍ نقديٍ للأيديولوجية السائدة. لعله من الأفضل لهذا البرنامج ألا يحظى بقسمٍ مستقلٍ، بل عليه بالأحرى أن يسعى إلى أكبر انخراطٍ ممكنٍ بالنقد الاجتماعي الشامل في الأقسام المختلفة ومن أولئك المهتمين بهذا النقد. يشكل برنامج من هذا النوع استمرارية طبيعية وقيّمة لاهتمام الفلاسفة بتحليل المفاهيم.
أريد أن أؤكد مرةً أخرى بأن المسألة تتعدى السياسة بمعناها الضيق. أعتقد بأن تطبيق العلوم السلوكية في التعليم أو العلاج النفسي، من باب الاكتفاء بمثالين ليس إلا، بحاجةٍ ماسةٍ للتحليل النقدي يساوي بأهميته تحليل تطبيقات مكافحة التمرد.
وكذلك أعتقد بأن الافتراضات والقيم الكامنة وراء برنامج الفقر أو التجديد الحضري تستحق ذات الدرجة من التحليل الرصين كتلك التي تكمن وراء الدبلوماسية المناوِرة في حقبة ما بعد الحرب. من اليسير إيراد العديد من الأمثلة الأخرى.
في هكذا تكنوقراطية ليبرالية كالتي يرجح أن ننتهي إليها، قد يكون الاضطهاد مستتراً كما قد تكون أساليب السيطرة أكثر “تطوراً”. من الممكن لأيديولوجية قسرية جديدة تنادي بقيم الإنسانوية و”الأخلاق العلمية”، أن تصبح بمثابة ملكيةٍ فكريةٍ للنخبة الفكرية التقنية التي تكون الجامعة مركزها، غير أنها تتحرك بحرية ويسر نحو الحكومة والمؤسسات.
من شأن التجزئة والاحترافية اللتان ترافقان تلاشي “المفكر العام”، الذي قيل لنا بأنه من بقايا عهد بائد للمجتمع، أن تساهم في صيغٍ جديدةٍ للسيطرة الاجتماعية والإفقار الفكري. ليس هذا مآلاً حتمياً، إلا أن احتمال حدوثه ليس ضعيفاً كذلك.
هذا مآلٌ يفرض علينا تطوير أساليب مقاومته، تماماً مثلما يتوجب علينا تطوير أساليب مقاومة أشكال أخرى أكثر وضوحاً للبربرية. من صميم تقاليد الفلسفة الأصيلة، أن تأخذ هذه المهمة على عاتقها.
من الممكن الإشارة إلى مشاكل أكثر تحديداً. سأكتفي باستحضار واحدةٍ منها فقط. نعلم جميعاً بأن آلاف الشباب قد يدانون خلال الأشهر القليلة القادمة بتهمة “العصيان المدني” بسبب إتباعهم لما تمليه عليهم ضمائرهم، وقد يتعرضون لعقوبات صارمة بسبب إخلاصهم للقيم التي يدعو لها كثيرٌ منا.
من شأن النظر إلى هذه المسألة باعتبارها محض تطبيقٍ للقانون أن يكون خطأً فادحاً. يتحدد المحتوى الجوهري للقانون، إلى درجةٍ كبيرةٍ، بمستوى الثقافة الفكرية والإدراك الأخلاقي للمجتمع بشكل عام. سيترتب على الفلاسفة، بالتالي، إن ارتأوا أن هذه المسائل تندرج ضمن نطاق اهتمامهم، أن يساهموا في صياغة الفهم والمبادئ التي ستحدد ماهية تأويل القانون عن طريق أمثلةٍ ملموسةٍ.
لنطرح ببساطةٍ أكثر الأسئلة وضوحاً: لماذا لا يُشَكِل خرق الرئيس للقانون الداخلي والدولي عن طريق توسل القوة في فيتنام “عصياناً مدنياً”، بينما هو كذلك بالنسبة للشباب الذين يأبون لعب دورٍ في ممارساتٍ إجرامية؟ لا يكمن جواب هذا السؤال في القانون، وإنما بدرجة كبيرة في توزيع السلطة في مجتمعنا.
ليس بوسع المحاكم اتخاذ قرارٍ بلا قانونية تجريد حملة عسكرية أمريكية لسحق تمردٍ على أرضٍ غريبة، وذلك بسبب العواقب الاجتماعية التي قد تترتب على ذلك القرار. تؤدي الممارسات الإجرامية لمسؤولٍ متنفذٍ يتمتع بالحصانة إلى تآكل مفهوم “حكم القانون” بدرجةٍ كبيرة، وإلى تحلل إطار العمل القانوني بالمجمل.
حريٌ بأولئك الذين يسعون إلى مناصرة الحقيقة، لا السلطة، ألا لا يلوذوا بالصمت إزاء هذه المهزلة. لقد فات أوان إنتاج مناخ مناسب للرأي العام يتيح المجال لتفعيل النظام القضائي، وبالتالي لإنقاذ الرجال من السجن بسبب مقاومتهم لتحويلهم إلى مجرمي حرب. لكن لم يفت بعدُ أوان العمل على إعادة بناء القيم، وعلى خلق مجتمع أرفع فكراً وأكثر عافية يكون بمقدور هؤلاء الرجال العودة إليه، مرحّباً بهم، كأعضاء مكرمين.
ليس ثمة للجامعة في السنوات القادمة مهمةٌ أكثر إلحاحاً من إعادة إحياء نفسها كمجتمع جدير بأناس يقومون بهذه التضحية بدافع التزامهم بالقيم الأخلاقية والفكرية التي تتظاهر الجامعة بإجلالها. كما لا أرى لزوماً للتوسع في إظهار بأنه قد يكون لقسم الفلسفة موقع رأس الحربة في هذه الجهود.
ينتابني عند مناقشة هذا الموضوع إغراء جارف لاقتباس مقولة ماركس الشهير على هامش نقاشه حول فيورباخ، “فسّر الفلاسفة العالم بأشكال مختلفة حتى الآن؛ إلا أن الهدف بالأحرى هو تغييره.” لن أقاوم هذا الإغراء: المهمة التي تواجه المواطن المسؤول تكمن في واجب تغيير العالم.
لكن علينا ألا نتغاضى عن حقيقة أن التفسير والتحليل الذي يوفره الفيلسوف، والمفكر بشكل أعم، يشكل مكوناً أساسياً لأي محاولة جادة تهدف إلى تغيير العالم. إذا كانت راديكالية الطلاب غالباً ما تنحو باتجاهٍ معادٍ للفكر، فالخطأ يكمن جزئياً في عيوب المناهج، في ثقافتنا الفكرية، في فروعنا المعرفية – كالفلسفة – وفي مؤسساتنا – كالجامعة – التي تقتصر علة وجودها على تفسير وتطوير هذه الثقافة والذود عنها.
صرح السيناتور فولبرايت، ضمن خطابه الأخير بالغ الأهمية في مجلس الشيوخ، بأن الجامعات قد قامت بخيانة ثقة الشعب من خلال ارتباطها بالحكومة ونظام الشركات عن طريق مركبٍ عسكريٍ-صناعيٍ-أكاديميٍ. لقد تخلوا إلى حد كبير، حسب تعبيره الصائب، عن الدور الذي يجب أن يلعبوه في مجتمع حر وخسروا حقهم في الدعم الشعبي بسبب هذا التخلي، أو بوسعنا القول، بسبب هذه الخيانة.
وحده المنافق بمقدوره أن يعظ الفيتناميين ومجتمع السود في أمريكا حول فضائل اللاعنف، في وقتٍ يستمر فيه بقبول عنفٍ أشدُ هولاً يتعرضون له من قبل المجتمع الذي ينتمي إليه. بالمثل، وحده المنافق بوسعه شجب العداء للثقافة من قبل الطلاب الناشطين، بينما يتسامح حيال تدمير المعرفة وإفقار العقل، واللاأخلاقية الصرفة، لنكن صريحين هنا، للمختصين الأكاديميين: حين يساندون العنف والقمع الأمريكي من خلال المساهمة في التسلح ومكافحة التمرد، من خلال السماح للعلوم الاجتماعية بالتطور كتكنولوجيا سيطرة واستغلال، أو بطريقة أكثر رقّة.
من خلال المساعدة في خلق وتأييد منظومة القيم التي تتيح لنا التصفيق للموقف البراغماتي والمسؤول الذي يصدر عمن يعارضون حالياً الحرب في فيتنام لأسباب تتعلق بالتكتيك وبترشيد الكلفة. تشكل عملية ترميم نزاهة الحياة الفكرية والقيم الثقافية أكثر المهمات التي تواجه الجامعات والمهن الأكاديمية إلحاحاً وخطورة. بوسع الفلاسفة قيادة هذا المجهود، وسيخونون بدورهم مسؤولية منوطة بهم إن لم يفعلوا ذلك.
- الهوامش:
Vietnam: The Logic of Withdrawal (Boston: Beacon Press, 1967), p.50
Arthur M. Schlesinger, Jr., The Bitter Heritage (Boston: Houghton Mifflin, 1967) pp. 34, 47.
مانشوكو: دولة في منشوريا وشرق منغوليا الداخلية أقيمت على الأرض التاريخية لقومية المانشو. تشكلت فيها عام 1932 حكومة عميلة لليابان بعيد استيلاء الأخيرة عليها، وانتهت عام 1945 عقب هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية (م).
داخاو: أول معسكرات الاعتقال النازية في ألمانيا. تم توثيق 32,000 حالة وفاة فيه (م).
“Statehood and Anarchy,”1873; cited in P. Avrich, The Russian Anarchists (Princeton, N.J., 1967) pp. 93-94.
“Anarchism and Anarchosyndicalism,” in European Ideologies (New York: Philosophical Library); reprinted in P. Eltzbacher (ed.) Anarchism (London: Freedom Press, 1960), p. 257.