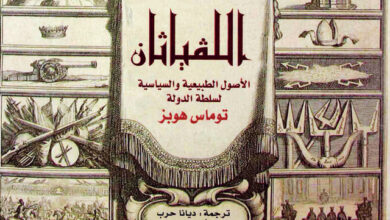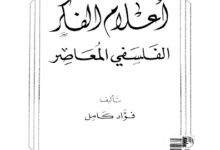فلسفة المكان

من أين تبدأ فلسفة المكان؟ هل تبدأ من المكان نفسه؟ بعدِّه واحدًا من المقولات التي تتأسس في الطبيعة وتتطور في العمل؟ أم تبدأ من الفلسفة الميتافيزيقية لعلاقة المكان والزمان باعتبارهما مقولات رياضية مجردة من أي تشكيل مادي محسوس؟ أم من الاثنين معًا عندما يشتبكان في بنية فضائية يكون المكان معلمًا بتكوين وجودي، وتكون الفلسفة قد عثرت على فضاء يوضح لها كيفية اندماج العناصر فيها؟
قبل الخوض في تفاصيل العلاقة بين الأمكنة والطبيعة فلسفيًّا، الأمكنة وتطورها الاجتماعي والتشكيلي والهندسي والهوياتي، نعود إلى الأوليات التي رسمت لنا خارطة لا تزال متحركة بين كل العلائق التي تشمل علاقة المكان بالطبيعة وبالثقافة والحضارة.
وهي أن البداية هي أن الأمكنة التي نتعامل معها تكون أمكنة استعارية لما تماثله، قد تكون في الكهوف أو في السماء، وهذه الأمكنة الواقعية ليست إلا محاكاة لتلك التي لم تُرَ، ولم تُعَشْ، ولكنها موجودة بوجود خالق كوني.
والتحول الاستعاري هو أن الأمكنة الواقعية ليست «إلا تسمية شيء ما باسم يخص شيئًا آخر»(١). هذا ما خلص إليه أرسطو أيضًا في فن الشعر الفصول (25-21). شأنها شأن أي شيء يمكن استعارته.
الأمكنة كيانات مجردة إذا لم تُسَمَّ، وإذا لم تعدْ لكائن آخر، أي أن تسميتها وتعيينها يتم من خلال تحولاتها الهوياتية والوظائفية، ولذلك ستكون الأسئلة ضمن هذا التحول، من الفضاءات الطبيعية، إلى الأمكنة التشخيصية، وهو ما يعني أنها أصبحت صالحة للتعامل الإبداعي معها كصلاحيتها للبناء والاستعمال.
لم يَدُرْ بخَلَدي أن أصل إلى مرحلة التفكير بالمكان، أن يطرح المكان سؤاله الفلسفي الخاص لي، فأنا كاتب سعيت منذ أربعين عامًا إلى أن أنتبه للهامش، والمتروك، والثانوي، والمهمل، والغائب، والأشياء الصغيرة،
أملًا في العثور على شيء خاص في هذا النثار الحياتي، ليحقق لي شيئًا من طماح الذات وهي تنأى بعيدًا من التقليد والتفكير نقديًّا في القضايا الكبرى، بما فيها كتابة الرواية والشعر، أو صراع الطبقات وغيرها، من المواضيع التي تضيع فيها الخبرات الصغيرة.
وكان اللجوء إلى الفعل الإنساني اليومي، الذي ألفناه حياة وممارسة وعيشًا وتفكيرًا، هو هدفي الذاتي، وكانت أشياء القرية المحدودة، وعلاقاتها البيئية والعملية من متقلبات اليد والعين والذاكرة، كافية ضمن منطق وجودنا فيها للإجابة عن الأسئلة اليومية التي تولدها علاقاتنا بالأشياء.
لذلك كان اهتمامي المبكر بالتراث الشعبي: الأمثال والأغاني والصناعات الشعبية، ومفردات الحياة اليومية للأصدقاء، وبخاصة الفتيات اللائي بعمري، وهو ما مهد لي أن أتغلغل في صنوف من الممارسات اليومية الصغيرة، وكنت أعتقد أنها كل ما في عالمنا الواقعي الذي كنت أعيشه.
ولكن الحقيقة كنت أعيش في مخيال واقعي فرضته علي الحياة القروية البسيطة، وبخاصة عندما تطلع الشمس على الأشياء فتخصبها، وعندما تغيب عنها، فتميتها بالظلام، كنت أرصد هذا التغير في الأشياء؛ هل تتغير بفعل ما يحدث لها، أم تبقى كما هي بالرغم من طلوع الشمس وغيابها؟
وما يحدث من تغييرات كنت أتصوره تغيرًا في درجات الضوء وانحساره، وإتيان الظلمة من جوف السماء لتعم الأرض والناس والأشياء كما لو كانت كفنًا أسود يغلف القرية بموتها الليلي. هكذا بدأت علاقتي مع الأشياء، وما زلت مهووسًا بذلك العالم الصغير المتخيل الذي يملأ مسامات تفكيري من أن الطبيعة ليست خلوًا من العقلية، ولكنها العقلية المتكررة، وليست العقلية المتغيرة.
في كل مواسم السنة أرى الحياة نفسها، وما يتغير فيها نحن فقط، نكبر فيضج تفكيرنا وضوحًا بالأسئلة، ومن داخل هذا التفكير، وجدت أن الانتماء لتيار فلسفي عقلي تجريبي، نقلة كبيرة في حياتي، مصحوبة بآلاف الأفكار الصغيرة عن دور المهمل والمتروك والثانوي والعابر والمحذوف.
على الرغم من صغرها وهامشيتها، وكأنها أمتعة لرحلتي ألقيت خارج حياتي، كثيرًا ما ألتقط تمرات سائبة وخيوط صوف مهملة، وورقة من دفتر قديم، وحكمة يتداولها كبار السن، ومثلًا أستفيد منه لمحاكاة شخص، ولكني فوجئت لاحقًا أن الفكرالجدلي ينطلق أيضًا من هذه الأرضية المهملة ليؤلف قانونًا يغيَّر فيه معتقداتنا المألوفة، ليحشد المواقف ضد من يهملها، أو يلغيها، أو يعدّها من إنتاج الطبقات الدنيا من الناس.
- الوعي المركب
في هذه المرحلة من الوعي المركب، بين خبرتي القروية البدائية، وخبرة الانتماء العلمية، بدأت أفكر في أن الأشياء كلها ليست على درجة واحدة من الوعي. فكل وعي لشيء ينبع من خصوصية العلاقة مع الشيء، هكذا بدأت أفرز بين ما ينتجه زرع الفلاحة، وما تنتجه النباتات الطبيعية، وما يصطاد من الأنهر.
وما يزرع في الأرض، وما يعمل بالخبرة مع الأرض، وما يترك عفوًا لينمو حاملًا غرائبه هذا الوعي المتدرج، والمختلف، حملته معي كمنهاج بحث في الحياة، كنت قد نضجت كثيرًا، وفهمت معنى أن أنتمي لتيار سياسي تقدمي، ينادي بالعدالة والعمل، مع أني ابن أسرة ميسورة، لا تفكر بالآخر، بقدر تفكيرها بما يزيد مكانتها.
كل هذه المتراكمات من الوعي البسيط، ومن الوعي المنتبه، كانت خميرة تتشكل كأسئلة مصدرها الناس، وأمكنتها القرية وحاضنتها الحياة اليومية ومتطلباتها، والفكر وأقواله، لأجد نفسي لاحقًا بين مطارد ومُنْتَمٍ، بين أن أكون معلمًا للعيش ومثقفًا واعيًا لما يحدث، هذه الأسئلة،
على الرغم من بداياتها وعفويتها، كانت هي الأساس الذي تطور لاحقًا في اهتمامي بحشائش الحياة اليومية ومهملاتها، بما فيها أفكاري البسيطة الساذجة عن الأمكنة والضياء والظلام وحركة الناس في الحقول واستماعهم الليلي للحكايات، هذا العالم الصغير ما أوسعه حين نتأمله لاحقًا.
- مفهوم جديد للمكان
خلال الأربعين سنة الأخيرة، عندما شاع مفهوم جديد للمكان من أنه عنصر من عناصر بنية النص، وجدت أن المكان عبارة عن الأشياء التي تشكل بمجموعها المأوى، أو الألفة، أو العيش، أي تلك التي كنا نعايشها كأشياء، وهو الأمر الذي نهضت عندي حاسة أخرى.
تلك هي الرؤية القصدية للأشياء البدائية وهي تتفاعل مع حيواتنا اليومية، ومن بينها انتقالنا من بيوت القصب والبردي إلى بيوت الصرائف المزركشة بفنون القصب المظفور، ثم إلى بيوت الطين، وأخيرًا بيوت الآجر والإسمنت والحديد.
ومع هذه الرحلة، كانت الأشياء نفسها مع تطور استعمالاتها ترافق هذه المسيرة بأسئلة جديدة عن المدينة والعمارة، عن السكن والمأوى، عن العيش والبحث عن أمكنة أخرى، وبالقدر الذي تصبح فيه الأشياء القديمة جزءًا من التراث البيتي الذاتي،
أصبحت الأشياء الجديدة نافذة على المدينة والحياة الواسعة، والأفكار. ويحدث مع هذا كله انحسار جزئي، ولكنه مستمر، لدور الطبيعة التي كانت تفرض ارادتها على طبيعة الأشياء والسكن والحياة الهامشية.
في هذه المرحلة بدأت أعي أهمية التفاصيل في الأشياء؛ ما معنى أن تضع النساء بقايا الأكل ليلًا على عتبة الباب وتبسمل، ثم تفتح القدر، وعندما أسألها، تجيب هذا طعام الملائكة التي تحرس بيتنا، لا يجوز أن نأكل ونترك حراسنا من الملائكة بلا طعام، ها هم ينظرون إلينا، لم نرهم ولكنهم موجودون.
ولم أَدْرِ لماذا يكون للباب قفلان، خارجي يُقفل عندما نخرج، وداخلي يقفل عندما ننام، وعندما تسأل، يجيبك الأب، الحرامية لا تعرف من أين يأتون، حرامي أجنبي تغلق الباب بوجهه كي لا يدخل، وحرامي من داخل بيتك تغلق الباب أمامه كي لا يخرج، فلكل بيت قفلان، أحدهما يحمي الداخل، والآخر يحمينا من الخارج.
مثل هذا الوعي بالأشياء الصغيرة، كان مثار أسئلة، لم أَعِ أنها ستكون كبيرة ومقلقة وتقودني إلى البحث والاستقصاء، وتشمل ليس الحيوات الصغيرة، بل الأفكار الكبيرة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وها هي تتبرعم نباتات عن تلك الجذامير القروية البسيطة لتتحول إلى وعي مدرك أهمية الأمكنة في حياتنا اليومية.
الهوامش :
١. تيرنس هوكس ، الاستعارة، ترجمة عمرو زكريا عبدالله، المركز القومي للترجمة ،القاهرة ع 2733، ط1، 2016م، ص 18.