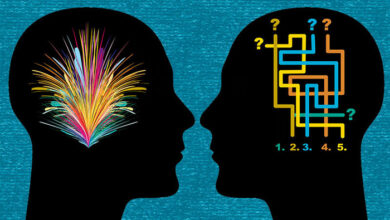نشأة المسيحية والدولة الإسلامية

نشأت المسيحية دعوة لتجديد قيم التعايش بين الناس، و شد وثاق التآخي، لم يكن مشروعها بناء الدولة أو التفكير في سياسة تفرضها على الدولة، فصارعت الوثنية، و واجهت اليهود الرافضين لرسالة المسيح دفاعا عن الديانة التي أتى بها موسى، و غدوا في نظر أنفسهم أصحابها و حماتها، و خصوا أحبارهم الرافضين للتسامح المسيحي و المساواة بين البشر، كما أنهم كانوا يعرضون رفض العقوبات على المذنبين و الخطائيين و عدم ترك أمرهم لله ليجزيهم بما فعلوا،
لكن مع اتساع المسيحية، و كثرة أتباعها، اهتدت الدولة الرومانية إلى تبنيها و اعتبار نفسها دولة مسيحية، و كانت هذه التجربة السياسية وليدة قراءة لتاريخ الدول القديمة، بما فيها الدولة الفرعونية و حتى الفارسية، بحيث أن كل حكم يحتاج لمشروعية، كلما كانت مقدسة، ضمن الحكم استمراريته و قدرته على تجديد سلطته و مد نفوذه باسم نشر الحق الحقيقة، فلماذا تحققت العلمانية في الدول الغربية وريثة الرومان، و فشلت هذه التجربة في دول الشرق و منها الدولة الإسلامية؟
- -1 المسيحية و الدولة
لم تنشئ المسيحية الدولة كما ذكر سابقا، و في خضم الصراعات التي عاشتها الدولة الرومانية، استغلت الفكر المسيحي لتبرير هجوماتها على الغير، وإعطاء حروبها قداسة، لتبدي أنها تحارب باسمه، و تقتل بسيفه، غير أن السياسة طغت على الدولة، و عاشت صراعات مريرة ضد الرهبان الذين صاروا فيما بعد هم الحكام الفعليون،
و كان الوعي بحضور الديني و تحويله للحكام إلى مستبدين، مشرعين و منفذين، لما يختاره رجالات الدين، تجاه المجتمع و حتى باقي الدول المجاورة و البعيدة، بل حتى التي تتبنى المسيحية، و هنا ظهرت فئات و تجمعات اقتصادية و نخب ثقافية اصطدمت مبكرا بدينية الدولة المسيحية الرومانية، بل و مجمل الدول الأوروبية قبل الثورة الفرنسية و النهضة الثقافية، التي مهدت للتحولات السياسية التي عرفتها أروبا، مما حتم إعادة النظر في النظم السياسية، و البحث عن بديل مناهض للتجربة التيوقراطية، التي كانت الحضارات العتيقة، و التي عاشت مغلقة في الشرق،
مما حدا بأرسطو إلى اعتبار الاستبداد ملائما لطبيعتها، و ما كان لليونان تصور احتكام الرومان لآليات الديانة المسيحية، كصيغة مناقضة لمجرى التاريخ العقلاني كما اعتقد رجالات الغرب الأوروبي منذ اليونان، هكذا استطاع الفكر الأوروبي، فرض رهاناته الجديدة على الكنيسة، بأن تتجنب الممارسات السياسية، و تترك مجال الدولة بعيدا عن رجالاتها و أساقفتها، مما سمح للديانة المسيحية بمراجعة ممارساتها التاريخية في ضوء التحولات التي عاشتها أروبا هو ما عرف بالإصلاح الديني،
كتأويل للمقدس ليصير في خدمة الإنسان روحيا، بدل أن يعتبر الإنسان خادما له و خاضعا في أمور دنياه و آخرته له، بوساطات بشرية استغلت الدين لتحقيق سلط موازية، سرعان ما تحولت إلى سلط فعلية، كلفت كثيرا من الجهد و الأرواح، دون نسيان أن هناك رهبانا و علماء، ساهموا بمجهودات تاريخية، للحد من سطوة الديني و الكنسي على السياسي.
- -2 الدعوة و الدولة في الإسلام
بدأ الإسلام روحيا، لكنه كان مضمرا لغاية الدولة، بفعل عدم وجوده في ظل دولة قائمة، فمكة لم تكن خاضعة بشكل مباشر لدولة مؤسسة سياسيا، بحكم وجود نظام قبلي، له أعرافه، التي اندمجت مع العبادة الوثنية، المختلفة هي الأخرى عما عرف بتعدد الديانات اليونانية مثلا، بل كان الإنسان العربي، يقر بوجود الله، و يعيش داخله اليهود و النصارى، كموحدين، رغم قول المسيحية بألوهية المسيح،
و قول اليهودية بأبوة الله لعزير، غير أن الإسلام بالمدينة لم يخض في صراعات ضد أهل الكتاب، بل اكتفى بوضع أسس الدعوة، أي التوحيد و الحث على مساواة البشر لبعضهم، و لم تتبلور الرؤية السياسية للإسلام إلا بعد الهجرة إلى المدينة، هناك دخل في جدالات دينية مع أهل الكتاب، مستبعدا أي حوارات سياسية، بحكم عدم إلمام العرب بما هو سياسي مقارنة باليهود و النصارى،
و هنا بدأت التصنيفات السياسية للأعداء و الخصوم، فقد كان المسيحيون أقرب إلى المسلمين، امتنانا لما قام به ملك الحبشة تجاه المسلمين الفارين من سطوة سادة قريش، الذين أرادوا تحريض ملك الحبشة عليهم، فرفض رغم هداياهم، أما اليهود، فقد كانت جدالاتهم للمسلمين مؤججة للغضب، بما أثاروه من إشكالات حول النبوة، و الله، رغم اعتراف الإسلام بعلمهم، و سبقهم، غير أنهم لم يستصيغوا ظهور نبي من خارجهم،
وهنا يبدو أن النبي عليه الصلاة و السلام، أدرك قوة الخصومة و خطرها على المسلمين بعده، و لذلك حسب المصادر الشيعية، فإن النبي عقد البيعة لعلي، فيما عرف بغدير خم، لكن بعد الوفاة، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فلحق بهم المهاجرون، و في خضم النقاشات عقدت البيعة اتفاقا لتظل في قريش، فسمي أبو بكر خليفة للمسلمين بدعم من عمر و عائشة زوجة النبي، مما ولد رفضا من طرف شيعة علي ابن أبي طالب، حكيم بني هاشم رضي الله عنه،
فقد كان في نظر الكثير من الصحابة أجدر الناس بها، و أدرى بخطط اليهود و الأقدر على مجادلتهم و تسفيه خططهم، و باختصار فإن السلطة السياسية في صيغة الخلافة، اعتبرت ثابتا دينيا في الفكر الشيعي، فالمسلم ملزم بالانتصار للإمام، و تصديق ما لمح إليه، فالخلافة لا تصح إلا بوصية مكتوبة أو مشهود لمستحقها، و من ينكث العهد لا يصح إيمانه، غير أن الصحابة و في مقدمتهم أبو بكر و عمر، أتوا ما عرف بحديث أحادي، رووه عن النبي، قيل فيه لا تجتمع النبوة و الخلافة في بيت واحد،
و أضاف لها في خطبة تسلم الخلافة، قوله ،أيها الناس وليت عليكم و لست بخيركم، فمن كان يعبد محمدا، فمحمد قد مات، و من كان يعبد الله، فالله حي لا يموت، هنا تبدو صعوبة التمييز في الإسلام بين الديني و السياسي، رغم أن المسلمين فعلوا التمييز بدون إعلانه.
- -3 العلمانية والدين:
التحديث سياسيا، ارتبط بالتعاقد لتأسيس جماعة تمارس الحكم وفق قوانين منظمة للقوى المتصارعة، فاتخذ هذا التوازن، اسم الحق المدني، ليختلف عن الحق الإلهي، الذي أعطى للدولة مضمونا دينيا مقدسا، جعل الحاكم خارج المحاسبة والمساءلة، فصار حاكما باسم الله متعاليا على المجتمع بحكمه له وفق مقدس، سمي شريعة، لها رجالها الداعمون له، والذين قد يتمردون عليه لاستبداله بآخر، أكثر إيمانا وصلاحا،
وهنا راكمت التجربة البشرية معارف حول، استحضار الديني في السياسة، وعاشت محنا في الغرب الأوروبي، ما تزال في تاريخها ناضحة بالجروحات والحروب الأهلية، بل إن التاريخ في مثل هذه المحن، لم يكن محصورا في أوروبا وحدها، بل عاشته مجتمعات أخرى غير أوروبية، وهوما لا يمكن نفيه أو تجاهله، إلا بمقولات سلفية دينية، استبدلته بمقولة المستبد العادل، بدون أن تسأل نفسها، كيف يكون المستبد عادلا، وقد احتكر السلطة لنفسه أو جماعته،
وبذلك اعتبرت العلمانية في نظر هذا المشروع، متناقضة مع الدين، وعمل المسلمون على اعتبار ذلك، بداهة في سياق رفض المشروع الغربي المسيحي، كشكل دافعوا به عن هوية مجروحة تعيش شرخا، سببه، سوء فهم تطور حاملي المشاريع العلمانية واندحار المدافعين عن الدولة الدينية خصوصا في العالم الإسلامي، وهنا لا بد من تصحيح معطى، بسبب تجاهله، سادت الكثير من الأوهام، يمكن تصحيح بعض محتوياتها، وأولها أن العلمانية، ليست منعا للدين اجتماعيا أو تحقيرا له،
بل هي عدم استخدامه في السياسة، بحكم وجود أقليات غير دينية، تخاف الحيف، وحاجة المجتمع لمن يخدمونه مدنيا بتحقيق مصالحه والدفاع عنها، أما الغايات الأخرى فينشدها بنفسه بعيدا عن أية وعظية، تنسي الناس مآلهم وتستغل طموحاتهم الأخروية لينسوا حاجاتهم الملحة في الحرية والحياة الكريمة، فإن كان الدين حاجة روحية، فالفرد يحققه بذاته وبدون وساطات، أما السياسة ففيها الجماعي والفردي، الحق والواجب، تجاه الذات والغير، وذلك بتطوير القوانين المدنية،
التي لها قابلية المراجعة والتجديد، لتتطور موافقة لتقدم القيم وحتى لتصورات العدالة المتغيرة، فلوا وضعت تحت رحمة المقدس، فسوف تظل ثابتة وكل مس بها يخلق صراعات وانحيازات مذهبية أو دينية، تخفي مصالح وتعمل على خلق اصطفافات غير مدنية بحكم دينيتها وحتى عرقيتها، بحكم وجود تماس بين الديني والعرقي كما عرفه الإسلام حتى في الفكر الفقهي نفسه،
وبذلك، فالعلمانية ليست مجرد غاية، بل هي شرط للديمقراطية، كأساس لانتقال السلطة بدون غلبة أو عنف سياسي، والتحديث لا يمكن أن يوجد بدون ديمقراطية، مهذبة لكل طموحات الحكم، بما تفرضه من مراقبة له ومواكبة لكل ما يقترحه في التنافس الحر الديمقراطي.
- خلاصات
من الصعب خلق تشابه بين تاريخ الأديان، بغية تسطير مسار واحد لها، حتى إن تقاربت مبادئها، و من غير المجدي استنساخ إصلاح ديني، أو استيراده من ديانة أخرى ،لإصلاح محتوى ديانة مغايرة أو حتى مشابهة، بدون الإحاطة بمختلف الاجتهادات التي تعرفها الديانة الواحدة، و رصد إمكانات التطوير من داخل النسق نفسه، ما دامت المجتمعات العربية عاجزة على فرض التحديث الثقافي مجتمعيا.
لكن سياسيا يمكن استحضار الثقافي ممهدا للقبول بخبرات البشرية في بناء نظمها السياسية، وتحصين قيم التعايش الجماعي، بنبذ التعصب، خصوصا الديني، وعلى الفكر العربي الديني، أن يستوعب حقيقته، بعيدا عن اعتبار الدين وسيلة للحكم وفرض السيادة باسم المشترك العقدي،
المعتبر شريعة، ولذلك، ينبغي بناء ثقافة قابلة بتجديد الفكر الديني ليقبل بقيم الحداثة، تمهيدا لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تعتبر غايتها هي تحرير المواطن ببناء مواطنة فاعلة وغير خاضعة إلا لما يمليه القانون والمشترك الجماعي الثقافي، القابل بالاختلاف وحرية المعتقد والاختيار.