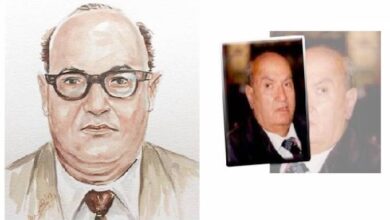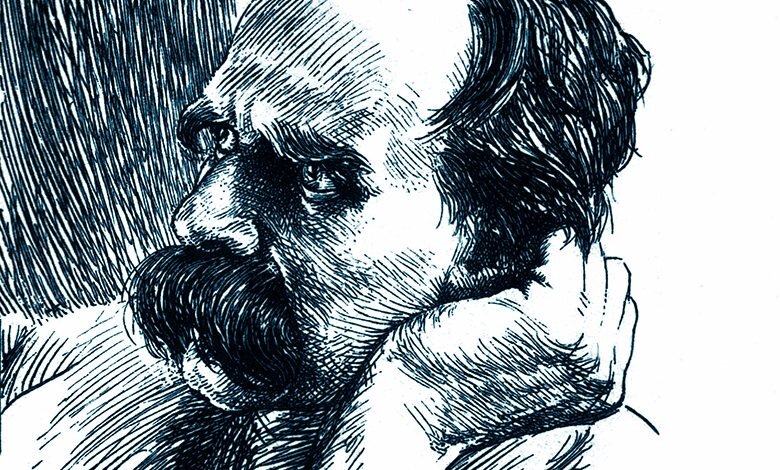
يفكّر نيتشه بقوله :” نحن الخيّرون …السعداء” (1)، في شيئين: في وضعية الأقوياء بشكل صريح ، وفي ماهية الحياة، بشكل ضمني ولكنه أساسي. ندرك وضعية الأقوياء لا نظريّا انطلاقا من وضعية الضعفاء. يَعبر هذا التقابل بين الضعفاء والأقوياء مؤلف نيتشه أمام دهشة وربما انزعاج الشارح.
لكي نوضّح هذا التقابل بين الأقوياء والضعفاء، سنطرح أربعة أسئلة :
1) من هم الأقوياء، فيم تتمثّل قوّة الأقوياء؟
2) من هم الضعفاء، فيم يتمثّل الضعف؟- لكن بما أن نيتشه يؤكّد أنّ الضعفاء يتغلّبون لا محالة على الأقوياء، وأنّه على الأقوياء أن يدافعوا عن أنفسهم ضدّ الضعفاء ، تعلّق الأمر بأن نفهم أيضا:
3) ما الذي يخوّل للضعفاء التفوّق على الأقوياء ، فيم تتمثّل قوّة الضعفاء؟ و، بشكل متلازم:
4) كيف يقهر الضعفاء الأقوياء ، ما الذي يخلق ضعف الأقوياء؟
عن السؤال الأوّل – ما الذي يُكسب الأقوياء قوّتهم ؟- يبدو أنّه من اليسير أن نجيب : يكون الأقوياء أقوياء من حيث هم كذلك، حيث تكون القوّة ماهية الكائن ، وهو ما يسمّيه إرادة الاقتدارvolonté de puissance أو إرادة القوّة . علينا أن نقول كلمة عن ” إرادة الاقتدار” التي لا يمكن فهمها إلاّ انطلاقا من شوبنهاور.
فالإرادة عند شوبنهاور هي ” واقع متعطّش” réalité affamée” ، وظمأ لا يرتوي، ورغبة لا تُشبع ولا تقبل أن تشبع، لأنّها رغبة في واقع لا يوجد، لأنه لا يُوجد واقع آخر غير تلك الرغبة بلا موضوع. من هنا كانت الإعادة غير المحدّدة لهذه الرغبة و غرورها.
وعلى العكس، وبما أنّنا قلنا ذلك على سبيل الذكر، فليست إرادة الاقتدار لدى نيتشه رغبة ، التطلّع إلى واقع لا تملكه (هذه الإرادة) بعدُ، أي، ليست ، في هذه الحالة إرادة اقتدار لا تملكه ( أي الواقع) بعدُ وتجهد نفسها في الوصول إليه. إنّ إرادة الاقتدار هي بالفعل قوّة. قوّة، هي بأكملها اقتدار وبأكملها قوّة. فـ”الإرادة” التي ترتبط بهذا الاقتدار ليست في الواقع سوى حركته الذاتية، واكتمال ماهيته الخاصّة بواسطتها وهي سنده.
وعلى أيّة حال فليست الإرادة لدى شوبنهاور رغبة، في معنى مجرّد ضعف إرادةvelléité منقطع عن الواقع. إنّ هذه ( الإرادة)هي الجسد الأصلي، لا الجسد الذي نتمثّلّه بل الجسد الذي هو ذاتنا، جسد الحركات الواقعية، و الأداء الجسداني الواقعي، و كون هذا الأداء لا يفضي إلى أيّ إرضاء حقيقي ويُعاود أو يتكرّر دون تحديد، فإنّه لا يحذف شيئا من واقعه.
إنّ الإرادة الشوبنهاورية ليست إذن في أي لحظة كانت مفصولة عن الاقتدار بل هي الاقتدار، الاقتدار الوحيد في العالم، بل هي أكثر اقتدار في كليّته، هذا الاقتدار الذي يُجمع في كلّ نقطة من نقاط فعله – ومن هنا كان الطابع المذهل للعالم الشوبنهاوري.
ماذا يعني إذن الربط النيتشوي للإقتدار بهذه الإرادة التي هي بعدُ اقتدارا من جانبين، واقتدارا كامل الاقتدار؟ هو ذا: أنّ الاقتدار والقوّة، وأيّ كانت درجة هذا الاقتدار وأي ّ كانت كثافة قوّته، يجب أن يكونا être أوّلا ، كونًا être يتمثّل في هذا الاقتدار السّابق والمُفترض الذي بفضله يتملّك الاقتدار والقوّة ذاتهما و ماهيتهما الخاصّة، والذي بفضله يكونان.
تعني الإرادة والاقتدار، في المنظور النيتشوي ، اقتدارَ أو قدرة الإرادة. بمعنى أنّ الإرادة ليست فحسب قوّة ، وأنّها الجسد، بل هذا الأمر الأساسي وهو أنّ كلّ اقتدار، وكلّ قوّة والجسد ذاته لا يوجد إلاّ بفعل اقتدار أصيل أكثر، يقذفهم إلى ذواتهم ويكرههم على الوجود. يكون للاقتدار والقوّة جواز التمدّد في هذا الاقتدار الهائل للأصل فحسب.
بيد أنّه ، وعلى فرض أنه توجد درجات اقتدار ونِسَب قوّة – فالاقتدار السابق والذي بواسطته توجد وفيه تُقيم، (هذا الاقتدار) لا يعرف لا درجة ولا نسبة ، ولا زيادة ولا نقصانا، لا تحويرا ولا تغييرا، إنّه الاقتدار الهائل دائم الوجود ودائم القدرة في كلّ اقتدار والذي يتركه لشأنه بحيث يكون قادرا على أن يكون ما هو عليه وأن يفعل ما يفعله، حاضرا في كلّ اقتدار : في الأضعف كما في الأقوى.
هكذا نفهم من الآن فصاعدا أنّه ليس نقطة قوّة ، قد تكون جدّ تافهة وساذجة والتي لا تحمل معها اللامحدود لهذا الاقتدار الهائل – اقتدارا عظيما لا يمكنه بذاته أن يقاس بأيّ قوّة أخرى، مثلما لا تقاس به أيّ قوّة، بما أنّه موجود في كلّ قوّة قبل أن تتمدّد، وقبل أن تأخذ وتمنح مقدارها. إنّه أي الاقتدار، موجود في كلّ قوّة بوصفه لاإنضغاطية l’incoercibilité ولا مشروطية الرابط الذي بواسطته تنتشر بذاتها وتثبت ذاتها .
يجب علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار الحدث الحاسم للفلسفة المعاصرة رغم كونه غير ملحوظ ، أنّ الكائن يأخذ مع شوبنهاور ونيتشه لأوّل مرّة معنى أن يكون الحياة. إنّ تأويل الكائن بوصفه حياة لا يعني أيّ نسيان للكائن ذاته ، ولا أيّ اختزال للكائن في مجرّد كيفية وجود لكائن هكذا étant خالص قد يكون الكائن الحيّ l’étant vivant .
إنّ تحديد القوّة بوصفها قوّة حيّة يعود بنا إلى الفعل الأصلي للكائن ، يعني إلى الضَمِّ الأصلي لذاته ما يعود إذن بذاته والذي ينمو من ذاته والذي ، خلافا لهذه التجربة لذاته ولهذا النموّ بذاته، نموّ لا يبدأ ولا ينتهي ، هو الحياة- والتي تكون في لغة نيتشوية للأسطورة: ديونوزوس.
إنّ إرادة الاقتدار هي النموّ الذاتي مدمجا في الضمّ الأصلي للذات، إنّها ” أثرى” le plus richeما في الذات، (2)” الحاجة للذات” (3). هذا النموّ للذات بوصفه يعود في ذاته، بوصفه تجربة للذات، وبوصفه كائنا في ذاته، هو ما أسمّيه المحايثة l’immanence.
لقد فكّر نيتشه في المحايثة بعدّة وجوه وخاصّة بالقول بأنّ الحياة نسيان. أن ننسى ، هو أن لا نفكّر في…نقابل النسيان بالتذكّر الذي يتمثّل على العكس في التفكير فيما لم نفكّر فيه إلى حدّ الآن. النسيان والتذكّر هما نمطي تفكير ، وتمثّلٍ ، أحدهما إيجابي والآخر سلبي .
أن تكون الحياة نسيانا ، فذاك ما يقوله نيتشه في معنى آخر. فليست الحياة نسيانا لأنّها لا تفكّر في هذا أو ذاك، بفضل تسلية عابرة، بل لأنّها لا تحمل في ذاتها ماهية الفكر، وإمكانية التفكير في شيء ما على وجه العموم، وتذكّره مثلا. إنّ الحياة في نسيانها ، هي كذلك بحكم الطبيعة، من حيث هي محايثة، تستبعد من ذاتها كلّ نشوة ek-stasis ثمّ كلّ شكل من التفكير الممكن والتّمثّل .
يمثّلّ نيشته هذه البنية الأصلية للكائن بوصفها محايثة لذاته وبوصفها حياة ، في شكل الحيوان، الذي يَعْبُر كامل مؤلّفه- وهذا عن استحقاق إذا ما تعلّق الأمر بالتعبير عن غياب الفكر، الذي يُعرّف تقليديا إنسانية الإنسان ويميّزه بوصفه حيوانا عاقلا. بفضل هذه الضرورة الجوهرية إذن ومع كونه يشكّل ماهية الحياة وأنّ هذه تستبعد التمثّل ، يجد الحيوان نفسه يُعرّف في وجوده بالنسيان – الإنسان، “هذا الحيوان النسّاء oublieux بالضرورة” .(4)
إذن، كيف يمكن على العكس لمن هو بالضرورة نسّاء أن يتذكّر؟ هنا تكمن المفارقة التي يصطدم بها نيتشه بالضرورة وتحتلّ صدارة المقالة الثانية لجينيالوجيا الأخلاق :” أن نربّي حيوانا يقدر على أن يَعِدَ” (5)، أن يتذكّر، وهذا في الوقت الذي تستبعد فيه الحياة الفكر.
من البيّن أنّه وللحسم في هذه الصعوبة، يحوّل نيشته كليّا مشكل الذاكرة، وبدل أن يجعل منها ما تمثّله ( أي الفكر) تقليديا ، أي مَلَكَةَ تفكير تحديدا، مَلَكَةً تَمَثُّلية ، يخضعها فورا لإرادة الاقتدار، أي للحياة- ، بل أكثر،(يخضعها) لما يظهر لنا هنا لأوّل مرة: العاطفة أو الانفعالl’affectivité. ” ننقش شيئا بالحديد الساخن لنثبّته في الذاكرة: نحفظ فقط في الذاكرة ما لا يكفّ عن إيلامنا ” .(6)
وكما هو الحال دوما حينما يكتشف نيتشه عمق الحياة – العاطفة والمعاناة- يشتعل النص النيتشوي ، يحمله نَفَسٌ شديد، وتنفجر الصور، وتُستدعى حرائق التاريخ الكبرى، كل دليلٍ نارٌ متأجّجة، وبعض صور التعذيب الرهيبة نُدعى للاستمتاع بها.
هذا ما كان يجب للإنسان كي يصنع ذاكرة: “…آلام، شهداء . التضحيات والرغبات الأكثر رعبا…والتشويهات الأكثر اشمئزازا…والطقوس الأشدّ قسوة… “. وهذا ما كان يجب للإنسان الألمانيُّ :” الوسائل الأكثر رعبا…الرجْم…العجلة…آلام العصا، التمزّق، السحق تحت أقدام الخيول، سلق المجرم في الزيت…السلخ…ختان اللحم”. (7) الألم في كلّ مكان هو” المعين الأقوى للذاكرة” (8)، تحلّ المعاناة محل الفكر وتؤسّسه في نهاية الأمر.
إنّ محايثة الحياة، وتناسقها في ذاتها اللامشروط ، هو شرط تمدّدها ، وشرط الظاهرة المركزية للعمل- وهو ما تظهره حكاية الطيور الجارحة التي تحطّ على الحملان لتلتهمها.(9) يقدمّ هذا التحليل العسير ولكنّه أساسي في شكل نقد للأخلاق. ويتعلّق الأمر برفض الحجاج الذي يحاول الحملان بواسطته إنقاذ حياتهم ، وهذا بفضل إدانة عمل الطيور الجوارح- إدانة يكفي الطيور الجوارح تقاسمها حتّى تحفظ الحملان بالفعل سلامتها.
بيد أن حجاج الحملان يرتكز على مسلّمة ازدواجية القوّة، على انفصالها عن ذاتها، وباختصار على نفي مُحايثتها الجذريّة. وتتمثّل هذه الازدواجية للقوّة في فصلٍ مُقامٍ في كلّ عمل بين ذات قادرة على التصميم أوْ لا على هذا العمل و بين العمل ذاته- عملا يفهم إذن بوصفه أثرا لإرادة حرّة لهذه الذات.
إنّ ازدواجية الفعل، هو مثلا ،- حتى نحتفظ بمجاز نيتشه- ، ما يقيمه الشعب بين الرّعد والبرق والذي يتمثّل في أن نأخذ نفس الظاهرة مرتين، مأخذ السبب أولا ثمّ مأخذ نتيجة لهذا السبب.” لا يقدّم العلماء شيئا أفضل ، يقول نيتشه مُعلّقا، على قولهم :” القوّة تنتج حركة”، القوّة نتج أثرا”..” (10)
لنعد إلى حِمْلاننا: فهي التي تعتبر الجوارح ذواتا حرّة في أن تمدّد قوّتها أوْ لا، وحرّة في أن تكون طيورا جوارح أو لا. و يكمن خلاص الحملان في هذه الحرية في أن تكون جوارح أو لا، وفي حرية القوة في أن لا تكون قوّة ، وفي أن لا تَعَضَّ ـ. فقط هي لا تملك هذه الحرية في أن لا تكون ذواتها، ولا القوّة ولا الحياة بوجه عام.
إنّ اللاحريّة ، واستحالة أن لا نكون ذواتنا، تنضوي على الماهية التي تتحكّم في علاقة الحياة بذاتها، علاقة مُنْشِأة للحياة ، التي هي اختبارها لذاتها في لامشروطية الرابط الذي يصلها بذاتها كي تكون ما هي عليه إلى الأبد- الذي هو أبديتها، وهو ما يسميّه نيتشه ” العود الأبدي لما هو عينه”retour éternel du Même”.
إنّ اللاحريّة non-liberté، أي لا انضغاطية incoercibilité الرابط الذي يترك الحياة لشأنها، هو الاقتدار الهائل الذي يستجمع فيه الكائن ذاته ويتملّك ذاته في هذا الاختبار لذاته الذي يجعل منه الحياة تحديدا. ولأنّ هذا الاقتدار الهائل للكائن هو لاحريّة، هو أيضا عدم اقتداره impuissance ،أي القدرة القصوى للحياة على التخلّص من ذاتها.
ولا يمكننا القول إطلاقا بأنّ الجميع لا يكونوا أحرارا في فعل شيء آخر غير ما يفعلون، وبالأساس، إنّهم لا يقدرون على أن يكونوا غير ما هم عليه. هكذا ، ولا يكونوا مع ذلك إلاّ على أساس الكائن فيهم- طالما كانت بنية الكائن هي اللاحرية، سلبيته تجاه ذاته التي لا يمكن تخطّيّها ، واللاقدرة على التخلّص من ذاته وممّا هو متماسك في ذاته مثل الحياة ذاتها.
تلك هي ماهية القوّة التي تُزجل العطاء:” تُكَاِفئ كل ما تجد في ذاتها… تضع في المقام الأوّل الشعور بالاكتمال، وبالاقتدار الذي يريد التجاوز، وسعادة معرفة توتّر شديد، والوعي بثراء يودّ أن يعطي و يُزْجِل العطاء “، على نحو يصدر عنها كل ما تفعل ، مثلا إنقاذ البؤساء ” بفعل حاجة تتولّد من فيض قوّتها” (11).
فقط ، إذا كانت ماهية الارستقراطية هي ماهية الحياة، فأي قوّة تصنع قوّة الأقوياء ، لقد فهمناها: ليست هذه القوّة المعطاة أو تلك ، إلى حدّ ما كبيرة، هذا الاقتدار الذي قد يصنع مصيرا، بل الاقتدار الهائل الذي ، برفضه كلّ قوّة وكل قدرة في ذاتها ، يخوّل لها أن تنمو بذاتها وبالتالي أن تفيض.
فيم يتمثّل ضعف الضعفاء، هذا هو على العكس، ما يمثّل مشكلا: إذ لو كانت إرادة القوّة ( الاقتدار) هي ماهية الكائن ، ولو كان كلّ ما يوجد ليس كذلك إلاّ بهذا الاقتدار الذي يفيض بذاته ، فلن نرى إذن كيف لشيء ما مثل الضعف عامّة أن يظلّ ممكنا.
إنّ تفسيرا خارجيا يعني: كل شيء قوّة بلا شكّ، ولكن توجد كميات من هذه القوّة ، حينما توجد إحداها في حضور أخرى أكبر، تكون أضعف منها ، وتنبثق عن الاختلاف الكمّي للقوى اختلافها الكيفي، الضعف والقوّة – التي لا تصف إلاّ الأقوى.
نعبّر أيضا عن هذا التفريق الكيفي بالقول بأنّ القوّة الأضعف التي تتقبّل فعل القوّة الأقوى تصبح ” ارتكاسية” réactive، طالما كان فعلها مُحَدَّدا من هذا الفعل الأقوى الذي لا تكفّ عن تقبّله، بينما تظلّ القوّة الأقوى لوحدها “فعّالة” active واقعيّا، بدقّة وبصفة شاملة.
إنّ هذا التحديد الكامن للطبيعة الداخلية للقوّة هو فحسب ، بكل بساطة، على نقيض ما يعنيه نيتشه بإرادة الاقتدار- التي تشير إلى هذه الطبيعة الداخلية للقوّة بما هي كذلك، تفيض من ذاتها ولا تكفّ بوصفها كذلك عن أن تكون ما هي عليه.
أن توجد ماهية القوّة التي لا يمكن لها مثل أيّ قوّة أن تصير شيئا آخر ، ولا حتّى نقيضها، وأنّ الأسياد لا يتحوّلون فجأة إلى عبيد في منعطف طريق ، إذا ما التقوا فيه بمن كان أقدر منهم، وأنّ السيادة والعبودية إذن، و القوّة والضعف لا يمثلان بوصفهما تحديدات متعاقبة ومُجَاِزفة ، فذاك ما يطرحه نيتشه بجعله الارستقراطية عرقا race ، أي ماهية.
وبالمثل فإنّ العامّة هي كذلك: يُفهم الضعف هو أيضا لا انطلاقا من تحديد خارجي بل من إمكانيته الداخلية. بيد أن هذه الإمكانية هي بالضبط مماثلة لإمكانية القوّة- لايوجد شيء آخر- إنّها ماهية الحياة، بمعنى المحايثة.
إن القوة – ومن هنا فنحن لا نعتبرها بأكثر سذاجة في سهولتها- هي قوّة المحايثة ، إنّها مالا يقبل التكميم واللاانضغاطي وغير القابل للتجاوز قوّة الرابط الذي يصل الحياة بذاتها. لا يَفْهم نيتشه الضعف بوصفه أقلّ قوّة بل بوصفه نفيا لماهيتها، طالما كانت هذه الماهية محايثة، بوصفه قطيعة مع هذه الأخيرة.
إذ هنا يكمن معنى العدمية ، المسكوت عنه في الحياة، لا بوصفها نفيا خارجيا لوجودها الفعلي بل تدميرا لماهيتها الداخلية. غير أن هذا التدمير الداخلي بوصفه تدميرا ذاتيا – إن الحياة ، وسنرى لماذا، هي التي تقول لا للحياة – هذا النفي للذات يصطدم باستحالة ماهوية، بماهية الحياة تحديدا، طالما أن الرابط الذي يصلها بنفسها غير قابل للكسر و غير قابل أن يُقطع.
إنّ استحالة التحطيم الذاتي للماهية الداخلية للحياة، تحطيما ذاتيا لا ينتهي بوصفه كذلك، هو ما يسمّيه نيتشه سقم الحياة، وهو ما يجعل الإنسان – من حيث أنّه محايثة هي الحيوانية وهو ما يتعلّق الأمر بتقويضه- ” إنسانا مريضا”، ” الإنسان الأكثر سقما” (12).
ليس لنيتشه شيئا آخر غير أن يقدّر بانتباه شديد اللغز المبهم لمرض الحياة هذا، هذه الإرادة للحياة في إيذاء ماهيتها الخاصّة وبالتالي تدمير ذاتها.
لقد وصف كلّ الأشكال التي يحلم بها مشروع هذه القطيعة ، والشكّ إزاء الذات ، وفقدان الإيمان ، والريبية، والموضوعانية والعلموية ونقد الذات في كل مظاهرها – نميل إلى كتابة ” التحليل”- وكل مذاهب سوء النية ، والوعي السيئ، والنظر إلى الذات ، والتأويل والظنّة، وكل المذاهب التي تضع حقيقة الحياة خارج الحياة، جاعلة من زماننا هذا ” الحاضر المعطوب” avarié(13)الذي تفوح منه، مثلما يقول من جهته أوسيب ماندالستام، رائحة سمك متعفّن.
كلّ هؤلاء المؤيدين للقسمة مع الذات ، ” غير المرحّب بهم…هم هؤلاء، الأضعف ، الذين يخرّبون ويفسدون الحياة بين الناس أكثر من أيّ أحد كان، والذين يسمّمون ويشكّكون على نحو خطير جدا في ثقتنا في الحياة، في الإنسان وفي أنفسنا”. (14)
أن تُمثّل قطيعة محايثة الحياة هذه، ما يختصّ به الضعف، فذلك ما نراه بوضوح أكثر لو ألقينا منذ الآن نظرة على صراع الضعفاء مع الأقوياء، على الطريقة التي يسلكها الضعفاء كي يسحبوا القوّة من الأقوياء. إنّ هذا التدمير للقوّة،
هو بالضبط محايثتها لذاتها، التي قد تكتسبها لو توصّل الضعفاء إلى إدماج ضعفهم الخاص في روح الأقوياء،” لو نجحوا في إقحام بؤسهم الخاص وكل بؤس العالم في وعي السعداء ، حتى يأتي يوم يخجلون فيه من سعادتهم وربّما تهامسوا فيما بينهم :” من المؤسف أن نكون سعداء ! يوجد كثير من البؤس!” (15). تتوزّع إذن القوّة والضعف وبكل وضوح على السعادة والخجل، مثل محايثة الحياة ومثل قطيعتها.
أن تكون هذه (القطيعة) مستحيلة، فذاك ما يقودنا في النهاية إلى عمق الضعف وماهيته الحقيقيّة . إذ أن ما يصنع في النهاية ضعف الضعفاء ، ليس فقط ما يختبأ تحت وحل الخجل واحتقار الذات :” ينمو على أرض احتقار الذات هذه ، كمستنقع حقيقي ، كل عشب طفيليّ، وكل نبتة سامّة…” (16)- بمعنى مشروعا رهيبا للتدمير الذاتي : إنّ فشل هذا المشروع هو الذي يمثّل الماهية القصوى للضعف.
إنّ إرادة الحياة أن لا نكون ذواتنا ، وإرادة هدم الذات للذات هو الضعف ذاته من حيث أنّ هذه الإرادة تصطدم مبدئيا بقوّة أقوى منها، بأكبر قوّة ، بقوّة الحياة. كيف يتعارض ضعف إرادة أن لا نكون ذواتنا، في العلاقة الداخلية للحياة بذاتها مع قوّة هذه الذات ويمثّل إذن ماهية الضعف، ماهيةَ ” غير المرحّب بهم” و”غير الموفّقين”؟،
وهو ما يقوله هذا النصّ:” كيف نتجنّب هذه النظرة المكبوتة للإنسان غير الموفّق منذ البداية، هذه النظرة التي تخون الطريقة التي يكلّم بها مثل هذا الإنسان نفسه– هذه النظرة في كونها تحسّرا:” هل يمكنني أن أكون إنسانا آخر، أتحسّر على هذه النظرة، لكن لا يوجد أمل! أنا من أنا : “كيف يمكنني التخلّص من نفسي؟ مع أني قد ضقت ذرعا بنفسي! ” (17) تلك هي ماهية الضعف. هل من حاجة للإشارة إلى أنّ التصوّر النيتشوي للضعف يشبه سوء الفهم ، وضعف اليأس حسب كيركجارد؟
السؤال الثالث: كيف يتغلّب الضعفاء على الأقوياء؟ سؤال يطرح نفسه ، على ما يبدو، بوصفه معضلة لا يمكن تجاوزها إذا ما تعلّق الأمر بفهم كيف يمكن لضعف مشروعِ تخليص الذات من الحياة أن يتغلّب على قوّة تناسقها مع ذاتها في المحايثة، كقوّة غير القابلة للتجاوز.
في الحقيقة ، إذا بدا الضعف وأمكن له التغلّب على أكبر قوّة ، فذاك لأنّه يحملها في ذاته ،طالما أنه موجود و يكون مثلَ أكبر إشارة للضعف، يشترك مع نفسه في الاقتدار الهائل للحياة: لم تكفّ إرادة تخليص الذات من الحياة، للحظة، عن الانتماء إلى الحياة وعن أن تحمل في ذاتها ماهيتها؟
هذا ما يؤكّده نيتشه في التحليل المتميّز للأسقف الزاهد. هنا ولأوّل مرة يُسلّط ضوء ارتجاعي على مجموع المُؤَلّف، فالضعف والقوّة غير موزّعين مثل كيانين منفصلين ، يحيلان إلى فردين مختلفين: يمسك القس الزاهد في نفسه بالواحدة والأخرى ، مانحا رؤية ارتباطهما الداخلي. فالقس الزاهد ضعيف ، وذلك لأنّه إنسان الوعي البائس، أي إنسان الحياة وقد انقلبت على نفسها.
يتميّز عن ضعفاء آخرين من حيث أنّه ( القسّ) هو المُعْتَنِي بمرضهم garde- malade، وبما يملكونه أيضا، ذلك أنّه من المهمّ، لتجنّب عدوى هذا المرض الخطير للحياة ، أن يكون الذين هم في صلة بالمرضى ، خاصّة مقدمي الرعاية، هم أيضا مرضى. بيد أن القسّ الزاهد قويّ، وأقوى ربّما من الأقوياء: لكن يجب عليه أيضا أن يكون قويّا، سيد نفسه أكثر من الآخرين، سليما فيما يخصّ إرادة القوّة ( الاقتدار) لديه.”(18)
ذلك أن هذه المَهَّمَة مدمّرة، وعليه في الآن نفسه، الدفاع عن القطيع ضدّ الأقوياء وضد نفسه. ضدّ الأقوياء ، باختراع عبقري لمثل أعلى زهدي يشرّع العداوة، بقلب القيم ، وبصنعه أشكالا مختلفة من الضعف، يضمن الخير ومختلف أشكال القوّة ، والشرّ ، ويضمن بعملية قلب القيم ، تملّك وهيمنة الضعفاء على الأقوياء.
ضدّ القطيع نفسه: بعد الدفاع عن الضعفاء ضد الأقوياء بتدبير العداوة، يجب منع أن لا يحطّم انفلات هذا العداوة بدوره القطيع، ولأجل هذا ، توجيه هذا العداوة، وقيادتها والتخفيف منها، وهو ما يفعله هذا السّاحر الكبير : يسمّم و يضمّد الجرح في آن واحد. (19)
وحينئذ سيظهر فيه (أي القس) تراكب غريب للضعف والقوّة وكيف يبدّل الأولى إلى الثانية. ففيه ، وبه، سوف تتعهّد حياة مُنْهَكَة ، مَيْئوس منها ، بالحفاظ على البقاء وإنقاذ نفسها. ولكن، ما الذي يمنحها أوّلا في أقصى الضعف، هذه القوّة الخارقة لإرادة استمرارية الحياة، وعدم الاستسلام أمام الأقوياء بل أكثر، استعبادهم – أيّ غريزة للحياة بقيت على حالها؟
إنّها تلك التي يكشفها نظر نيتسه الثاقب في عمق المثل الأعلى الزهدي:”يجد المثل الأعلى الزهدي منبعه في غريزة الدفاع وخلاصَ حياةٍ في طريق الانحلال، حياة تبحث عن البقاء بكلّ الوسائل وتكافح من أجل وجودها؛ إنّه ( مثل أعلى ) يشير إلى كبح وإرهاق فيزيولوجي جزئي، لا تكفّ قبالته، غرائز الحياة الأكثر عمقا والتي ظلت على حالها عن محاربته باختراع وسائل جديدة”.(20).
مذاك ، ينكشف هذا المثل الأعلى الزهدي نقيضا لما نتخذه أولا: ليست حياة مواجهة للحياة ، ضدّ نفسها، بل الجهد المثير للشفقة لهذه الحياة المتلاشية من أجل البقاء :” يشكّل هذا القس الزاهد ، هذا العدوّ الظاهر للحياة … ، هو بالتحديد، جزءا من قوى كبيرة جدّا محافظة وتثبيتيّة للحياة”(21).
ثمّ أيضا :” فيه وبه تصارع الحياة الموت.” (22) ما هو هذا الموت الذي تصارعه الحياة بشغف، يقال هذا أيضا: ليس الموت تحديدا، بل السّقم المميت ، المرض الميتافيزيقي للحياة:” إنّ صراع الإنسان مع الموت ( وبشكل أدق : مع فقدان طعم الحياة ، مع الإرهاق ، مع الرغبة في ” النهاية”(23). كيف إذن للقوّة الأكبر أن تنتشر في صلب الحياة وهي بصدد الانحلال لتنقذها،هذا ما فهمناه : من حيث أنّ هذه الحياة تأتي إلى ذاتها في عظم اقتدار محايثتها.
يظل الارتياب قائما: هل تدرك التحليلات السابقة تماما إمكانية الضعف ، وأصله؟ إذ لماذا تنقلب الحياة على ذاتها؟ من أين يأتيها هذا المشروع الشاذّ بأن تتخلّص من ذاتها؟ يقول نيتشه: من الألم. ” القطيع غير المرغوب فيه …مِن هؤلاء الذين يتألّمون من أنفسهم.” (24) نحال إذن إلى التحديد الثاني الأساسي للحياة: العاطفة أو الانفعال.
يبدو الألم لدى نيتشه محتقرا حينا، وموضوع تقريظ لا مشروط حينا آخر. بيد أنّه إذا ما نظرنا في النصوص عن قرب فسنتبيّن أنّ الألم لم يكن مُدَاًنا في ذاته بل فقط الكره أو الانتقام هو الذي يفترض وبشكل أدقّ أن يثير هذه الإرادة الخاصّة جدّا التي تولّدها حينما ، تصبح غير محتملة أي غير قادرة على تحمّل ذاتها ، فيَشْرع الألم في التخلّص من ذاته.
إنّه (أي الألم) إرادة الحياة في أن لا تكون ما هي عليه لكنّها المشروع ذاته للضعف. حينما لا يولّد الألم العدمية ، يكون موضوع احتفاء في أيّ مكان آخر: ” ألا تعرفون من ثقافة الألم، من أكبر الألم ، أنّه هنا يكمن السبب الوحيد لكلّ تجاوز للإنسان؟”(25) ها هو لماذا، مثلا يكون أوديب هو ذاك الذي” من فرط آلامه، يمارس حول نفسه عملا سحريا حسنا”(26).
على العكس وبشكل مفارقي، تُتّهم المسيحية ، مثل وريثها ” الحركة الديمقراطية” ، بموجب ” قصورها الأنثوي تقريبا لرؤيتها تتألّم ، وتترك الآخر للألم”.(27)
الخيّرون، والأقوياء ، والأسياد هم سعداء. ماذا يعني هذا الاحتفاء بالألم؟ إنّه يضعنا أمام حدس عميق لنيتشه، بأنّ الألم والفرح لا يتعارضان بل هما نفس الشيء، بل أكثر من ذلك، يكوّنان معا حقيقة الأشياء.
ماهية الحياة، وحدتهما، هو ما يسمّيه نيتشه الواحد الأصلي l’Un originaire. نوضع ، منذ ولادة التراجيديا، أمام هذه الهوية للألم والفرح الذي يُقترح علينا في شكل تغيير سحري للأولّ ( الألم) إلى الثاني. نشهد في التراجيديا محنة البطل ، أيّ كان– تريسان أو أدوديب-، الذي هو البطل الشوبنهاوري ، وقد هيّجته الرغبة ، يصارع مسار العالم الذي ، سينقلب عليه لا محالة ويُبِيده. بيد أنّه، وبينما نَشهد ، قَلِقين ، مِحَنَ البطل وفي النهاية موته، تجتاحنا متعة غير مفهومة أرفع منّا بكثير.
ذلك أن نهاية هذا البطل، ومشاريعه ورغباته هي فناء هذا العالم الظواهري كلّه، وأنّه عبر هذا الفناء للعالم ينكشف لنا عمق الأشياء، ماهيتها السريّة، بمعنى إرادة الاقتدار. غير أنّ هذا الانكشاف لإرادة الاقتدار هو في ذاته المتعة اللامحدودة التي تمنحنا إياها التراجيديا.
أو بالأحرى فإنّ هذا الانكشاف هو في الآن نفسه ألم وغبطة. وليست رؤية معاناة البطل سوى مناسبة لتذكيرنا وحتّى نعيش من جديد الألم اللامحدود للحياة الذي هو كذلك بهجته ولذّة وجوده.
كيف ذلك؟ فالحياة هي ما يُختبر بذاته، هي بشكل أدق اختبارنا أنفسنا، دون مسافة، إنّها تألّم مباشر، تألّم للذّات، يجد فيه الألم إمكانه. لكن تألمّ الذات ، من أجل الحياة ، هو الإغتناء في حدّ ذاته، الترفع بذاته وهو الاستمتاع بالذات. فليس الألم والفرح نبرتان مختلفتان ، منفصلتان ومتعارضتان كلّ منهما مكتفي بذاته وقائم بذاته.
بل على العكس كل منهما ماهية للأخرى، كي يكوّنان إذن هذا ” المزيج المدهش للانفعالات” الذي يكشف عن ” ازدواجية مجانين ديونوزوس” (28)، أي أولئك الذين يماثلون أنفسهم بالإله، بالماهية الفريدة للأشياء. هذا المزيج من الانفعالات، هو ” هذه الظاهرة التي تستيقظ بواسطتها اللذّة من الألم ذاته” (29).
و”الظاهرة” التي تستيقظ بواسطتها اللذة من الألم ، هي الماهية الأصلية للظاهراتية phénoménalité، وهي الاغتناء الأصلي للكائن في حدّ ذاته- الألم الذاتي في ارتفاع الذات في متعتها الخاصّة.
لا يوجد الكائن ، إنّه نموّ venue ، النموّ في ذاته الأبدي للحياة . و لا يحدث مثل هذا النموّ انطلاقا من المستقبل، و لا يذهب إلى الماضي. إنّه نموّ اللذة انطلاقا من الألم ، على نحو يكون فيه هذا الألم ، التحقّق الفينومينولوجي لتألم الذات من الحياة، الذي يمثّل كذلك لذّتها الذاتية.
هذا الارتباط الداخلي للألم بالفرح يعبر كل ّ مؤلّف نيشته ويستخدمه كدعامة غير مرئية. لنتأمّل مثلا في جينيالوجيا الأخلاق . إنّها تتحقّق في الظاهر انطلاقا من علاقة اجتماعية أولى هي علاقة المدين والدائن والناتجة عن تبادل البشر لمنتوجات يصنعونها.
ينشأ داخل هذه العلاقة الأولى الدَّيْنُ ، والشعور بالإلزام الشخصي ، وضرورة التذكّر وبالتالي تربية حيوان يقدر على أن يَعِدَ ، والاعتراف بوجود الضرر، وقبول ضرر العقاب بوصفه تعويضا عن ضرر. إنّ شبكة هذه العلاقات هي من الكثافة بمكان بحيث تفسّر بدورها علاقة الفرد بالمجتمع ، وبالأسلاف وفي النهاية بالإله.
لكن يبدأ التسلسل الأساسي لهذه الجينيالوجيا للأخلاق حينما لا يردّ المدين الدَّيْن للدائن، الذي له الحقّ إذن في تعويض غريب ، لا في شكل نقد أو مقايضة بل الحقّ في جعل المدين تحديدا يتألّم، بضربه ، وسوء معاملته، بشتمه أو حتّى باغتصابه.
من هنا كان السؤال العميق لللجينيالوجيا:” كيف يمكن للألم أن يكون تعويضا عن دين؟” والجواب ليس بأقل عمقا:” لأنّ التألّم يمنح لذّة كبيرة وأنّ من يعاني من الضّرر والضيق يحصل في المقابل على نقيض المتعة: أن يُؤْلِم غيره – احتفال حقيقيّ.” (30)
قد نقول: لكن يتعلق الأمر ببساطة بالانتقام. غير أن الانتقام يرجعنا إلى نفس المشكل:” كيف يمكن أن يكون إيلام الغير رضا أو إشباعا؟” قد نقول بأن الأمر يتعلّق بقسوة أو بوحشية؟ غير أن الوحشية ليست هي أيضا سوى اللذة التي تعقب الألم.
في القسوة وفي الانتقام ، يبدو أن الألم والفرح متخارجين أحدهما عن الآخر ، مرابطتين بشخصين مختلفين، الألم مرتبط بالمدين والفرح بالدائن( الذي يشعر بلذة كبيرة في جعل المدين يتألم وقد أضرّ به وبالتالي الانتقام منه). لكن هنا في الظاهر. إذ يجب أيضا تفسير كيف يمكن لألم ، الدائن ذاته ، للضرر الذي لحقه ( حينما لا يردّ المدين دينه) أن يتحوّل إلى فرح بجعل المدين يتألّم.
وبالمثل يجب تفسير هذا التحوّل للألم إلى فرح لدى المتفرج في الكوميديا – وفي النهاية لدى ديونوزوس ذاته، الذي ليس شيئا سوى ماهية الحياة. ليس الأقوياء كما الضعفاء ، كما الانتقام كما القسوة سوى أشكالا للحياة ،تفصل بين المكوّنات الداخلية للواحد بغرض أن تقدّمها للنظر.
ومن بين فضاعات اليونان القديم التي تفتن نيشته كثيرا، التضحية بإنسان شابّ أعضاءه ممزّقة ودامية متناثرة ومنتشرة في الأرجاء على نحو يثري هذا الدم الأرض ويوصلها بالحياة . إنّ فلسفة نيتشه هي هذا القتل الطقوسي ، الذي هو الفصل dis-jonction و الإسقاط pro-jection المضخّم في سماء الأسطورة ، لبنية الذاتية المطلقة.”
محاضرة ألقيت في جامعة نيس في 1991 ونشرت لأول مرة بالانجليزية تحت عنوان:” onNietzsce’s: We good ,beautiful ones!” في ” the graduate faculty philosophy journal, New york n : 15l2 ,1991 p 131-141.
ميشيل هنري
في الذاتية الجزء الثاني ( فينومينولوجيا الحياة).
الفصل الثامن ص: 147-161 ( puf 2003).
- – هوامش:
1- “نحن الشرفاء ، الخيرون ، الجملاء، السعداء “: انظر نيتشه ، جينيالوجيا الخلاق ، المقالة الأولى :” الخيرون والأشرار”، ، الحسن والسيء”، 10، ترجمة هيلدانبرنت و ج. قراتيان في العمال الكاملة ، باريس قاليمار 7 ، 1971 ص .234
2- نيتشه ، من وراء الخير والشرّ 295 ترجمة س. هايم في الأعمال الكاملة
3- نفس المصدر ص71
4- نيتشه ، جينايلوجيا الخلاق ” المقالة الثالثة” : ” الخطا” ، ” الوعي السيء” الترجمة المذكورة ص252
5- نفس المصدر ص 251
6- نفس المصدر ًص 254
7- نفس المصدر ص254-255
8- نفس المصدر ص254
9- نيتشه ” جينيالوجيا الخلاق” : المقالة الأولى : ” الخيرون و الأشرار” الحسن والسيئ ، 13
10- نفس المصدر ص241-242
11- نفس المصدر ص 184
12- نيتشه ، جينيالوجيا الأخلاق ، المقالة الأولى …ص 310وص346
13- نفس المصدر ص 286
14- نفس المصدر ص 312
15- نفس المصدر ص 314
16- نفس المصدر ص 312
17- نفس المصدر
18- نفس المصدر ص 315
19- نفس المصدر ص 315-316
20- نفس المصدر ص310
21- نفس المصدر
22- نفس المصدر
23- نفس المصدر
24- نفس المصدر
25- من وراء الخير والشر 225 ص 18
26- ولادة التراجيديا 9، ترجمة لاكو- لابارت ص78
27- من وراء الخير والشر 202 ص119
28- ولادة التراجيدياé، ص 48
29- نفس المصدر
30- جينيالوجيا الخلاق المقالة الثانية6، ص 258