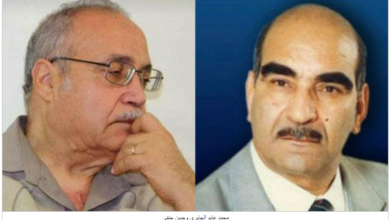أركيولوجيا الذاكرة .. أضواء على حياة محمد عابد الجابري

ارتبط اسم محمد عابد الجابري بمشروعه الفكري في قراءة التراث، والذي استهله بكتابه المعروف “نحن والتراث“، ليكتمل بإصدار رباعية “نقد العقل العربي“؛ ومن ثم صار الحديث عن المفكر مقرونا بإنتاجه؛ حتى لكأن سيرة الجابري هي سيرة فكره.
أو بعبارة أخرى لقد تشكلت صورة الشخص في أذهان الناس مما كتبه في الفكر والنقد. وهي صورة تظل، في نظرنا، ناقصة إذا لم تكتمل بصورة المفكر الإنسان؛ أي حضور الجانب السير-ذاتي في مسار المؤلف.
ومن المثير للانتباه أن الكتاب العمدة في حياة هذا المفكر الكبير، والذي هو سيرته الذاتية ”حفريات في الذاكرة من بعيد”(1) الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 1997، لم يلق الاهتمام المطلوب، والرواج المتوقع له، مثلما راجت سير بعض رفاقه من المفكرين وزعماء اليسار.
لقد مر أزيد من عقدين من الزمن ولم تطبع هذه ”الحفريات” من جديد، فظلت كثير من تفاصيل حياة رجل يحظى باحترام كبير، من الخصوم قبل الأصدقاء، خفية على القارئ العام. تلك التفاصيل التي تشبه غالبية أطفال المغاربة في القرى النائية، والمداشر، والجبال، والقفار.
من هذا المنطلق، ارتأينا تسليط الأضواء من جديد على جوانب من حياة مفكك العقل العربي. تلك المتعلقة بالطفولة الأولى في مدينة فجيج الشرقية، في منتصف ثلاثينات القرن الماضي، وما عرفته حياته في وقت لاحق من تقلبات على المستوى الفكري والعاطفي.
لن نقف إذن على المسيرة الفكرية والتجربة السياسية للجابري، والتي سجل أغلب مراحلها في سلسلته الشهرية ”مواقف”، وإنما عنايتنا سوف تنصرف إلى ممارسة نوع من الحفر الأركيولوجي في حياة الأستاذ الجابري ما قبل ”الشهرة”.
إن ما يهمنا أساسا ليس الجابري المفكر المعروف، وإنما الجابري الطفل الأمازيغي البسيط، وكيف انبعث من الهامش، من بيئة صحراوية قاحلة في المغرب الشرقي، ليسطع اسمه في سماء الفكر العربي المعاصر.
- 1 – الحفر في القشرة الخارجية: قراءة في خطاب العتبات
- 1-1 موقع “حفريات في الذاكرة” من مؤلفات الكاتب
يلاحظ متابعُ الإنتاجات العلمية للجابري غزارتها وتنوعها، لقد كتب المؤلِّف في التربية، ونقد التراث، وإشكاليات الخطاب العربي المعاصر، وتفسير القرآن الكريم وغيرها من المجالات المعرفية، وهو ما يعكس تعدد اهتمامات المؤلف من جهة، وموسوعية ثقافته من جهة أخرى.
ولا يخفى أن مجمل هذه الكتابات قد اتخذ صبغة علمية نقدية، لعل أبرزها وأشهرها مشروع “نقد العقل العربي”. فما موقع حفريات في الذاكرة من هذه المؤلفات ؟ وما صلة هذا الكتاب بها؟
يختلف كتاب حفريات في الذاكرة، بحكم طبيعته، عن باقي مؤلفات الكاتب؛ ذلك أن الجابري في هذا الكتاب، انعطف عن مجال الفكر والنقد، وانتقل إلى مجال آخر هو أقرب إلى الكتابة الأدبية السردية منه إلى الكتابة العلمية النقدية.
بيد أن هذا الاختلاف في طبيعة التجنيس لا يعني القطيعة، إذ يمكن اعتبار حفريات في الذاكرة امتدادا لمؤلفات الجابري الأخرى، ويتجلى ذلك في مظهرين على الأقل:
أولا: إن المؤلف وهو يمارس الحفر في ذاكرته، مسترجعا ذكريات الصبا والمراهقة وأوائل الشباب لم يكن عمله هذا ضربا من الترف الذي يميل إليه الكتّاب عادة في أواخر العمر، بل لعل الدافع الأساس وراء ذلك هو محاولة تقديم صورة، ولو تقريبية، عن مسار إنسان سيصبح فيما بعد من أهم أعلام الفكر العربي المعاصر.
ومن ثمة فالقارئ المطّلع على أعمال الجابري الفكرية، وهو يقرأ حفريات الذاكرة، لابد أن يقوم بعملية ربط ذهنية بين الوقائع والأحداث الماضية وما آل إليه الوضع الاعتباري للمؤلف فيما بعد، وذلك بالبحث عن المنعطفات التاريخية في حياته، والتي كان لها بالغ الأثر في مساره الشخصي والعلمي.
وعليه، فحفريات الذاكرة كتاب لا ينفصل عن مؤلفات الكاتب الأخرى بقدر ما يتصل بها اتصالا شديدا من جنس قرابة العائلة الواحدة.
ثانيا: إن اللغة الواصفة البعيدة، إلى حد ما، عن مظاهر البلاغة والبيان التي كتبت بها حفريات الذاكرة من جهة، والمنهج الذي سلكه الكاتب في عرض وقائع من حياته، القائم أساسا على الحفر في الذاكرة ، واستبطان أحداث الماضي، واستنطاق الذكريات،
من جهة أخرى، فضلا عن استدعاء الكاتب لمختلف التجارب العملية والقراءات النظرية والمخزون الثقافي الذي اكتسبه عبر عقود من الزمن؛ من علم النفس، وعلم التربية، والأنثربولوجيا، والسوسيولوجيا، والفلسفة، وغيرها من المجالات التي توسل بها الجابري لاستنطاق ذكرياته، وعرضها بنوع من التأويل والتفسير.
كلها مؤشرات دالة على أن المؤلف لم ينأ كثيرا عن مجال اشتغاله كباحث والذي هو الفكر والنقد، في عرضه لذكرياته الشخصية، رغم محاولته المستميتة كي يظل طابع العفوية والسليقة مهيمنا على النص.
ذلك أن ما من وقيعة يتعرض لها المؤلف إلا ويقرؤها نوعا من القراءة النقدية، مضفيا عليها “معنى” من المعاني، محاولا فهمها عن طريق آليتي الوصل والفصل؛ وصلها بالماضي وفهمها داخل سياقاته التاريخية والاجتماعية والنفسية، وفصلها عنه؛ لفهمها فيما نتج عنها بعد ذلك.
وإذن، فالجابري لم يبتعد كثيرا في “حفريات الذاكرة” عن الإطار المنهجي والنقدي الذي تحرك داخله في مؤلفاته الأخرى. ولما كان من المسلم به القول إن لكل كِتاب موضوعه الخاص ومنهجيته الملائمة لطبيعة الموضوع.
فإن حفريات في الذاكرة كتابٌ وإن كان يشكل امتدادا لمؤلفات الكاتب، كما سلف الذكر، فإن اختلافه عنها يبقى اختلافا بالدرجة الأولى، في الطبيعة، طبيعة موضوعه ومنهجيته، باعتبار جنسه الأدبي. وهو ما سنقف عنده في العنصر الموالي.
- 2-1 في مسألة تجنيس الكتاب
تطرح محاولة تجنيس كتاب “حفريات في الذاكرة” إشكالا نظريا أمام القارئ، ومرد ذلك إلى أن صاحبه انتقل فيه إلى مجال غير معهود في مساره كمفكر ألا وهو مجال الأدب. فبعدما كان الجابري يكتب في مجال الفلسفة، مع ما يتطلبه الاشتغال الفكري النظري من بحث واستقصاء واعتماد المصادر والمراجع، وآليات التفكيك والتحليل والتفسير وغير ذلك.
انتقل في هذا الكتاب إلى نوع آخر من الكتابة، إنها الكتابة عن الذات، حيث لا مصادر ولا مراجع غير الذاكرة؛ ذاكرة الكاتب الفردية أو الذاكرة الجمعية للأقرباء والأصدقاء من مجايليه. وحيث السرد هو الأداة الأساس لعرض الوقائع، وحيث الذات، أولا وأخيرا، هي الموضوع.
وبما أن المؤلف كتب عن ذاته وما يتعلق بها من ذكريات، وهو ما يتصل في مستوى أول بمجال الكتابة السيرذاتية، وبما أنه لم يلتزم بمجمل المبادئ المقررة لدى نقاد ومنظري هذا الجنس الأدبي، في عرض ذكرياته، خاصة ما يرتبط منها بمستويات البناء واللغة والحكي والوصف، وهو ما يتصل في مستوى ثانٍ بما بات يعرف في الدراسات النقدية الأدبية بـ”محكي الحياة”، أو السرد الذاتي.
بناء على ذلك يمكن القول إن كتاب حفريات في الذاكرة لا يخرج عن إطار نوعين أدبيين: فهو إما سيرة ذاتية أو محكي حياة.
- حفريات في الذاكرة: سيرة ذاتية.
إن ما يسوغ إدراج حفريات الذاكرة ضمن جنس السيرة الذاتية، هو التزامها، عن قصد أو دون قصد، بأهم مقومات هذا الجنس الأدبي، ولعل أهمها ما حدده الناقد الفرنسي فيليب لوجون Philipe Le Jeune في عمله المعروف “ميثاق السيرة الذاتية”.
إذ يقول معرفا السيرة الذاتية: ” هي حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة”(2).
وبالعودة إلى سيرة الجابري نجد أنها تتمثل جميع هذه المقومات، وتوضيح ذلك فيما يلي:
– حكي استعادي: بما أن المدى الزمني الذي تتأطر داخله وقائع وأحداث ‘الحفريات” يتحدد ما بين منتصف ثلاثينات ونهاية خمسينات القرن الماضي، وبما أن الكاتب في لحظة الكتابة يوجد في أواخر تسعينات القرن نفسه، فمؤكد أن المؤلف قد اعتمد تقنيتي الاسترجاع والاستذكار (فلاش باك)؛
– حكي نثري: المؤلف يحكي بلغة واصفة نثرية ذكرياته الماضية؛
– يقوم به شخص واقعي: إن الذي يحكي سيرته هو محمد عابد الجابري، وقد أشار إلى اسمه العلَم في أكثر من موضع داخل العمل؛
– الحكي عن الوجود الخاص بالتركيز على الحياة الفردية وتاريخ شخصية الكاتب: وهذا ما سلكه المؤلف، عن طريق عرض ذكريات الصبا والمراهقة وأوائل الشباب متتبعا سيرورة تطور شخصيته خلال ما يغطي ربع قرن من عمره.
وعلاوة على هذه المقومات، يشير فيليب لوجون في موضع آخر من كتابه المذكور إلى شرط أساسي لتمييز السيرة الذاتية عن غيرها من الأنواع الأدبية المتصلة بها (المذكرات، الاعترافات، اليوميات، السيرة الروائية…إلخ)، إذ يقول: “لكي تكون هناك سيرة ذاتية يلزم توفر تطابق بين المؤلف والراوي والشخصية الرئيسية”(3).
ويهمنا من هذا القول لفظة “تطابق”، ومعلوم أن التطابق مبدأ يقضي بحصول نوع من التماهي بين العناصر السابقة، فالمؤلف هو الراوي والشخصية الرئيسية في الآن ذاته. الأمر الذي التزم به الجابري في حفرياته إلى حد بعيد.
- حفريات في الذاكرة: محكي حياة
يقصد بمحكي الحياة Récit de vie، ويسمى أيضا الوثيقة المعيشة Le document vécu، ذلك النوع من الأدب الملحَق Paralittérature، و”الذي تنتفي فيه الأدبية، ويكتب لإثارة القراء وإمتاعهم بمغامرات من صلب الواقع”(4)،
غير أننا نرى أن هذا التعريف لا ينطبق تماما على حفريات الذاكرة، ذلك أن ما عرضه الجابري من وقائع حياته حضر فيه قدر من الأدبية، كما أنه لم يهدف بالضرورة إلى الإثارة ولا إلى الإمتاع، إن ما هدف إليه بدرجة أولى من كتابة السيرة هو محاولة قراءة مرحلة من مراحل حياته الشخصية بـ “القيام بعرض وتحليل، مع نوع من التأويل، لما يبدو للكاتب ]…[ أنه يستحق، على وجه ما، أن يحكى وينقل إلى القارئ”(5).
وإذن فحفريات الذاكرة وفق هذا الفهم، من حيث أحداثها، سيرة لا تختلف كثيرا عن سير سائر الناس. ولذلك فإن كان من شيء يضمن رواجها، وإثارة فضول القراء للاطلاع عليها، فهو المكانة الرمزية لصاحبها، باعتباره أحد أهم أعلام الفكر العربي المعاصر.
قد لا يكون هذا التفسير، الذي ذهبنا إليه، على درجة عالية من الصواب، ولكن، مع ذلك، فوضع الكاتب الاعتباري يتدخل إلى حد كبير في رواج السيرة من عدمه، إنه شرط- كما يقول الباحث إحسان عباس- “أساسي في السيرة الذاتية بخاصة.
إذ لابد لشمول الرغبة فيها أن يكون صاحبها ذا صلة دقيقة بأحداث كبرى، أو أن يكون ممن لهم مشاركة في بعض تلك الأحداث، أو أن يكون]…[ ذا نظرة خاصة إلى الحياة وحقائق الكون؛ قد تجعله سابقاً لأوانه متقدما على أبناء عصره، أو ذا غاية كبيرة ]…[ فإن الجواذب التي تجذب الناس إليه إنسانية أولا”(6).
والواقع أن ليست هذه الاعتبارات وحدها ما دفع الجابري لكتابة سيرته الذاتية. إذ ينفي المؤلف ذلك قائلا: “لم أشعر لا من قبل ولا من بعد بأي ضغط ناتج عن أي اعتبار ذاتي ولا موضوعي. فيما يتعلق بالكتابة تعودتُ أن آخذ حريتي كاملة وأن أتصرف بكل استقلال عن أي ضغط خارجي، باستثناء التقيد بقواعد الكتابة، ومنها الضرورة التي تفرضها اللغة، والضرورة التي يفرضها الصدق”(7).
ومهما يكن من أمر، فسواء أ كانت حفريات في الذاكرة محكي حياة، أم سيرة ذاتية، فإن الشرط الأهم الذي يعني القارئ التزامَ الكاتب به، في هذا الجنس من الكتابة، هو تحري الصدق، “فإذا ضعف عنصر الصدق في السيرة لم تعد تسمى سيرة لأن الخيال قد يخرجها مخرجا جديدا ويجعلها قصة منمقة ممتعة”(8).
ولعل أهم ما يجيز لنا إدراج حفريات الذاكرة ضمن جنس السيرة الذاتية هو صدقها، فالجابري عرض سيرته
باعتبارها وقائع مرتبة زمنيا من الطفولة الأولى، مرورا بالمراهقة، فأوائل الشباب. دون أن يشغله همّ إضفاء طابع فني إبداعي على نصه لإمتاع القارئ وتلبية فضوله الأدبي، كما اعتدنا ذلك، مثلا، في “أيام” طه حسين، و”حياتي” لأحمد أمين، و”في الطفولة” لعبد المجيد بنجلون و”الخبز الحافي” لمحمد شكري، وغيرها من السير التي يتداخل فيها ما هو روائي بما هو سيرذاتي.
“إن السيرة الذاتية هي أولا وأخيرا، شهادة، والشهادة لا توزن بمعايير اليقين ولا بميزان النجاح والفشل، بل توزن بميزان واحد هو الصدق. وعندما يسلم المرء نفسه إلى حاكمية الصدق فليس له أن يتخيل ولا أن يبدع ولا أن يتفنّن. شيء واحد يُغفر له هو أن يخطئ عن غير قصد”(9).
والحق أن هذا الكتاب، الذي نحن بصدد تحليله، ليس بمحكي حياة، ولا بسيرة ذاتية، بالمعنى الدقيق لهذين المصطلحين، إنه ببساطة: “حفريات في الذاكرة من بعيد”. فما مرجعية هذا العنوان؟ وما أبعاده؟
- 3-1 مرجعية العنوان وأبعاده
من المفترض أن يثير عنوان الكتاب في ذهن القارئ ثلاثة تساؤلات على الأقل:
ما مرجعية كلمة “حفريات”؟
وكيف جاز للكاتب الحفر في ميدان مجرد هو الذاكرة؟
وما دلالة البُعد في العنوان الفرعي “من بعيد”؟
ينتمي مصطلح حفريات، كما هو معلوم، إلى علم الأركيولوجيا L’archéologie، وهو مصطلح انتقل إلى العلوم الإنسانية مع الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو(10)، ويقصد به، على الخصوص، الحفر والتنقيب عن اللامفكر فيه والمسكوت عنه في مختلف النصوص والخطابات الإنسانية.
ولعل هذا المعنى هو ما أجاز للجابري استعمال “حفريات” للتعبير عن عملية استرجاع ذكرياته. كما يُلاحظ انشغال المؤلف بعملية التذكّر لحظة الكتابة على نحو مثير للانتباه، ولا شك أنه مدفوع في ذلك بحاكمية الصدق، ويظهر ذلك جليا في تكراره الملحوظ لعبارة “يتذكر صاحبنا…” التي هيمنت على جُمل النص.
لما كان المؤلف مشغولا بالرجوع إلى الماضي، والبحث عما يستحق “أن يُحكى وينقل إلى القارئ” من حياته، وبما أن هذا الماضي قد تعرض بفعل التقادم إلى عوامل تراكم الذكريات وتدافعها، وتغطية بعضها بعضا أو خنقه أو محوه أو إلغائه.
ولما كان ما يبقى صامدا من تلك الذكريات أشبه بالقطع الأثرية المقاومة لكل عوامل النسيان والتلاشي، فإن الكاتب وجد نفسه في موقع الباحث الأركيولوجي، فعمل على الحفر وتعرية ما توارى منها، وترميم ما أخذ في التحلل. وبعبارة واحدة: ممارسة الحفريات في ذاكرة الماضي، من بعيد.
تفيد عبارة “من بعيد” التي جعلها المؤلف عنوانا فرعيا، اتخاذ مسافة طويلة من الشيء. وإذا علمنا أن الجابري عمد إلى لغة الرمز والإشارة والإيحاء في أكثر من موضع من سيرته، فإن ذلك يجيز لنا فتح باب التأويل لفك شفرات رموزه وإشاراته. ومن التأويلات التي يمكن تقديمها لعبارة “من بعيد” ما يلي:
البعد الزمني: وهو الظاهر في كون العبارة صادرة عن الكاتب في الحاضر، من قريب، في لحظة الكتابة، ما يدل على الالتفات إلى الزمن البعيد، زمن الماضي، لسرد وقائع من مرحلة الصبا فالمراهقة ثم الشباب. وهذا “الالتفات إلى الماضي” هو ما عبر عنه المؤلف، في مكان آخر(11)، بالإحساس “بالقِدم”،
ويقر الكاتب بأنه استوحى هذه العبارة من جدته التي كانت كلما حكت له أحداثا تعود إلى ماضيها البعيد، ختمت ذلك الحكي بعبارة (آه كم أنا قديمة !)، والراجح أن الجابري قد انتابه إحساس جدته عندما التفت إلى ماضيه، من بعيد؛
البعد المكاني: إن معظم أحداث السيرة يجري في المغرب الشرقي، في مسقط رأس الكاتب بمدينة فجيج، مرورا ببوعرفة، فوجدة وضواحيها، ثم الرباط والدارالبيضاء ودمشق. وبما أن المؤلف كتب سيرته في منزله بالدارالبيضاء، مسافرا عبر ذاكرته إلى مسقط رأسه إلى واحات وقصور فجيج، خاصة قصر أولاد جابر، “القصر الخراب”، الذي ظلت أطلاله شاهدة على أحداث جسام عاشها أجداد الجابري،
فلا شك أن هذا الأخير، شعر، لحظة الكتابة، بمثل ما كان يشعر به الشاعر الجاهلي وهو بعيد عن الديار، ذلك الشعور الذي يمتزج فيه البعد عن الأهل، بالإحساس بالغربة وما يصاحبه من رجّات في الوجدان والذاكرة؛
البعد “عن المشاكل”: إن عبارة “من بعيد” لا تفيد مفهوم البعد ببعديه الزمني والمكاني فحسب، بل إنا نرى أنها تشمل أيضا ما يلاحظه القارئ من “حياد” في سرد الأحداث، وهو ما يمكن وصفه هنا “بالبعد عن المشاكل”، يتجلى ذلك من خلال مجموعة من الإشارات منها على الخصوص:
– الملاحظة الأولى التي صدّر بها المؤلف سيرته: والتي جاء فيها “باستثناء بعض الشخصيات التي ذكرت في سياق وطني، لاشخصي، اقتصرنا على ذكر أسماء الذين فارقوا الحياة من الأهل والأصدقاء ولم نذكر أسماء الأحياء تجنبا للإحراج”(12).
وتعنينا هنا العبارة الأخيرة “تجنبا للإحراج”، والتي تشير إلى أن المؤلف كان واعيا تمام الوعي بخطورة السرد الذاتي، أو تعرية الذات أمام القارئ، ما قد يدفع بالكاتب، أيّ كاتب، أحيانا إلى إفشاء أسرار خطيرة شخصية، أو انتهاك حرمات أشخاص آخرين جمعته بهم أحداث ما.
وقد تصل خطورة الأمر، في أحايين أخرى، إلى مقاضاة الكاتب في ردهات المحاكم، ولربما اغتياله. ولذلك لم يشر الجابري في سيرته إلا إلى أسماء الموتى. فالموتى، على أية حال، لا يتحرّجون ولا يقاضون ولا يخلقون المشاكل!
– الالتزام بالأعراف: وإلى جانب تلك الملاحظة، يبدو أن الجابري التزم باحترام الأعراف، وعدم ذكر أي شخص من شخوص سيرته بما يسيء إلى سمعته؛ فلم يخدش صورة أبيه الذي طلّق أمه وهي حامل به، اعترف بما لأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده من فضل عليه في تنشئته.
تفهّم موقف جدته لأبيه التي طلقت أمه لسبب تافه كان “جاري به العمل” في محيطه الاجتماعي آنئذ. وإذن، لقد نجح الكاتب، إلى حد ما، رغم صعوبة هذا الأمر، في أن يظل طرفا محايدا، نائيا بنفسه عن المشاكل.
– توظيف ضمير الغائب: كما أن توظيف ضمير الغائب المعبر عنه في السيرة بعبارة “صاحبنا”، ينطوي بدوره على دلالة البعد، فمعلوم ما يحمله ضمير المتكلم من مسؤولية وتبعات، ومراقبة ذاتية، في حين أن إسناد السرد لطرف آخر، يمنح للكاتب حيزا من الحرية في النظر إلى نفسه من الزاوية التي ينظر منها القارئ، هناك، من بعيد.
وبهذا يصبح ضمير الغائب وسيلة لوضع مسافة بين المؤلف والشخصية؛ لقد نصّب الجابري نفسَه “أستاذا يتحدث عن طفل، وعلى لسانه، قبل أن يتعلم هذا الطفل الكلام، قبل أن تكون له ذاكرة،]…[ قبل أن يتقوى فيه الوعي بالوعي إلى الدرجة التي يغدو معها قادرا على نقل هذا الوعي بالوعي إلى اللغة، إلى كلام ! لقد استمر كلام الأستاذ عن الطفل وباسمه، كذات له ثانية، إلى المرحلة التي لم يعد فيها من الممكن النيابة عنه، اللحظة التي أصبح فيها راشدا”(13).
هذا فضلا عما في الحكي باعتماد ضمير الغائب، وعبارة “صاحبنا” (بالجمع) من إشراك للمتلقي في سرد الأحداث؛ وذلك بعقد علاقة ألفة وصداقة بينه وبين المؤلف والشخصية البطل، من جهة. ومن جهة أخرى، ينطوي ضمير الغائب على قيم التواضع والتأدّب ونكران الذات.
كانت هذه ، إذن، جملة من العتبات، حفرنا فيها حفرا خارجيا حاولنا من خلاله ولوج “أجواء” حفريات الذاكرة، وفيما يأتي سنحاول تشكيل جانب من صورة الجابري الإنسان وبيئته من خلال سيرته، لكن هذه المرة بالحفر في باطن النص، بالتوغل أكثر في أعماقه والتنقيب عن المسكوت عنه بين السطور.
- 2 الحفر في الطبقات الباطنية: صور الجابري وبيئته
- 1-2الجابري الطفل أو حمّو عابد
يستهل الجابري سيرته بعرض خمس من وقائع طفولته بقصر زناكة بمدينة فجيج(14)، حيث وُلد ونشأ نشأته الأولى. غير أننا لن نقف، هنا، عند كل واقعة على حدة، لما في ذلك من تكرار لن يغني، بحال من الأحوال، عن قراءة النص.
ولكننا، مع ذلك، ارتأينا الوقوف على واقعتين، هما في نظرنا، من أقوى تلك الوقائع، مع تقديم نوع من التأويل لكل واحدة منهما:
أولاهما: حادثة جرت والجابري ما يزال رضيعا يحبو، فاتجه برأسه نحو أمه المنشغلة في غزل الصوف، محاولا اختراق الفجوة ما بين رجل أمه اليسرى المسرحة على الأرض، وساقها اليمنى المنتصبة في شكل زاوية، لقد اتجه الرضيع نحو المنطقة الوحيدة من جسم أمه، والتي كانت تشكل بالنسبة له المجهول الأكبر.
فلم يشعر إلا ويد أمه تدفعه بعيدا عنها دفعة قوية عنيفة قضت على فضوله، لقد شعر لأول مرة من خلال تلك الدفعة العنيفة أن أمه شيء، وأنه هو شيء آخر(15).
تكشف هذه الحادثة، على بساطتها، عن أمرين:
– بداية الوعي بارتكاب المحظور، وما ينتج عنه من عقاب، فيستوجب احترام الحدود المرسومة سلفا؛
– طبيعة المحيط الاجتماعي المحافظ الذي نشأ فيه الجابري، حيث الأعراف هي القانون الأسمى. ومن المعروف أن سلطة الأعراف تفرض على المرأة في المجتمع الأمازيغي البدوي، كما في مناطق أخرى من المغرب، التستر وحجب جسدها عن الآخر دائما، حتى وإن كان هذا الآخر مجرد رضيع يحبو!
ثانيهما: حادثة انهيار سقف مسجد الجامع بقصر زناكة: وكان المؤلف حينذاك قد شارف الثالثة من عمره، وكان يدعى يومئذ “حمّو عابد” (من الملاحظ أن الأسماء العربية عند أهل فجيج، وفي المجتمع الأمازيغي عامة، يطالها نوع من التحريف والتخفيف والاختزال حسب المراحل العمرية للشخص.
فمثلا: محمّد، يختزل إلى “حمّو”، في طفولته وشبابه، و”أمّو” في كهولته وشيخوخته، وأحمد إلى “حِدا” ثم إلى “دودّو” بعد ذلك، وخديجة إلى “خِجّا” ثم إلى “جّا”، وهكذا) وكان له صديق من أولاد الجيران اسمه “حمّو زايد”، صديقه الحميم الذي لا يفارقه أبدا.
غير أن صداقتهما لن تدوم طويلا، إذ سيحدث حادث سيودي بصديقه، وينجو منه حمّو عابد بأعجوبة، ألا وهو انهيار سقف المسجد عندما همّ أهل القصر بترميمه. وتفصيل ذلك أن الطفلين معا كانا يلعبان بجانب العمال الذين يشتغلون في ترميم المسجد، وفجأة تداعى السقف بالسقوط، فبلع الحطامُ كثيرا من الأشخاص بمن فيهم الطفل “حمّو زايد”، أما “صاحبنا” فقد انتشلته يد القدر من هذه الواقعة المأساوية.
وبالرغم من أن صداقته بحمو زايد لم تعمر طويلا، إلا أن الجابري لم يستطع نسيانه، “إنه يتذكر جيدا أن علاقته بصديقه “حمو زايد”، أول صديق له، كانت أشبه بعلاقة المتصوف مع ربه. إن صداقة الأطفال تنطوي على أسرار لا يعرفها الكبار، أسرار فقدوها نهائيا عندما فقدوا براءة الأطفال”(16).
غني عن البيان القول إن لفي تذكر الجابري لصديقه الأول، وحضوره الدائم في ذاكرته ووجدانه، الذي لم تستطع السنون المتوالية محوه ولا تغييبه، ما يؤكد قيمة الصداقة لدى الجابري، باعتبارها من القيم الإنسانية السامية، التي تشد المرء لصديقه بألف وثاق، وتعظم الصداقة حينما تتخذ الطابع الطفولي؛ فتخلو من أية منفعة أو مصلحة، وتصير رديفا للمحبة الطاهرة البريئة. بل إن حياة بلا صداقة صادقة مخلِصة، لنقرأ عليها السلامَ مع الإمام الشافعي.
وبعدما سقنا هاتين الواقعتين، لعله من المفيد هنا، وما دمنا بصدد الحفر في ذكريات طفولته، أن نختم الحديث عن هذه المرحلة بالإشارة إلى قصة تسمية المؤلف باسمه المعروف به اليوم. يحكي الجابري هذه القصة التي روتها له جدته لأبيه في طفولته.
فيقول: “لقد أخبرته غير ما مرة أن أخواله كانوا يريدون تسميته بـ”عبد الجبار”، تيمنا بجدهم سيدي عبد الجبار الفجيجي العالم المشهور]…[ غير أن هذه الرغبة اصطدمت برغبة أخرى حرّكت جدته لأبيه.
ذلك أنها كانت قد سمّت ابنها البكر، والد صاحبنا، باسم “محمّد” تيمنا باسم النبي الكريم ]…[ أما اسمه الثاني “عابد” فهو اسم أحد جدوده من أبيه صار علما على حيٍّ من أحياء آل جابر، فيقال “أولاد عابد”، كما يقال “أولاد الطيب”، و”أولاد بوزيان” وغيرهم من فروع آل جابر”(17).
قضى الجابري، إذن، طفولته الأولى بمدينته فجيج، في جو من الرعاية البالغة، من قبل أهله لأمه، وأهله لأبيه، قضاها في اللعب مع أصدقاء الجيران، وأبناء الأخوال.
وقد مكث في منزل جده من أمه وأخواله لمدة سبع سنوات، بناء على النذر الذي نذرته أمه حينما طلّقها أبوه وهي حامل بصاحبنا في الشهر السادس. لقد قررت عدم الزواج من جديد إلا حين يبلغ الطفل-الجابري السابعة من عمره.
وكذلك كان، فلم تتزوج الأم برجل آخر إلا حينما بلغ ولدها السابعة. ويشكل بلوغ هذه السن المرحلة الثانية من طفولة المؤلف، التي سينتقل فيها إلى العيش مع أبيه وأعمامه، ولتعلن انطلاقة مشواره التعليمي؛ بدءا من التردد على المسيد لحفظ القرآن الكريم ومنظومات قواعد اللغة العربية.
مرورا بالالتحاق بـ “ليكول” أو المدرسة الفرنسية التي أنشأها المستعمِر بالبلد، ثم سرعان ما سيغادر الطفل هذه المدرسة، بعد عامين، سيما وأن الالتحاق بها، كان يعني في عرف الفجيجيين، ضلالا وخروجا عن الطريق وموالاة للاستعمار.
وفيما بعد سيسجل بمدرسة “النهضة المحمدية” التي أنشأ الحاج محمد فرج أحد زعماء الحركة الوطنية بفجيج آنذاك. ومن هذه المدرسة حصل الجابري على الشهادة الابتدائية سنة 1949، ثم سيلتحق في “القسم التكميلي” بالمدرسة ذاتها.
وجدير بالذكر أن ما عُرف به المؤلف من صفات الذكاء والنبوغ والعصامية في التحصيل العلمي، ترجع بوادره إلى هذه السنة، السنة التكميلية. ويقول المؤلف واصفا كدّهُ في طلب العلم في هذه المرحلة: ” لقد كان الحضور الأسبوعي إلى المدرسة، خلال تلك السنة التكميلية، محصورا في بضع ساعات، وبصورة متقطعة، مما ترك المجال واسعا للعمل “العصامي”.
خصوصا في بيئة لم يكن فيها ما يستهلك وقت الفراغ غير اجتراره اجترارا في “مجامع” على حافّتي الأزقة تعاد فيها نفس المرويات والمشاهدات والقيل والقال]…[ وكان صاحبنا عزوفا عن هذه المجالس لا يرتادها إلا نادرا، ربما بسبب طبعه “الانطوائي” بعض الشيء]…[ ولابد أن نضيف إلى ذلك تأثير”الفكرة الوطنية” عليه:
فلقد استقر في وعيه آنئذ بتأثير من معلميه ومدير المدرسة، ومن أبيه كذلك، أن الاجتهاد في الدراسة والتحصيل واجب وطني، لأن الاستعمار إنما تغلب علينا بسبب الجهل السائد فينا”(18).
ويلي هذه المرحلة، السفر إلى مدينة وجدة، حيث سيتابع المؤلف الدراسة في المرحلة الإعدادية- الثانوية بمدرسة “التهذيب” العربية. ويمكن اعتبار الالتحاق بهذه المدرسة إعلان الخروج من مرحلة الطفولة، والدخول إلى مرحلة المراهقة والشباب، وهو ما سنفصل فيه القول لاحقا.
أما ما يتعلق بأنشطة الجابري “الموازية” في طفولته، فكانت موزعة ما بين زيارة الأضرحة رفقة عمته أو خاله، والتردد على الحقول وواحات فجيج. كما يسترجع المؤلف بعض طرائف شخصيات كان لها حضور بارز لدى أهل فجيج، وهي شخصيات جلها من الحمقى والسفهاء،
أمثال “ناسا” و”كاسو”، واليهودي “بيكا” وغيرها من الشخصيات غريبة الأطوار والمحبوبة لدى الجميع، نظرا لمساهمتها في تكسير وقع هيمنة الفراغ والرتابة والملل وندرة الجديد، على حياة الفجيجيين في تلك الفترة من الزمن.
- 2-2 المراهقة والانخراط في سلك الرجال
نشير بداية إلى أن ما دفعنا هنا إلى الحديث عن مرحلة مراهقة الجابري مقرونة بمرحلة الشباب، سببان: الأول؛ افتراضنا أن المراهقة والشباب فترتان من العمر ليست بينهما حدودا فاصلة على نحو واضح، سيما وأن الحديث هنا متعلق بمرحلة زمنية كان الإنسان خلالها يتحمل “المسؤولية” في سن مبكرة.
قد تعود إلى الطفولة، وبما أن تحمل المسؤولية من سمات الانخراط في سلك الرجال في عرف المجتمعات البدوية المحافظة، فإن المراهق بهذا المعنى، يغدو شابّا، أو بعبارة أخرى “رجلا” بكل ما تحمل كلمة رجل من حمولة اجتماعية وثقافية.
والسبب الثاني؛ أن السيرة موضوع التحليل يستغرق القسط الأوفر منها عرض وقائع طفولة ومراهقة الكاتب، أما مرحلة الشباب ففي أوائلها كانت نهاية الكتاب. ولذلك، في نظرنا، ليس هناك من وقائع “هامّة” متعلقة بهذه المرحلة الأخيرة تستحق إفراد محور خاص لها. ولذلك أدرجنا المرحلتين معا في محور واحد.
عندما نتحدث عن مرحلة المراهقة فإن الأذهان تتجه، عادة، نحو استدعاء مفاهيم؛ الانفعال، واكتشاف الذات، والحركية، والطيش، وغيرها مما يسِمُ هذه المرحلة من عمر الإنسان. فإلى أي حد تنطبق هذه الصفات على مراهقة الجابري؟
لعلنا لن نجانب الصواب إذا قلنا إن الجابري، كما قدم نفسه في سيرته، كان أبعد ما يكون عن تلك الصفات. وللتدليل على هذا الطرح سنكتفي هنا بتحليل شخصية الجابري المراهق من خلال تمثله لعاطفة الحب. من المسلم به في الأدبيات النفسية والاجتماعية أن الانجذاب نحو الجنس الآخر.
إنما تنطلق شرارته الأولى، بشكل واضح في هذه الفترة، نظرا للتغيرات الفيزيولوجية والسيكولوجية التي تميز مرحلة المراهقة. فيبدأ المراهق باكتشاف ذاته، والتعرف عليها، والاهتمام بها، ومن ثمة سعيه الدؤوب للبحث عن الطرف الآخر الذي يحقق لهذه الذات إشباع رغباتها، ويعيد إليها توازنها.
بيد أن هذه الدوافع الفيزيولوجية-السيكولوجية، غالبا ما تصطدم في البيئات المحافظة، بعوامل اجتماعية- دينية، ما يؤدي إلى تهذيب تلك الدوافع، وتأطيرها داخل عادات وقواعد اجتماعية متعارف عليها.
وهذا حال الجابري المراهق الرزين الذي رسّخت في ذهنه أعرافُ المجتمع الفجيجي الصحراوي أن العلاقة بين الذكر والأنثى يجب ألا تنزاح عن العلاقة الشرعية الوحيدة في حياة المرء ألا وهي الزواج. أما ما عداها من علاقات عاطفية فتدخل ضمن نطاق “المحرم” و”المرفوض” و”المسكوت عنه”.
إن الجابري “ليذكر أنه كثيرا ما حدث له وهو شاب أن حمل نفسه على صرف النظر عن أية فتاة تشد إليها بصره، وذلك تحت ضغط سؤال كان يأتيه من أعماق نفسه ليهمس في أذنه: ” ما دمت لن تتزوجها فلماذا تشغل نفسك بالنظر إليها؟”. سؤال لا يستطيع أن يدعي أنه تحرر من سلطته، حتى في أكثر فترات مراهقته وبلوغه جموحا وهياجا”(19).
ولعل أوضح تجليات سلطة هذا السؤال/ الحاجز تظهر في التجربتين العاطفيتين “الفاشلتين” اللتين ذكرهما الجابري في سيرته، أولهما عاشها وهو تلميذ بمدرسة التهذيب العربية بوجدة، حيث حال نظام المؤسسة، الذي يصفه المؤلف بـ”العسكري”.
دون فتح مجال للارتباط بزميلة له سحرته بنظراتها داخل الفصل، ما جعل علاقته بها علاقة لم تتجاوز “التقاء النظر” على حد تعبيره. ويعزو المؤلف ذلك أساسا إلى مدير المدرسة ذي الطبع العسكري الصارم الذي لا يسمح حتى بأن يحدّث الذكور الإناث حديثا في الدراسة، بلْهَ أن يكون حديثا في الحب والغرام!
أما التجربة الثانية فحدثت خارج أرض الوطن، وبالتحديد في سوريا، حينما سافر المؤلف إلى هناك لمتابعة دراسته الجامعية سنة 1957، لقد جرت وقائع هذه التجربة في عيادة طبيب عيون، أثناء مرحلة علاج المؤلف من مرض “الرمد الحبيبي” الذي استدعى علاجُه بنترات الفضة التردُّدَ المنتظم على العيادة، عبر حصص علاجية دامت ما يقرب شهرين.
وكانت الساهرة على تلك الحصص ممرضةٌ شابة باذخة الجمال، فأسرت عيناها الدمشقيتان عيني الجابري المريضتين، بل من الممكن أن يكون للنظر المستمر إلى وجه تلك الحسناء دور في الشفاء السّريع من المرض، إذا ما استندنا إلى القول المأثور: “ثلاثة يزدن في قوة البصر: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن”.
وإذا كان نظام المدرسة الصارم واحترام الأعراف عاملين حالا دون نجاح التجربة الأولى، فإن الأمر هنا، بالإضافة إلى حضور جانب من العوامل السابقة، قد تدخل فيه عامل آخر أقوى ألا وهو العامل الديني؛ ذلك أن الفتاة كانت من أسرة مسيحية في حين أن المؤلف مسلم.
وكما وُئدت تجربة الحب الأول في مهدها، فكذلك انفرط عِقدُ حبّ الجابري الثاني في بدايته. لقد فاجأته الممرضة داخل حافلة نقل عمومي، بعبارة مشرقية يائسة قاتلة: “أنا أعرف أن قصدك شريف، ولكن… ما فيش فايدة”، ثم أضافت مبرّرةً: “محمّد… أنا من عائلة مسيحية محافظة”(20).
وأمام هذا التصريح القاتل، لم يصدر من الجابري الشاب أي رد فعل، غير تمنيه لو يهرب رفقة حبيبته إلى مكان ما في العالم ليست فيه حواجز بين المسيحية والإسلام، مكان حر طليق خال من جميع القيود التي تحمل الفتاة أو الفتى على القول بكل مرارة اليأس: “ما فيش فايدة”(21). وعلى كل حال، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
وإذا كان الجابري الشاب قد فشل مرتين على المستوى العاطفي، فإنه على المستوى الدراسي كان ناجحا متفوقا. وواضح أننا لسنا هنا بصدد عقد مقارنة بين الفشل العاطفي والتفوق الدراسي، إذ هي مقارنة لا تستند إلى أيّ أساس علمي ولا منطقي،
إلا أن هناك بعض المعطيات في السيرة تسعف المحلّل للقول إن انشغال الشابّ بدراسته، وصرف وقته بين صفحات الكتب، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية ونفسية سبقت الإشارة إليها، لمن شأنه أن يرغمه على تحويل عاطفة الحب من الانجذاب نحو الجنس الآخر، إلى انجذاب من نوع خاص، ذلكم المتعلق بالعلم والمعرفة.
ومما يعزز هذا القول خاطرةٌ كتبها الجابري في عنفوان شبابه، بتاريخ 1958-12-9، إذ يقول: “ماذا ينقصني، هل الزوجة أم الخليلة، أم شيء آخر؟ إني لستُ أدري. أنا أخشى من الزوجة في هذا الوقت على الأقل، وأخشى من الخليلة في كل وقت، إذن ليكن خليلي الكتاب وكفى،
فأنا لا أرضى بغيره خليلا”(22). حقا إن المرء على دين خليله، ولذلك نظر الجابري فقدّر، فاختار خليله بعيدا عن مجال العاطفة، قريبا من مجال العقل، مقتفيا أثر أبي الطيب المتنبي الذي جعل من الكتاب خير جليس في الدنيا.
- 3-2 صورة الأم
لقد حاولنا في المحاور السابقة تقديم صورة الجابري الإنسان وبيئته التي نشأ فيها، من خلال بعض ملامح طفولته ومراهقته وشبابه، غير أن تلك الصورة ستظل ناقصة، في نظرنا، إذا لم نضف إليها جزءا هاما، ألا وهو صورة الأم، كما قدمها المؤلف في سيرته.
ولعل ما يبرر سَوْقَ الحديث هنا مقصورا على الأمّ دون الأب، هو ما يلاحظ من استغراق المؤلف في وصف أمه، وبيان معاناتها، في أكثر من موضع من الكتاب، في حين أن الإشارة إلى أبيه جاءت في مناسبات قليلة عابرة على سبيل التعريف بعمله في التجارة، أو انخراطه في صفوف رجالات الحركة الوطنية بالمغرب الشرقي.
وتكشف هذه الموازنة عن تعاطف بيّنٍ للجابري مع أمّه، وأسفه لما لحقها من حيف وظلم، في مجتمع تقليدي تهيمن عليه النزعة الذكورية، فتكون الأنثى، في نهاية المطاف، هي الطرف الأضعف. كما سنوضح بعد قليل.
هذا، ونلفتُ إلى أن ما يهمنا في الحديث عن صورة الأم بالتحديد، هو البحث عن تجليات علاقة الأم بولدها، وعلاقة الولد بأمه. ذلك أن كثيرا مما يشكل شخصية الإنسان، أيّ إنسان، يكون للأم، في الغالب، دور أساسي في تشكيله، سلبا أو إيجابا.
لاشك أن القارئ بتتبعه لصورة أم الجابري في الحفريات، سيخلص إلى أنها كانت امرأة مثالية، ذلك أن الصفات التي يضفيها المؤلف عليها ترتفع بها إلى مقام عالٍ. ولكي تتضح لنا معالم تلك الصورة جليا، سنحاول تحليل جانب من صفات الأم التي وردت في السيرة وتبيّن مرجعيتها.
ومنها على الخصوص قول المؤلف: ” كانت من النساء الصامتات الخجولات الصابرات القانتات، اللائي لا يسمع لهن أنين ولا شكوى ولا نحيب ولا قهقهة”(23). من الملاحظ أن الكاتب قد أورد مجموعة من الصفات السامية لفئة من النساء أدرج أمه ضمنها، ومعلوم أن توالي الصفات في الخطاب على هذا النحو المتتابع من غير عطفها بروابط لفظية، يجعل بعضها مشدودا إلى بعض كأنها كلمة واحدة.
كما يبدو أن ذاكرة الجابري القرائية قد وجّهته، إلى حد ما، في معرض وصف أمه، والدليل على ذلك تناصّ بعض مما ورد في السيرة من صفات الأم، مع صفات المرأة الخيّرة في النص القرآني، ومنها قوله تعالى: ” عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً”(24).
ما يؤكد المرجعية الدينية التي حكمت المؤلف في تقديم صورة الأم على هذا النحو المثالي، إذ إن الإسلام، كما هو معروف، بوّأ الأم، إلى جانب الأب، منزلة عالية؛ فشرَط رضى الله برضاها، وجعلها أحق الناس بحسن الصّحبة، وحذر من مغبة مخاطبتها بكلام فظّ، حتى ولو كان مجرد كلمة “أفّ”، بل قرَن اجتناب كبيرة الشرك بالله بالإحسان إليها.
تقديرا لمعاناتها طوال تسعة أشهر وهي تحمل في أحشائها جنينها وَهْنًا على وَهْنٍ، ثم ما يتلو ذلك من آلام الوضع والإرضاع والسهر والتعب والخوف والتوجس.
يتضح مما تقدم، أن أمّ الجابري كانت من فئة الأمّهات البدويات اللائي يعشن على الفطرة السليمة، فيتحملن الظلم والألم بلا امتعاض ولا أنين ولا شكوى.
كما أن طباعهن التي على درجة كبيرة من الوقار الذي يميل بصاحبه إلى الانطواء، تحملهن، في الغالب، على العزوف عن “مجامع” القيل والقال وإطلاق القهقهات الصاخبة، وكل ما من شأنه أن يخدش حياء المرأة المسلمة وعفتها. فلا يشغلها شاغل عن تربية الأولاد، والاهتمام بشؤون البيت.
غير أن اللافت للانتباه هو أن أمّ الجابري، على الرغم مما هي عليه من صفات المرأة الصالحة، ما يفرض أن تكون زوجة هنية سعيدة في بيت زوجها، فإن خِلاف ذلك هو الحاصل، لقد كانت حياتها أبعد ما تكون عن الهناء والسعادة.
إذ طلّقها زوجها- كما أشرنا سابقا- وهي حامل بالجابري في الشهر السادس، ولربما مرد ذلك لأمر تافه حصل بين أمها وحماتها العنيدة، ما دفع هذه الأخيرة إلى أمر ولدها بتطليق زوجته. والحق أن الزوجين كانا على “علاقة حميمة دفينة قمعتها “الحرب” التي كانت بين الجدّتين. إن “رضا الوالدين” كانت له هنا الكلمة العليا على العاطفة بين الزوجين”(25).
والواقع أن الجابري لم يستشعر، وهو صغير، وقع هذا الانفصال، نظرا للرعاية الشاملة التي كان محفوفا بها من قبل أهله لأمه، في سنواته السبع الأولى، ثم من أهله لأبيه فيما بعد. ولما كان فراق الطفل لأمه جرى في سن مبكرة، فمن الطبيعي ألا تكون علاقته بها علاقة شديدة الحميمية.
ذلك أن واقعة وفاتها، كما يصفها الكاتب، لم تحرك في وجدانه حينئذ أية مشاعر حزن ولا انفعالات مأساوية، بل إنه ذهب لحضور جنازتها في المقبرة، ثم التحق بالمدرسة (مدرسة التهذيب العربية بوجدة) ليتابع دروسه، وكأن شيئا لم يحدث.
والحق أن تلك الانفعالات الدفينة سيكون لها أثر بعديّ، سينتاب المؤلف لحظة الكتابة، ما جعله يعقد فصلا كاملا، يستحضر فيه واقعة وفاة أمه. ولسنا في حاجة للتأكيد على أن أسف الكاتب لحظّ أمه العاثر، وشعوره بثقل دين أمه عليه قد لازماه طوال حياته، وما عنونته للفصل الأخير الذي يحكي فيه كل ذلك بـ”فصل فريد” إلا دليل على فَرادة هذا الشخص المحكي عنه، وموقعه في وجدان الكاتب إنه: الأم.
ومهما يكن من أمر، فإن علاقة الأم بابنها، كانت قوية؛ فلم يستطع زواجها الثاني المشؤوم، وما قاسته من عذاب حماتها الجديدة، أن ينسياها فلذة كبدها، لقد ظل ولدها-الجابري حاضرا في وجدانها، إلى لحظة احتضارها، ويتجلى ذلك فيما تركته له من متاع ثمين، على بساطته، أودعته لدى إحدى قريباتها الموثوق بها، والمتمثل في؛ حزام، وقصعة، وجفنية، وخلخال، وإزار، وآلة نسج يُكبس بها الخيط على المنوال حين النسج.
وذلك ما تملكه المرأة عادة في فجيج ملكية شخصية، لكون هذه الأشياء هي قوام مهرها وتجهيزها، وتحتفظ بها المرأة لتقدمها لابنتها عند زواجها. وبما أن المرحومة لم ترزق بمولود آخر غير صاحبنا، وبما أنها لم تكن متأكدة من العودة (=العودة إلى فجيج بعد رحيلها إلى وجدة، إثر طلاقها الثاني) لاشتداد المرض عليها وإحساسها بدنو أجلها،
فقد احتفظت له بهذه الأغراض، هدية منها تُقدّم له عند وفاتها(26). وإذن، فلقد كانت أمّ الجابري، مثالا للمرأة “الوازنة” اسما ومسمى.
ولئن كان ذلك هو الإرث الوحيد الذي ناله الجابري في حياته، كما أشار إلى ذلك في سيرته، فإنه ترك للإنسانية إرثا فكريا عظيما لا يفنى أبدا.
هكذا، إذن، عاش المفكر المغربي محمد عابد الجابري حياة عظيمة تستحق أن تُروى، أن تخلّدها النصوص، ثم مات. وليسَ النّصُّ- بتعبير الشاعر عبد الله زريقة- إلاّ جسداً آخرَ لمَوْتِ الكاتِب.
الهوامش
(1) نُشرتْ فصول هذه السيرة أول مرة في جريدتي الشرق الأوسط والخليج خارج المغرب، وفي جريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية، نشرا متزامنا على حلقات، في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر ديسمبر 1996. ثم جُمعت في كتاب صدر في طبعته الأولى عن دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1997، ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997. وقد اعتمدنا، في هذه القراءة، الطبعة الأولى الصادرة عن المركز، والتي جاءت في 238 صفحة من الحجم المتوسط، موزعة على سبعة فصول، فضلا عن ملحق نصوص، ونص حوار مشترك أجرته مع الكاتب كل من جريدة الاتحاد الاشتراكي ومجلة المجلة حول هذه “الحفريات”، وكان ذلك الحوار قد نشر في فبراير 1997، هذا بالإضافة إلى تقديم الكتاب. ونلفتُ إلى أن المؤلف كان قد أشار في مقدمة الكتاب، إلى أن “حفريات في الذاكرة” هو بمثابة الجزء الأول من سيرته، والذي أفرده لسرد ذكرياته الشخصية، أما ما يتعلق بالذاكرة الثقافية والذاكرة السياسية للجابري، فقد وعد القراء بتخصيص لهما الجزئين الثاني والثالث من سيرته، وفعلا فقد أوفى المؤلف بوعده ذاك، لكن ليس بنشر الجزئين في مجلدين، كما هو الحال بالنسبة للجزء الأول، وكما كان منتظرا، وإنما عمل على نشرهما عبر سلسلة من الكتب صغيرة الحجم، كانت تصدر كل شهر من مطلع العشرية الأولى من هذا القرن، إلى حين رحيل الجابري، ويتعلق الأمر هنا بسلسلة “مواقف”. وبالمناسبة، فحبذا لو يعمل أحد من القيّمين على نشر أعمال الراحل، على إعادة طبع كتاب “حفريات في الذاكرة”، نظرا لنفاذ نسخه من جل المكتبات، وكذا تجميع أعداد سلسلة مواقف في مجموعة كتب من حجم الجزء الأول من السيرة، لما في ذلك من تيسير على الباحثين والمهتمين بفكر الجابري، والقراء عامة.
(2) فيليب لوجون، ميثاق السيرة الذاتية، ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، ط1، 1994، ص22. أورده عادل آيت أزكاغ، في: رؤية الضحك ونقده في تجربة “قصة حياتي” لشارلي شابلن، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط1، 2016، ص22
(3) Jean-Philippe Miraux, L’autobiographie, écriture de soi et sincérité, Paris, Grasset, 1996. أورده الباحث رشيد الإدريسي في مقال: تأويل الأحداث من خلال التأريخ للذات. مجلة فكر ونقد، العدد 13، نوفمبر، 1998، ص 153
(4) محمد الداهي، محكي الحياة النسائية في المغرب، ص59، أورده عادل آيت أزكاغ، مرجع سابق، ص24
(5) حفريات في الذاكرة، ص07
(6) إحسان عباس، فنّ السيرة، دار الشروق، عمان ، ط2، 2011، ص96
(7) حفريات في الذاكرة، ص 231
(8) إحسان عباس، فن السيرة، ص 70
(9) مواقف، العدد 01، ص 07
(10) معلوم لدى متابعي فكر الجابري، مدى تأثره بأعمال ميشيل فوكو، ويظهر ذلك التأثر جليا في توظيف الجابري لمفاهيم ذات مرجعية فوكوية في أكثر من موضع من كتبه، من قبيل (حفريات، إبستيمية…إلخ)، كما اعترف الجابري، والاعتراف شيمة الكبار، في أكثر من مناسبة باستفادته من طروحات فوكو، ومن ذلك يقول: “أما فوكو فربما يقبع في داخلي بصورة ما، ذلك أني حين أقرأ له أكتشف أنني أشبهه شيئا ما، أو هو يشبهني شيئا ما” مواقف، العدد 18، ص106
(11) مواقف، العدد01، ص05
(12) حفريات في الذاكرة، ص10
(13) سلسلة مواقف، العدد 01، ص10
(14) القصر ويسمى بالأمازيغية إغْرَمْ هو عبارة عن تجمع سكني، من منازل مبنية من الطّوب، ومسقفة بجريد النخل والتراب.
(15) حفريات في الذاكرة، ص12
(16) نفسه، ص110
(17) نفسه، ص127
(18) نفسه، ص127
(19) نفسه، ص69
(20) نفسه، ص164
(21) نفسه، ص164
(22) نفسه، ص197
(23) نفسه، ص26
(24) سورة التحريم، الآية 05
(25)حفريات في الذاكرة، ص30
(26) نفسه، ص167.