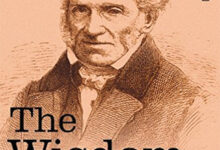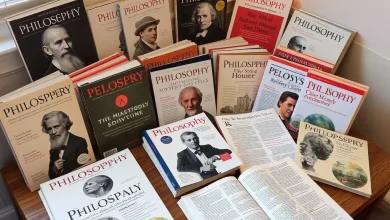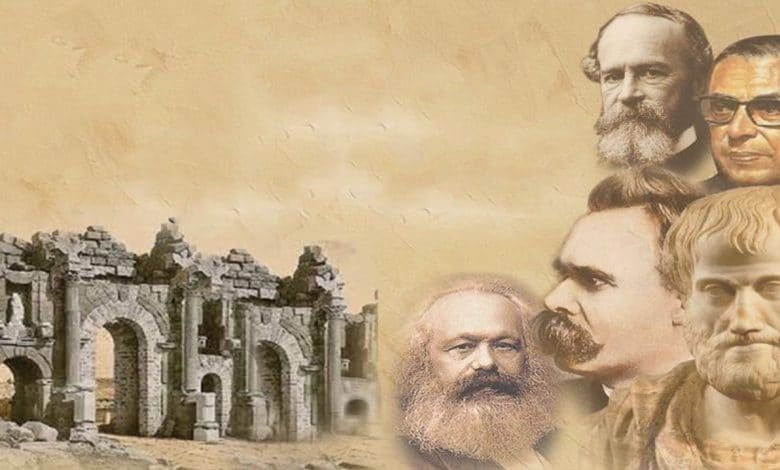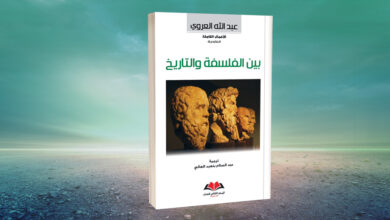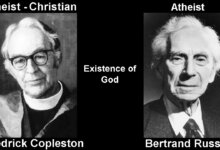المعرفة التأملية والعلم المركب

لا تتوقف العلوم عن التطور والتجدد، وبإيقاع سريع، تمشياً مع العصر المتسارع في كل الميادين. يتجلى ذلك في ما نشهده من انبثاق فروع معرفية جديدة في مختلف الحقول العلمية، وعلى نحو يسهم في التغطية، معرفياً، لمجمل أنشطة الإنسان وتجاربه ومشاريعه.
ولكل فرع ميدانه وحقل عمله، وله مناهجه في البحث ونماذجه في التفسير، كما له أعرافه وتقاليده، فضلاً عن عدته من المصطلحات والمفاهيم التي تميزه عن سواه.
ولا شك أن العلوم الإدراكية، وتعني حرفياً «علوم المعرفة»، هي من الفروع الحديثة التي تشكلت خلال العقود الأخيرة، كحقل مستقل للإنتاج المعرفي، والتي تسهم في التحولات الكبيرة التي تصنع عالمنا وتغيّر مشهده وخريطته.
وهي تختلف عن الفروع الأخرى؛ مثل نظرية المعرفة، أو الابستمولوجيا، أو الأركيولوجيا. فنظرية المعرفة تهتم بالبحث عن مصادر المعرفة:
الحس أو العقل، الحدس أو البرهان، التجربة أو الذهن، كما تُعنى بدرس العلاقة بين الذات العارفة وموضوع المعرفة الذي قد يكون العالم أو الذات نفسها. وفضلاً عن ذلك، فهي تهتم بكشف المسبقات التي تشكل مبادئ المعرفة الأولى، من البديهيات والضروريات.
من هنا تعمل في نظرية المعرفة ثنائيات مثل الحدس والاستدلال، أو الأولويات والعقليات، أو القبلي والبعدي.
أما الأبستمولوجيا، فإنها تهتم بدرس الأسس والنماذج والمعايير التي يستخدمها العلماء في إنتاج معارفهم، لا سيما في ميادين الرياضة والطبيعة. فهي إذن، تنشغل بآليات الإنتاج أكثر مما تنشغل بمضامينه.
وإذا شئنا المقارنة، فإن المقابل للأبستمولوجيا الحديثة في الثقافة العربية، العلمية، القديمة، هو «علم الأصول»، أي ذلك الفرع الذي يُعنى باستخلاص المبادئ والمفاهيم والقواعد، التي يوظفها علماء الفقه والحديث والكلام أو التفسير، في إنتاج أحكامهم وعقائدهم وتفاسيرهم، أو في التحقق من صحة الروايات والأحاديث المنقولة عن السلف.
وهذا ما حملني على استخدام مصطلح «المعرفيات» أو «علم أصول المعرفة»، لترجمة المصطلح الفرنسي. وأياً يكن، فالأبستمولوجيا، كعلم يبحث في الأسس والأصول والمعايير، إنما تشتغل بثنائيات الصحيح والخاطئ، أو العقلاني والخرافي، أو العلمي والأيديولوجي.
وأما الأركيولوجيا، وهي أحدث من الأبستمولوجيا، فإنها تهتم بالحفر في طبقات المعرفة المتراكبة، والكشف عن أنساقها الثاوية، كما نجد ذلك في تحليلات ميشيل فوكو وتنقيباته في التشكيلات الخطابية، وكما يتجلى ذلك في كتابه: «الكلمات والأشياء» (1965).
من هنا، آثر البعض نحت مصطلح «أثريات المعرفة» أو «حفريات المعرفة»، لترجمة المصطلح الفرنسي.
والبحث الأثري، في مجال المعرفة، يتعدى ثنائيات الحدس والاستدلال، أو الصحيح والخاطئ، أو العقلاني والخرافي، لأنه يهتم بكشف البنى والأشكال، أو العلاقات والتحولات التي تتيح، من وراء الذات المفكرة،
انتظام المعارف في تشكيل خطابي أو حقل فلسفي أو ميدان علمي، كما تتيح تفسير الانتقال من علم إلى آخر أو من عتبة معرفية إلى سواها.
من هنا، ولدت مع الأثريات لغة مفهومية جديدة من مفرداتها؛ الأرشيف، القطيعة، العتبة، الممارسات الخطابية، وخاصةً مصطلح اللا مفكر فيه، أو الخارج عن نطاق التفكير، مما هو منسي أو مستبعد أو مسكوت عنه… وبحسب قراءتي وصياغتي للدرس الأثري،
فأنا أميّز بين الممتنع على التفكير بسبب مسبقات الفكر، وأوهام العقل أو قوالب الفهم، وبين ما يمنع التفكير فيه بسبب ما يمارس من ضغوط أو قمع من جانب السلطات السياسية والمجتمعية، في ما يخص حريات التفكير والتعبير.
أخلص من ذلك إلى العلوم الإدراكية التي افتتحت درساً جديداً في عالم المعرفة، وهي لا تتعامل مع الذهن كجوهر روحاني أو كذات متعالية، كما اعتقد الفلاسفة من أفلاطون إلى هوسرل، مروراً بابن سينا وديكارت. فالمعرفة، بحسب المدرسة الإدراكية،
ليست مجرد نشاط تأملي محض، ولا هي أيضاً مجرد ممارسة قولية خطابية، بقدر ما هي بنية من الرموز أو شبكة من المعلومات أو منظومة من الترابطات.
وفي أبسط تعريف للمدرسة الإدراكية أنها تتعامل مع الذهن، في مختلف أنشطته وقواه (الحس، الذاكرة، الخيال، العقل)، بوصفه منظومة تشتغل على المعلومات، بالقراءة والإدارة والتصرف، سواء في فهم الواقع، أو في حل المشكلات.
وإذا كانت العلوم الإدراكية قد تفرعت، في الأصل، عن علم النفس، فإنها تشكلت وتطورت بتفاعلها مع ثورتين علميتين أحدثتا انقلاباً في حياة البشر، هما ثورة المعلومات، والتطور الهائل الذي شهدته علوم الدماغ والأعصاب. من هنا، فإن المدرسة الإدراكية تشكلت، في طور أول، باتخاذ الحاسوب نموذجاً في المقاربة.
بحيث عومل الفكر بوصفه عملية حسابية أو لغة رقمية، تقوم على التصرف بالرموز وفقاً لقواعد مجردة وأنماط مختلفة من التداخل والتشابك، كما عومل الذكاء بوصفه برنامجاً إعلامياً يقوم على حلّ المشكلات، بناءً على المعلومات التي يتلقاها أو يخزّنها.
وبعد انفجار العلوم العصبية، تلا طور ثانٍ، اتخذت فيه المدرسة الإدراكية الدماغ البشري وكيفية عمله، نموذجاً في المقاربة. وعندها أصبحت الأفكار والصور الذهنية تدرك بوصفها منظومة من الترابطات، هي التي تتيح التعرف إلى الأشكال وبناء شيفراتها،
تماماً على النحو الذي تعمل بموجبه خلايا الدماغ، بهندسة ترابطاتها وأنماط تجمعها وتعدد مساراتها… هذا ما جعل البعض يتحدث عن مدرسة جديدة ولدت من المدرسة الإدراكية، هي «المدرسة الترابطية».
وأياً يكن، فقد تشكلت مع العلوم الإدراكية لغة مفهومية جديدة، من مفرداتها: الإعلام، البرنامج، الشبكة، الارتباطات، التداخلات، البيئة الافتراضية.
واليوم، تشهد العلوم الإدراكية في نموها وتطورها قفزة نوعية، يطلق عليها البعض اسم ما وراء العلوم الإدراكية، وأنا أوثر اشتقاق مصطلح آخر هو: الإدراكيات الماورائية.
ولا يُقصد بالمصطلح هنا معناه الفلسفي الغيبي، أي ما يحيل إلى ما وراء الطبيعة، وإنما يفهم منه النشاط التفكري، الارتدادي، الذي به يعود صاحب العلم إلى ما أنتجه لإخضاعه للدرس والتقييم.
هل معنى ذلك أن نسبة الإدراكيات الماورائية إلى العلوم الإدراكية، هي كنسبة علم أصول المعرفة إلى العلوم في هذا الميدان أو ذاك؟ هل نحن إذاً إزاء علم جديد هو «علم أصول الإدراكيات»؟
ليس الأمر على هذا الوجه تحديداً، ثمة فارق بين النسبتين. ذلك أن التطور الجديد ينحو منحى تربوياً تعليمياً، لذا، فهو يتعلق بالذوات والأفراد. وهكذا نحن إزاء طور إدراكي جديد يتيح تنمية القدرات ومضاعفتها، وبصورة تمكن الواحد من أن يتعلم كيف يتعلم،
كما يبيّن جان فرنسوا دورتييه (مجلة «العلوم الإنسانية»، أكتوبر 2012). فمع كل حقل معرفة يتشكل، تفتتح إمكانات جديدة للنظر والعمل.
لا شك أن هذا يعيدنا إلى المقولة القديمة: أن نعرف كيف نعرف. ومعرفة المعرفة، التي تشكل نمط علاقة الإنسان بذاته، هي ميزته وفرادته، بما تعنيه من الارتداد والانعكاس أو التفكر والتأمل.
هذه الميزة هي التي يتعذر اختزالها إلى تشكيلات الخطاب وأبنية الرموز، أو إلى برامج المعلومات وتشابكات الخلايا العصبية. إنها المساحة التي تشكل ملعب الإنسان، كما يتجسد ذلك في قدرته على الخلق والاجتراح، أو على الخرق والتجاوز.
وتلك هي اللعبة: خرق الحدود وتغيير الشروط، بافتتاح فروع للمعرفة تزيد من قدراتنا، بقدر ما تغير علاقتنا بمفردات وجودنا، بما في ذلك المعرفة نفسها: مصادرها، حقولها، قواها، طرقها، مساراتها، آلياتها، منافعها، وربما مضارّها.. ولذلك حديث آخر.