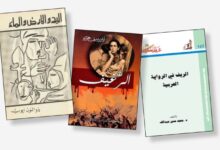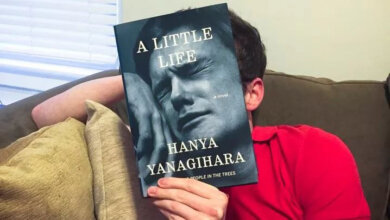الميتافيزيقا في إبداع نيكـوس كزنتزاكي
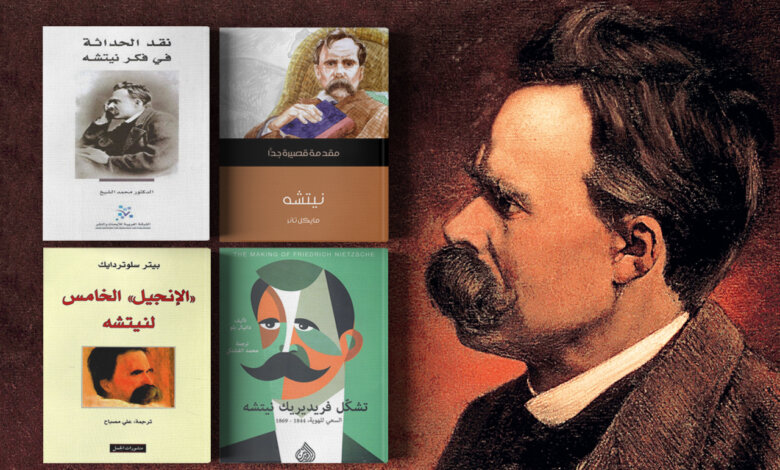
“إذا كان الانشغال بالاهتمامات الميتافيزيقية مرضًا، فأنا مريض جدًا”
كازانتزكي
يمثل الروائي اليوناني نيكوس كزنتزاكي أيقونة مهمة لها تميزها وحضورها الطاغي في السرد اليوناني الحديث، ولا شك أنه بإبداعاته، وعبقريته الخلاقة يعتبر علامة مهمة في تاريخ الأدب الإنساني ليس في اليونان وحدها ولكن في العالم كله، وهو يمثل حلقة ضمن سلسلة متصلة من أدباء اليونان العظام – شعراء وروائيين – تمتد جذورهم عبر قرن من الزمان.
وهي مرحلة النهضة اليونانية أو صحوة اليونان في العصر الحديث، حين شرعت اليونان عن طريق أبناءها المخلصين في كافة المجالات في البحث عن ماضيها وتراثها وحاضرها ومستقبلها لتصل بينهم جميعًا في وشائج وروابط قوية تمتد أصولها وجذورها إلى أعماق تاريخ اليونان في الحضارة الهيلينية القديمة وما بعدها،
وفي مجال الأدب برز عدد من كتابها العظام كان أبرزهم شاعر الإسكندرية اليوناني العظيم قنسطنطين كفافيس، والروائيين نيقوس نيقوليدس، وكوستاس جاراداس، وأندونى ساراماكي، وإيفانجلوس أفيروف، وإيليا فونتيزي،، وبيرسا كوموستي، وذيمتريس ذيمتريتس، ذيمتريس س ستيفاناكيس، ويمثل كزنتزاكي وسط هذه النخبة من مجايليه علامة متميزة لها ألقها وتوهجها في ساحة السرد اليوناني والعالمي المعاصر.
ولد نيكوس كزنتزاكي في بلدة إراكليون بجزيرة كريت في الثامن عشر من نوفمبر عام 1883 وقد خيمت على طفولته ظلال حركة التمرد الدموية من أهل جزيرته للتحرر من ربقة المستعمر التركي آنئذ.
تلقى دروسه الأولى في مدرسة الراهبات الفرنسية، ثم درس القانون في جامعة أثينا عام 1906، وفي عام 1907 سافر إلى باريس لاستكمال دراساته العليا، وهناك قرأ أعمال فريدريك نيتشة الفلسفية وتأثر بأفكاره وأشعاره تأثرًا عميقًا، قبل أن ينكب على عالم بوذا وتعاليمه الشرقية، وسرعان ما تتلمذ على يد الفيلسوف الفرنسي “هنري برجسون” وتأثر كثيرًا بتعاليمه وفلسفته.
وحصل على درجة الدكتوراه الفلسفة عام 1909 من جامعة باريس عن رسالة بعنوان “أثر فريدريك نيتشه على القانون والحضارة”، وعندما عاد من باريس دخل في حالة من العزلة، إذ عاش لمدة عامين في دير منعزل للرهبان في جبل “آتوس” الذي تردد ذكره في رواياته ومسرحياته وأشعاره.
فرض كزنتزاكي نفسه على المشهد السردي في العالم من خلال أعماله الروائية والأدبية التي لاقت نجاحًا كبيرًا.
حيث صدر له “تصوف منقذو الألهة”، الثعبان والزنبقة”، “النفوس المحطمة”، “الحرية أو الموت”، “فقير أسيزي” “الأخوة الأعداء”، “زوربا اليوناني”، “الإغواء الأخير للمسيح”، “المسيح يصلب من جديد” “القبطان ميشيل”، وسيرته الذاتية “تقرير إلى جريكو” وهي رسالة ذاتية إلى جده الرسام اليوناني المعروف “آل جريكو”. كما صدرت له عدة مسرحيات أهمها “مآساة ميليسا”، و”تيتيوس”.
كما قام بترجمة الكوميديا الآلهية لدانتى (شعرًا)، وفاوست لجوته (شعرًا)، و(هكذا تكلم زرادشت) لنيتشه إلى اللغة اليونانية.
تحولت روايتّي “زوربا” و”الإغواء الأخير للمسيح” إلى فيلمين أخرج الأول المخرج مايكل كاكويانيس المولود في مصر، ووضع موسيقاه الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس الذي ألف عام 1988 باليه بعنوان “ألكسيس زوربا” مستلهما نفس الشخصية الروائية في هذا العمل الأوبرالي الموسيقي. وقد قام ببطولة فيلم “زوربا” أنتوني كوين وإيرين باباس وآلابيتس.
كما كتبت عنه زوجته إيلينى كتابًا بعنوان “المنشق” تحدثت فيه عن حياتها مع كزنتزاكى، بحلوها ومرها، من خلال رسائله ومذكراته وبعض نصوصه غير المنشورة، يبين هذا الكتاب حياته على خلاف الكثير من كبار الكتاب، ويكشف عن كفاح رجل لم يتزحزح عن مواقفه برغم كل المصائب والآلام التي حلت به، لكنه يتضمن أيضًا قصة حب فريدة، يمكن أن تشكل وحدها زاوية أخرى لقراءة الكتاب،
وقد يكون بطلاها نيكوس كزنتزاكى الطيب الشرس أو هو زوربا الشخصية الملتبسة العائشة حقيقتها، وإيليني المرأة التي ذاقت الأمرين بسبب عناده في ملاحقة مثله الأعلى في الحياة.
إنها قصة حب وتحد وتعطش جارف للحياة والخلود والإبداع، وتشير إيليني في كتابها أن كازنتزاكى دائمًا ما كان يقول لها: سوف أموت، وكتب كثيرة لا تزال في داخلي، إنه نيكوس كازنتزاكي أو زوربا اليوناني بطيبته وشراسته وخيره وشره وحياته وموته، ومنجزه الإبداعي الخالد.
منح كزنتزاكي جائزة لينين في مدينة فيينا في الثامن والعشرين من يونيو عام 1957، ورشح إلى جائزة نوبل عام 1956 ولكنه لم يحصل عليها بفارق صوت واحد، وحصل عليها ألبير كامو عام 1957 “والذى قال في خطبته التي نال عنها الجائزة: إن كزنتزاكي يستحق شرف نيل الجائزة أكثر مني مئة مرة”.
رحل كزنتزاكي في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1957 في ألمانيا ونقل جثمانه إلى أثينا، لكن الكنيسة الأرثوذكسية منعت تشييع جنازته ودفنه هناك، فنقل إلى مسقط رأسه في بلدة “أراكليون” بجزيرة كريت حيث دفن وكتب على شاهد ضريحه هذه العبارة المأخوذة من قصص التراث الهندي”: لا أمل في شيء، لا أخشى شيئًا، أنا حر”.
كان كزنتزاكي مغرمًا ومنشغلاً دائمًا بالميتافزيقا سلبًا وإيجابًا خاصة بعد أن قرأ نيتشه وتأثر ببرجسون، وتأثر كثيرًا بالبوذية، وآثر أن يبتعد بعض الشيء عن العالم ويعتزل خاصة بعد عودته من دراسته من باريس، هو يبحث في كل أعماله عن الأسئلة الأبدية لما وراء الطبيعة خاصة منطقة ما بين الحياة والموت، وكان غرامه بالرحلات الطويلة يفوق الوصف، وقد شكلت هذه الرحلات جزءًا كبيرًا من حياته وإبداعاته، حيث قام كزنتزاكي بسلسلة من الرحلات الوثائقية زار خلالها أنجلترا وأسبانيا وروسيا ومصر والصين واليابان وفلسطين وغيرها، وقد ظهرت انطباعاته عنها في عدد من المقالات المهمة.
فضلاً عن توجهاته الفكرية الذاتية، وعمله في اليونسكو، وتوليه منصبًا وزاريًا في بلاده، فإنه كان يفضل أن يكون هو الإنسان في كل شيء، وأن يفعل أشياء ينفرد هو بها، ولا يشاركه فيها أحد، لذا كان يقول: “قلت لنفسي: سوف أذل رغبات الجسد، وأقلصها قدر المستطاع، فإذا أردت النوم، أسهر، وإذا أردت الجلوس، أظل واقفًا بل وأتسلق الجبل، وإذا أحسست بالبرد أخلع ثيابى وأمشي على البلاط، وعندما أهزم هذا الجسد، ألتفت إلى الروح وأقسمها هي الأخرى إلى معسكرين، أسمى وأدنى، إنساني وإلهي، سوف أقاتل الأهواء والرغبات خاصة الذهنية الصغيرة”.(1)
من هذا المنطلق كان كازنتزاكي يتفرد في أعماله الإبداعية ويتطرق فيها إلى أشكال وفروع عدة كتب الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والملحمة الشعرية وترجم العديد من الكتب خاصة المتصل منها بفروع الفلسفة وكانت أعماله الإبداعية جميعها وكأنها أواني مستطرقة متصلة من أسفل ولكنها تتشكل من أعلى في أشكال إبداعية مختلفة كيفما يريد ويرغب وتحمل جميعها في محتواها رؤيته الحياتية الإنسانية والفلسفية الإبداعية التي اجتراها منذ نشأته وتعليمه وتأثره بمن سبقوه من الكتّاب والفلاسفة العظام.
- ألكسيس زوربا 1947 بين النص والرؤية
في رواية “ألكسيس زوربا” يجد القارئ مزيجًا من الصوفية العالية والواقع المتدني، والحياة كما هي على سطح صفيح ساخن في بساطتها وانثربولوجيتها المعتادة.
فالقارئ يكاد يستنشق رائحة تلك الجزيرة الكريتية الغارقة في البحر والصاعدة إلى السماء، والتي لا تزال فيها العادات والتقاليد القديمة قائمة، والصراع ضد الأتراك محفورًا ومتجذرًا في الذاكرة، والشعب في فقره وكرامة حياته اليومية يبدو متوحشًا ومتمدنًا في آن واحد. الراوي في الرواية فيلسوف يعشق التأمل ويدرس الفكرة البوذية، تركه خير صديق له ليقوم برحلة خطرة وتواعدا على أنه “إذا وجد أحدهما نفسه في الخطر، فكر بالآخر تفكيرًا عميقًا جدًا حتى يشعره بمكان وجوده”.
ويغادر الراوي أثينا بدوره ويحاول أن يمارس عملاً ما، فيستأجر على الشاطئ الكريتي منجمًا مهجورًا يحاول أن يستغله، فيلتقي صدفة بشخص ستيني غريب يدعي “ألكسيس زوربا” فيأخذه مديرًا لمشروعه الجديد المتمثل في المنجم المهجور.
كان كزنتزاكي قد ألتقى صديقه جورج زوربا منذ خمس وعشرين سنة مضت، وعاش معه، ليس في كريت حيث أجرى فيها كازنتزاكي أحداث روايته، بل في باستروفا بأقليم مانيس، وكان ذلك عام 1917 حيث اشتركا معًا في صفقة منجم الفحم المهجور، كما ألتقاه مرة ثانية عام 1919 في إرسالية إعادة المهاجرين اليونانيين من القوقاز، وقد استحضر كازنتزاكي ذكريات تجربته السابقة في “مانيس” مع زوربا إلى كريت، وعاد يحيا صورة الحياة الأخرى النابعة من أعماقه في محيط جزيرته الحبيبة كريت.
وبعد خمسة وعشرين عامًا، يسجل كزنتزاكي في مقدمته لرواية “أليكسي زوربا” أن بأمكانه الآن أن يذكر من الذين تركوا بصماتهم العميقة على روحه، هم ثلاثة أو أربعة “هوميروس” الشاعر الأغريقى مؤلف الألياذة والأوديسا، والفيلسوف الفرنسي “هنري برجسون”، والفيلسوف الألماني “فريدريك نيتشة”، ثم صديقه “جورج زوربا”، الذى استلهم من صداقتهما وحياتهما رائعته “زوربا اليوناني” وليس من الصعب على القارئ أن يتبين في أعمال كازنتزاكى بصمات كل من هوميروس وبرجسون ونيتشة، أما صديقه زوربا فلو لم يحدثنا كازنتزاكى عنه، وعن تأثيراته العميقة عليه لما أمكننا أن نتبين بصماته على منجز الإبداعى وحياته الخاصة.
وبالرغم من كل هذه السنين فلم ينطفئ في قلبه الاعتراف بتأثير هذا الرجل عليه. بل هو يمعن في الاعتراف بها، مقررًا أن تأثير هذا الأخير لا يقل عن تأثير أولئك الأعلام الثلاثة الكبار إن لم يزد. ولئن كان لم يتنبه إلى تأثير زوربا عليه أول الأمر، إلا أنه راح يتذكره فيما بعد، ولم يعد بوسعه سوى أن يعترف بفضله عليه من وجوه عدة.
وكان الاسم الحقيقى لزوربا هو “جورج زوربا” فغيره كزنتزاكى في الرواية إلى “إلكسيس”، وقد اختار كزنتزاكي هذا الرجل عامل منجم الفحم ليكون بطلاً لروايته التي أصبحت بصمة كبيرة في السرد اليوناني والعالمي لما لها من تأملات روحية وفلسفية، ولأنه كان الوحيد القادر على انتشاله من متاهات الميتافزيقية والأخلاقية وقراءاته الفلسفية التي كان مترديًا فيها، وعلى تلقينه كيف يلتصق بالحياة ولا يهاب الموت.
وتعتبر شخصية زوربا في رأي من أعظم الشخصيات الروائية، والسر في ذلك بساطتها وعمق تصويرها تصويرًا إنسانيًا حقيقيًا، ما جعلها تمثل الإنسان في أسمى معاني الإنسانية أينما وجد وأينما حل، ما هو إلا نموذج للبهجة الحقيقية والإنسانية المفرطة، نموذج للبدائى والحيوانى معًا، الهمجى والقديس، المحتضر كما هو الحال، والطاقة المتفجرة بالضحك والفكاهة والحياة والرقص والذكاء وحب العمل.
والرواية في حد ذاتها تعتبر فتنة جمالية وفكرية رائعة ما جعل السينما تستثمرها في فيلم من أنجح ما قدمته هوليوود من إخراج مايك كاكويانيس، جسد فيه الممثل الأمريكى أنطونى كوين شخصية “زوربا” كما وضع موسيقى الفيلم باقتدار الموسيقى اليوناني ميكيس تيدودوراكيس حيث قدم تصورًا للموسيقى الشعبية اليونانية بجمالياتها الخاصة والتي عزفها زوربا على آلة السنتوري.
وقد جسد كازنتزاكي ميتافيزيقية الشخصية من خلال فلسفة حياتية خاصة تظهر من خلال العلاقة التي قامت بينه وبين رئيس عمله عبر أحاديثه المفعمة بالدهشة التي يظل يطرحها كلما شرب كأسا من النبيذ أو صادف امرأة أو تذوق طعاما شهيا، وكأنه يفعل ذلك لأول مرة.
كانت الحياة بالنسبة له هى الحياة بفطرتها، كان يصنع عالمه بنفسه كما يريد وكما يحب، عالم فريد متداخل مع عوالم الآخرين. يحكى زوربا لصديقه المثقف الشاب تعاملاته مع الحياة، هو يحكيها بخيرها وشرها، في صراحة وبساطة شديدة، كما لو كان يشرب كوبا من الماء. هذا هو زوربا الشخصية المحورية في الرواية والذي استدعاها كازنتزاكي من الزمن الجميل الذي عاشه مع الشخصية المفعمة بالحرية والحياة، هو لا يقيم وزنًا لأي شيء، ولا يحسب حسابًا لأحد.
وإنما يحيا الحياة كما يحلو له أن يحياها، مثلما يحياها الرجل البدائي الذي يلتصق بها قلبًا وقالبًا، لذا كانت ممارسات الشخصية في الرواية كثيرًا ما تتحول إلى بعد ميتافيزيقي يحلو للراوي الشاب المثقف أن يغترف منه التجربة والرؤية والحياة غير المألوفة في هذا الوقت، ومن ثم كان كثيرًا ما يطلب من زوربا أن يحكى له عن الحياة كما يحياها هذا الـ”زوربا” ويقول له دائمًا: أحك يا زوربا.
ويحكى زوربا فيقول: أنى لى أن أذكر كل شيء، ذات مرة في شبابي انتابتني نزوة، فرحت آخذ من كل امرأة أرقد معها خصلة شعر. كنت أحمل مقصًا صغيرًا جيبى، أينما ذهبت، فأنت لا تعرف ماذا في انتظارك.
رحت أجمع خصلات الشعر، سوداء، شقراء، كستنائية، بل وحتى خصلات وخطها المشيب، رحت أجمع وأجمع، وملأت بما جمعت وسادة مضيت أضعها تحت رأسي وأنام عليها في الشتاء، أما في الصيف فقد كانت هذه الوسادة تلهب بشرتي، على أنني بعد وقت قصير تقززت منها، فقد أخذت الخصلات بداخلها تفوح برائحتها، فأحرقتها، سئمت، اعتقدت أول الأمر أن عددهن لن يكون كبيرًا، ولكنني وجدت أنه لا حصر لهن، وألقيت بالمقص جانبًا.
- “الأخوة الأعداء” بين النص والواقع 1954
تقوم هذه الرواية على أحداث فتنة داخلية عاشتها قرية كاستللوس اليونانية خلال الحرب الأهلية أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر.
بين المتمردون الأنصار من جهة والجنود الوطنيون من جهة أخرى، أبناء بلد واحد وقرية واحد، لا يميزهم سوى بيريهات الرأس بلونيها الأسود أو الأحمر، أبناء بلد واحد تتسع بينهم دوائر الحقد والموت والكراهية فتمتلئ القلوب بالآلام والأحزان والضغينة وتطفح العيون بدموع الانتظار ولوعة الشوق والحنين، منتجة الكثير والكثير من المذابح والمجازر والمعارك الطاحنة والسبي للنساء والسلب للأموال والاغتصاب لكل شيء. وتتسع دائرة الحرب وتطحن في رحاها أكثر ما تطحن، الفقراء، والبؤساء، والمقهورين.
وتحاول الكنيسة أن تقوم بواجبها تجاه هذا الغليان الذي تعيشه مأساة هذه القرية اليونانية خلال هذه الحرب فيقول الراهب الشاب نيكوديم للقسيس العجوز الأب ياناروس في ثورته على الواقع المتردي في القرية: “المسيح لا يرضى حاجتي بالحالة التي جعلوه عليها..
بملابس الذهب والقصور التي يقيمون فيها الحفلات في المساء مع سادة هذه الدنيا، أنا أتحرق شوقًا إلى مسيح حافي القدمين، جائع مقهور، شبيه بهذا الذي لقيه الحواريون على طريق عمواس.. فرسالة المسيح هانت، وانمحت آثاره المقدسة من الأرض. نحن لا نتبع اليوم إلا آثار المنافقين ذوي اللحى. الآثار التي تركتها في الوحل حوافر الشيطان. لقد قلبوا كلمات المسيح فجعلوها: “طوبى للقساة بالروح لأن لهم ملكوت الأرض. طوبى للمتكبرين لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاشى إلى الظلم، طوبى لمن لا يرحمون. طوبى لمن لهم قلب دنس، طوبى لصانعي الحروب”.
هؤلاء هم الذين يسمونهم اليوم مسيحيين”.(2)
لقد كانت القضية التي تحتل مركز الاهتمام في كل مؤلفات كازنتزاكي، هي الفلسفة الميتافيزيقية التي تأثر بها من خلال دراسته لبرجسون ونيتشة هو يريد لهذه الروح الإنسانية أن تتوافق مع الواقع في كل ممارساتها وأفعالها، لذا كانت نظرته إلى الدين نظرة واقعية لا افتعال فيها لذا كان يعوّل على هذه التيمة في روايته فيقول: “أن الدين في حقيقته ثورة، والأنبياء في حياتهم على الأرض بين البشر ثوار وقادة، جاؤوا ليحققوا الحياة الكريمة للناس في هذه الدنيا، لا ليدفعهم إلى التخلي عنها، ورجال الدين في أعمال كازانتزاكي ينقسمون عادة إلى نوعين: “ثوار فقراء يرفعون راية الثورة مع راية الدين، ومرتزقة يستخدمون الدين لتحقيق أطماعهم الشخصية، يستخدمونه وسيلة لانتزاع فتاة الخبز من أفواه الجوعى، وحماية سلطان الظلم. وهو ما جسده في روايته الكبرى “المسيح يصلب مرة أخرى” حيث كان هناك رجلان يقفان في كل أحداث الرواية وجهًا لوجه، مفهومان للدين، القسيس الفقير الثائر الأب “فوتيس”، والقسيس الثرى المنافق الأب “جريجوريس”.
الأول يقود المسيحيين المخلصين من أجل العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة على أهالي ليكوفريسي والمتمردين ضد الحكم العثماني، والثاني يقود أغنياء القرية ليحمي أملاكهم ويحمي سيطرة الأغا التركي، الأول جائع حافي القدمين شجاع، والثاني متخم البطل يرفل في الحرير، مخادع يفعل أي شيء لإرضاء الأغا، ولا يتورع عن أن يصحب له عذراء شابة يطلبها غلامه المدلل”.(3)
- “الإغواء الأخير للمسيح” بين الروح والجسد 1955
يقول كازنتزاكي حول كتابته رواية “الإغواء الأخير للمسيح: “لم أتبع مسار رحلة المسيح المخضبة بالدم إلى صيحة الرعب الهائلة التي هزت الكون ساعة صلبه.
لم أعش حياته من جديد ولا آلامه بمثل تلك الكثافة، وذاك التعب والحب، كما حدث خلال الأيام والليالي التي كتبت فيها هذه الرواية “الإغواء الأخير للمسيح” ولعلني وأنا أقر بهذا الاعتراف يكون الجنس البشري بآماله ومشاعره العظيمة قد تأثر تأثرًا شديدًا حتى أن عينييّ قد امتلأتا بالدموع، وقلبي بالشجن، ولم أكن قد شعرت بدم المسيح يسقط قطرة قطرة في قلبي بمثل هذا القدر من الألم والشجن. فلكي يرتقي المسيح إلى الصليب، قمة التضحية مر خلال تلك المراحل المضنية التي يمر بها كل من يصارع الحياة.
هذا الجانب من طبيعة المسيح والذي كان إنسانيًا بعمق يساعدنا على فهمه وحبه وعلى اتباع درب آلامه وكأنها آلامنا، ولو لم يكن في داخله هذا العنصر الإنساني الدافئ لما تمكن من أن يصبح رمزًا نموذجيًا لحياتنا. لذا كان الإغواء الأخير للمسيح في رؤية كازنتزاكي هي نوع من الاستشعار بالحياة من جانب الألم، هى نوع من قهر الفتنة، وقهر الإغواءات الأخيرة لدى الإنسان كلما هم الشيطان بأن يضعه على أول طريق الغواية”(4)
وكأن الصليب في تلك الآونة في انتظار قدوم المسيح إليه، ويهوذا الواقف بالباب ينظر في تشف وفرح لهذه المأساة التي نسج نسيجها مع الشيطان، وكانت الحياة قبله قابلة للكشف عن الغواية والسير في طريقها، ولكن الإغواء الأخير جاء مخيبًا للآمال عند أصحاب هذا المذهب البشري الخادع.
الصليب كان في انتظاره، لكن المسيح عرج عن هذا الإغواء، وابتعد عنه وأمام عينيه كشفت روح الشر نفسها، في لمح البصر انتشرت الرؤى الخادعة للحياة السعيدة الوادعة، وبدا للمسيح أنه سلك سبيل البشر الممهد السهل، تزوج وأنجب الأطفال، وأحبه الناس واحترموه، كان هذا المشهد بمثابة الإغواء الأخير الذي جاء كلمع البرق ولمح البصر ليعكر صفو اللحظات الأخيرة من حياة المخّلص.
لكن المسيح هز رأسه بعنف على الفور، وفتح عينيه، ورأى الرفض قائمًا أمام عينيه، لا.. لا، لم يكن خائنًا. المجد للرب! ولا كان آبقًا، لقد أنجز المهمة التي وكلها الله إليه، إنه لم يتخذ له زوجة، ولم يعش حياة سعيدة هادئة مثل بقية البشر، لقد وصل إلى ذروة التضحية، وها هو مسمّر على الصليب. ينتظر النهاية.
أغمض عينيه راضيًا، ومن ثم تعالت صرخة انتصار عظيمة: لقد أنجز المهمة على خير ما يرام. وبكلمات أخرى وأخيرة: لقد أديت واجبي، وها قد صلبت ولم أستسلم للغواية.
في هذه الكلمات التي عبرت عن موقف السيد المسيح بعد غوايته بالإغراء والغواية الأخيرة. وهي جزء من مقدمة الرواية، يقول كازنتزاكي: لقد كتبت هذا الكتاب لأنني أردت أن أقدم نموذجًا ساميًا للإنسان المقاوم، أردت أن أبين له أن عليه أن لا يخشى الألم، أو الغواية أو الموت، لأن الثلاثة يمكن قهرهم، وأن الثلاثة قد قهروا فعلاً.
لقد عانى المسيح الألم، ومنذ لك الحين تقّدس الألم، وجاهدت الغواية حتى آخر لحظة لتضلله، ولكنها هزمت، مات المسيح على الصليب، وفي تلك اللحظة تلاشى الموت إلى الأبد.
أصبحت كل عقبة ظهرت أثناء رحلته علامة على الطريق، وفرصة لإحراز مزيد من النصر، أمامنا الآن نموذج، نموذج يضئ دربنا بتألقّه ويلهمنا القوة. ويستطرد كازنتزاكي ويقول: هذا الكتاب ليس سيرة حياة، إنه اعتراف كل إنسان يكافح، وأنا بنشري أياه أكون قد أديت واجبى، واجب إنسان كافح كثيرًا، وذاق الأمرّين في حياته، وانطوى على آمال كثيرة، أنا واثق من أن كل إنسان حر يقرأ هذا الكتاب المترع بالحب، سوف يحب، أكثر من أى وقت مضى”.(5)
- “المسيح يصلب من جديد” بين الخير والشر
تقوم أحداث رواية “المسيح يصلب من جديد” في قرية من قرى اليونان التي ما زالت خاضعة تحت حكم الإقطاع التركي، وفيها يرتأى الأب جريجوريس كاهن القرية، أن يمثل مشهد آلام السيد المسيح قبل عيد الفصح، ويعطي لكل دوره في هذا التشخيص الاحتفالي، فينال الفتى الراعي مانوليس دور المسيح، ونياكوس وميشليش وكوتانديس أدوار الرسل المفضلين، وبانئيوتيس دور يهوذا الخائن،
وبينما القرية مهتمة بهذه الاحتفالية الموسمية، إذا بسكان مشردين قد لجأوا إليهم مع كاهنهم الأب فوتيس بعد أن نجوا من مجزرة تركية، آملين بأن ينالوا من سكان القرية عطفًا إنسانيًا في موقفهم المأزوم، لكن الأب جريجوريس رفضهم، ألّب عليهم أهل القرية بحجة أنهم مصابون بالكوليرا، فهربوا إلى الجبال المجاورة، بيد أنهم لاقوا من بعض أهل القرية عطفًا ومودة لاسيما من مانوليس ورفاقه الرسل المفضلي، وذات يوم بينما كانت القرية في آمنها وحياتها الطبيعية، إذا بغلام الآغا التركي المسمى بيوسوفاكي وجد مقتولاً في قصر الآغا. فيحتدم غضب الآغا ويلقى القبض على أعيان القرية ويعلن أنه سيشنقهم جميعًا إن لم يظهر القاتل ويعلن عن نفسه.
وفي هذه الأثناء يتقدم الفتى كانوليوس ليقدم نفسه ضحية عن أهل القرية، وعندما أوشك الآغا أن يشنقه إذا بالجريمة تكتشف، وإذا بمرتكبها من داخل قصر الإقطاعي نفسه. وتسير الأحداث بعد ذلك على وتيرة المؤمرات والتضحيات، ويلقي كازنتزاكي الضوء فيها على صراعات الإنسان ضد أخيه الإنسان، ويقول كازنتزاكي على لسان “ياناكوس” هكذا يكون الإنسان.. كائن حي يتكلم ويعترض ويسائل،
فعلى هذا النحو يحقق الإنسان ذاته أو يمنحها الوجود الحق، إننا نفرض ذواتنا على الحياة، أو هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وهكذا كان القسيس فوتيس داخل النص، هو نموذج الإنسان ومسيرته الإنسانية على طريق الحياة. معانا وجلد وتحرر وحب وعمل، وفي ذلك يقول القسيس فوتيس: “الحياة يا إلهي عبء ثقيل، ولولاك لأمسك كل منا بيد الآخر، رجالاً ونساء، وذهبنا لنلقي بأنفسنا في هوة سحيقة ليس لها من قرار لنتخلص من الحياة، ولكنك موجود، فأنت الفرحة والعزاء”.(6)
من هنا نجد أن ميتافيزيقا الروح وواقع الجسد هما المحوران اللذان اشتغل عليهما كزانتزاكي في معظم أعماله الروائية، تحرر الروح من البطون المتخمة، ومحاولة الجسد أن يتحلى بما تمنحه إليه الروح الشفافة الموحية بالحب والطهر والجمال.
- تقرير إلى جريكو بين الرواية والسيرة 1961
في هذا الكتاب الروائي السيّري “تقرير إلى جريكو” وكان الأخير في إبداع كازنتزاكي، ويعتبر بمثابة رسالة وداع من كازنتزاكي لهذا العالم، وكانت زوجته هيليني تعرف هواجس الإنسان في نفس زوجها، وتخشى عليه من مشاعر الشعور بقرب النهاية.
لذا فعندما طلب منها نيقوس قراءة ما كتبه في هذا الكتاب، وكان متلهفًا على معرفة مشاعرها الذاتية تجاه سيرته الذاتية التي كانت هي إحدى أطرافها، وعندما قرأت أيليني السطور الأولى من الافتتاحية شعرت وكأن رائحة الموت تملأ هذه السطور وتلونها بالسواد، فلم تتمالك نفسها وسرعان ما أجهشت في البكاء، مثل هذا الكتاب الذى نشر بعد رحيله بأربع سنوات مثّل في مسيرة كازنتزاكي حالة من الوجد والدهشة لأفكاره، ومشاعره الفياضة تجاه ما كان يكتب ويبدع،
وكان انعكاسًا أخيرًا لإبداعاته التي كتبها أثناء حياته، كان يريد فيه أن يتحرر من الموت الذى كان يقترب منه في ذلك الوقت، فكل شيء في هذه السيرة الشجية كان يلتفت فيها إلى الوراء ليرى حصيلة حياته بزخمها الكبير وتجاربها الحياتية والإبداعية والإنسانية، والتحولات التي طرأت عليها، والأماكن التي عاش فيها، كان يحاول أن يمنح الديمومة لكل ما هو عابر، ويطرح حوارًا مع الذات والإله والطبيعة، كانت روح الحياة في تقريره اليومي إلى جريكو هو استحضار روح الحياة اليومية التي اعتاد رؤيتها دون توقف، والتي كان يقدسها وكأنه يزيح غبارها عن كتبه ويمنحنا من خلالها الإثارة والمتعة السردية الخالصة والكاشفة،
هو دائمًا يردد فيها عما هو ميتافيزيقي في إبداعاته ومشاعره الروحية وهو ما بدا واضحًا عبر تقريره هذا إلى جريكو وفيه يقول: إن موتاك لم يعودوا يقبعون في التراب، إنما صاروا طيورًا وأشجارًا وهواء، إنك تجلس بينهم وتستطعم لحمهم، وتستنشق أنفاسهم، لقد صاروا أفكارًا وأحاسيس يحددون مشيئتك وسلوكك وأفكارك. إذا كان هذا الكتاب بمثابة رحلة فكرية فلسفية قام بها كازنتزاكي، وجملة اعتراضية يقول فيها: إن روحي كلها صرخة، وأعمالي جميعها تعقيب على هذه الصرخة. ويضيف: طوال حياتي كانت هناك كلمة تعذبنى وتجددني، هى كلمة الصعود، وسأقدم هذا الصعود، وأنا أمزج الخيال بالواقع، مع أثار الخطى الحمراء التي خلفتها ورائي وأنا أصعد”.(7)
كما تضيف زوجته هيليني عن تجربته في كتابة هذه السيرة الميتافيزيقية: “ذات مرة قال له أحد المناضلين لكازنتزاكى لا تحكم على من أفعالى. أحكم علىّ من الغاية الخفية التي تسعى إليها أفعالي!” وتقول هيليني: “هكذا يجب أن نحكم على كازنتزاكي، أي من خلال ذلك الذي كان يريد أن يدركه. ثلاثة وثلاثون عامًا إلى جواره، لا أذكر أننى شعرت بالخجل مرة لفعل بدر عنه.
كان شريفا، لا أوزار تثقل ضميره، بريئًا مترفقًا بالآخرين، ولم تكن تخشن معاملته إلا مع نفسه. كان يعتزل الحياة. ويلوذ بالوحدة، لأنه كان يشعر بأن المهمة التي أخذها على عاتقه كبيرة وساعات العمر محدودة، كان يقول: تنتابني الرغبة في أن أفعل ما يقوله برجسون – فيلسوفه المفضل – أن أنزل على قارعة الطريق، وأمد يدى إلى المارة مستجديًا ليعطنى كل منهم ربع ساعة من وقته إحسانًا”.(8)
كانت حياة كازنتزاكى ملحمة تمثل الصراع في مختلف أشكاله، صراعًا بين روحه وجسده، بين قلمه وما يزدحم به عقله من رؤى وأفكار وآراء متحررة، وكان كازنتزاكي قد صور حياته النفسية والفكرية في كتابه “خطاب إلى الجريكو” ثم كان آخر ما نشره مقالة نشرت بعد وفاته – عام 1959 – بأمريكا في كتاب عنوانه “الإيمان” مع مقالات لكتاب آخرين – جاء بها: كان منبع تعاستي منذ مطلع حياتي، هو الصراع الذى كان ينشب في نفسى بين روحي وجسدي، وفي يأس ذهبت إلى جبل “آتوس” وترهبت في صومعته عدة أشهر، ودربت جسدي على الحرمان والجوع والعطش..
وفي ذات ليلة رأيت الخيط الأحمر الذي تخلف وراء محارب يصعد إلى الجبل – آثار أقدام حمراء خارجة من الحياة إلى الروح.. وعرفت واجبي وهو أن أسير وراء هذا المحارب المكافح. وأصبحت حرًا ولم أغيّر الدنيا، لكنني غيرت النظرة التي أتطلع بها إلى الناس”.(9) كان هذا هو نيكوس كازنتزاكى حفيد الجريكو وأسطورة اليونان الحديثة، الذى كان القلق الميتازيفيزيقى ديدنه، وغذاء روحه في كل مراحل حياته القلقة الزاهرة.
- الإحالات:
1- كازنتزاكيس بقلم زوجته، حسب الله يحيى، ج الصباح، بغداد، ع 3048، 27 فبراير 2014
2 – رواية “الإخوة الأعداء” رواية نيكوس كازنتزاكي، ترجمة إسماعيل المهدوى، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1967، ص1
3 – المصدر السابق ص 2
4 – رواية الإغواء الأخير للمسيح، نيكوس كازنتزاكيس، ترجمة أسامة منزلجى، منشورات دار المدى للثقافة والنشر، بغداد، ط 2، 1995 ص 16
5 – المصدر السابق ص 18
6 – “المسيح يصلب من جديد” رواية نيكوس كازانتزاكى، ترجمة شوقى جلال، دار المستقبل العربى للنشر والتوزيع، القاهرة، 1982ص 8
7- كازنتزاكي في تقريره إلى غريكو، كاظم حسونى، ج المستقبل العراقى، ع 128، 10 أكتوبر 2011
8 – أرملة كازندزاكي تتحدث عن تجربته، د. نعيم عطية، م الدوحة، ديسمبر 1976
9 – نيقوس كازنتزاكي قصصه ورواياته، نقولا يوسف، م القصة، القاهرة، ع 16، أبريل 1965 ص138.