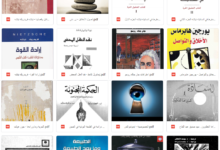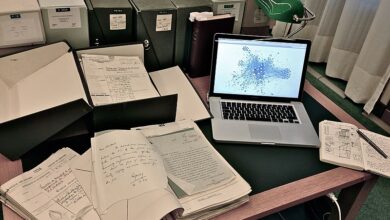النزاع بين الدين والفلسفة – تاريخه ورموزه واتجاهاته

- الكتاب: “قصة النزاع بين الدين والفلسفة“
- المؤلف: د. توفيق الطويل
- الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2019.
يعد الدكتور توفيق الطويل من أهم رواد الفلسفة الأخلاقية في العالم العربي المعاصر، فهو صاحب أول دراسة عربية متكاملة عن فلسفة الأخلاق، بعنوان “فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها”، استعرض فيها مذاهب الأخلاق على اختلافها منذ العصر الهيليني وصولاً إلى الفلسفات المعاصرة في القرنيين التاسع عشر والعشرين الميلادي، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1960.
وقد أعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة، نشر كتابه المرجع “قصة النزاع بين الدين والفلسفة”، الذي يستعرض فيه المؤلف جانباً من قصة النزاع بين الدين والفلسفة عبر العصور المختلفة، من اليونان قديماً حتى العصر الحديث، مُركزاً بصورة كبيرة على مرحلة العصر الوسيط، على اعتبار أنها المرحلة التي شهدت صراعاً معلناً بين السلطة الدينية وسلطة العقل.
سعى الكاتب أيضاً إلى محاولة رصد جوانب الاختلاف بين الدين من جهة والفلسفة من جهة أخرى، مجيباً عن سؤال: هل يمكن الجمع بينهما؟.
الشطر الأكبر من الكتاب عن تاريخ ذلك الصراع في الغرب بين الكنيسة والفلاسفة، حتى جاء الإسلام ليجعل من التدبر العقلي واجباً دينياً، ويحرر العقل الإنساني من سلطة الكهنة والأسلاف والأوصياء، ويطلق ملكاته للبحث والتفكر والإبداع، وذلك بتحريض مباشر من نصوص الوحي الإلهي.
رؤية الدكتور توفيق الطويل من خلال كتابه بشكل عام تتجه نحو محورين:
المحور الأول: أنه ليس ثمة صراع بين الدين سواء كان مسيحياً أو إسلامياً وبين الفلسفة، وأن النزاع الحقيقي هو بين الرؤية التفسيرية لرجال الدين وبين الفلسفة.
المحور الثاني: بيان فساد القضية التى تقول أن التفلسف يقتضي الإلحاد، وأن الإيمان يمنع الابتكار والإبداع، وفي دحض هذا الوهم يؤكد المؤلف “أن حركة التحرر من الدين، كانت عنيفة واضحة في عصر النهضة، ورغم هذا التحرر لم يستطع مفكروا ذلك العصر أن يبدعوا فلسفة جديدة مبتكرة.
وظل التفكير الفلسفي عندهم ميالاً إلى ابتعاث المذاهب الفلسفية القديمة، أما الفلسفة المبتكرة حقاً فلم تولد إلا في مطلع القرن السابع عشر، الذي اشتد فيه الإيمان بشريعة العقل، مع الإيقاء على قدسية الدين وحرمة تعاليمه، فالإنسان يستطيع أن يكون فيلسوفاً مبدعاً مع وفائه لعقيدته الدينية وإيمانه بوحيها”.
طارد المتزمتون من رجال الدين أحرار الفلاسفة، ونكلوا بهم دون رحمة، واستطاع الاضطهاد الدامي أن يسكت أصواتهم أمداً من الدهر ـ قصر أو طال ـ لكن الأفكار التي استشهد هؤلاء الأحرار من أجلها قد بقيت حية بعد مصرعهم، تكفل صدقها بخلودها.
فالفكرة الصحيحة التي يكشف عنها النظر الفلسفي أو البحث العلمي، لا تموت أبداً، لأن صدقها لا يعرف زماناً أو مكاناً يقف عنده، وصدقها يضمن بقاءها، بل يكفل خلودها، وسيان بعد هذا أن ينجح أو يفشل الاضطهاد الآثم في إسكات أصوات الداعين لها.
لأن الفكرة الصحيحة إذا عدمت أنصارها في الأيام السود، وجدت هؤلاء الأنصار بعد انقضاء العهد المشئوم، ومن هنا كان الفشل هو المصير المحتوم لكل اضطهاد يزاول في مجال الفلسفة والعلم معاً.
وما أصدق فكتور هيغو حين قال: “نحن مع الدين على رجاله”.
يقول المؤلف في صفحة (30): “تبعة السلوك المسيحي إزاء النظر العقلي الحر، مردها إلى مؤولي النصوص المقدسة، لا إلى هذه النصوص نفسها، ولما كان التأويل حتى مطلع العصر الحديث، في يد رجال الكهنوت، لا ينازعهم فيه منازع، كانوا هم المسئولون عن جرائم النزاع بين الدين والفكر الحديث، لاسيما وأن الكتب المقدسة قد خلت من كل إشارة تعرقل طلاقة الفكر”.
يلفت المؤلف إلى ملاحظة هامة بقوله: “من الإنصاف أن نقول إن فظائع المسيحيين التي تضمنها هذا الكتاب، لا يحمل تبعاتها إلا بعض رجالها في الغرب، دون مسيحيي الشرق.. هذه حقيقة سجلها تاريخ الأديان في شتى البقاع ومختلف العصور”.
هيمنت الكنيسة على كل ميادين البحث العلمي، حتى النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وفرضت عليها ما تراه حقاً، مستندة في ذلك إلى سلطة الكتاب المقدس المعصوم من كل خطأ، وسرعان ما اتصل الدين بالظواهر الطبيعية ونحوها مما يدخل في نطاق العلم والفلسفة.
فاتصل وصف التوراة لخلق الكون ووقوع الإنسان في الخطيئة بفكرة الفداء في المسيحية، وأفضى هذا إلى استبعاد علم طبقات الأرض وعلم الحيوان، وعلم الإنثروبولوجي من ميادين البحث الحر، وأصبحت الحقيقة هي التي تقوم في ظاهر نصوص الإنجيل، وأدى هذا إلى القول بدوران الشمس حول الأرض.
إذا كانت ساحة الإسلام قد برأت من آثام غلاة المتعصبين من رجاله، فإن المسيحية غير مسئولة عن تاريخها الملطخ بالدم، فليس في طبيعة الإسلام، ولا في طبيعة المسيحية ما يدعو إلى الاضطهاد، ولا إلى محاربة الجديد، ولا إلى مناهضة حرية الرأي، أو اخذ العقول بالجمود أو يحظر عليها حرية الرأي قليلاً أو كثيراً.
وإذا كانت العصور القديمة لم تخل من أمثال أبقراط الذي أقام دراسة الطب على التجربة والمنهج العلمي، فإن العصر الوسيط قد ارتد إلى الأفكار البدائية في العصور البربرية، إذ كانت الأمراض الجسمانية تعزى إلى عوامل خفية، أظهرها حقد الشيطان أو غضب الله.
وقد أكد هذا أكبر آباء الكنيسة “أوغسطين” إذ قال أن أمراض المسيحيين مردها إلى الشياطين، وبينما كانت الكنيسة تربح من الأحجبة والتعاويذ، كان الأطباء معرضين في أكثر الأحوال للاتهام بالسحر والكُفر معاً، وكانت الكيمياء تعتبر فناً شيطانياً خبيثاً، وقد أدان البابا المشتغلين بها عام 1317م، وسُجن روجر بيكون عام 1292، مدة طويلة رغم حماسته للدين لمجرد نزوعه الطبيعي للبحث العلمي.
وهذا شاهد كبير على كراهية العصر الوسيط للعلم، وقد لبثت أوروبا منشغلة بمقاومة السحر والتنكيل بأهله ثلاثة قرون من الزمان، وأصدر البابا أنوسنت الثامن أمراً بابوياً عام 1484 أكد فيه أن الطاعون والزوابع من عمل الساحرات، وآمن بهذا حتى المستنيرين من الناس، حتى اجتثت النزعة العقلية الحديثة جذور هذه العقيدة ووضعت حداً لفظائعها.
يلاحظ المؤلف أن الفترة التي بسطت فيها الكنيسة سلطانها على التفكير، كان العقل مقيداً في سجن شيدته الكنيسة للعقل البشري، وكانت محاكم التفتيش أخطر سلاح تقلدته السلطات الكنسية لمحاربة العقل الحر، عندما أدخلت في قانون أوروبا العام مبدأ “أن الحاكم يحتفظ بعرشه متى قام بواجبه في استئصال الهرطقة، فإن تردد في الاستجابة لأمر البابا باضطهاد الزنادقة، أُكره على الطاعة، وصُودرت أملاكه، وبيعت لأعوان الكنيسة وعرض نفسه للاعتقال”.
كانت عيون الكنيسة تفتش عن خصومها، وتقيم المحاكم لتروع الملاحدة بأحكامها الصارمة، ولهذا أنشأ البابا جريجوري التاسع محكمة التفتيش عام 1223م، ومكن لهذا النظام أمر بابوي أصدره أنوسنت الرابع عام 1252، ضبط به نظام الاضطهاد كجزء رئيسي من الكيان الاجتماعي في كل مدينة أو دولة، وكانت هذه أداة لكبح التفكير الحر، لم يعرف التاريخ لها نظيراً.
كان المبدأ الذي اعتنقته محاكم التفتيش يقول: “لأن يدان مائة برئ زوراً وبهتاناً ويعانون العذاب ألواناً خير من أن يهرب من العقاب مذنب واحد!، ومن ساهم في تقديم الوقود الذي يُحرق به الزنديق فقد استحق المغفرة!”.
وكان من أهم أعمال محاكم التفتيش وضع فهرست الكتب المحرمة على المؤمنين، والعالم الأوروبي يمضي مع هذا التيار الجارف وقد أغمض عينيه، حتى أذن فيه مؤذن العقل في فجر العصر الحديث فاستجاب له.
كان جاليليو أحد السباقين إلى المنهج العلمي الجديد، فبينما اعتمدت الكنيسة القول المنسوب إلى بطليموس، من أن الأرض ثابتة وأنها مركز الكون، الذي قام عليها العشاء الرباني، وسخرت من أجله كل الظواهر الكونية، وأن الشمس وسائر الكواكب تدور حولها.
وأيدت هذا الاتجاه بنصوص من الكتاب المقدس، عكس جاليليو الآية، وصرح بأن الشمس هي مركز الكون وليست الأرض، وأن الأرض تدور دورة مزدوجة، حول نفسها ـ كل أربع وعشرين ساعة ـ وحول محورها في الوقت نفسه ـ مرة كل عام ـ فأثار ضيق الكنيسة، وتضافر خصومه على إخفات صوته والتنكيل به، وأقام جاليليو في منفاه مريض النفس والجسم معاً، ولبث في سجنه حتى كف بصره، فقيل: مات كفيفاً ذلك الذي مد أبصار الناس إلى عجائب السموات.
- موقف الإسلام وفقهائه من التفكير الفلسفي:
عرف العالم الإسلامي من رجال الدين أحراراً يسايرون التطور ويسبقون الزمن، وينتصرون للعقل، ويحاربون الجمود والجهل والتعصب، وعرف إلى جانب هؤلاء متزمتين يجمدون والدنيا من حولهم في حركة دائمة ونشاط متصل، فيطمعون في أن يوقفوا الركب ويعرقلوا حركته، لأنهم لا يحتملون من أحد أن يخرج على مألوف، أو يصيب عند الناس شهرة أو عند الحكام عطفاً ورعاية.
ذهب جمهرة فلاسفة الإسلام إلى القول بأن غاية الدين تتشابه مع غاية الفلسفة، فكليهما يرمي إلى تحقيق السعادة عن طريق الاعتقاد الحق وعمل الخير، ويقولون أن موضوعات الدين والفلسفة واحدة، لأن كليهما يعطي المبادئ القصوى للموجودات.
يرى المؤلف أن هذا موقف الفلاسفة إجمالاً، أما علماء الدين فقد كانوا ينفرون من كل علم ينسب إلى الفلسفة أو يتصل بها، ويقول أصحاب هذا الاتجاه “إن النبي (ص) حين سأل ربه أن يعيذه من علم لا ينفع، إنما قصد علوم الأوائل (كان مفكروا الإسلام يطلقون على دائرة المعارف اليونانية من رياضيات وطبيعيات وإلهيات اسم علوم الأوائل).
بل يرى ابن تيمية الحنبلي في الجزء الأول من مجموعة رسائله الكبرى أن العلم هو ما كان موروثاً عن نبي، وكل ما سواه فهو علم لا ينفع، ومن أجل هذا كان أهل السنة ينصحون طلاب العلم بتجنب الاتصال بالمشتغلين بعلوم الأوائل، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
من الإنصاف أن نقول، أنه رغم أن حكام المسلمين قد جمعوا بين الحكم الدنيوي والديني في الصدر الأول من الإسلام، إلا أنه لم يحدث من المحن بعض ما عرفنا في العالم الأوروبي، وأن بعض حكام المسلمين في غير هذه الفترة قد انساقوا إلى حيث أراد المتزمتون من رجال الدين، فحجروا على الفكر الحر واضطهدوا أهله.
ومن معسكرات المتكلمين ـ معتزلة كانوا أو أشاعرة ـ صدرت كتب كثيرة تهاجم الفلسفة والمنطق بوجه خاص، منها كتاب “الرد على أهل المنطق” للنوبختي وغيره. أما في الغرب الإسلامي فقد أمر المنصور بن أبي عامر بإحراق الكتب المؤلفة في العلوم القديمة، لاسيما ما كان منها في المنطق والنجوم.
وقد أيد حكمه في هذا الصدد رجال الدين، وعرض الغزالي في “المنقذ من الضلال” موقفه من الفلسفة، قسم فيه الفلاسفة إلى ثلاثة أصناف: دُهريون وهم الزنادقة، أنهم زعموا أن العالم لم يزل موجوداً بنفسه..
ثم طبيعيون وهم الذين سلموا بوجود قادر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها لكنهم أنكروا معاد النفس وجحدوا الآخرة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، وهؤلاء أيضاً زنادقة، ثم إلهيون: وهم المتأخرون منهم كسقراط وأفلاطون وأرسطو، وقد هاجموا الدُهرية والطبيعيين لكنهم استبقوا من رذائل كفرهم بقايا فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهم..
وقد ندد الغزالي في تهافته بالفلاسفة، ورماهم بالغباوة والحمق وسوء الظن بالله، لكن تكفيرهم كان أقسى ما في حملته التي أماتت الفلسفة في الشرق الإسلامي، وامتد لهيبها إلى الغرب الإسلامي، فلما مات الحكم المستنصر بالله الذي بعث الحركة العلمية وأجزل لأهلها العطاء.
خلفه ابنه هشام الذي اغتصب ملكه الحاجب المنصور، وناهض العلم واضهد العلماء والفلاسفة، وحاصر قرطبة وأسقط قصر الخلفاء، وأمر بإحراق ما فيه من كتب الفلسفة والمنطق والفلك، فأحرقت في ساحات قرطبة أو طرحت في آبارها.
وقد فعل هذا كله رغبة منه في استمالة رجال الدين وإرضاء الشعب بعد اغتصابه الملك من هشام، وليكون بهذا بطل الدفاع عن شريعة الناس ودينهم، ثم خلفه الخليفة عبدالمؤمن الذي اجتمع في بلاطه أعظم فلاسفة العصر، وفي طليعتهم ابن رشد، فشجعه الخليفة على شرح كتب أرسطو، فاستجاب له وكان الشارح الأعظم.
الطريف أنه حين اجتاحت قوات ألفونس السادس ـ أمير قشتالة ـ مدينة طليطلة عام 1085م، أنشأ المونسيير ريموند كبير أساقفة المدينة ـ بين سنتي 1130 حتى 1150 ـ ديواناً لترجمة الكتب العربية في الفلسفة، على يد مترجمين من اليهود، وأمر رئيس الشمامسة دومنيك جنديزالنس بترجمة التراث الفلسفي الإسلامي لاسيما ما خلفه ابن سينا، ثم تكفل الديوان بعد هذا بترجمة الفارابي والكندي.
وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر، تولى ميخائيل الإيقوصي ترجمة الشارح الأعظم ابن رشد تحت رعاية الإمبراطور فردريك الثاني، الذي اتصل بالعالم الإسلامي في حروبه الصليبية، ومهر في العربية وأعجب بفلاسفتها، فتاق لنقل تراثهم إلى اللاتينية والعبرية، وعلى هذا النحو عرفت أوروبا فلسفة أرسطو منقولة إلى اللاتينية عن كتب شراحه ومفسريه من المسلمين.
واستطاع مفكروا أسبانيا المسلمين أن يقدموا للغرب تراثه قبل أن تنتعش فيه الدراسات الإغريقية بعدة قرون، وأضحت ترجمتهم مرجعاً للعلم في القرن الثالث عشر، في حين استعان الأكليروس اليهودي في حملته على الفلسفة بالغزالي الذي اشتد في هجومه على الفلسفة،
فترجم اليهود كتابه “تهافت الفلاسفة” عام 1538م، ليدحضوا به أتباع بن رشد وأرسطو، ولبثت الحال على هذا حتى احتلت الفلسفة الأوروبية الميدان في العصور الحديثة.
كان على ابن رشد أن ينصف الفلسفة من هجمات الغزالي، فوضع كتابه “تهافت التهافت” ليدحض به حملة الغزالي، وليثبت إمكان التوفيق بين الدين والفلسفة، ومهد إلى هذا بالاستدلال بالقرأن على وجوب النظر العقلي.
ومتى صح هذا وجب الانتفاع بتراث اليونان، ومحاولة التوفيق بين حرفية النص وتراث العقل القديم، بتأويل ظاهر النصوص وجعلها متمشية مع منطق العقل السليم، وقد وقف على هذه الغاية كتابيه: “فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال” و”الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الأمة”.
لم تؤثر الحملات التي شنها المتزمتون من أهل السنة على التفكير الفلسفي، لأن الدين الإسلامي في أصله لا يعوق طلاقة النظر العقلي، ولا يعرقل حريته، وقد خلت الآيات القرآنية والمعتمد من الأحاديث النبوية من نص يشجع على عرقلة الفكر الحر والتنكيل بأهله.
بل لقد روى بعض أئمته ورجاله، أن من أصول الإسلام: النظر العقلي لتحصيل الإيمان، وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض، والبعد عن التكفير “فإذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر”، ثم إلغاء السلطة الدينية “فليس لأحد بعد الله سلطان، والخليفة ليس موضع عصمة ولا مهبط وحي”، كما يقول الكاتب.
وأجمل ما في موقف القرآن الكريم بصدد الحرية العقلية، قوله تعالى في سورة البقرة: (لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، وقوله في سورة الكهف: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ).
بهذا أطلق القرآن الكريم حرية النظر، وسجل على المتزمتين إثم ما يفعلون، وجعل رسول الله مبلغاً ومذكراً، لا مسيطراً ومهيمناً “فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر”، وبهذا كله خلا الإسلام من شئ اسمه السلطة الدينية، والخليفة لا يحتكر تأويل الكتاب والسنة، ولا يعتبر معصوماً من الخطأ، فإن زل وجب تقويمه “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
ومن الإنصاف أن نقول، أنه رغم أن حكام المسلمين قد جمعوا بين الحكم الدنيوي والديني في الصدر الأول من الإسلام، إلا أنه لم يحدث من المحن بعض ما عرفنا في العالم الأوروبي، وأن بعض حكام المسلمين في غير هذه الفترة قد انساقوا إلى حيث أراد المتزمتون من رجال الدين.
فحجروا على الفكر الحر واضطهدوا أهله، لكنهم لم ينشئوا محاكم تفتيش تطارد هؤلاء الأحرار أينما كانوا، ولم يضعوا سجلاً يثبتون فيه أسماء الكتب التي حُرمت قراءتها على المؤمنين.
ولم يلجأوا إلى الإعدام والإحراق والتنكيل إلا في حالات نادرة، ومن الإنصاف أن نقول كذلك: إذا كانت ساحة الإسلام قد برأت من آثام غلاة المتعصبين من رجاله، فإن المسيحية غير مسؤولة عن تاريخها الملطخ بالدم، فليس في طبيعة الإسلام، ولا في طبيعة المسيحية ما يدعو إلى الاضطهاد، ولا إلى محاربة الجديد، ولا إلى مناهضة حرية الرأي، أو اخذ العقول بالجمود أو يحظر عليها حرية الرأي قليلاً أو كثيراً.