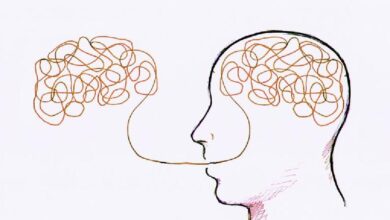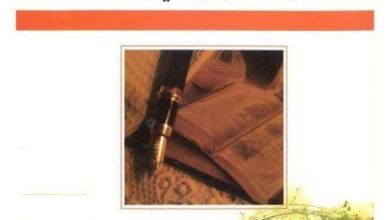تمسرح المعنى

يدفعنا القول بأن الإنسان كائن رمزي إلى التعامل بالضرورة مع كل أشكال الممارسة الإنسانية بصفتها أنساقا مليئة بالعلامات والتمثلات التي تؤكد بأن الوجود الإنساني هو وجود استعاري في بحث دائم عن استجلاء المعنى، على نحو يلتهم في كثير من الأحيان ما نعتبره تخوما فاصلة بين عالم الممكنات وعالم التحققات، سواء داخل النصوص اللسانية أو خارجها،
إلى حد أن الظاهرة المسرحية، تتلبس صفات من التجربة البشرية لتضمنها خطابها في سبيل إنتاج المعنى، أي في سبيل الغائية ذاتها التي توحد كل التمفصلات على اختلافها وتنافرها، ضمن بنية كبرى تتواصل معنا عبر العلامة، إذ لا وجود لمعنى محايث ومنفصل عن الفضاء الإنساني، ما دام هو نفسه ما يؤثث كل المعاني ويسمح لها بالتدفق ضمن مستويات دلالية تنظمها وتصوغ معايير إنتاجها.
تتطلب عملية إدراك الأنا، بالضرورة، ارتطام العلامة اللغوية مع مخزون النماذج المودعة في الذاكرة، لانتقاء النموذج الذي يحيل إلى موضوع إدراكها – أي الأنا – بما يثبت أن هذا الإدراك لا يمكن أن يتم خارج قوانين الفرز، والتفييء، والانتقاء، التي تفرضها جملة من الخصوصيات تجعل من النص كائنا مركبا لا يترجم التجربة الفردية للأنا المرسلة فحسب،
بل يضم مختلف التجارب الغيرية المشتركة داخل وحدة دلالية تنتقل من الكلي إلى الجزئي، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن وجود سابق إلى وجود لاحق، ومن وجود لاحق إلى وجود سابق، إذ لا سبيل إلى استيعاب طرف دون استناد إلى الثاني، أي لا سبيل إلى تفسير العلة دون عودة إلى المعلول. من هذا المنطلق:
“أي تساؤل حول المعنى سيثير حوله دفعة واحدة، سلسلة من الأسئلة الخاصة بعمليات، مثل الإنتاج، والتداول، والاستهلاك، والقراءة، والتأويل، والموضوعية، والذاتية، والإمساك الحدسي أو الانطباعي بالوقائع، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تؤكد من جهة، الطابع المركب لظاهرة المعنى وأنماط وجوده، فالمعنى لا يوجد خارج هذه العمليات، إنه ينبثق من الإنتاج والاستهلاك والتداول، وتؤكد من جهة ثانية البعد التداولي للمعنى، فالمعنى لا يوجد إلا ضمن شروط للتلقي تحدد له أبعاده وامتداداته”.
أمام هذا الزخم من العمليات التي تتظافر لاستخراج المعنى من النصوص المكتوبة والمرئية، كان لزاما على الممارسة المسرحية أن تنحو في اتجاه قضية التمسرح، للتحول بالسؤال من حيز الماهوية، أي ما المسرح، إلى كيف ينتج المسرح المعنى، وهو تحول يؤذن بالخروج من ربقة التنظير والتجريد إلى فضاء التجربة والتفكيك، عبر مطاردة العلامة والقبض على مكامن امتدادها، داخل تعددية الأنساق الدلالية التي تصوغ الخطاب المسرحي.
ولما كان التمسرح مرتبط بفعل السميأة، فإنه يشتغل وفق خصائصها وضمن أنماطها الدلالية التي تنتقل من معنى أول يتسم بالتقريرية والوضوح، إلى معنى ثاني ذو منحى إيحائي ينطلق من المألوف، المحكوم بقانون التواضع، إلى تحريك دلالات استعارية تتجاوز التعيين إلى التأويل، أي اللاتحقق المطلق الذي ينفلت بين دوائر هرمسية، تأبى الركود والاستسلام أمام انفجار المعنى. إنه انتقال ‘بالواقعة’، في لغة سعيد بنكراد، من عمومية التجربة المشتركة إلى خصوصية التجربة الفردية، أي خروج من المحددات النفعية وولوج لعالم الرمزيات الفج.
يستدعي هذا النمط المركب الذي تفرضه كل محاولة للكشف عن المعنى استحضار مختلف الممارسات الإنسانية التي تختزن الأنساق اللغوية وجودها الافتراضي، عبر بناء صرح من القيم والدلالات يشهد العالم الخارجي على وجودها الفعلي، من هنا:
“علينا لكي نجعل من المعنى كيانا قادرا على التدليل على حد تعبير غريماس، أن نسلم مبدئيا بوجود نسق مجرد للقيم الدلالية، لا نرى منه سوى وجوهه المتحققة، ويشتغل بصفته بنية حاضنة لأساس قيمي مجرد، إن هذا السقف المجرد وغير المرئي يشكل الأساس الذي تتحقق انطلاقا منه كل الوقائع الخاصة”.
هكذا تبرز حاجة الأنا، عند الاصطدام مع أي نص، إلى وجود مرجع تتوسل به لتدرك عوالم النص التي تبدو منغلقة ومبهمة خارج المرجع، أي أن هذا المرجع هو ما يضع للأنا حدودا للإدراك، تندمج داخلها مع التجربة النصية، وفق استيهاماتها وتمثلاتها ومعارفها التي تشكل بؤرة للفهم في مرحلة أولى، ثم منطلقا نحو التأويل في مرحلة لاحقة.
إن انتقال النص من المدلول التقريري إلى المدلول الإيحائي ليس انحدارا من الموضوعية نحو الذاتية، وإنما انفلاتا من نمطية الاستقرار في اتجاه إغواء الديناميكا، فالنص والحال هذه، يمارس نوعا من التمسرح أمام الذات القارئة، حينما يدعي أن المعنى التقريري يتسم بالجمود، من حيث كونه بداية صلبة لا تقبل الانزياح. فالتقرير ” ليس أول المعاني ولكنه يوهم بذلك، (بهذا الإيهام فإنه آخر الإيحاءات)، تلك التي تقوم فيما يبدو بتأسيس القراءة وغلقها، إنه الأسطورة الكبرى التي يوهم النص من خلالها بأنه يعود إلى طبيعة اللغة، إلى اللغة كحالة طبيعية”.
إن هذا التمسرح الذي تمارسه اللغة هو ما يحفز عملية القراءة على اختراق الوجه التمثيلي للنص، تجاوزا لعتبة المألوف، وخلخلة لتماسك الدوكسا، وهو اختراق يحركه الاشتهاء، بالمعنى البارتي للكلمة، الذي يروم بلوغ المعنى في أقصى ملامح غربته عن الوجه التقريري. فالأنا المتلقية تلج البنيات الدلالية للنص، عبر أسنن حاملة لنسخ عن عالم التحققات، وممتدة داخل النسيج النصي، بما يسمح ببناء معرفة عبر فعل ‘التحيين’، أي إدراك مدلول الدال انطلاقا من انتقاء النموذج الذي يحيل عليه في الممارسة الإنسانية.
وعليه فالحديث عن القراءة لا يعني التعامل معها كفعل أفقي الاتجاه، بل كسيرورة تشتغل عبر التسنين شرطا لأجل الفهم، ذلك أن الأحكام التي تصدر عن تجربة القراءة لا تصوغ نفسها خارج النسق الثقافي الذي يمتلك معايير لها سلطة على عملية القراءة نفسها، حتى وإن ادعت العكس تماما بما يؤكد أنها تمارس، إلى جانب أفعال الفرز والتصنيف والانتقاء، فعل التمسرح لتوهمنا بموضوعية مواقفها وتفسيراتها.
لا شك في أننا لا نستطيع الكشف عن لعبة التمسرح في النصوص المسرحية تحديدا، دونما اقتحام لفضاء التأويل الذي يجعلنا نتحول من النص الكامن إلى النص المتفجر، فالتأويل ليس مرحلة سابقة لوجود النص، وإنما ينبثق من داخل تخومه، بعد ارتطام مدرك الأنا بالعلامات النصية. ما من تأويل إلا وينم خلسة أو علانية عن هوية الأنا المؤولة، بما أنها قد تنزاح في كثير من الأحيان عن قصدية النص.
“فالتأويل الذي يبيحه نسق العلامات، لا يمكن أن يكون مجرد استنتاج منطقي، ذلك أن نسق العلامات يجب أن ينتج المعنى، إن التأويل هو تعليق أو حاشية على النسق السيميائي في علاقته بالذات العارفة”. من هنا تكون العلاقة التي تنشئها الأنا المؤولة مع الأنا النصية، علاقة جدلية يحكمها الصراع، لاستيطان المعنى المنشود، الخاضع بدوره لسلطة الزمن، إذ لا مجال لبلوغ الفهم خارج الزمان، وفي غنى عن المكان، بما أن الهنا والآن محددان جوهريان للتحقق التأويلي، أي لذروة الانتماء. وهذا يذكرنا بقول إيميل سيوران عن “كون المرء لا يسكن بلادا بل يسكن لغة، ذلك هو الوطن ولا شيء غيره”.
في سياق الحديث عن تمسرح المعنى لا بد أن ننتبه إلى أن مفهوم ‘التنكر’، كما جاء به باتريس بافيس، لا يضطلع به الممثل فحسب داخل المسرحية، وإنما أيضا المقاطع النصية التي تشتغل عبر الحوار، بما يضع العلاقة بين المتلفظ والملفوظ والمتلفظ له موضع تساؤل، لاسيما أن أي تعامل مع الحوار المسرحي يستدعي معرفة سابقة بخاصية التلفظ المزدوج (La double énonciation)،
ذلك أن الحوار في كثير من الحالات قد يوهم المتلقي بأن مضمون التبادل الكلامي بين شخصيتين أو أكثر، موجه للممثلين دون الجمهور في حين أنه يستهدف مرسلا إليه مركبا. وهنا نعود إلى حيز الحديث عن ‘تعدد المرسل إليه’، حيث يشكل الحوار المسرحي ذريعة للممثل الذي يخاطب الجمهور عبر الممثل، أي باعتباره وسيطا وليس مرسلا إليه.
هكذا، فالمتلقي مطالب بالانتباه إلى طبيعة المتلفظ له من جهة، مثلما هو مطالب بالانتباه إلى ‘البياضات والفراغات’ باعتبارها نصا غائبا داخل النص، ويقابلها الصمت داخل العرض، من جهة أخرى، ” فخطاب الشخصية لا يقول كل شيء، إنه يتجنب بذلك ذكر ما هو واضح لدى المخاطب، فلا تذكر إلا العناصر التي تعد وثيقة الصلة بالحوار، لذلك فإن أخذ غير الملفوظ بعين الاعتبار، تنبثق عنه أسئلة مدهشة”.
من هنا يُطرحُ السؤال: ما الذي يوجد خارج كلام الشخصية؟ أي مساءلة الملفوظ ذاته الذي يحيط المتلفظ له بهالة من الشك حول شفافية المقول. يشتغل النص ضمن عنصري الحضور والغياب، مؤكدا – من جهة – بأن المعاني التي يستنفرها تمتد إلى خارج تخومه، ومضمرا – من جهة ثانية – كونه يتشكل عبر سلسلة نصوص سابقة لوجوده. وإن دور القراءة هو الوقوف على أسلوب المخادعة.
على أن علاقة الأنا القارئة بالنص ليست علاقة استهلاك فحسب، وإنما إنتاج طموح نحو تحقيق لذة النص، تلك اللحظة التي فيها “سوف يتبع جسدي أفكاره الخاصة، لأن جسدي ليس لديه نفس الأفكار مثلي”، على حد تعبير رولان بارت الذي يدافع عن القراءة الحية باعتبارها ‘لا تحترم النص’ ضدا على ‘القراءة الميتة’، “الخاضعة للنماذج المكرورة والقوالب الذهنية وكلمات الأمر”.
- الهوامش:
1- سعيد بنكراد، “النص بين التعددية والتأويل الأحادي”، مجلة علامات، العدد13، 2000، موقع سعيد بنكراد، تاريخ آخر زيارة:23/1/2018.
2- سعيد بنكراد، “النص بين التعددية والتأويل الأحادي” م. س.
3- سعيد بنكراد، “النص المتعدد”، مجلة علامات، العدد13، 2000، موقع سعيد بنكراد، تاريخ آخر زيارة:23/12/2018.
4- نمط التفكير السطحي أي مجموع المعتقدات والتمثلات المشتركة المؤسسة للوعي الجماعي وغير الخاضعة لمقياس العلمية.
5- ماريو فالديس “بصدد التأويل، ترجمة سعيد بنكراد”، مجلة علامات، العدد 2008/30، ص39.
6- إيميل سيوران لو كان آدم سعيدا، ترجمة محمد علي اليوسفي، أزمنة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2014، ص53.
7- أنوال طامر، “ضمنية الخطاب في المسرح”، مجلة إنسانيات للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية الجزائر، وهران العدد43 (يناير- مارس 2009)، ص29.
8- Roland Barthes Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, 1973, p.30.
9- عبد السلام بنعبد العالي القراءة رافعة رأسها، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى2019، ص6.