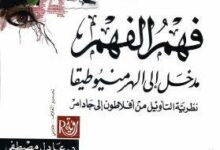في سميائيات الخطاب السياسي

هذا ليس كتابا في السياسة، ولا يُصنف ضمن خطابها. فللسياسة منطقها؛ إنها تَستعمل النص وتُوجهه ولا تؤوله. وغايتها هي الوصول إلى “حقائق” مثبتة في مقدماتها. أما نحن فلا نبحث عن حقيقة، بل نلتمس سبلا إليها.
لذلك لم نُطلق في دراستنا هاته حكما، ولم نتحيز ولم نشجب أو نستنكر؛ وإنما اكتفينا بالوصف، أي برد الظاهر إلى أصله الغابر ورد الملفوظ إلى حالات تَلَفُّظِه، وربط الحكم بما يَفْضُل من طاقات الهوى ومضافاته في الدلالة والانفعال.
فما نقدمه في هذه الصفحات هو دراسة لنص لا يقول كل شيء من خلال منطوق لفظه. فالمضمر فيه أقوى من المصرح به، والضمني أشد وقعا في التنزيل من دلالة الملفوظ وأحكامه. ففي ما هو أبعد من “النص الدستوري”، هناك نصوص السياسة والتاريخ والدين ومصالح المؤسسة ذاتها.
وهي نصوص قد لا تعبر عن نفسها بشكل صريح، فهي تختفي في العرضي والتفصيل الزائد، وتستوطن الوصف الذي لا تبرره لغة التشريع ولا يُعتمد في صياغة الأحكام، ولكنها هي الضمير الأعلى وهي الأساس الذي يحدد مضمون كل القوانين التنظيمية.
فلسنا أمام نص أدبي يُزين أطرافه وحواشيه بمجاز يغطي على جفاف القيمة وحرفيتها، بل في حضرة نص له لغة خاصة شبيهة بكل اللغات المتخصصة، وهي لغات تبلورت على هامش الاستعمال النفعي للسان، أي أصبحت، “محايدة” بفضل تخلصها من الانفعالات والتعبير الاستعاري المنحاز إلى شغف النفس وهواها؛ وذاك أمر بالغ الأهمية.
فالنص الدستوري يتجنب عادة اعتماد الأفعال الإنجازية[1] في صياغة أحكامه، ويكتفي بتقرير وإثبات حالات بلا سابق ولا لاحق. تُضمن الأولى ملفوظاتها فعلا ( التوجيه والوعد والوعيد والتحذير)، أما الأفعال الثانية فتتميز بالحياد في الوصف والتقرير.
وذاك ما تستدعيه طبيعة نص يُشَرِّع لسلوك الناس في المجتمع ويحدد لهم مواقفهم، بل يحدد لهم طريقتهم في العيش وفي ما يجمع بينهم ويحدد أفق السلطة والسقف القيمي أيضا. فالمجتمع ليس مجموعا عبثيا من أفراد بلا بوصلة تَهدي وتَشد إلى الخلف أو إلى الآتي، بل هو “نموذج كلي” تُخزن داخله كل ممكنات السلوك الفعلي والممكن والمحتمل.
وهو سلوك تحكمه ضوابط قانونية ليست سوى المظهر البراني لمجموعة من المحددات الحضارية التي تتجسد في مواقف وردود أفعال وطقوس، أي بكل ما يمكن أن يحدد، ضمن حالات الاسترجاع، نتيجة ستكون، بمنطق السبرانية ولغتها، هي السبب في ما يجب أن نكون عليه.
لا يتعلق الأمر بنماذج سلوكية تخضع دائما لضابط وضْعي، إنها موزعة بين ما يقع تحت “طائلة القانون” وبين “مُسبقات” و” أمر” و”نهي” بُؤْرتها الدين والموروث والأعراف الاجتماعية. لذلك، فالدستور، في حالتنا، لا يحْظُر ويمنع فقط، بل يَعِد ويُحذر ويتوعد، استنادا إلى نصوص ليست من طبيعته.
فالكثير من فصوله هي في الأصل قصة ممكنة في التاريخ لا في الفعل المباشر؛ قصة لا يمارسها فرد بعينه، بل هي خلاصة ممارسات تستوعب داخلها كل مساحات “الانتماء” وإكراهاته. إن التداخل بين الديني والسياسي هو الذي جعل الخطاب القانوني يخرج عن وظيفته لكي يتبنى صيغا استعارية ومجازية ليست من طبيعته. الله وحده يعرف النوايا فهو يجازي ويعاقب، أما القانون فيكتفي بالوقائع فيحمي ويردع.
وهكذا، عوض أن يكتفي هذا الدستور بتحديد مساحات تدخل ضمن القانون، وأخرى تقع خارجه، فإنه حلل وحرم، وميز المسالمين من المؤمنين عن العدوانيين من الناس أجمعين، فصل بين السماحة والتشدد، بين الميل إلى التصوف والتقوى، وبين الحرفية في التعبير والممارسة على حد سواء (الشعب المغربي في الدستور طيب ومتسامح…).
لا يتعلق الأمر إذن باستشراف لسلوك يتجسد في المطلق الوجودي، بل بما يمكن أن يسمح به نظام سياسي يستعين فيه الدستور بتقوى القلب والإيمان ومقتضيات الضبط الوضعي للسلوك والتنظيم الاجتماعي في الوقت ذاته.
وهذا معناه أن الدستور لا يُقَعِّد في سياقنا هذا، لسلوك “كوني”، بل يرسم حدودا لحالة يقبلها النظام السياسي ويقبلها سقف ثقافي/ ديني ما. يتعلق الأمر بعتبة افتراضية يُفْصَل من خلالها بين المسموح به والممنوع. وهي عتبة ليست محددة داخل “المطلق” الإنساني، بل تُبلورها قوى سياسية واجتماعية ودينية لا يعلو عليها الدستور ولا يجب أن يقول ما لا يرضاه سِجِلها القيمي أو السياسي.
يتحول المجتمع، من خلال النص الدستوري هذا، إلى محفل كلي يُمْكن، من خلاله، تسريب المواقف المقبولة والمرفوضة داخل الفضاء العمومي استنادا إلى أحكام لا مكان لها في الدستور.
والحال أن الدستور من طبيعة أخرى، إنه شبيه باللغة، أي أداة للتوسط، فهو يملأ “الفجوة” الفاصلة بين الذات وفعلها، تماما كما هو الفاصل بين المعرفة ورد الفعل الحسي. وبهذه الوظيفة يحدد طبيعة الروابط بين ما يملكه الفرد من معارف (الخبرة عامة سواء تجلت من خلال معرفة عالمة أو من خلال موروث يوجه السلوك ويمنحه معنى ) وبين قدرته على تحيينها في أفعال لا يجب أن تكون “خروجا” عن قانون هو ما يشكل السلطة الضابطة للأفراد والمجتمع على حد سواء.
وهذا ما حاولنا التنبيه عليه في هذا النص، وتلك هي مهمة المثقف، أو ذاك هو موقف الباحث الأكاديمي الذي لا يدير ظهره للسياسة، ولكنه لا يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من الوصف، أي أبعد من الكشف عن اختلالات الخطاب ذاته، فما نفهمه هو العلامات، أما ما نشرحه فهو الوقائع، بلغة دلتاي. ونحن لا نريد أن نشرح فقط، بل غايتنا هي التأويل، لذلك قد يقودنا الكثير من الشرح إلى الكثير من الفهم، أي إلى مزيد من التأويل، كما يقول غادامير.
ما يعنينا في المقام الأول هو الكشف عن المسبقات والغايات المضمرة في النص لا خارجه، فالحقيقة الوحيدة التي تعنينا هي العوالم التي تبنيها اللغة ضمن هذا السياق الخاص، فالكلمات ليست وصفا بريئا لوقائع بلا ذاكرة، بل تتضمن أحكاما وتصورات وتصنيفا وتصريفا إيديولوجيا لقناعات، جزء منها من النفس الأمارة بالسوء أو الخير، وجزء من انتماءات طبقية وسياسية ودينية. بعبارة أخرى، لا نحكم على فعل لا نستطيع تحديد أبعاده، بل نبحث في لاوعي الملفوظ وطاقاته الدلالية الممكنة.
[1] -الأفعال الإنجازية (actes performatifs) هي أفعال يقود تلفظها إلى تجسيد الأفعال التي تعبر عنها ( الوعد والتحذير والتهديد…). وهي أفعال تصنف ضمن دائرة إنجازية عادة ما تتضمن طاقات إقناعية أو ردعية. أما الأفعال الإثباتية ( actes constatifs) فهي أفعال تكتفي بوصف واقعة أو حالة أشياء ، أي إنها تكون محايدة عما تعبر عنه .