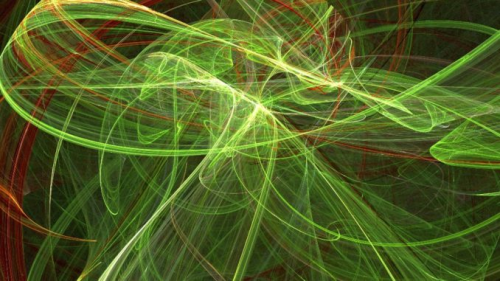
يعتبر سوسير (1871 – 1913)، في التقليد الأوروبي، أول من بشر بعلم جديد سيأخذ على عاتقه دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية من خلال الكشف عن قوانين جديدة تمكننا من تحليل منطقة هامة من ” الإنساني والاجتماعي” عبر إعادة صياغة حدود هذه الأنساق وشكلنتها.
فاللغة باعتبارها نشاطا إنسانيا عاما تتجاوز في كيانها حدود اللسان الذي لا يشتغل داخلها سوى وسيلة ضمن وسائل أخرى لا تقل أهمية عنه (الإشارات – الطقوس – الرموز – الأمارات …). ولن يكون بمقدورنا، والحالة هذه، قصر التواصل على اللسان وحده، فذلك يعني تجاهل وإهمال أنساق أخرى لها دور رئيس في إنتاج المضامين الدلالية وإبلاغها.
ومع ذلك لابد من تنسيب الأحكام. فاللسان واقعة تتمتع بوضع خاص، فهو أرقى هذه الأنساق وأكثرها أهمية، بل يمكن القول إن اللسان هو الأداة الوحيدة التي عبرها نعقل الكون ونحوله من مجرد ” معطيات حسية بلا نظام ” إلى كون يُعقل من خلال كيانات أخرى هي المفاهيم.
ولاستيعاب هذا المعطى العام يكفي أن نستحضر الروابط الممكنة بين الأنساق وموقعها من بعضها البعض لكي ندرك أهمية اللسان ودوره الرئيس في التواصل وتنظيم التجربة وكذا دوره في التصنيف وإنتاج الدلالات وتنويعها. فالأنساق المكونة للغات الإنسانية ترتبط فيما بينها بعلاقات بالغة التنوع، حدد بعضها بنفنيست في ثلاث :
– علاقة قائمة على وجود تناظر بين نسقين أو أكثر. ويقدم بنفنيست في هذا المجال مثال العلاقة التناظرية الموجودة بين الفكر السكولائي والعمارة القوطية، وكذلك التناظر الموجود بين الكتابة الصينية وطقوس المجتمع الصيني.
– أما العلاقة الثانية فهي من طبيعة توليدية. وفي هذا المجال يمكن استحضار حالة الأنساق الفرعية المحلية التي يستعملها التواصل الحربي أو التجسسي (حالة المورس)، أو ” أبجدية براي” الخاصة بالمكفوفين. فهذه الأبجدية مثلا مشتقة أصلا من أبجدية اللسان واستنادا إليها تبني قواعدها وتركيبها.
– أما العلاقة الثالثة، وهي أهم هذه العلاقات، فهي العلاقة التأويلية. فهناك أنساق تؤول اعتمادا على نسق آخر. وهذا معناه أن نسقا ما يصبح أداة لتأويل الأنساق الأخرى، أي يقوم بوصفها وتحديد نمط اشتغالها ومكوناتها. وفي هذا المجال فإن اللسان يعتبر هو مؤول كل الأنساق فمن خلاله نتعرف على مكونات الأنساق الأخرى، فهو أداتنا في فهم دلالات الإيماءات وشرح معاني الصورة واللوحة والرقص…الخ . (1)
وتشير سلسلة العلاقات هذه من جهة إلى وجود لغات أخرى غير اللسان لها منطقها وتركيبها وطرقها في إنتاج الدلالات، وتشير من جهة ثانية إلى اقتصار هذه اللغات على اشتقاق لغة ثانية تشرح نمط اشتغالها. وهذا ما يدعو إلى ضرورة خلق علم يقوم ،من جهة، بتحليل أنساق ليست بالضرورة من طبيعة لسانية، ويقوم ،من جهة ثانية، بتوحيد هذه الأنساق ومقاربتها كأشكال دلالية وإبلاغية يحكمها قاسم مشترك واحد هو انضواؤها ضمن سيرورة التدليل وأنماطه المتعددة.
إلا أن هذه الأنساق تتميز بالتنافر والتعدد والتغير والاختلاف من حالة تلفظ إلى أخرى، وهي لذلك لا يمكن أن تدرك وأن تدرس استنادا إلى خصائصها الذاتية، فهي في حاجة إلى نسق يتميز بالاستقلالية والانسجام. ولن يكون هذا النسق سوى اللسان، فاللسان هو أداة الوصف والتصنيف، بل هو الأداة الخالقة والمؤولة للمجتمع كله.
إن اللسان أرقى هذه الأنساق لأنه يعد مؤولها ووجهها اللفظي. وهو أيضا المصفاة التي عبرها تحضر هذه الأنساق في الذهن. فلا يمكن الإحاطة بجوهر هذه الأنساق ومعرفة طرق اشتغالها دون الاستعانة بنسق من طبيعة أخرى يوجد خارجها.
فاللسان وحده يستطيع أن يكون في نفس الآن أداة للتواصل (فهو أرقى وسيلة للتواصل وتبادل المعارف والخبرات الإنسانية)، ويشتغل كنسق يوضح نفسه بنفسه (اللغات الواصفة المشتقة منه بهدف مقاربة تجارب معرفية متنوعة، واللغات الواصفة المشتقة منه لدراسة قوانينه التركيبية والدلالية والصوتية …). وهو أيضا- وبعد هذا وذاك -الأداة الوحيدة لفهم وتأويل الأنساق الأخرى.
فلا يمكن الحديث عن الموسيقى من خلال خطاب مشتق من النوتات الموسيقية، تماما كما لا يمكن شرح الصورة بالصورة، ولا فهم اللوحة من خلال خطاب آخر غير خطاب الكلمات المؤولة لعناصر اللوحة. إن تحديد عناصر التدليل وميكانيزماته يمر بالضرورة عبر ما يقدمه اللسان من أشكال للتقطيع والتنسيق والتداول.
إن اللسان في المقام الثاني هو المضمون الرئيس للكون ولأنماط وجوده. فلا يمكن معرفة أي شيء دون الاستعانة بعلامات اللسان. ذلك أن العالم بكل موجوداته يحضر في الذهن على شكل مضمون لساني، فأشياؤه وتجاربه توزع وتصنف من خلال المفاهيم وطرق التقطيع التي يوفرها اللسان. فنحن لا يمكن أن ندرك هذا العالم ولا أن نعرف عنه أي شيء إلا عبر الكلمات وكل ما يسمح به نظام اللسان. فاللسان أداة للتعيين وأداة للتصنيف وأداة للتقطيع المفهومي.
إن موقع اللسان هذا هو الذي يجعل منه بوابة رئيسة نحو فهم مناطق جديدة من الإنساني والاجتماعي وتحديد أنماط التدليل والتواصل داخلها. لقد كانت هذه الأنساق في حاجة إلى شكلنة خاصة تمنحها وجودا مستقلا وتمكنها من إنتاج أشكال شتى من الدلالات الخفية والصريحة.
إلا أن هذه الشكلنة ما كان لها أن تتم قبل معرفة القوانين التي تحكم اشتغال اللسان، فهذه القوانين هي ذاتها التي يجب أن تطبق على الأنساق الأخرى تمهيدا لخلق علم يقوم بدراسة مجمل الأنساق الدالة التي تحكم الوجود الإنساني في كليته.
فهذه الأنساق، مثلها مثل اللسان، هي أنساق دالة وخاضعة لمجمل التسنينات الاجتماعية التي تحكم إنتاج الدلالة وتداولها، وهي أيضا قادرة على أن تشكل عناصر للتواصل ونقل المعرفة وتخزينها وصيانتها، وهي في النهاية جزء من تجربة إنسانية تتميز بالشمولية وموزعة على مناطق للتدليل والتواصل. ويمكن القول إجمالا إن هذه الوقائع تتميز بما يلي :
1- إنها شبيهة باللسان، ويمكن بالتالي دراستها انطلاقا من القوانين التي سيتم الحصول عليها بعد دراستنا للسان.
2- إن هذه الوقائع هي وقائع دالة أي حاضنة لقيم إنسانية، فهي ولدت ونمت وتبلورت داخل الممارسة الإنسانية. وعلى هذا الأساس فإن دلالاتها ووظائفها وأشكال تداولها لا تدرك إلا من خلال هذه الممارسة. فقصديتها ووظيفتها وصيغ وجودها محكومة بمنطق الفعل المسؤول عن وجودها.
3- إن هذه الوقائع تدرك من خلال موقعها داخل نسق ما. وبعبارة أخرى، فإن الواقعة الواحدة تفتقر إلى الثبات والاستقرار والاستمرار في الوجود إذا لم تتحدد كعنصر داخل نسق ما. فما يمنحها القدرة على التدليل ليس عناصرها الذاتية بل قدرتها على الانضواء داخل هذا النسق. إنها بذلك شبيهة بوحدات اللسان التي تتحدد وظيفتها الأساس في كونها من طبييعة اختلافية.
وعلى عكس تصور ش . س . بورس الذي جعل من السميائيات مادة أصلية لمقاربة مجمل الأنساق المكونة للتجربة الإنسانية، مستعينا في ذلك بالفينومينولوجيا والمنطق والتأويل (سنعود إلى هذا التمييز في الفصل الثالث)، فإن سوسير حصر اهتمامه الأساس في محاولة تحديد كنه اللسان والكشف عن قوانينه، لأن قوانين اللسان في اعتقاده – وهو أمر سيثبته لاحقا – هي نفسها التي يجب أن تقود إلى معرفة قوانين الأنساق الأخرى.
فتأسيس السميولوجيا كعلم مستقل لا يمكن أن يتم قبل تأسيس اللسانيات كدرس مستقل ومكتف بنفسه. ولعل هذا ما يفسر كون السميولوجيا لا ترد في كتابه الذي نشره تلامذته بعد وفاته ” دروس في اللسانيات العامة ” إلا بشكل عرضي، في صيغة استقبالية غير محددة الملامح والمضمون. فهي علم مستقبلي، سيتم تأسيسه ليكون حاضنا لكل الأنساق الدالة الأخرى. وسيكون من الشمولية والاتساع لدرجة أن اللسانيات لن تشكل داخله سوى جزء بسيط أو فرع من فروعه الكثيره.
ولن يكون اللسان، تبعا لذلك، سوى نسق عادي لا يختلف في شيء عن الأنساق الأخرى، على الرغم من أن قوانين هذا العلم الجديد ومفاهيمه وطرق عمله ستكون مستعارة من اللسانيات في المقام الأول. وتلك هي المفارقة الكبرى التي سيعمل التاريخ لاحقا على دحضها وتفنيدها (لنتذكر موقف بارث الذي قلب المعادلة وجعل من اللسانيات علما أشمل من السميولوجيا ولا تشكل هذه سوى جزء من اللسانيات).
يشير سوسير إلى هذا العلم في معرض تعريفه للسان قائلا : ” إن اللسان نسق من العلامات المعبرة عن أفكار، وهو بذلك شبيه بأبجدية الصم والبكم وبالطقوس الرمزية وبأشكال الآداب والإشارات العسكرية، إلا أنه يعد أرقى هذه الأنساق.
من هنا تأتي إمكانية البحث عن علم يقوم بدراسة هذه العلامات داخل الحياة الاجتماعية . . . ] ويمكن أن نطلق على هذا العلم السيميولوجيا؛ وستكون مهمته هي التعرف على كنه هذه العلامات وعلى القوانين التي تحكمها. وبما أن هذا العلم لم يوجد بعد، فإننا لا نستطيع التنبأ لا بجوهره ولا بالشكل الذي سيتخذه.
إننا نسجل فقط حقه في الوجود، ولن تكون اللسانيات سوى جزء من هذا العلم العام، وستطبق قوانينه التي سيتم الكشف عنها على اللسانيات ” .(2)
إن وصف اللسان بأنه أرقى شكل داخل مجموع العلامات المغطية للجسم الاجتماعي، وكلها تشكل أدوات للتواصل، يجعل من تحديد هوية هذا اللسان وتحديد موضوعه وعناصر تشكله مدخلا أساسا لفهم كنه العلامات غير اللسانية. من هنا كانت نقطة البدء عند سوسير. فلكي يحدد مفهومه للعلامة انطلق من تحديد صارم ودقيق للسان.
فقوانينه لن يتم الكشف عنها قبل تعريفه وتحديد طبيعته وطبيعة الوحدات المكونة له. فاللسان، باعتباره نسقا مستقلا يتميز بالانسجام والوحدة، هو أكثر الأنساق قابلية للوصف، وأكثرها قابلية لأن تشتق منه قوانين وقواعد سهلة التعميم والتداول. إنه ليس جوهرا، فهو نسق شكلي يتكون من علامات من طبيعة خاصة.
وكما يتضح من التعريف الذي يقدمه سوسير للسانيات وللسميولوجيا معا، فإن هذين النشاطين المعرفيين متداخلان ومتشابكان لدرجة أن السميولوجيا لكي تتأسس في حاجة إلى المعرفة اللسانية، وعندما تتأسس هذه السميولوجيا، فإن قوانينها الجدية هي ما سيطبق على اللسانيات.
فماهي طبيعة اللسان، وما هي طبيعة الوحدات المكونة له ؟
لقد رفض سوسير الفكرة البسيطة والساذجة القائلة بأن اللسان مدونة، أي أنه يتكون من مجموعة من الكلمات التي تتناسب وواقع الأشياء في العالم الخارجي. وكان من الطبيعي إذن، أن يرفض أن تكون هذه الكلمات مجرد ظل للأشياء.
إن اللسان لا يعكس الواقع ولا ينسخه، إنه يقدم مفصلة مزدوجة له : إن التقطيع الصوتي، بالإضافة إلى طبيعته الفزيولوجية المادية، يشكل تمثيلا رمزيا تحضر الأشياء داخله على شكل رموز صوتية محددة لتواضع تمثيلي جماعي للكون.
وفي الآن نفسه، فإن المفهوم الذي تحضر عبره الأشياء إلى اللغة ليس مادة بل تصورا نفسيا تم الحصول عليه عبر سيرورة ترميزية بالغة التعقيد. وفي الحالتين معا، فإن ما يأتي إلى اللسان ليحتمي به ليس أشياء قابلة للمعاينة والضبط بل صور شتى تكشف عن عمق تجربة الإنسان مع الأشياء.
ولهذا رفض سوسير أن يجعل من الكلمات رهائن عند الأشياء، كما رفض أن تكون الأشياء جواهر وضعت سرا في الكلمات. ويعلل ذلك بسببين على الأقل :
1 -إن القول بأن اللسان مدونة معناه القول بأن الأفكار سابقة في الوجود على الكلمات. والحال أن لاشيء واضح قبل ظهور اللسان، ولا شيء يمكن أن يدرك خارج ما تسمح به العلامات. إن ذاكرة العالم ليست مضمونا فكريا يوجد خارج أي لسان، إنه مضمون من طبيعة لسانية، وعبر وحدات اللسان تتوضح الأفكار وتصنف التجارب وتدرك الأشياء وتوزع. >
فالعلامة ليست غلافا تسنده الصدفة إلى الفكر، بل هي عضوه الضروري والأساس. فهي لا تستخدم من أجل إبلاغ فكر معطى بشكل جاهز، بل هي الأداة التي من خلالها يتخذ الفكر شكلا ويخرج للوجود، ومن خلالها فقط يكتسب كامل معناه <. (3)
2- إن القول بأن اللسان مدونة معناه القول إن العلاقة بين الكلمات وبين العالم الخارجي علاقة في غاية البساطة. والحال أن الأمر على خلاف ذلك. فتشكل الدال وكذا تشكل المدلول خاضعان لسيرورة بالغة التعقيد والتركيب.
فإذا كانت الدوال هي من صنع التواضع والتعارف، فإن المدلولات تستدعي تحكما تجريديا في التجربة الواقعية وإخضاعها لعملية تقليص تقود إلى “الإمساك بالجوهر القابل للتعميم “على حد تعبير سابير (4)، إنه تحديد للقانون الذي يجب أن يحكم وقائع التدليل استقبالا.
إن اللسان من طبيعة أخرى، لذا فإنه يخضع لقوانين وقواعد وإكراهات يجب معرفتها وتصنيفها وتحديد انعاكاساتها على الأنساق الأخرى. وبهذا فهو لا يمكن أن يكون فقط أداة خاضعة في الوجود وفي الاشتغال لعرضية التجربة الواقعية وتحولاتها الدائمة.
من هنا فإنه، وعلى الرغم من استجابته الدائمة لحاجيات التجربة الواقعية، منفصل عنها وفاعل فيها أيضا. إنه يوجد خارج الفرد وخارج أهوائه، لذا رأى سوسير في اللسان مؤسسة اجتماعية (5) شبيهة بباقي المؤسسات الأخرى التي خلقها المجتمع ليودعها قيمه وأخلاقه وفكره وحضارته.
ومع ذلك فإن هذه المؤسسة من طبيعة مختلفة. فاللسان ليس نتاج قرار فردي أو حتى قرار جماعي كما هو الشأن مع مؤسسات المجتمع الأخرى، إنه وليد سيرورة اجتماعية يصعب تحديد بدايتها كما لا يمكن تصور نهايتها. إنه يوجد خارج الذات المتكلمة وخارج إرادتها في الرفض أوالقبول، وخارج قدرتها على تغييره أو تبديله. إنه نتيجة تعاقد اجتماعي، والتعاقد لا يمكن مناقشته عقليا، لذا فإنه يستدعي خضوع الذات المتكملة خضوعا كليا.
إن هذا التحديد القاضي بإقصاء الذات المتكلمة من فعل اللسان، والقذف بها إلى عالم الكلام، معناه البحث عن موقع العلامة داخل اللسان لا خارجه، وهو أيضا ما يفسر التمييز الذي يقيمه سوسير بين نشاطين مختلفين في الاشتغال ومترابطين في الوجود فلا يمكن لأحدهما أن يوجد دون الآخر ويتعلق الأمر بإحدي الثنائيات الشهيرة : اللسان الكلام.
فاللسان يمكن النظر إليه باعتباره نسقا من العلامات الموجودة خارج إرادة الذات المتكلمة، فهو نتاج لما يسجله الفرد سلبيا. وعلى هذا الأساس فإن اللسان ليس فعلا ولكنه ذلك المخزون من الكلمات والقواعد السابقة في الوجود على الفرد. وهذا ما يجعله موضوعا للدرس، فنحن لانتكلم اللغات الميتة، ولكننا على الرغم من ذلك، نستطيع دراستها وإعادة رسم ميكانيزماتها. (6)
استنادا إلى هذا، يمكن القول إن اللسان هو في الآن نفسه مؤسسة اجتماعية ونسق للقيم. فهو باعتباره مؤسسة لا علاقة له بالفعل الفردي، إنه تعاقد اجتماعي لا حول للفرد أمامه ولا قوة. وهو باعتباره نسقا من القيم يتكون من عناصر تشتغل في الآن نفسه باعتبارها ما يحل محل شيء ما، وباعتبار علاقة بعضها ببعض.
وهذا ما دفع سوسير إلى تشبيه العلامة اللسانية بالقطعة النقدية التي تسمح لنا، من جهة، باقتناء بضائع ما، وتسمح لنا بتحديد قيمتها داخل النظام النقدي الذي تنتمي إليه (7). وبناء عليه، فإن جوهر اللسان يوجد خارج طابعه الصوتي، لذا فهو شكل وليس مادة.
أما الكلام فهو على النقيض من ذلك فردي، إنه يعود إلى الفرد وإلى قدرته على تحويل النسق إلى إجراء، وتحويل الثابت إلى متغير، وتحويل العلامة المفردة إلى خطاب. إن فعل الكلام يتم من خلال دخول ذات الخطاب باعتبارها ما يُسَرِّب الإجراء وما يحدث الفعل وما ينظم ويرتب ويخلق السياقات والمقامات.
إنه تحول مطلق من الجماعي والعام والمجرد إلى الفردي والخاص والمحسوس. ولأنه أداء فردي، فهو يشير إلى قدرة الفرد على تحويل اللسان من نسق مجرد إلى كيان مرئي من خلال أفعال تحيينية.
ويرى سوسير أن هذه الفردية يمكن الإمساك بها من خلال :
أ – التأليف الذي من خلاله تستطيع الذات المتكلمة استعمال سنن اللسان للتعبير عن أفكارها.
ب – الميكانيزمات النفسية والفيزيولوجية التي تسمح بإخراج هذه التأليفات. (8)
ومع ذلك فإن الفردية لا تعني أن الذات المتكلمة حرة في استعمالها لعناصر اللسان وفق أهوائها الخاصة. إنها على العكس من ذلك محاصرة بقوتين : ما يقدمه اللسان من قواعد وضوابط وإرغامات تحد من حركة التأليف وحريته، وهي ثانيا محاصرة بالإكراهات ذات الطابع الاجتماعي والديني والأخلاقي والتي على الرغم من وجودها خارج اللسان، فإنها تمارس ضغوطا على الذات المتكلمة وتفرض عليها انتقاء وتركيبا للوحدات وفق مقتضيات المقامات والسياقات المتنوعة.
وكما سنرى لاحقا، فإن هذا التمييز بين مستويين (اللسان والكلام)، ليس مجرد تقسيم يطال الوظيفة الإبلاغية الموزعة على نسق وإجراء. إن الأمر يتعلق بمبدأ حقيقي للتصنيف يتمتع بمردودية تحليلية بالغة الأهمية.
فقياس الظاهرة من زاوية بعدها النسقي أو من زاوية بعدها الإجرائي هو ما يسمح لنا بتحديد موقع الـ”أنا” المنتجة للفعل، باعتبار هذه الـ”أنا” هي البؤرة التي يتجلى فيها وعبرها التدليل والإبلاغ معا. ومن جهة ثانية، فإن هذه الثنائية سيكون لها في ميادين أخرى كالأدب والأنتروبولوجيا والتاريخ أهمية كبيرة في التعرف على الظواهر وتصنيفها وتحديد الثابت فيها من المتحول. (انظر ما يقدمه بارث عن النظام اللباسي والنظام الغذائي) (9).
إن التمييز بين اللسان والكلام هو المدخل الرئيس نحو تحديد ثنائية أخرى محددة للموضوع اللساني. ويتعلق الأمر بالفصل بين محورين يشيران إلى نشاطين ذهنيين مختلفين : المحور الأول يطلق عليه سوسير محور العلاقات الترابطية، وهو ما اصطلح عليه فيما بعد بمحور الاستبدال (أو محور الاختيار)، والمحور الثاني يطلق عليه محور العلاقات المركبية (أو محورالتوزيع). >
فالعلاقات التي تجمع بين الحدود اللسانية (العلامات) تتطور في اتجاهين، وكل اتجاه يثير حوله مجموعة من القيم، ويقوم التقابل بينهما بالكشف عن مضمون كل محور على حدة (…) فالكلمات تقوم داخل الخطاب بنسج سلسلة من العلاقات المنبثقة عن الطابع الخطي للسان الذي يستبعد إمكانية النطق بعنصرين في آن واحد <.(10)
إن هذا الترابط بين الوحدات هو ما يطلق عليه سوسير بالعلاقات المركبية، والمركب هو تأليف لمجموعة من العلامات داخل سلسلة كلامية. إنه يشير إلى علاقات تتم في الحضور، وتشير إلى نظام التتابع الخطي للوحدات اللسانية، مثال ذلك الجملة التالية : “ذهبت إلى المدرسة”، فالعلاقة الموجودة بين مجمل العناصر المكونة للجملة هي علاقات تجاورية تجعل من التدليل يتبع سيرا خطيا يقود من أول كلمة إلى آخر كلمة داخل السلسلة المنطوقة أو المكتوبة.
فكل كلمة داخل هذه السلسلة تستمد قيمتها من الكلمة السابقة عليها ومن الكلمة اللاحقة لها. وتشكل هذه الوحدات سلسلة كلامية تشير إلى علاقات “واقعية”، وهذا ما يسمح بتقطيعها إلى كيانات منفصلة، الأمر الذي يجعل من هذا النوع من العلاقات أقرب إلى الكلام منه إلى اللسان، فالكلام هو بؤرة البرهنة عليه، وهو أيضا بؤرة تحيينه.
ومن جهة ثانية ، ” فإن الكلمات خارج الخطاب ترتبط فيما بينها، على مستوى الذاكرة، بقواسم مشتركة يتم عبرها تكوين مجموعات تحكمها علاقات متنوعة “. (11) وهكذا فإن كلمة مثل : تعليم تشير من الناحية الدلالية إلى : علم -تعلم -معلم -تعاليم معلومات… ويمكن كذلك أن تشير من زاوية التشابه الصوتي إلى: تسليم وتجريم وتقزيم.
وعلى عكس وحدات المحور السابق، فإن الوحدات المنتمية إلى المحور الثاني مرتبطة فيما بينها بعلاقات تتم في “الغياب”. فكل وحدة تشكل نقطة مركزية تلتف حولها مجموعة من الوحدات القابلة للتحقق مع أدني تنشيط للذاكرة أو الرغبة في تغيير السجل الدلالي. إن المبدأ الذي يحكمها هو التصنيف.
إن المحورين معا مرتبطان بالنظام الذي يتم عبره الإمساك بالإجراء التدليلي. فالإمساك بالمعنى وتحديد حجمه وعمقه يحتاج إلى ضبط خطي لوحداته وعناصر تجليه، كما يحتاج من جهة ثانية إلى مبدأ للتصنيف يربط الأول بالأخير ويقابل بين العنصر المتحقق بالضمني والموحى به.
وكما سنرى لاحقا، فإن ضبط ميكانيزمات هذين المحورين يعد مدخلا نحو نقل معطيات التدليل اللساني إلى حقول من طبيعة أخرى. فعالم الدلالة غير اللساني محكوم هو الآخر بهذين النشاطين الذهنيين، وفي جميع الحالات فإن الدلالة لا تكترث للمادة الحاملة لها.
وبالإمكان نقل التحليل إلى مستوي بالغ الدقة لتحديد فحوى الإجراء والنسق، وفحوى المؤسسة والقيمة. فاللسان كيان كلي يحتوي القواعد كما يحتوي المتن الذي تجري عليه هذه القواعد. إن هذا المتن ليس شيئا آخر سوى وحدات اللسان التي يطلق عليها سوسير العلامات اللسانية : الأداة الرئيسة في تحديد جوهر اللسان وموقعه من الفعل الفردي والفعل الاجتماعي على حد سواء.
بل يمكن القول إن آلية تجديد الفكر اللغوي عند سوسير بدأت مع التعريف الذي يخص به العلامة ووظيفتها وموقعها ومكوناتها، تماما كما فعل من قبل مع اللسان الذي اعتبره مهدا لهذه العلامات.
فهذا التعريف هو الذي سيقوده إلى تحديد أهم خاصية يمكن البحث عنها في التراث السوسيري : وظيفة العلامة هي وظيفة اختلافية. وبعبارة أخرى، فإن العلامة لا تملك معنى، إنها تملك استعمالا، والاستعمال هو صيغة أخرى للقول إن المعنى موجود في الاستعمال لا في الوحدات اللسانية المعزولة.
والاستعمال هنا، وفي جميع الحالات أيضا، يحيل على نسق، والنسق كيان غير مرئي، ولكنه يعد البؤرة التي يتم عبرها التدليل والتواصل.
إن أهم ما يميز العلامة هو طابعها المزدوج : فهي صوت ومعنى، حامل ومحمول، قيمة في ذاتها وقيمة في علاقتها بما تحل محله. إنها > وحدة نفسية بوجهين وثيقي الارتباط بعضهما ببعض، ويستدعي أحدهما الآخر.
إن الرابط بين العنصرين هو ما يشكل العلامة <. (12) فإذا كان اللسان لا يشكل مدونة، وليس ركاما من الكلمات الجامدة في الأسماء وإجراءات التعيين، فإن العلامة لا تربط بين إسم وشيء بل تربط بين صورة سمعية وتصور ذهني. ومن هنا يكون الحدان اللذان تستدعيهما العلامة من طبيعة نفسية يطلق عليهما سوسير على التوالي : الدال للأداة الحاملة والمدلول للمضمون. إن الموقع الاصلي للعلامة هو اللسان، ووظيفتها الاساسية وظيفة اختلافية.
إن الدال عند سوسير صورة سمعية مشتقة من كيان صوتي، أو هي تمثيل طباعي (في حال وجود كتابة). إنه متوالية من الأصوات أراد لها الاستعمال الجماعي الناتج عن تعاقد لا تُعرف له بداية، أن تكون كيانا يحل محل شيء آخر. ويتميز هذا الكيان ب :
أ- إنه نفسي وليس ماديا، فنحن لا نحتاج إلى استحضار الجزء المادي في تعريفه. إن آلة الصوت لا تحدد مضمون الصوت. من هنا فإنه البصمة النفسية التي تلتقطها أذن المتلقي، أو يقوم بتشكيلها فم الباث. إنه نفسي > فنحن نستطيع أن نتحدث إلى أنفسنا أو نستظهر مسرحية أو قصيدة شعرية دون تحريك الشفاه “(13).
ب- إنه مفروض وليس حرا. فالذات المتكلمة لا تستشار في أمره، ومن ثم لا تستطيع لا تبديله ولا تغييره. فهو نتيجة عرف، وسلطة العرف أقوى وأعمق من سلطة القانون، فالدال الذي يختاره اللسان لايمكن استبداله بآخر لأنه ينفلت من إرادتنا ومن قدرتنا على إحلال عنصر آخر محله.
أما المدلول فهو التصور الذهني الذي نملكه عن شيء ما في العالم الخارجي. إنه ليس الشيء ولا يمكن أن يكونه، إنه الصورة المجردة التي يمنحها اللسان إلى الشيء عبر التعيين والتسمية. فالشيء لا يحضر في الذهن من خلال ماديته، إنه يأتي إليه من خلال بنية شكلية تعد تكثيفا لمجموعة من الخصائص التي تمكننا من استحضار هذا الشيء وفق سياقات متعددة.
ورغم أن سوسير لم يكن واضحا بما فيه الكفاية في تعريفه للمدلول، فإنه مع ذلك كان قطعيا في تحديد جوهره، فالمدلول ليس شيئا ولا يعين مرجعا، إنه يكتفي بالإحالة على قسم من الأشياء وفق سيرورة تقليصية تقود إلى تجريد الظاهره وتحويلها من الملموس إلى المجرد. وعلى هذا الأساس اعتبره سوسير، شأنه في ذلك شأن الدال، كيانا نفسيا.
ويؤكد سوسير أن العلاقة الرابطة بين الدال والمدلول، استنادا إلى ما ذكرناه عن تعريف اللسان وعن سيرورة تشكل العلامة، هي من طبيعة اعتباطية. والاعتباطية في مفهومها الأدنى هي غياب منطق عقلي يبرر الإحالة من دال إلى مدلول.
فلا وجود لعناصر داخل الدال تجعلك تنتقل آليا إلى المدلول. فالرابط بين هذين الكيانين يخضع للتواضع والعرف والتعاقد. فاختيار الأصوات لا تفرضه مقتضيات المعنى، فـ> فكرة /أخت/ لا تربطها أية علاقة داخلية مع المتوالية الصوتية / أ خ ت / التي تعتبر دالا لها، فبالإمكان التمثيل لها بأية متوالية صوتية أخرى <(14). فلا شيء يمنع -سوى قوة العرف- من إسناد هذه المتوالية الصوتية إلى هذا التصور الذهني.
وتشير الاعتباطية في مفهومها الأقصي إلى الطابع الثقافي الذي يحكم الظواهر المكونة للتجربة الإنسانية في كليتها. فإذا كانت الثقافة هي نقيض الطبيعة، فإن الاعتباطية هي طريقة أخرى للقول إن التسمية والتعيين والتصنيف هي إضافات الثقافة إلى ما منحته الطبيعة للكون الإنساني.
من هنا، إذا كانت الطبيعة هي مرادف للمعطى البيولوجي والفزيولوجي الموجود خارج تجربة الإنسان مع الفعل ورد الفعل، فإن الثقافة هي ما يحدد الإضافات التي جاء بها التمدن وما خلقته الرغبة في التخلص من المحايث والاستعانة بالمكتسب.
فهل معنى هذا أن الذات المتكلمة حرة في انتقاء الدوال ورفض بعضها واستبدالها بدوال أخرى ؟ ليس الأمر كذلك في تصور سوسير. فعوض أن تكون الاعتباطية مبدأ يشير إلى الفوضى والتسيب، فإنهـا في نظره تقوم بحماية اللسان من الوقوع في الرمزية الصوتية من جهة، كما تحميه من التغير من جهة ثانية.
ولعل وجود ألسنة متعددة هو ما يفسر كون الاعتباطية هي ما يحكم اللسان ويحدد وجوده. فإذا كان في مقدورنا أن نمثل لأية فكرة بأية متوالية صوتية، فذلك يرجع إلى إمكانية انتقالنا من نسق لساني إلى آخر دون أن نلحق تغييرا بهذه الفكرة.
إن مبدأ الاعتباطية ليس خاصا بالعلامات اللسانية فحسب، بل هو مبدأ واسع يمكن أن يشمل مجموع الظواهرالاجتماعية. فهذه الظواهر هي أيضا، وكما سبق أن ذكرنا من قبل، وليدة تعاقد انبثق عن الممارسة الإنسانية. إن الأمر يتعلق بظواهر ثقافية لا بمعطيات طبيعية. من هنا، فإن ما يصدق على اللسان يصدق على هذه الظواهر أيضا، ويمكن أن يشكل قاعدة لتعريفها وتصنيفها.
” فكل وسائل التعبير المتداولة داخل مجتمع ما تستند مبدئيا إلى عادة جماعية، أو إلى عرف. فأشكال الآداب مثلا التي تملك نوعا من التعبيرية الطبيعية (مثال الصيني الذي يحيي امبراطوره بالانحناء تسع مرات) هي في واقع الأمر محكومة بقاعدة.
وهذه القاعدة هي التي تفرض استعمالها لا قيمتها الجوهرية “(15). وبناء عليه، فإن الظواهر غير اللسانية، مثلها مثل الظواهر اللسانية، هي من طبيعة اعتباطية، ويجب، بالتالي، التعامل معها بنفس القواعد التي تحكم اللسان.
ورغم الانتقادات التي وجهت إلى التصور السوسيري لمفهوم الاعتباطية، فإن قيمته المعرفية ومردوديته التحليلية لا يمكن إنكارهما. فسواء تحدثنا عن مبدأ الضرورة أو تحدثنا عن الاعتباطية النسبية أو التعليل النسبي، فإن التكون اللاحق غيرالمعطى بشكل سابق على التجربة الإنسانية سيظل هو الركيزة الذي استندت إليها كل الألسنة في تشكلها وفي نموها واشتغالها.
تلك بعض المبادئ الأساس التي اعتمدها سوسير في بناء صرحه النظري. وهي نفسها التي ستقوده إلى الدعوة إلى صياغة حدود علم آخر ستكون مهمته هذه المرة هي دراسة الوقائع غيراللسانية.
فالتجربة الإنسانية تعبرعن نفسها من خلال مجموعة من الوقائع التي تعد لغات تستخدم للتواصل وإنتاج الدلالات، ومن ثم فهي خاضعة لنفس القواعد والقوانين، ومحكومة هي الأخرى بنفس المبدأ، فهي اعتباطية في جوهرها ودلالاتها آتية من العرف الاجتماعي لا من المادة المشكلة لها.
فما يميز هذه الوقائع هي أنها علامات، أي وقائع دالة، فهي تنتج معانيها وتدرك باعتبارها منتجة لهذه المعاني استنادا إلى وضعها السميائي. وكان من الضروري، لكي تصبح كذلك، أن تتخلى عن وظيفتها الأصلية الأولى لكي تتحول إلى حامل مادي لدلالات هي من صلب الثقافة، أي وليدة الممارسة الإنسانية.
ومن هذه الزاوية فإن كل الوقائع التعبيرية – بما فيها تلك التي تستند إلى موضوعات مادية تقع خارج الذات وخارج قدرتها على التصرف في مادة تكوينها- تستند إلى قاعدة عرفية تحولها من وضعها الأصلي، كشيء لا حول له ولا قوة، إلى علامات تنتج دلالات ضمن أنساق ثقافية بعينها، وتمارس تأثيرها على السلوك الإنساني وتوجهه.
وعادة ما تنسى هذه العلامات مع كثرة الاستعمال وضعها الأصلي لكي تصبح علامة” طبيعية” منتجة لمعانيها بشكل طبيعي. ” فالعلامات تبدو في المعتاد طبيعية لدى أولئك الذين يستخدمونها، والناس ميالون إلى تأكيد أن سلوكهم الخاص إنما تحكمه اعتبارات عملية أكثر منها رمزية، كما أنهم يؤكدون أنهم يختارون الملابس ” المريحة” أو ” الحياة الجيدة في نوعها “و”يشترون الطعام الذي يحبون مذاقه”، ويستخدمون الإيماءات التي يرونها معبرة بصورة طبيعية.
وبقدر ما تكون الحضارة قوية يكون نجاحها في التعامل بعلاماتها بوصفها علامات طبيعية. ومن ثم يتطلب التحليل السميوطيقي نموذجا يؤكد الأساس الحضاري العرفي للعلامات من أجل مقاومة الجهود الإيديولوجية التي تجعل منها علامات طبيعية، وإذا ما بدأ المرء بافتراض أن العلامات اعتباطية، فإنه سيتجه إلى التماس نظم العرف الأساسية “. (16)
ولقد كان بارث سباقا إلى تأكيد هذه الحقيقة، فإيديولوجية عصرنا كما أشار إلى ذلك في أماكن كثيرة تكمن في تحويل ما ينتمي إلى الثقافة إلى عنصر طبيعي يخون أصله ويتزيى بمظهرالبراءة الطبيعية. (17)
ولئن كان سوسير لم يتناول هذا العلم إلا بشكل عرضي وبصيغة مستقبلية، فقد نُظر إليه مع ذلك باعتباره الأب المؤسس لهذا العلم. فالمعرفة السميولوجية مستمدة في جانب كبير منها من المعرفة اللسانية. ذلك أن مجمل العناصر الخاصة بوصف النموذج اللساني وخصائصه وقواعده في الاشتغال وفي نمط الوجود، هي نفسها التي ستقودنا حتما إلى تصور نموذج سميائي قائم على ما يوفره النموذج الأول من معرفة تخص الأدوات والمنطلق المعرفي والغاية التحليلية.
فبما أن النموذج اللساني هو أرقي ما أنتجته التجربة التواصلية عند الإنسان ضمن أدواتها التعبيرية المتنوعة، فإنه سيكون هو الأداة التي عبرها سيتم الكشف عن مجموع القوانين التي تحكم الانساق الأخرى.
إن الأمر يتعلق بالاستحواذ على المفاهيم اللسانية ومنحها القدرة على الاشتغال خارج تربتها الأصلية التي هي اللسانيات. وتشكل هذه العملية الشرط الضروري للحديث عن سميولوجيا جديرة بصفة العلمية. فمفاهيم مثل : “اللسان” و”الكلام“و”الدال” و”المدلول” و”القيمة” و”محوري التوزيع والاستبدال” يمكن أن تكون، بعد تنقيحها وإخضاعها لسلسلة من التعديلات والإضافات وأشكال التكييف، هي الأداة والسبيل نحو معرفة الحقول غير اللسانية معرفة أفضل.
وإذا كانت مجهودات سوسير السميولوجية قد وقفت عند هذا الحد، فإن الهزة العنيفة التي أحدثها نموذجه المعرفي في تناول الوقائع اللسانية، سيمتد صداها إلى علوم مجاورة وجدت في هذا النموذج ضالتها المنشودة (لنتذكر التحليل الذي يقدمه شتراوس في البنية البسيطة للقراب استنادا إلي نموذج سوسيرة) ولاكان (الحلم المبنين كلغة).
وهذا ما سنحاول تأكيده من خلال حديثنا عن الأنساق غير اللسانية كالصورة واللغة الإيمائية في الفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس. فعلى الرغم من أن السميولوجيا عرفت اتساعا كبيرا وشملت سلطتها كل الوقائع الإنسانية واستقلت بموضوعها ومعرفتها وأسسها الإبستمولوجية (ما يتعلق بقضايا العلامة الفلسفية)، فإن المعرفة اللسانية مازالت تلعب دورا رئيسا في وصف الوقائع غيراللسانية وتصنيفها.
وهذا لا يحد من دائرة النموذج السميولوجي ولا يقلل من قيمته، فاستعارة الأنتروبولوجيا للنموذج اللساني مثلا لم يفقدها هويتها الخاصة، ولم يسلبها موضوعها الخاص.
- الهوامش
1- Emile Benveniste : Problèmesde linguistique générale ,2, éd Gallimard, , 1974 , pp 60-61
2- F De Saussure : Cours de linguistique générale , éd Payothèque, , 1979, p 33
3- Ernst Cassirer : La philosiphie des formes symboliques, 1- Le langage, éd Minuit, 1972, p. 27
4- E Sapir : Le langage , éd Payot , 1970, p.16
5 -سوسير م س 25
6- سوسير م س 31
7- سوسير م س 166
8- سوسير م س 31
9- انظر R Barthes : Eléments de sémiologie , Communications n 4 , 1964, pp 99 – 100
10- سوسير نفسه، ص 170
11- سوسير نفسه، ص 171
12- سوسير نفسه، ص 99
13- سوسير نفسه، ص 98
14- سوسير نفسه، ص 100
15- سوسير نفسه، ص 101
16 – جوناتان كالر : فرديناند دي سوسير (أصول اللسانيات الحديثة)، ترجمة عز الدين اسماعيل، المكتبة الأكاديمية ، 2000، ص 160
17- انظر على سبيل المثال
: semantique de l’objet, in l’avebture sémiologique, éd Seuil,1985,p 260.














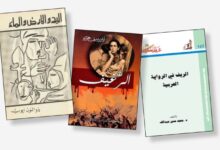
اريد تلخيص لهذا الفصل