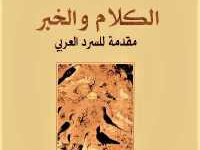السّـرد الدّينـي والتّجربـة الوُجوديّـة

تثير قراءة النصوص الدينية عامة، والقصصية منها على وجه الخصوص، قضايا تأويلية بالغة التنوع، بعضها مرتبط بطبيعة هذه النصوص ذاتها، فهي في عرف المؤمنين بها جزء من تصور عقدي شامل؛ لا يمكن القيام وفقه بأي شيء دون العودة إليها في حالات التحليل والتحريم. وبعضها وثيق الصلة بما يمكن أن يترتب عن إكراهات الانتماء المذهبي، وبعضها الآخر مستمد من إمكانات “استعمالها” في مجالات السياسة والاجتماع.
لذلك عُدت، في هذه الحالات جميعِها، خارج تحديدات المقاصد والمبدأ العقدي، خزانا من دلالات لا يمكن حصر عددِها إلا بالعودة إلى سياقات جديدة تبنيها الطاقات الاستعارية داخلها. فبعيدا عن الحكم الفقهي، أو في ما هو أعمق من الغاية الوعظية للحكاية، تتسلل “رغبات” و”حيرة” و”خوف” وأشكال كثيرة من “قلق” وجودي رافق الحياة الإنسانية على الأرض. لذلك وجب تَدَبُّرها في انفصال كلي عن معناها الحرفي، وفي انفصال عن السياقات التي تشترطها الأحكام المقاصدية، أو تشير إليها الوقائع المروية في الوقت ذاته. فالنص لا يحاكي سلوكا واقعيا، كما قد توهم بذلك تجلياته المباشرة، بل يسقط عالما ممكنا.
وذاك هو الدور المركزي الموكلُ إلى العلامات. فهي أداة إدراك الكون وأداة التوسط وهي الأداة التي يتشكل ضمنها الوعي وتتحدد طريقته في صياغة مضامينه. فبما أن الشكل الوحيد لوجود الأشياء هو وجودها في اللغة، فإن القول فيها أو عنها لا يكتفي بوصفها، بل يتضمن قصد الواصف أيضا، فما هو موصوف في العالم الخارجي لا يمكن أن يكون استنساخا لما يتم تمثيله من خلال اللغة، بل هو نسخة معدلة منه. وهي صيغة أخرى للقول، إن المعرفة ليست امتلاكا فعليا لواقع لا حد لامتداداته، بل هي في المقام الأول بناء رمزي من إنتاج الذهن.
وتلك طبيعة كل تعبير استعاري، فالقول المجازي في عموميته “مرتبط بتجربتنا الداخلية للعالم، ومرتبط أيضا بسيرورات انفعالاتنا” (1)، فما لا تستطيع اللغة تسميته بشكل مباشر، وما لا يستقيم ضمن إكراهات “الأنا”، ببعديها الفردي والأعلى، تلتقطه أشكال وصيغ استعارية عادة ما يكون مُضْمرُها المجرد هو بؤرة المعاني وغايتها النهائية. فنحن نخرق القوانين التي تتحكم في التداول اليومي للأشياء والكائنات والكلمات من أجل بناء معان لم تستطع التجربة المشتركة استيعاب حدودها القصوى. يصدق هذا على كل النصوص، قديمِها وحديثِها، ذلك أن “عالم النص يُبنى على أنقاض عوالم الواقع “(2). وقد يكون هذا الأمر هو مبرر وجود النص وأصل المتعة الجمالية فيه.
يحيل هذا الانزياح على موقع الدلالة، في بعديها التقريري والإيحائي، داخل التجربة الإنسانية كما يحدد وظيفتها المركزية في التبادل الاجتماعي؛ فهي ليست أداة للتعرف على عالم غُفل خال من الأحكام، بل هي في المقام الأول “صيغة يتم من خلالها حل التناقض القائم بين الإنسان الطبيعي والإنسان الثقافي” (3)، ما يعود إلى الغرائز باعتبارها برمجة بيولوجية أولية، وما يعود إلى الثقافة باعتبارها أداة التأنسن الأولى. إن الطبيعي فينا صامت، أو هو ناطق في الغرائز وحدها، أما الثقافي فإحالة على وجود آخر يُبنى ضمن دلالات مستحدثة تُمنح للكائنات والأشياء ووفقها تتحدد مظاهر الوجود.
ومع ذلك، فإن الاحتفاء بالبعد الرمزي “لا يعني أن الاستعارة تكتفي، لحظة تأويلها، بإنتاج جواب انفعالي” (4)، لا يقوم سوى بشرح انفعال سابق. إن الأمر على العكس من ذلك، فالتعبير الرمزي يقتضي استعادة جديدة للبعد التجريدي القادر وحده على تخليص التجربة من بعدها المشخص وإسكانها مفاهيم قابلة للتداول خارج سياقات اللغة، وفي انفصال كلي عن خصوصيات التلوين الثقافي. وتلك هي الغاية من كل تعبير استعاري، إنه رابط غير مرئي بين الغامض في هوى النفس، وبين تجربة العقل، كما يمكن أن تعبر عن نفسها في التجريد المفهومي. وهذه الحقيقة هي التي تحتم علينا التفكير في النص من خلال إحالاته الرمزية، لا من خلال الحدث الموصوف فيه.
ذلك أن تخلص المفاهيم من صيغتها التجريدية وانصهارها من جديد في عالم الانفعال الإنساني خارج كل استقطاب، حيث تمتزج التجربة السلوكية الغُفل بعالم الأشياء، سيمنح اللغة قدرة هائلة على استنفار القول الاستعاري داخلها. حينها يرتد القول إلى صيغ المجاز ويصبح كل تمثيل سردي، أو شعري، انزياحا عن الوجه النفعي للأحداث لاستقبال الرمزي داخلها. يتعلق الأمر ببعد مركزي في الوجود الإنساني؛ فما لا يستقيم من خلال المفاهيم تستوعبه حالات تعبير “تناظري” يربط بين تجربة “الوجدان” وميله الدائم إلى التمرد على كل أشكال الضبط الاجتماعي والأخلاقي، وبين كائنات الطبيعة وأشيائها (الأسد للشجاعة والسماء للسمو والتعالي، والماء للتطهر الخارجي والنار للتطهر الداخلي…).
استنادا إلى ذلك، وجب تصنيف كل استعمال إضافي للكلمات والأشياء والكائنات ضمن سجلات دلالية هي في الأصل سياقات ضمنية ليست معطاة بشكل بديهي. وهي الخاصية التي جعلت بعض الباحثين ينظر إلى الرمز باعتباره أساس المعاني المزدوَجة (ريكور)، وهي الأساس الذي قامت عليه الهرموسية الرومانسية التي لم تَرَ في المعاني الحرفية سوى حُجُبٍ وجب رفعها ليستطيع المؤول تحديد “المعنى الحقيقي” للنص. فنحن لا نمسك في سياقات النصوص بما تقوله وظيفية الشيء في الواقع النفعي، بل نبحث عن معناه في الثقافة، وبدون هذا المعنى سيظل حبيسَ مادته، تماما كما تظل الموجودات، بدون كلمات، غريبةً في العين والوجدان. لذلك، يقتضي فهم الاستعارة بالضرورة تدمير “المعرفة المزيفة” داخلها (5)، عبر “تصحيح” العلاقات القائمة بين حديها. وذاك شرط أساسي من أجل استعادة مضمون التجربة الموصوفة في النص.
ومركزية هذا الشرط هو ما تكشف عنه طبيعة الرمز ذاته، فهو، في الشائع من التعريفات، مجموعة من الصور التناظرية التي تربط بين وحدات من طبيعتين مختلفتين، تحل إحداهما محل الأخرى ضمن سياقات تُصَدِّق على دلالاته وتبرر استعمالاته المختلفة. فبدون هذه السياقات لا يمكن الحديث عن حالات ترميزية تمنح التعبير قيمة هي شيء آخر غير ما يحيل عليه موقع الأشياء في الواقع. وهو بذلك من طبيعة عرفية، فلا شيء في داله يستدعي أو يشترط استحضار مدلوله بشكل طبيعي ( اللون الأخضر مرتبط بأضرحة أولياء الله الصالحين في التقليد الإسلامي، ولكنه يعد جزءا من “ربيع حياتي” في ثقافات أخرى، وقد يكون لونَ البلادة والكسل والاسترخاء الأبله، كما يرى ذلك كاندينسكي).
وبهذا المعنى، يُعد الرمز شكلا تصويريا يمكن أن يتجسد في أشياء تُستعمل للإحالة على مدلول يقابلها عن طريق العرف والتواضع، أو يتجسد في محكيات أسطورية أو خرافية ليست سوى وجه مفصل لمفهوم هو الغاية من كل تمثيل سردي. فالأبيض لون كباقي الألوان قبل أن يصبح رمزا للسلام أو الاستسلام، ولم يكن الصليب، قبل أن يصبح دالا على الدين المسيحي، سوى شكل لا يختلف عن باقي الأشكال التي تعج بها الطبيعة.
وبالمثل، لا تشكل محكيات الخلق، بكل أنواعها، سوى محاولة مشخصة لاستعادة “زمنية مقدسة” هي لحظة “البداية” المفترضة في تاريخ الوجود الإنساني على الأرض. وهي إشارة إلى أن البداية ليست في الزمن، بل هي كذلك في المعتقد، لذلك تتعدد أشكالها وتتنوع دون أن تتغير مضامينها، فنحن، في الحالتين معا، لا نستطيع الفصل، داخل هذه الزمنية المفترضة، بين قلق مرتبط بضياع البدايات وبين خوف مبعثه غموض النهايات.
ووفق هذه السيرورة، يمكن لكل شيء أن يصبح رمزا لحالة إنسانية وفق شروط ثقافية بعينها، يكفي في ذلك تحديدُ الروابط الدلالية التي تمكننا من الانتقال من الأداة الرامزة إلى ما يمكن أن تحيل عليه من معان هي جزء من انفعالات عادة ما تتسرب إلى الداخل النفسي المظلم ولا تكشف عن نفسها إلا من خلال الغامض والملتبس والضمني. فكل المفاهيم التي نتداولها لوصف حالاتنا النفسية، عند الفرد والجماعة، يمكن العثور عليها مجسدة في أشيائنا أو في كائنات تقتسم معنا محيطنا المباشر، أو تنتمي إلى ذاك الذي نستبطنه وننظر إليه باعتباره سلسلة من الصور الاستيهامية التي بها نحيا وبها نحلم ومن خلالها نتحايل على زمنية لا تتوقف أبدا.
بل قد تتخذ شكل طقس سلوكي لا شُبهة حوله، كما هي حال الكثير من أنشطتنا المعاصرة من قبيل استكشاف المغارات والكهوف وتسلق الجبال والاستحمام في البحار والاغتسال في الأنهار والبحيرات. فهذه الطقوس، وغيرها كثير، تُخفي في العمق رغبةً في التسامي والتفوق والتطهر والتخلص من محدوديتنا في الزمان وفي الفضاء.
ويمكن من هذه الزاوية أيضا، أن ندفع بالرمزية إلى حدودها القصوى، ونصنف كل المحكيات والأساطير ضمن الأشكال الرمزية التي اعتبرها إرنست كاسيرير أساس التوسط بين الإنسان وعالمه الخارجي. فما يصلنا بالعالم ليس حواس خالصة، كما تتوهم ذلك العين الساذجة، بل أحكام مسبقة هي التي تَهدي العين والذهن وتقود خطاهما؛ إنها الأساس الذي يتحكم في إدراكنا للعالم، ولكنه هو ما يفصلنا عن موضوع إدراكنا في الوقت ذاته. إن الإنسان في تصور كاسيرير “كائن رمزي” ورامز، فكلما اتسعت دائرة الرمزي في حياته، تراجع البعد الواقعي فيها.
وهذا ما يؤكد أن التشخيص، في مظاهره التصويرية وفي التمثيل القصصي خاصة، كان دائما بوابة مفضلة لتسريب عناصر لم يكن هناك، في مرحلة من مراحل المعرفة الإنسانية، ما يكفي من المفاهيم لتكثيف حدودها في وحدات مجردة، أو لم تستطع تلك المتوفرة منها الإحاطةَ بكامل مضامينها، أو كان ذلك رغبة في إدراج تجربة الفرد المحدودة ضمن تجربة الإنسانية كلها. فما ترويه الأساطير عن بدايات الكون، وما تُفَصِّل الحكايات القول فيه عن أصل النار والماء، وعن أصل الظلم والعدل والخير والشر لا يشير إلى وقائع فعلية، بل هو صياغة حدثية لمضامين مجردة.
أو قد يتعلق الأمر باستعادة لحدث عظيم له حقيقته في التاريخ، ولكنه تحول في ذاكرة الناس ومخيالهم، بحكم عظمته وطابعه الاستثنائي، إلى شكل أسطوري تبنته الكثير من الحضارات لتفسير ما استعصى عليها في الفهم والتدبر والتفسير، كما هو الشأن مع حكاية الطوفان الذي أغرق كائنات الأرض في لجة لم ينج منها سوى ” أهلِ السفينة”، وهم قلة من المؤمنين اعتقدوا في الحق صوتا وحيدا للوجود. لذلك لا يمكن أن يكون الطوفان في الغالب سوى استعارة شاملة تشير إلى رغبة البشرية في التجدد والانبعاث من خلال التخلص من زمنية “شريرة” وإسقاط أخرى تبشر بخير عميم.
استنادا إلى هذه المبادئ وجب التعامل مع النصوص الدينية، القصصية منها على وجه الخصوص، باعتبارها “طبقات” دلالية متراكبة، أو باعتبارها، سلسلة من المقاصد الضمنية التي تختفي في الوجه المشخص للحدث المروي أو في تفاصيل الحكم الموصوف.
فما يبدو في الظاهر وكأنه مجرد تمثيلات مشخصة لحالات وعي أو كائنات قابلة للاستحضار البصري، سيتحول إلى حامل لدلالات من طبائع شتى لا يمكن أن تستكين إلا في المفاهيم. فهي وحدها قادرة على رصد حالات التحول والاستقرار والنمو في الوجود، ما يعود إلى حياة الناس ووعيهم، وما يعود إلى محيطهم على حد سواء. وهو الأمر الذي يشير إليه النص الديني ذاتُه حين يُسند إلى القصة وظيفة العبرة والموعظة والشاهد والبينة.
وهو ما يعني أيضا أن القصة ليست أحداثا فحسب، بل هي مجموعة من السجلات الثقافية التي تخبر عن قلق الإنسان ورغباته واستيهاماته وتصوراته عن الموت والحياة، وكذا عن طقوسه في الحزن والفرح، كما كانت سجلا لملبسه ومأكله ومعماره … لذلك قد تقول من خلال ذاكرتها القيمية أكثر مما تقوله من خلال أحداثها، بل قد لا يكون للأحداث في ذاتها أية قيمة خارج إحالتها على مضمون رمزي هو الباعث الأول والأخير على السرد.
وهذه الخاصية هي التي يجب أن توجه الاستكشاف التأويلي وتحدد مردوديته التحليلية، فمن خلالها ينفتح النص على عوالم هي من صلب الرغبة والحلم والاستيهام. إن القراءة الحرفية مشدودة إلى الحدث دائما، أما التأويل فوثيق الصلة بالدلالات الإيحائية. تكتفي الأولى برصد الوقائع وعدها، أما الثاني فيحتفي بالاستعاري فيها، إنه لا يلتفت إلى الحدث إلا من أجل إدراجه ضمن ذاكرة قد تتسع لتشمل مضمون الموسوعة كلها.
بعبارة أخرى، يشترط “الفهم”، في حالات النصوص السردية خاصة، الفصلَ بين “معنى” الحكاية وبين “المرجعية المفترضة” التي قد تحيل عليها وقائع القصة المروية أو توهم بها. ذلك أن محاولة التعرف على مضمونها من خلال البحث في مرجعيتها عن معنى كلي يكون هو الغاية من الوصف الحدثي، لن يقود سوى إلى إفقارها ونزع صفة الرمزية عنها.
وهو ما يعني أن بناء الدلالات الإيحائية يشترط بالضرورة “تدمير” القصة فيها، أي تأويلَها. فالوجه المشخص فيها يعد حاجزا بيننا وبين المعرفة المفهومية التي يقود إليها التجريد، وهو أساس كل فهم عقلي.
وهي طريقة أخرى للقول، إن المبدأ التأويلي يقوم أساسا على سيرورة تقود إلى الدفع بالمشخص إلى التراجع من أجل انتقاء ما يحل محله من المفاهيم. تماما كما لا يجب البحث في الملفوظ الاستعاري عن مرجعية تؤكد مضمونه، ذلك أن موطن هذا المضمون ليس شيئا آخر غير معادلِه المفهومي. وبدون هذا المعادل ستصنف كل التعبيرات الاستعارية ضمن “المعنى العبثي” أو ضمن ما يحيل على “شذوذ في القول”.
إننا نمنح النص، من خلال هذا الفصل، قدرة على تسليم بعض أسراره بالنفخ في المضمر فيه، أي بناء مقاصد جديدة تصبح وعاءً لمعاني تخفيها عناصر التجلي. وشرط ذلك هو التخلص من التشخيص وتحرير القصة من سياقات تُبنى ضمن المشترك الثقافي بإحالاته النفعية. فهذا التحرير وحده يمنح النص فرصة تجاوز البعد الحرفي فيه.
ذلك أن الحرفية قد تشوش، بطبيعتها تلك، على الديناميكية الداخلية للنص وتحوله إلى وعاء أجوف لا يمكن أن يقول إلا ما تبيحه وتصدق عليه حقائق يعرفها القارئ، أو يدرك مضمونها استنادا إلى ما يأتي من التجربة المشتركة. ومن خلال هذا التجاوز وحده يمكن للنص أن يستعيد ذاكرته الممتدة في موسوعة يحتل الاستعاري والرمزي فيها موقعا مركزيا.
2
استنادا إلى هذه الملاحظات الأولية، سنحاول قراءة بعض الوحدات السردية المقتطعة من السجل القصصي القرآني، قصة إبراهيم على وجه الخصوص، وهي قصة موزعة على الكثير من السور القرآنية، دلالة على الموقع المركزي الذي يحتله هذا النبي ضمن المنظومة العقائدية للديانات التوحيدية الثلاث ( يُطلق عليه في الكثير من الأحيان: أبو الأنبياء).
فقد يكون وحده من الأنبياء من ارتبط اسمه، قبل الدعوة المحمدية، بحالات تأمل انصبت على مساءلة جوهر الكون وماهية خالقه. لقد شكك في قيمة ما تلتقطه الحواس وتنتشي به باعتباره حقيقة إليها تنتهي هذه المنافذ وعليها تستقر. ففي ما هو أبعد من الوجود المادي للأشياء والكائنات والظواهر، هناك ما لا يُرى بالعين، ولكنه يعد أصل كل شيء، ما سنشير إليه لاحقا باعتباره السيرورة التي تقود من المرئي العرضي في الوجود، إلى اللامرئي الثابت خارج موجودات الكون.
ويتمحور مضمون هذا التأمل، كما تكشف عن ذلك أغلب اللحظات الموصوفة في مقطعين سرديين مركزيين ( سورة الأنعام، سورة الأنبياء )، حول ثيمة واحدة تتكرر مضمونا وتتنوع صياغاتها حسب مقامات القول الوعظي أو التبشيري. يتعلق الأمر بمحاولة للتعرف على الله خارج المشخص في الوجود، من قبيل الأصنام والتماثيل، ومن قبيل كائنات الوجود وأشيائه. لقد كان رفضه عبادة الأصنام مرتبطا برفضه لسلطة الأب وتراثه، ورفضا لجبروت نمرود وطغيانِه في الوقت ذاته. إن التخلص من عبادة الأصنام دعوة ضمنية إلى التمرد على نمرود نفسه.
وهو ما يعني أن رفض السجود لآلهة من حجر لا ينفصل عن رفض الخضوع لسلطة سياسية متجبرة، كما سنرى ذلك في تفاصيل هذا التحليل. فالنمرود ليس سلطانا إلا في الظاهر، أما في الجوهر فهو صورة عن إله مزيف، أو هو دمية شبيهة بالأجرام المتغيرة أو الأصنام الصامتة؛ لذلك لا يمكن أن يكون مصدرا لحقيقة مطلقة. إن وضع الله في ما هو أبعد من كل كائنات الوجود، ورفض التشابه أو التطابق عنده، معناه تنسيب لكل الحقائق الأرضية، بما فيها حقيقة السلطة ذاتها.
وهي ثيمة لا تبنى استنادا إلى أمر إلهي يحث بشكل مباشر على التوحيد والبحث عن ذات الله في ما هو أبعد من مجسمات بلا روح (الأوثان)، بل تتحقق من خلال حالات تأمل قادت “عاملا”(actant)، بالمفهوم السميائي للكلمة، إلى إدراك سر ما هو موجود خارج الظاهر للعيان من خلال فعل إرادي قصدي يُنسب إلى ذات فاعلة يجسدها إبراهيم. قد يكون مصدر هذه الرؤيا “إلهاما” داخليا شبيها باستيهامات المتصوفة والأولياء، أو قد يكون حاصل تأمل عقلي، كما تثبت ذلك حادثة تحطيمه أصناما قَدَّرَ، من موقع المتأمل العارف، أنها لا يمكن أن تنفع الناس أو تضرهم.
ذلك أن الوصول إلى الجوهر، أي الإمساك بالمطلق الكلي، باعتباره حالة تفترض أصلا موجودا خارج المتجلي، يقتضي الانطلاق من عناصر التجلي ذاتها. فليس لدى الرائي من سبيل آخر إلى الإحاطة بمضمون ما يوجد في منأى عن البصر سوى ما يسكن العينَ ويستوطنها. وتلك ضرورة يقتضيها كل “فهم”، فهو في حدوده الدنيا وفي غاياته القصوى سيرورة مركبة نستطيع من خلالها التعرفَ على المجرد من خلال علامات حسية تقود إليه أو تستثيره.
إلا أن الانطلاق من هذه العناصر المشخصة لا يعني الإحالة على مرجعية محددة من خلال سجل يُثبت هوية فردية خاصة، هي ما تحاول القصة تسريد بعض عناصرها. فصفة إبراهيم هاته، محددة ضمن ما تحيل عليه القصة داخل ذاكرة الإنسانية ككل، لا باعتبار موقعه في تاريخ قابل للتعيين.
وهذه الخاصية وحدها قد تفسر خلو الفضاء الموصوف في النص من عناصر يمكن أن تحدد مضمونا ثقافيا يستمد حقائقه من مرجعية معلومة. ولهذه الغاية يَعمد السرد إلى إفراغ محيط التأمل من أشيائه، ووضعه ضمن حالة تقابل قصوى بين سماء لا سبيل إلى الوصول إليها، وبين أرض أصبحت أشياؤها مألوفةً في العين: كان إبراهيم في مسرح الأحداث وحيدا يواجه نورا يأتيه من بعيد وقد لفه الظلام من كل جانب.
فأن نلغي فكرة المشخص الحدثي الذي تنتظم وفقه العناصر المشكلة للقصة، معناه أن البداية ستكون مفهومية بالضرورة، ما كان يسميه إيكو “الطوبيك”(6)، تلك الفرضية التي يعتمدها القارئ من أجل انتقاء مسار تأويلي يعيد من خلاله بناء قصد يقوم على أنقاض نوايا النص الظاهرة.
ولهذه المفهومية علاقة بطبيعة الدلالة ذاتها، فهي ليست معطى قابلا للعد، بل هي في المقام الأول سيرورة يُعاد من خلالها بناء ما سُرب إلى النص في شكل لقطات ومشاهد متفرقة. لذلك لا نعين، في عمليات التأويل، معنى جاهزا يبرره الإيمان أو يفسره، بل نقتفي آثاره في تفاصيل الحدث وقرائنه المهملة.
يختصر المقطعان السرديان المثبتان أدناه رحلة البحث عن إله جدير بالعبادة، يكون شيئا آخر غير ما يقترحه السائد الديني في المحيط المباشر. وبذلك يكثفان في “حدث” مخصوص ما يمكن العثور عليه مفصلا في مجموع المقاطع التي تروي قصة إبراهيم، وتتحدد دلالات هذه التفاصيل استنادا إلى مضمون هذين المقطعين، لا خارجهما. ففيهما تتحدد المفاصل المركزية لحياة رجل “شذ” عن السائد الثقافي والديني ودخل في مواجهة صريحة مع أقربائه في الدم وفي الانتماء الثقافي، انتهت بإلقائه في نار كانت عليه بردا وسلاما، كما تقول ذلك عبارة النص.
يقدم لنا المقطع الأول: “فلما جن عليه الليل رأى …”، من خلال خطية حدثية صريحة، بنية سردية متكاملة من حيث التقطيع الزمني الذي يحتضن سلسلة من التحولات ستقود من وضع بدئي مباشر ومحسوس يتجسد في انتقاء لحظة زمنية تدشن فعل التساؤل، وتحدد موضوعه ( البحث عن الله)، إلى حالة نهائية تعلن عن لحظة الاهتداء إلى محفل أعلى وسع ملكهُ الطبيعةَ كلها: ” وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ”.
وهي كذلك أيضا من حيث الإحالة على شخصية مثبتة في النص باعتبارها فاعلا بطلا تَعِدُ مواقفُه بأحداث ستمنح الرحلة التأملية غاية ومعنى، وتُسقط في الوقت ذاته ما يناسبها من سلوك (ستكون قاعدة الفعل فيها هي تكسير الأصنام، كما نعثر على ذلك في مقطع سردي آخر).
يتعلق الأمر بلحظات سردية متقابلة تُستوعب ضمن كم زمني معدود يتحدد مضمونه من خلال تعاقب الليل والنهار (الكوكب والقمر والشمس)، دون أن يعني ذلك أن الأمر يتعلق بتقابل إقصائي، بل يشير إلى سيرورة تُضمِّن التعاقب إحالة على بعض مظاهر الحقيقة وعلى درجات عمقها أو ضحالتها.
فهذه الحقيقة في جميع الحالات نسبية وعرضية (البزوغ ثم الأفول). بعبارة أخرى، تختزن هذه اللحظات سلسلة من التحولات تُدرك بداءة ضمن ما يوحي به “الخارج الطبيعي” من حيث الإحالة على انتقال من كوكب إلى قمر ثم إلى شمس بازغة، ولكنها مهددة بأفول لا راد لوقوعه: من جهة هناك تركيز ظاهري على تفاوت في الحجم (الشمس أكبر من القمر والقمر أكبر من الكوكب)، ومن جهة ثانية هناك تفاوت في كثافة النور: من البصيص، إلى ظلال القمر ثم إلى النور الساطع.
وضمن هذا التعاقب ” الطبيعي” سيتحدد التحول الذي سيعرفه وعي المتأمل، حيث تنتقل الذات من عبادة ما يُرى عينا في الوجود إلى الانصهار في ما لا يُرى باعتباره سر الكون وحقيقتَه النهائية، أي من رفض التعدد الربوبي إلى تمجيد الإله الواحد الذي لا تُدركه الأبصار. وهو الانتقال الذي يجعل اللامرئي سبيلا نحو استعادة حرية المتأمل في الأرض.
إن الانصهار الكلي في اللامرئي هو المقابل المحسوس للتخلص من عبء الأشياء وسلطتها، فالتجريد في جميع الحالات هو صيغة من صيغ التخلص من الأشياء والاحتفاظ منها بصورة عامة لا يمكن أن تتطابق مع شيء بعينه.
ويرسم هذا التقابل، من جهة ثانية، فاصلا بين كونين موضوعين ضمن علاقة تراتبية، “التحت” الأرضي، بمحدودية وعرضية الأشياء فيه، و”الفوق” السماوي الممتد إلى ما لانهاية. ويشتغل “الفوق”، ضمن هذا التقابل، باعتباره مصدر النور المطلق الذي لا يمكن أن يختفي، إحالة على “الحقيقة الثابتة” التي لا تتغير بتغير حالات الكواكب والنجوم. وهو ما يعني بصيغة أخرى، أن استكناه جوهر الكون لا يتم استنادا إلى ممكنات الفضاء الأرضي، بل يقتضي إسقاط ملكوت السموات العلا، مرموزا إليها ب”فوق” لا تطاله منافذ الحس ولا يمكن أن تدرك كنهه عقول مشدودة إلى المعطى الطبيعي.
لكن الأعلى المرئي ذاته يخفي، من جهة ثانية، ما هو أعلى منه؛ فما يحده البصر وتدركه العين لا يمكن أن يكون “منتهى الوجود”، تماما كما لا يمكن للكواكب والنجوم التي تظهر وتختفي أن تكون مصدرا للنور: إن النور الظاهر للعيان ليس سوى ظل للنور الأصلي الذي يحتضن كل الأنوار. إنها إحالة على الممكن في ” النوعية” (بالمفهوم البورسي للكلمة) حيث يقوم الوجود كله على أحاسيس مفصولة عن السياقات ومواد التحقق، ما يشبه الجوهر المحدد في ذاته في استقلال كلي عن أعراضه. فهذه النوعية لا تدرك من خلال نسخة مجسدة في شيء (النور الأرضي) بل هي مصدر النور وجوهره، أي هي في ذاتها قبل أن يصبح النور حقيقة في العين التي ترى.
وهو أمر تفسره رمزية الأبعاد ذاتها، فكل الثقافات تثمن ما يوجد في الأعلى باعتباره الإيجاب في كل شيء، في الطبقات والحظوة والجاه والرؤية، وفي وضعية الأشياء أيضا، فيد الله فوق أيديهم؛ في حين يشير “التحت” فيها إلى النكوص والتردي والحضيض والوضاعة حيث تُنكس الأعلام وتنكسر العيون ويتهاوى الجسد، و”من كان في أسفل الهوة لا ينحدر”.
ويبدو أن المدخل المركزي لاستيعاب مجمل هذه العناصر يبدأ من جملة مركزية من المقطع الأول:” فلما جن عليه الليل”، فهي مفتاح كل ما سيأتي بعد ذلك، وهي ما يفسر لاحقها والسابق عليها. وفي هذا السياق أيضا لا يمكن استيعاب الممكنات الدلالية لهذا المقطع إلا من خلال استبعاد حالات التشخيص فيه. فالمضمون الحرفي في الجملة يكتفي بالإشارة إلى سلوك إنساني مألوف، وهي عادة أهل القرى والبوادي في الخروج ليلا إلى الفضاءات المفتوحة للاحتفاء بصفاء السماء وتأمل مهرجان النور فيها.
وهو ما يقوم به الرحالة بحثا عن نجم يهديهم، وما يقوم به المزارعون الذين يترجون غيثا من السماء، ويفعله العاشقون أيضا، ففي العشق نفس صوفي أيضا. لذلك، فإن استبعاد هذا المعنى المتداول أمر ضروري من أجل استعادة المخزون الرمزي فيها، ودون ذلك لن نرصد سوى سلوك يكرر سلوكات سابقة عليه في الزمان.
إن الفعل “جن” دال على سياقات تُصنف كلَّها ضمن حالات الاختفاء والستر. فجن عليه الليل، ستره بظلمته، ومنه الجنة والجنة والجنة والجنين والمجن والجن؛ بل قد يدل الجن على “نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم على الأبصار ولأنهم استجنوا من الناس فلا يُرون، وقد يكون دالا على الملائكة أيضا” (لسان العرب). ومع ذلك، فإن هذا المعنى، رغم تعدديته، لن يكون سوى ظاهر لمعنى آخر هو الأصل في التمثيل، وهو الغاية من الوصف السردي.
لا يتعلق الأمر بوصف خاص بليلة معلومة، بل بالإمساك بموقف تأملي ثابت شبيه بتأمل الأنبياء قبله وبعده، وشبيه برؤى الفلاسفة والحكماء أيضا. وهو ما يعني أن الجملة تحتضن سلسلة من التقابلات ننتقل من خلالها من حدث فردي، إلى ما يشمل سيرة الإنسان كلها على الأرض.
ومن هذه الزاوية، لا يقود الفعل “جن”، في هذا السياق، إلى التركيز على حالة تصف موقفا في الزمن، أي لحظة انتباه شخص معلوم إلى وجود كواكب تضيء ظلام الليل، فالكواكب كانت هناك دائما، وقد رآها مرات عديدة قبل ذلك، ولا شيء في السياق أو في منطوق النص أو في الذاكرة المحيطة يجعل هذه الليلة مختلفة عن باقي الليالي.
كما أننا لا نعثر على أية قرينة تؤكد فرادة هذا الكوكب أو تميزه عن باقي الكواكب، فهي جميعها واحدة في العين المحايدة. يبدو الأمر وكأن الحالة السردية الموصوفة تقتطع من متصل زماني لحظة خاصة تصفها خارج المعتاد من حالات الإدراك، أو تحدث شرخا في المألوف في العين من خلال فصل الرؤية عن أشياء الكون لكي لا ترى سوى كوكب ضمن حالة تشبه الدهشة بالمفهوم الفلسفي للكلمة.
نحن إذن أمام موقف مركب تمتزج داخله حالات تشير إلى غياب مطلق للوعي، هو ما يمكن أن يُحيل عليه معنى من معاني الفعل “جن”، وما يمكن أن يدل عليه الظلام باعتباره يعين حالة تنعدم فيها القدرة عند الإنسان على الرؤية والتمييز بين الأشياء. قد يتعلق الأمر بالجهل في معانيه المتعددة، بما فيها غياب الصدق وانتفاء الحقيقة، وقد يكون دالا على الضلال والتيه والضياع بين حقائق لا شيء يجمع بينها، ومنها دلالة الجن على المجنون والجنين في الوقت ذاته، فالأول فقد القدرة على التفكير، أما الثاني فإحالة على كائن لم يتعلم مبادئ التفكير بعد.
وهو ما يعني أن الجمع بين “جن” و”الليل”، بين الاختفاء والظلام، يشير إما إلى حالة استلاب قصوى فقد معه الرائي القدرة على الرؤية والتفكير (الظلام في الداخل والخارج)، وإما إلى حالة إشراق لامتناهي يقتضي التخلص من المعروف والمألوف بحثا عن يقين لا يكون إلا في نور لا يحد من امتداده حد (الظلام في الخارج أما النور ففي الداخل الوجداني).
وعلى هذا الأساس، لن تكون المعرفة الجديدة حاصل ممارسة تتم ضمن المشترك الثقافي، بل مصدرها نور تحدد درجةُ كثافته درجةَ عمقها، وهو ما يحيل عليه الانتقال من نور كوكب يلوح في البعيد، إلى بزوغ فعلي للقمر باعتباره مصدر نور يشق ظلاما كثيفا، وتأتي الشمس لا لتجسد النور الكلي، بل لتؤكد صحوة المتأمل وتهديه إلى النور الحقيقي الذي يتسع ليشمل كل الأنوار الداخلية والخارجية.
بعبارة أخرى، إن الظلام وحده يجعل ضوء الكوكب ممكنا، بل هو ما يهدي الرائي ويمنحه بصيصا من نور يدله على سبيل آخر غير ما ما يأتيه من محيطه. وهذا هو مصدر التقابل بين النور والظلام من جهة، وبين الجهل والهداية من جهة ثانية (الجهل بمفهومه الديني والفكري في الوقت ذاته).
فوسط هذا الظلام الدامس يلوح نور من بعيد، إشارة إلى لحظة أولية في المعرفة أو في الهداية، ستتلوها لحظات أخرى يكون فيها النور أكثر قوة واتساعا. حينها سيصبح التقابل بين الجهل والعلم، بين الكفر والإيمان، بين عمى العين وصحوة البصيرة لا بين الليل والنهار، بين الظلام والنور. ذلك أن النور الذي تلتقطه العين ليلا أو نهارا ليس سوى صورة للنور الأبدي الذي يجب أن يشع في الداخل.
وبما أن الإنسان كائن حي في الجسد وفي الذاكرة وفي المبادئ التي ينظم من خلالها تجربته، فإن الأصنام ذاتها لا تحيل على كائنات فعلية، كما لا يمكن أن يكون التكسير فعلا حقيقيا أيضا، كما تشير إلى ذلك الدلالات الحرفية للقصة. قد يتعلق الأمر في الحالتين معا بإحالة رمزية المراد منها تشخيص حالات التمرد على المسبقات في الأحكام الاجتماعية وفي المعتقدات الدينية وفي منطق السلطة السياسية أيضا. وذاك موقف مألوف في الممارسة الإنسانية؛ حدث هذا التمرد أيام إبراهيم، وحدث بعده أيضا أيام الدعوة المحمدية (وجدنا آباءنا…). بل أصبح “تكسير الأصنام” تعبيرا شائعا في الأدبيات الاجتماعية التي ترى في التفاوتات القيمية حاصل نوع من التمرد يمارسه جيل على جيل آخر.
بل يمكن أن ندفع بالرمزية إلى ما هو أبعد من ذلك، فواقعة تكسير الأصنام تشير إلى وجود مجموعة من الأصنام الصغيرة يتوسطها صنم كبير. وقد لا يكون هذا التمييز مجازيا غريبا عن تراتبية السلطة ذاتها: السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والسلطة الأخلاقية. وفي هذه الحالة لن يكون الصنم الكبير سوى نمرود نفسه؛ فزيف عقيدة أمة إبراهيم من زيف الحقيقة التي يمثلها سلطانها. وفي هذه الحالة سيصبح سقوط الأصنام إحالة على سقوط السلطة ذاتها. ذلك أن الإيمان بسلطة غير قابلة للتجسيد، هو في الواقع انعتاق للفرد والجماعة من سلطة في الأرض.
وفي الاتجاه ذاته، لن تكون النار التي وضع فيها إبراهيم “نارا” إلا من باب التعبير المجازي. فقد تعني في منطق المناهضين لإبراهيم محاولة لطمس معالم الحقيقة التي يدعو إليها (العسف والاضطهاد)، وقد تكون من زاوية الرحلة التأملية “تطهرا” يخلص الذات من الزيف الذي يحيط بها (الابتلاء، ما يشبه الطقس الاستئناسي). تندرج الحادثة كلها ضمن طقوس اجتماعية أو صوفية لا يمكن للفرد أن ينتقل من وضع إلى وضع داخل وضع ثقافي بعينه، دون الخضوع لتجارب تؤهله لذلك. وهي حال كل الطقوس الاستئناسية، الدينية والأسطورية على حد سواء.
وهو أمر تؤكده رمزية النار، بل يؤكده أيضا الاختلاف بين عرضية النار وجوهر الماء. فإذا كان الماء مادة أصلية في الوجود وليس اكتشافا من اكتشافات الإنسان، فإن النار على العكس من ذلك. فقد تعلم الإنسان كيف يستثيرها، فكانت دفئه في الداخل والخارج، وحولها بعد ذلك إلى أداة للوقاية من الموت بردا، واستعملها في طعامه وفي ليال أنسه. وقد يكون هذا ما دفع البعض إلى تصنيفها ضمن ما يطهر من الداخل. إن سلام النار وبردَها من طبيعة روحية، ذلك أن الوصول إلى حقيقة جديدة تبعث الطمأنينة والسكينة في القلوب يقتضي التطهر من الداخل، أي التخلي عما سبق أن تعلمه المرء أو جاء من أهله ومحيطه.
ويمكن أن ننظر إلى “النوع” (genre) ذاته باعتباره عنصرا مركزيا في تحديد هذا اليقين الفكري والوجداني. ذلك أن الانتقال من الكوكب، كما ورد في النص (رأى كوكبا)، باعتباره يتضمن التذكير والتأنيث (الزهرة والمشتري)، إلى القمر والشمس باعتبارهما دالين بالتتابع على مذكر ومؤنث خالصين في الثقافة والوقع اللغوي (بازغا وبازغة)، هو إحالة رمزية على رفع التذكير والتأنيث عن الذات الإلهية، ولكنه يضعها في الوقت ذاته في ما هو أبعد من كل مخلوقاته. فكما لا يمكن أن نعبد من يتغير ويشيخ ويهرم، فإن الذي يشبه ما خلق ليس جديرا بالعبادة.
والخلاصة أن تخلصنا من الوجه المشخص للقصة واستبعادَنا لحالات التطابق بين وقائع القصة وبين مرجعية تاريخية مزعومة، يمكننا من الانتقال من تجربة فردية قابلة للعزل في الزمان وفي المكان، إلى استيعاب وجود إنساني على الأرض لا تشكل حكاية إبراهيم داخله سوى مقطع من قصة شاملة تستوعب في واقع الأمر كل محاولات الإنسان الرامية إلى تجاوز حدود المرئي للوصول إلى مطلق أبدي يوجد خارج الزمن ( التعاقب بين الليل والنهار)، أي إجلاء المضمون اللازمني للكون باعتباره حالة أصلية يفيض عنها ما تدركه العين كما تحاول القصة تمثيل ذلك.
والحاصل من هذه الرمزية أن ما هو موضوع للتسريد، ضمن هذه الوضعية، ليس موقفا خاصا بفرد استبدت به رغبة التوحد في ملكوت الله، بل حالة ثقافية عامة تمتلك داخلها الأبعاد والأشياء وحالات الزمن دلالات لا يمكن فهم القصة دون استحضار مضمونها. فالـمُمَثَل في القصة لا يشكل سوى ممر بسيط نحو التمثيل لحالات القلق التي رافقت الكائن البشري على الأرض وأججت رغبته في معرفة بعضٍ من أسرار هذا الكون.
إننا نلغي من الوجه المشخص للقصة كل ما له علاقة بالفعل الإرادي الفردي المباشر، أي ما يمكن أن يُصنف ضمن التجربة السلوكية العادية للفرد أو الجماعة. يتعلق الأمر العودة إلى محفل سماوي تنتهي إليه كل الحقائق، ولكنه يعد مدخلا مركزيا أيضا نحو تحديد تعددية الحقيقة في الفضاء الأرضي، وهو ما يعني أيضا انتفاء مركز “تحتي” يكون وحده مصدرا للحقيقة.
وبذلك، فإن الحكاية لا ترصد فعلا محددا من خلال سياق فردي، بل تشير إلى تمثيل سردي يشخص فعل التأمل الإنساني ذاته، كما جسدته كل الذوات المتأملة على مر التاريخ البشري. وفي هذه الحالة، لا يمكن للفاعل أن يكون شخصا، بل نحن أمام عامل كوني ( actant universel) يكثف في فعل مخصوص كل حكايات التأمل التي تداولتها الذاكرة منذ انبثاق زمنية إنسانية تعي ذاتها خارج أشياء الطبيعة وظواهرها. ومن هذه الزاوية يصبح إبراهيم التخييل أغنى من إبراهيم التاريخ.
- هوامش
*- نشرنا جزءا من هذا المقال في جريدة الأحداث المغربية ليوم الجمعة 3 مايو 2013
1-أومبيرتو إيكو: التأويل ، بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، بيروت ، 2000، ص158
2- Paul Ricœur : Du texte à l’action, P. 158
3- R Barthes : L’obvie et L’obtus, éd Seuil,1982,p.21
4- إيكو نفسه ، ص 158
5- Paul Ricœur : le conflit des interprétations, p.266
6-Eco : Lector in Fabula, éd Grasset , 1985,p.114
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ َلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( الأنعام).