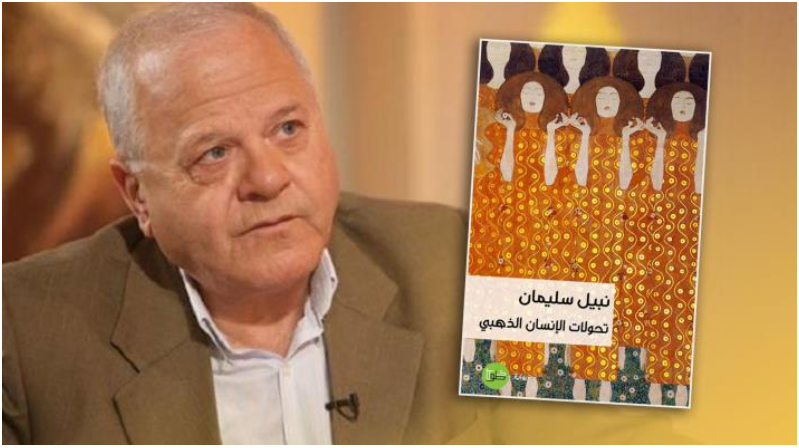” طلب امبراطور صيني من كبير الرسامين في القصر أن يمحو صورة الشلال المرسومة على الجدار لأن هدير المياه كان يمنعه من النوم”
ريجيس دوبري(1)
- تمهيد
إن كل المعطيات الموصوفة في النموذج اللساني يمكن أن تتحول إلى كوة نطل من خلالها على الأنساق غير اللسانية، فالقوانين التي تتحكم في اشتغال الأنساق الأخرى مبنية وفق قوانين اللسان. هكذا تصور سوسير السميولوجيا، ووفق هذا المنطق حدد موضوعها وتخومها.
فهذه المعطيات تقدم معرفة أولية ستقود السميولوجيا إلى الاستقلال بنفسها والبحث عن هويتها من خلال تبني ما يوفره النموذج اللساني من أدوات ومفاهيم وأساليب في التحليل والرؤية. وستتجسد هذه الهوية في الموضوع الجديد الذي يجب أن يحتضنه هذا العلم ويعيد تعريف عناصره وصياغة حدوده. وعلى هذا الأساس، يجب النظر إلى الدلالة وأنساقها وأشكال تجليها من خلال الحدود التي يوفرها النموذج اللساني ذاته.
فهذه الوقائع الجديدة شبيهة، من حيث الجوهر التواصلي ومن حيث البعد التدليلي، بالوقائع اللسانية، وما يصدق على اللسان يمكن أن يصدق عليها. فهي الأخرى تعد سندا لإنتاج الدلالات، ومحكومة في وجودها، شأنها في ذلك شأن اللسان، بمبدأ الاعتباطية. وهو المبدأ الذي اشترطه سوسير لولوج الوقائع الدلالية إلى دنيا العلم الجديد.
ولقد شكل هذا المبدأ، لفترة طويلة، عائقا منهجيا حرم الدارسين الأوائل من تبين موضوعات درسهم، واكتفوا في البدايات الأولى بمعالجة الوقائع الإنسانية استنادا إلى ما يقدمه النموذج اللساني من مبادئ وخصائص، فمبدأ الاعتباطية، في نظر سوسير، لا يصدق على اللسان فحسب، بل يصدق على مجموعة أخرى من الظواهر غيراللسانية.
وهو أمر يخص طبيعة الدلالة ذاتها. فالدلالة في تصور سوسير – وهو تصور لا يشكك فيه أحد – سيرورة وليست معطى جاهزا، فهي لا تتبدى إلا من خلال الأنساق المبنية التي تقوم باستعادة القيم الدلالية المحصل عليها من خلال الممارسة الإنسانية ذاتها، فما هو سابق على هذه الممارسة لا يدخل ضمن اهتمامات السميولوجيا ولايشكل موضوعا لها.
وبناء عليه، يمكن القول إن كل الصيغ التعبيرية التي تُشتم منها رائحة التعليل يجب أن تقصى من ميدان السميولوجيا، فدلالاتها ليست حصيلة تسنين، بل هي معطاة من خلال التشابه أو التجاور، وهو ما يقصيها، في رأي سوسير، من السيرورات التدليلية.
فـ” موضوع السميولوجيا يتكون من مجموع الأنساق ذات الطبيعة الاعتباطية”. (2) ومبدأ الاعتباطية هو المعيار الأساس الذي يتم من خلاله تصنيف الظواهر المنتجة للقيم الدلالية التي يستند إليها المتكلم في تمثل الوقائع الإبلاغية وفهمها. استنادا إلى هذا، “يمكن القول إن السميولوجيا تجد صورتها المثلى في العلامات الاعتباطية “. (3)
ومع ذلك، فإن هذا الحكم العام ليس قطعيا، ولا يمكن أن يخفي أن الوقائع غير اللسانية ليست بالبساطة التي يتميز بها اللسان، فهي لا تستند إلى نفس مبادئه من أجل إنتاج دلالاتها. والمثال الذي يقدمه سوسير للتدليل على اعتباطية المواد التعبيرية غير اللسانية (4) لا يغطي سوى جزء يسير من ” اللغات ” التي تشكل موضوعا للتواصل، وهي لغات تتجاوز في وجودها حدود التواصل لتعبر عن نوع من الانتماء الثقافي والاجتماعي والحضاري إلى هذه المجموعة البشرية أو تلك.
فهذا التصنيف المتضمن في مثال سوسير، سيترك جانبا مجموعة من العلامات التي لا يبدو – ظاهريا على الأقل – أنها تخضع لمبدإ الاعتباطية. فالرموز والقرائن والأيقونات علامات لها وضع خاص داخل سجل اللغات الإنسانية، ولا يمكن أن نتعامل معها كما نتعامل مع وحدات اللسان. فهي من جهة ليست اعتباطية بالمفهوم الذي يعطيه سوسير “للاعتباطية”، وهي، من جهة ثانية، ليست معللة بالمعنى الذي يجعل منها كيانا حاملا لدلالاته خارج سياق الممارسة الإنسانية وأسننها المتعددة.
” فالأيقونية مثلا هي حصيلة مجموعة من الإجراءات الخطابية التي تستند إلى التصور- وهو تصور نسبي على كل حال – الذي تتبناه ثقافة ما من أجل تقطيع الواقع “.(5) فهي إذن حبيسة البناء الثقافي لا معطى يوجد خارجه.
ولهذا السبب، فإن الوضع الخاص لهذه العلامات يقتضي منا إعادة تحديد مفهوم الاعتباطية، والنظر إليه، كما فعل إيكو، من موقع يقودنا إلى إعادة تحديد مضمونه من زاوية ترتكز على إواليات الإدراك وقوانينه، لا من زاوية العلاقة القائمة بين صوت ومعنى، أو صورة سمعية وتصور ذهني ( كما هو الشأن في اللسان).
فإدراك الإنسان لعالمه الخارجي ليس عملية بسيطة تكتفي بالربط بين ذات مدركة وموضوع مدرك ضمن علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسائط. إنها، على العكس من ذلك، عملية بالغة التعقيد، فهي تستدعي سلسلة من العمليات غير المرئية من أجل نقل العوالم الحسية من موقعها داخل الطبيعة لإدراجها ضمن الأكوان التي تمثلها الخطاطات المجردة.
وهذا التمييز بالغ الأهمية، فهو الذي سيمكننا من الفصل، داخل تحليل الصورة، بين مستويين : ما يعود إلى الإدراك ( كيف ندرك الصورة )، وما يعود إلى إنتاج الدلالة ( كيف يأتي المعنى إلى الصورة ). وهما عمليتان مختلفتان ولا ترتبطان بنفس الإشكالية.
- I – الصورة والسنن الإدراكي
إن أي انزياح عن النموذج اللساني في دراسة الظواهر البصرية يقتضي البحث في هذه الظواهر ذاتها عما يميزها عن الظواهر الأخرى، أي البحث عما يجعل منها كيانات تمتلك طريقة – أو طرقا – خاصة بها في إنتاج المعنى. فالوجود الرمزي المطلق للسان – صوتا وكتابة – يقابله الوجود المحسوس للظاهرة البصرية التي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار مجمل المثيرات البصرية التي تعد المدخل الرئيس نحو القيام بالشكلنة الضرورية لإدراك ما يوجد خارج الذات ( نحن نبصر لأن هنا أشياء يمكن إبصارها (.
وعلى هذا الأساس، فإن القضية المركزية في تحديد طبيعة الصورة تتلخص في معرفة الطريقة التي تأتي من خلالها هذه الصورة إلى العين وتستوطنها باعتبارها ” نظيرا ” للشيء الذي تقوم بتمثيله. فالإحالة الصافية على موضوع يتم تمثيله من خلال سند أيقوني يوحي بأن العلاقة القائمة بين دال الصورة ومدلولها علاقة قائمة على تشابه يجعل من الأول يحيل على الثاني دون وسائط. وفي هذه الحالة، فإن دلالة الصورة أمر يأتي من الصورة ذاتها دونما استعانة بمعرفة سابقة يمكن أن يوفرها التسنين الثقافي.
إلا أن الأمر ليس كذلك، فالعلامات البصرية – رغم إحالتها على تشابه ظاهري – لا تقدم لنا تمثيلا محايدا لمعطى موضوعي منفصل عن التجربة الإنسانية، فالوقائع البصرية في تنوعها وغناها تشكل ” لغة مسننة”، أودعها الاستعمال الإنساني قيما للدلالة والتواصل والتمثيل.
استنادا إلى ذلك، فالدلالات التي يمكن الكشف عنها داخل هذه العلامات هي دلالات وليدة تسنين ثقافي وليست جواهر مضمونية موحى بها. ومن هذه الزاوية، فإنها، شأنها في ذلك شأن وحدات اللسان، محكومة بوقائع توجد خارجها، أي أنها من طبيعة اعتباطية، ولا تنتج دلالاتها إلا وفق هذا المبدأ.
ولقد عبرت هذه الإشكالية عن نفسها من خلال مجموعة من المفاهيم الوثيقة الصلة بما تثيره طبيعة الروابط بين دال الصورة ومدلولها. ونعثر في كتابات إمبيرتو إيكو على تحاليل مفصلة لهذه القضية. فهذه الروابط تدور، جميعها، حول حقل علائقي متكون من مفاهيم من قبيل : “التشابه” و”التجاور” و”العرف” و”النموذج الإدراكي ” و” سنن التعرف ” (6)…الخ.
وهي مفاهيم وثيقة الصلة بما تحيل عليه مقولتا سوسير “الاعتباطية” و”التعليل” في اللسانيات ودورهما في تحديد طبيعة الدليل اللساني ونمط اشتغاله. فارتكازا على هذه المفاهيم التصنيفية، نُظر إلى فكرة ” الأيقونية ” – في مجال الإدراك البصري – باعتبارها نقطة البداية التي ستقودنا إلى إعادة النظر في كل الوقائع البصرية.
وهكذا، عوض أن نجعل من فكرة ” الأيقونية”، التي تحيل في كل السياقات على فكرة التشابه، مدخلا نحو إدراك وفهم إواليات الصورة، علينا أن ننظر إلى “البنية الإدراكية “، التي تنتظم داخلها مجمل الخطاطات المجردة، باعتبارها شيئا سابقا على الأيقوينة ومتحكما فيها. فالتعرف على هذه البنية يشكل “المفتاح السري” الذي يجب أن يقودنا إلى تحديد المفهوم الخاص للنموذج الإدراكي، أو ما يطلق عليه إيكو في أحيان كثيرة “سنن التعرف” ( الذي يشكل المعرفة الأولية التي تساعد الذات المدركة على فك رموز مجمل الصور البصرية وربطها بالتجربة الواقعية التي تشير إليها.
والأيقونية في نهاية الأمر > رهينة بمعرفة القواعد الخاصة باستعمال الموضوعات، فهذه القواعد هي التي تحول بعض هذه الموضوعات إلى علامات”.(7) فلا سبيل إلى الخلط بين الشيء ووضعه كعلامة، ” فالعلامة مختلفة، من الناحية المادية، عن الشيء الذي هي دليل عليه، ولو لم يكن الأمر كذلك لأمكن القول إني علامة لنفسي”. (8)
فنحن في واقع الأمر، لا ندرك أي شيء بشكل مباشر. فالإدراك والتذكر يقتضيان استحضار “خطاطة سابقة” ( “النموذج الإدراكي” أو “البنية الإدراكية” أو” سنن التعرف”) تثوي داخلها مجموع النسخ التي تلتقطها العين وتنتشي بها ضمن عالم يعج بالأشكال والصور والألوان.
وهذا له ما يبرره في إواليات الإدراك ذاتها، فعالم الأشياء لا يلج إلى الذاكرة على شكل ” أشياء ” معزولة لا رابط بينها، بل يتسلل إليها عبر النماذج المنظمة لهذه الأشياء في أقسام متباينة. فعلى الرغم من أن ما نراه هو شيء مخصوص فعلي وواقعي إلا أن ما يتسرب إلى الذهن هو فكرة عن الشيء وليس الشيء ذاته.
استنادا إلى هذا التصورالخاص بالإدراك، يمكن القول إن التسنين الذي يحكم عالم العلامات الأيقونية هو نفس التسنين الذي يحكم التجربة الإنسانية ككل : فكل محاولة لإدراك وتحديد كُنه ومضمون علامة أيقونية ما تقتضي إلماما بمعرفة سابقة مفتوحة على عوالم متعددة. ويعود هذا الأمر لسببين :
1- إن ما تدركه العين هو علامات لا موضوعات معزولة، والعالم تسكنه العلامات وليس خزانا للأشياء.
2- إن العلامة الأيقونية لا تدل من تلقاء ذاتها، فالمعنى داخلها يستدعي استحضار التجربة الثقافية كشرط أولي للإمساك بممكنات التدليل.
وبناء عليه، يمكن القول، دون تردد، إن هذه العلامات هي لغة مسننة، أودعها الاستعمال الإنساني قيما للدلالة والتمثيل، فهي في جوهرها خاضعة لمبدأ العرف والتواضع. ولقد كانت هذه القناعة هي السبيل الذي سيقود إلى الاستعاضة عن “الاعتباطة” ( وهو مفهوم محرج لعدم قدرتنا في جميع الحالات على الخلط مثلا بين فأر وفيل) بمبدأ “التسنين المسبق”.
ذلك أن القضية هنا لا تتعلق، في واقع الأمر، باعتباطية مطلقة يغيب فيها أي توقع للمدلول من خلال الدال الذي ينتجه ( كما هو الشأن في اللسان )، بل تتعلق برابط خاص قد لا يعود إلى التعرف ومقتضياته، ولكنه يعد المبدأ الذي يتحكم في سيرورة التدليل وكل توجهاتها المستقبلية. فالدلالات التي يمكن الكشف عنها داخل العلامات البصرية هي دلالات وليدة تسنين من طبيعة ثقافية.
استنادا إلى هذا، فإن قراءة الواقعة البصرية ( الصورة في حالتنا) وفهمها يستدعيان سننا سابقا يتم عبره التأويل والتدليل. وكما سيتضح ذلك من خلال تحديدنا للدال الأيقوني، فإن إنتاج دلالة ما عبر الصورة لا يعود إلى ما يثيره الدال داخلها من تشابه مع ما يحيل عليه، بل يعود الأمر إلى امتلاك سنن يتم فيه وعبره توليد كل الدلالات الممكنة.
من هنا، إذا كان من البديهي القول إن مجموع التمثيلات الصوتية لا تشتغل كدوال إلا في حدود إثارتها لمدلولات ( لمعان )، فإن التمثيلات البصرية، أي مجموع ما يشتغل كعلامات بصرية، هي الأخرى، لا يمكن أن تدرك إلا في حدود إحالتها على قسم من الأشياء أو “نوع” بتعبير جماعة مو، وهو نموذج مستبطن يمكن الذات المدركة من إدراج النسخة ضمن قسم بعينه كما سنري ذلك لاحقا .
ذلك أن المفصلة الصوتية المؤدية إلى إنتاج حروف تتآلف فيما بينها لتولد كلمات وجملا ومركبات، تعد نظيرا للمفصلة البصرية القاضية بتنظيم المدرك البصري ضمن وحدات بصرية دالة. فالذات المبصرة تجزئ المعطى البصري وتنظمه داخل أشكال لتجعل منه كيانات دالة.
وبعبارة أخرى، فإن الأشياء التي تُرى وتُدرك بالعين، أي كل ما يشتغل كعلامات أيقونية، لا ينظر إليها في حرفيتها، وإنما يتم التعامل معها باعتبارها عنصرا موجودا ضمن هذا القسم أوذاك. وهذا ما يجعل العلامات الأيقونية تشتغل هي الأخرى- رغم كونها محكومة، ظاهريا على الأقل، بمبدأ التشابه – وفق سنن أيقوني يحدد درجة هذا التشابه، ويَحُد من سلطة الإحالة المباشرة ويقيدها بمبدإ التسنين السابق، ويقوم، من ثم، بتحديد نمط إنتاج وإعادة إنتاج عناصر التجربة الواقعية استنادا إلى النموذج لا النسخة المتحققة.
وبناء عليه، فإن إدراك “الواقع “عبرالعلامة الأيقونية لا يتم انطلاقا مما تشتمل عليه هذه العلامة من عناصر قادرة على إحالتنا على “تجربة واقعية”، بل يتم عبر المعرفة السابقة التي تتوفر عليها الذات المدركة، فهي الشرط الضروري لتحديد هوية ما يتم إدراكه.
وعلى هذا الأساس يجب ألا تخيفنا المعطيات الظاهرة. فإذا كانت الصورة تشير إلى وجود تشابه بينها وبين ما تحيل عليه أو ما تمثله، فإن هذا التشابه لا علاقة له بإنتاج الدلالة ولا دور له في وجودها. إنه رابط من طبيعة خاصة، فهو يعود إلى فعل الإدراك الخاص بتحديد شيء ما يوجد خارج الذات المبصرة، ويعد شرطا ضروريا للإبصار، أي ما ينظر إليه كمعطى طبيعي.
فالتعرف على هذه الواقعة باعتبارها شيئا موجودا خارج الذات، عملية مختلفة عن عملية تأويلها وتحديد كامل دلالاتها داخل الصرح الثقافي الذي يحكم مجتمعا ما. صحيح أننا لا يمكن-استنادا إلى الطاقة الإدراكية التي توفرها التجربة المشتركة- أن نخلط، كما لاحظنا ذلك أعلاه، بين فأر وفيل، ولكننا نحتاج إلى معرفة سابقة لتحديد كل الإحالات التي تثيرها إيماءة عجلى أو نظرة متوسلة أو ابتسامة معلقة على شفاه عذراء.
إن المعرفة التي توفرها الخطاطات المجردة تمكننا، في الآن نفسه، من الإمساك ببنيتين : بنية إدراكية متولدة عما توفره العلامة الأيقونية كتمثيل ذهني عام، وبنية واقعية هي منطلق التمثيل ومادته ( إيكو). ومفاد هذا القول إننا لا ننتقل آليا، ودون وسائط، من الدال الأيقوني إلى ما يوجد خارجه، فنحن دائما في حاجة إلى وسيط يجعل الرابط بين الطرفين قادرا على توليد دلالة، أي قادرا على الانضواء ضمن نسق يمنح الصورة القدرة على إنتاج دلالاتها. فإدراك النسخة ممكن في حدود وجود خطاطة تمكننا من تحديد هوية النسخة.
ويختصر إيكو هذا الرابط فيما يسميه ” السنن الأيقوني” *( ما يتطابق مع الخطاطة المجردة المشار إليها سابقا). فلا يمكن الحديث عن إدراك، ضمن عالم العلامات الأيقونية أو غيرها، إلا استنادا إلى معرفة سابقة تمكننا من تأويل هذا العنصر أو ذاك وفق انتمائه إلى هذه الدائرة الثقافية أوتلك.
فمهمة السنن الأيقوني السابق على الإدراك المخصوص تتلخص في ” إقامة علاقة دلالية بين علامة طباعية وبين مدلول إدراكي مسنن بشكل سابق : أي إقامة علاقة بين العناصر المميزة داخل السنن الطباعي وبين تلك المميزة داخل سنن معنمي * ، يعد هو ذاته حصيلة لعملية تسنين سابقة على التجربة المدركة “(9)
وعلى أساس وجود هذه الروابط المخصوصة بين التمثيل الأيقوني وبين بنية التعرف، يمكن القول “إن العلامة الأيقونية لا تملك نفس خصائص الموضوع الممثل ولكنها تعيد إنتاج بعض شروط الإدراك المشترك على أساس وجود أسنن إدراكية عادية. ولايتم هذا الانتقاء إلا عبر تحيين بعض الدوافع التي تسمح، من خلال إقصائها لدوافع أخرى، بتحديد بنية إدراكية. إن هذه البنية الإدراكية تمتلك، انطلاقا من التجرية المحصل عليها، نفس دلالة التجربة الواقعية التي تشير إليها العلامة الايقونية “.(10)
ولشرح طبيعة الترابط بين البنيتين يمكن أن نقدم مثالا يوضح ذلك. ويتعلق الأمر برسم هو عبارة عن مجموعة من الخطوط التي تشكل في تآلفها ما يشبه الهيكل العالم الخاص بالفصيلة البشرية :
فالمؤكد أن هذا الرسم لا يشبه في شيء كائنا بشريا كما تقدمه التجربة الفعلية. ورغم ذلك لا أحد يتردد في القول، وهو يشاهد الرسم، إن الأمر يتعلق بـ” إنسان”. فما السر في ذلك ؟ إن الأمر يعود إلى إواليات الإدراك ذاته، فما يدركه المشاهد ليس جسما فعليا، بل مجموعة من الخطوط التي تشكل، في تآلفها، خطاطة عامة سابقة تختصر داخلها المكونات الأساس للكائن البشري.
ولهذا السبب أيضا فإن المشاهد لن ينسب الرسم إلى رجل ولا إلى امرأة ولا إلى شيخ طاعن في السن أو فتاة في مقتبل العمر، ولن يستخرج منه الخصائص الخارجية كالطول أو القصر ولون الشعر والعيون، فتلك عناصر لا علاقة لها بالبنية الإدراكية، ولا تعد عناصر ملائمة من أجل التعرف على الكائن البشري ولن تستوعبها الخطاطة كمثيرات أولية في عملية الإدراك ( على الأقل في سياقنا هذا ).
إنه يكتفي بالتنسيق بين مجموعة من الخطوط لكي يؤكد أن الأمر يتعلق بكائن بشري وليس بشجرة أو طائرة تحلق في الفضاء. وهذا ما يوضحه المنطق الداخلي للرسم البياني ذاته.” فالتناظر داخل هذا الرسم بين الدال ومرجعه ليس نوعيا بل علائقيا، فما يعيد الرسم البياني إنتاجه هي علاقات الموضوع الداخلية لا خصائصه الخارجية “. (11) فالعين، استنادا إلى هذا، تبحث عن علاقات لا خصائص مفردة.
إن الشكل الإنساني المحصل عليه من خلال عملية الاستذكار مرتبط بفعل تمثلي يستمد قواه من قدرته على التجريد التبسيطي لا على استحضار النسخة الفعلية، وهو ما يميز فعل الإدراك عن فعل التمثل كما يتصور ذلك إيزر(12)
استنادا إلى هذا، فإن > هذه البنية ليست فقط تبسيطا، أي إفقارا للواقع. إن هذا التبسيط وليد جهة النظر التي يتم تبنيها. إنني أختصر الجسم الإنساني في بنية هيكله، لأنني أروم دراسة الجسم الإنساني من زاوية نظر هذه البنية، أو من زاوية النظرالتي تجعل منه ” حيوانا واقفا ” أو ذا قائمتين يمتلك رجلين إحداهما فوقية والأخرى سفلية(…). وعلى هذا الأساس فإن البنية هي نموذج تمت بلورته استنادا إلى قواعد تبسيطية تسمح لنا باستيعاب مجموعة من الظواهر من جهة نظر معينة.” (13)
ووفق نفس الشروط يمكن مقارنة الفعل البصري بالفعل اللغوي. ذلك أن نفس السيرورة التي تقود إلى بلورة المدلولات التي تحول الأشياء إلى أقسام مدركة من خلال ما هو مشترك بينها، هي ذاتها التي تكمن وراء صياغة الخطاطات التي نستحضرها من أجل إدراك الأشياء وتصنيفها ضمن هذا القسم أو ذاك.
وخلاصة القول إن الأمر يتعلق بعملية تبسيطية تقودنا، من خلال تكرار التجربة وتداولها، إلى الاحتفاظ فقط بما هو ملائم في التجربة، واستبعاد كل العناصرالتي تحيل على خصوصية التجربة أو على سياق مخصوص. وهذا أمر تثبته سيرورات الإدراك العادية ذاتها، فما> يجعل بعض التجليات البصرية المختلفة عن بعضها البعض تبدو كنسخ متعددة لنفس الشيء يعود إلى كوننا لا نعتمد في التحديد إلا على بعض السمات. فمرجع صورة القط ليس ” القط الخاص” الذي التقطت له الصورة، بل هو فئة القطط مجتمعة الذي لا يشكل هذا القط المخصوص داخلها سوى عنصر معزول.
إن المتفرج يقوم بشكل سابق بانتقاء العناصر المميزة للتعرف : الحجم والشعر وشكل الآذان، وبطبيعة الحال لن يأخذ في الحسبان لون الشعر. إن الصورة ( السينمائية أوالفوتوغرافية ) لا يمكن قراءتها إلا من خلال التعرف على أشياء، والتعرف معناه خلق أقسام، بحيث إن القط، الذي لا يبدو في الصورة بشكل جلي، سيتم تسريبه من خلال نظرة المتفرج “.(14)
ونظرة المتفرج في هذه الحالة حاسمة. فما تدركه العين ليس مادة ولا جوهرا ولا واقعة معزولة. إن ما يتسرب إلى الذهن هو صورة مجردة تحقق الواقعة المخصوصة. ويمكن القول في هذا الإطار إن الأمر يتعلق بتسنين يطال التجربة الأيقونية في أفق خلق سنن أيقوني، يقوم بربط علاقة دلالية بين بعض العناصر التي تنتمي إلى تجربة بصرية وبين تجربة لسانية، أي مدلولات، تترجم ما يعطى عن طريق الأيقون إلى مضمون لساني. (15)
وفي هذه الحالة فإن “التشابه”، سواء كان مجسدا في حالاته القصوى ( الصورة الفوتوغرافية) أو في أشكاله الدنيا ( الاستعارات والرسموم البيانية وكذا كل الصور الذهنية )، لا يعود إلى الواقعة الفعلية في علاقتها بأداة التمثيل، بل إنه مرتبط بالسبيل المؤدي إلى إنتاج دلالات تعد في نهاية المطاف تأكيدا للحضور الإنساني في الكون ممثلا في إيداع الإنسان جزءا من نفسه داخل الوقائع.
فأن تدل “الوضعة ” * على هذا الموقف أو ذاك، أو تدل النظرة على هذه القيمة أو تلك، أو يدل الشكل على هذا المعنى أو ذاك، فتلك قضايا لا علاقة لها بالشيء في ذاته، بل يجب البحث عنها في التسنين الثقافي الذي يجعل هذا الشيء حاملا لقيم دلالية تتجاوزه. إن هذه الدلالات ليست طبيعية ولا يمكن أن تكون كذلك، إنها عرفية لأنها وليدة التواضع والتسنين الثقافيين الخاصين بالتجربة الإنسانية.
تأسيسا على هذا يمكن القول، إن الانتقال من الدال الأيقوني إلى ما يحيل عليه يتم انطلاقا من عملية تسنينية قائمة على خلق بنية مكونة من عناصر هي حصيلة لقاء بين تجربتين مختلفتين : تجربة واقعية تم اختصارها في عناصرها الأولية المميزة، وعلامة أيقونية تعيد بناء هذه العناصر وفق قوانينها الطباعية الخاصة. وبعبارة أخرى، هناك معادلة بين ما هو مميز داخل التجربة الواقعية ( الشكل الأدنى في وجود الواقعة) وبين ما هو مميز داخل العلامة الأيقونية، وذلك استنادا إلى سنن للتعرف على حد تعبير إيكو.
“فمضامين مجموعة من الوحدات الثقافية تتوزع على عناصر من طبيعة بصرية وأخرى من طبيعة أنطولوجية، وثالثة من طبيعة عرفية. الأولى مرتبطة عادة بالتجربة الإدراكية السابقة، أما الثانية فتتعلق بالخصائص التي هي في الواقع من طبيعة إدراكية أسندتها الثقافة إلى الموضوع، أما العناصر الثالثة فهي عرفية بشكل خالص وتعود إلى الأعراف الإينوغرافية “. (16)
ولم تتردد ” جماعة مو ” في الحديث عن ” برمجة” مسبقة مودعة في الأجهزة الخاصة بالتعرف على الصور، وهي برمجة بيولوجية ومن طبيعة كونية، فالإدراك عند هذه الجماعة من الباحثين > لا يمكن أن يصبح فعالا إلا عندما نستحضر النشاط التذكري، حينها نمر من النسخة إلى السلسلة، ومن الحدث إلى النوع، وهذا الانتقال هو الذي يسمح لنا بالحديث عن مقولة “الموضوع”، وفي هذه الحالة فإننا ننتقل نهائيا إلى الميدان الثقافي، أى إلى ميدان النسبية “. (17)
انطلاقا من هذا التصور العام للإدراك الأيقوني، تقدم لنا هذه الجماعة، في مجال بناء العلامة الأيقونية* ونمط اشتغالها، تصورا أصيلا يضع حدا لأي تشابه في الاشتغال بينها وبين بناء العلامة اللسانية. وهو تصور يستند، ضمنيا، إلى مقترحات بورس في مجال التوزيع الثلاثي للعلامة ( حتى وإن كان أعضاء الجماعة لايصرحون بذلك ). فالعلامة الأيقونية تتكون من ثلاثة عناصر مرتبطة فيما بينها وفق علاقات مخصوصة : الدال الأيقوني والنوع والمرجع.
1- الدال الأيقوني ” هو مجموع منمذج من المثيرات البصرية المتطابقة مع نوع قار يتم التعرف عليه استنادا إلى السمات التي يوفرها هذا الدال”. فالصورة تشتغل، من خلال تحققها ضمن كيان مخصوص، كدال يمثل لموضوعات تدرك عبر النوع.
2- أما النوع فهو ” نموذج مستبطن وقار، ويعد أساس السيرورة المعرفية عندما تتم مواجهته بمادة الإدراك. ويعتبر النوع، في المجال الأيقوني، تمثيلا ذهنيا يتشكل من خلال سيرورة إدماجية “. ويمكن القول إن النوع هو صيغة مخصوصة للتعريف الذي يخص به بورس المؤول، العنصرالثالث داخل البناء الثلاثي للعلامة، فكيفما كانت طبيعة العلاقة بين الدال وموضوعه فإن علاقتهما لا يمكن أن تتجاوز حدود اللحظة ومحكومة بشروطها. لذا، يعتبر النوع الضمانة الأساس على وجود العلامة استقبالا وعلى إمكانات التعرف عليها وتأويلها باعتبارها سندا لدلالات.
3- أما المرجع فهو القسم الذي يحيل عليه الدال ( وليس الشيء الذي يوجد خارج السميوز)، ولا يتعلق الأمر بالقسم في صورته الكلية بل يتعلق بقسم محين. وبعبارة أخرى، فإن المرجع هو موضوع يعد جزءا داخل قسم، لا مجموعا غير منظم من المثيرات .(18) فالمادة الغفل غير المشكلنة لا يمكن أن تكون مادة للتمثيل لأنها توجد خارج حدود الممارسة الإنسانية وإكراهاتها. فعلى الرغم من أن الصورة هي كيان يخصص ولا يعمم، ويظهر النسخة لا النموذج، فإن التعرف على مكوناتها لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى ما يوفره النوع من خطاطات. ولهذا السبب فإن الموضوع ليس شيئا بل تحيين لنوع.
إن هذا البناء الثلاثي يستعيد بشكل ضمني، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، التصور البورسي للعلامة، فهو يجعل العناصرالثلاثة المكونة للعلامة كيانات سميائية مرتبطة فيما بينها استنادا إلى سيرورة إدراكية تلتقط المعطى الحسي وتدرجه ضمن عجلة التسنين الثقافي الذي يعد المسؤول عن إنتاج مجمل الدلالات التي يستند إليها الإنسان في أحكامه.
وتؤكد في ذات الوقت ما ذهبنا إليه في الفقرات السابقة من أن العلامات الأيقونية ( الصورة بصفة خاصة ) لا يمكن أن تنفلت من ربقة التسنين المسبق في التعرف وفي إنتاج الدلالات. فلا وجود لكيان بصري مكتف بذاته وحامل لدلالته خارج أي سياق، إنه لن يكون كذلك إلا في حدود دخوله ضمن عالم التسنين الثقافي المسبق.
وهذا أمر يصدق على مجمل اللغات الإنسانية : فكل شيء يمكن أن يشتغل كعلامة شريطة استخلاص دلالة تعود إلى ثقافة المتلقي وتعود إلى السياق الذي استعملت فيه هذه العلامة أوتلك. إن تحول الموضوعات الخارجية إلى علامات هو الذي سيقودنا الآن إلى تناول سيرورة إنتاج الدلالة عبر الصورة.
- II – الصورة وإنتاج المعنى
حاولنا في الصفحات السابقة أن نحدد إواليات إدراك الصورة ( العلامة الأيقونية بصفة عامة )، ورأينا كيف أن الإدراك لا يتم دفعة واحدة دون وسائط، فالصورة لا تحضر في الذهن باعتبار وجودها المخصوص، بل تأتي إلى العين من خلال خطاطة مجردة يُطلق عليها ” البنية الإدراكية” أو “سنن التعرف” أو ” النموذج الإدراكي”. فالفعل الإدراكي يبحث في المعطيات الموصوفة عما يتطابق مع الخطاطات المجردة التي تمد بها الثقافة متلقي الصورة، وحين يتم هذا التطابق تبدأ عملية التعرف والتسمية والتصنيف.
إلا أن الأمر لا يتجاوز في هذه المرحلة حدود تبين ما هو موجود خارج الذات، وتصنيفه ضمن هذا القسم من الأشياء أو ذاك. فللتعرف إوالياته الخاصة، ولسيرورة إنتاج الدلالات إواليات أخرى. إلا أن العمليتين معا تشتركان في خاصية واحدة : حاجتهما إلى تسنين مسبق.
فالصورة لا تدل من خلال طاقتها المعنوية الذاتية المفصولة عن أي سياق ثقافي ( وهي طاقة غير موجودة أصلا )، بل تدل من خلال مجمل الأحكام التقييمية التي تنسجها الثقافة في مرحلة ما و” الحكم ربط فكرة بأخرى وإقامة علاقة بينه” كما يقول ابن سينا.
فـ “الوجه” دال على وجود إنساني، وذاك مبدأ للتعرف وكفى، إلا أن هذا الوجه ذاته يدل، في سياقات متعددة، على قيم دلالية بالغة التنوع. إنه يتحول إلى لغة تستمد دلالاتها من سياقاتها المتنوعة ( من مجمل استعمالاتها ). ولهذه اللغة موادها وأشكالها وطرقها في التحقق.
وهكذا، عوض أن نبحث في الوجه أو في الإيماءة عن دلالات كونية لا تحكمها السياقات ولا الثقافات الخاصة، علينا أن نبحث عن موقع الوجه والإيماءة داخل الممارسة الإنسانية وداخل الثقافة التي تسندها. فما نقرؤه في الصورة ليس عضوا ولا حركة ولا شكلا، بل يتعلق الأمر بقيم دلالية تسربت عبر الزمن إلى الوجه والإيماءة ومجموع مكونات الجسم الإنساني،
فنحن نبحث عن الانفعالات الإنسانية في الوجه والإيماءات وأشكال الجلوس أو الوقوف. وهكذا فـ “اليأس” و”الأمل” و”التشاؤم” و”الشجاعة” و”النبل” مفاهيم مجردة تغادر مواقعها لكي تسكن الأشياء والأشكال والألوان وكل مكونات السلوك الإيمائي الإنساني.
وعليه، يمكن القول إن “اللغة البصرية” التي يتم عبرها توليد مجمل الدلالات داخل الصورة هي لغة بالغة التركيب والتنوع وتستند من أجل بناء نصوصها إلى مكونين :
1- ما يعود إلى العلامة الأيقونية *
2- ما يعود إلى العلامة التشكيلية *
فالصورة تستند، من أجل إنتاج معانيها، إلى المعطيات التي يوفرها التمثيل الأيقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة ( وجوه، أجسام، حيوانات، أشياء من الطبيعة ….)، وتستند من جهة ثانية إلى معطيات من طبيعة أخرى، أي إلى عناصر ليست لا من الطبيعة ولا من الكائنات التي تؤثث هذه الطبيعة. ويتعلق الأمر بما يُطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية، أي العلامة التشكيلية : الأشكال والخطوط والألوان والتركيب ( ما يعود إلى الطريقة التي يتم من خلالها إعداد المساحة المؤهلة لاستقبال الانفعالات الإنسانية مجسدة في الأشكال والأشياء والكائنات “.
إن المضمون أوالمضامين الدلالية للصورة هي نتاج تركيب يجمع بين ما ينتمي إلى البعد الأيقوني ( التمثيل البصري الذي يشير إلى المحاكاة الخاصة بكائنات أو أشياء… ) وبين ما ينتمي إلى البعد التشكيلي مجسدا في أشكال من صنع الإنسان وتصرفه في العناصر الطبيعية وما راكمه من تجارب أودعها أثاثه وثيابه ومعماره وألوانه وأشكاله وخطوطه.
وتعد الصورة، من هذه الزاوية، ملفوظا بصريا مركبا ينتج دلالاته استنادا إلى التفاعل القائم بين مستويين مختلفين في الطبيعة، لكنهما متكاملان في الوجود : فكما أن العلامة الأيقونية تشير إلى تركيب لمجموعة من العناصر المؤدية إلى إنتاج دلالة ما، فإن العلامة التشكيلية لا تشتغل باعتبارها كذلك إلا في حدود تأويلها ككيان حامل لدلالات.
ويمكن، على المستوى الأول، الحديث عن مجموعة من المعطيات الخاصة بالإنسان، ما يعود إلى جسده وجلوسه ووقوفه واستدارته وإيماءاته ونظرته ومجمل أوضاعه، فهذه المعطيات الأولية هي التي نستند إليها، في قراءتنا، من أجل الكشف عن المعنى ( المعاني ) وطرق تسربه إلى الصورة. فما نشاهده وما نتأمله ليس وجها ولا يدا ولا وضعة، ولكننا نستحضر السياقات التي يستعمل فيها هذا العضو أو هذه النظرة.
وبعبارة أخرى، فإن الثقافة تحدد لكل عضو سلسلة من السياقات التي تحيل على دلالات مختلفة، بل قد تكون في أحيان كثيرة متناقضة. فقد تكتسي إشارة اليد الدالة على طلب الحضور دلالات متعددة استنادا فقط إلى الإيقاع الخاص بإنجازها، فهي قد تشير إلى السرعة، وقد تشير إلى التمهل، وقد تشير إلى الزجر وقد تشير إلى التواطؤ، ناهيك عن المقام التلفظي الذي يبيح لشخص ما أن يطلب الحضور من شخص آخر عبر إيماءة اليد ولا يجيزها لآخر : علاقة الكبير بالصغير، علاقة الرئيس بالمرؤوس، علاقة المتحكم بالمحكوم، السيد بالعبد. وهي مقامات، كما هو واضح من هذه السياقات، بالغة التنوع، فاليد معرضة، مع أدنى تغيير في السياق، لأن تكون مرتعا للاستعمالات الاستعارية، والأمر كذلك مع مجمل العناصر المكونة للصورة.
صحيح أن هناك مجموعة من السلوكات الجسدية التي يمكن النظر إليها باعتبارها سلوكات كونية، فجزء كبير ” من إيماءات الاتصال الأساسية هي عينها في مختلف أنحاء المعمور: عندما يكون الناس مسرورين فإنهم يبتسمون، وعندما يكونون حزانى فإنهم يقطبون. فهز الرأس ( أو الإيماءة بالرأس) علامة عالمية تقريبا دالة على الموافقة أو الإشارة إلى “نعم”، إنها تبدو شكلا من خفض الرأس، ولعلها إيماءة طبيعية، كما هي مستخدمة عند الصم البكم”. (19)
إلا أن هذه الحركات ذاتها لا تشكل، من جهة، سوى جزءٍ صغير داخل سجل التواصل الشفهي (= الجسدي)، وهي، من جهة، ثانية مرتبطة في الغالب الأعم بالبعد النفعي داخل السلوك الإنساني، والنفعي يصنف عادة ضمن المشترك بين الكائنات القاطنة للكوكب الأرضي.
فهو، في كل تمظهراته، مرتبط بالجانب الغريزي في الإنسان. ومن جهة ثالثة، فإن هذه الحركات، على الرغم من كونيتها، ليست طبيعية ولا فطرية كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، بل هي ثقافية تعلمها الإنسان كما تعلم أشياء أخرى من نفس الطبيعة كالغمز للدلالة على السكوت أو التواطؤ، وإسبال العيون للإغراء، والحدج للوعيد، وهي إيماءات لا نتردد في القول إنها كونية أيضا، وتعبر عن حالات وجدانية إنسانية مسكوكة، لكن كونيتها لا تلغي طابعها الثقافي.
وليس غريبا أن يكون للمناخ والجغرافية دور كبير في تحديد حجم الإيماءات وطاقاتها التعبيرية ( ما يقال عن سكان ضفتي المتوسط وميلهم إلى المزج بين الملفوظ اللساني والملفوظ الإيمائي ). ولهذا الأمر أهمية خاصة، فقد أكدت مجموعة من الأبحاث وجود روابط وثيقة بين اللسان وبين الملفوظ الإيمائي المرافق له، فنادرا ما نستطيع الفصل بين الإيماءات الصادرة عن ذات اجتماعية ما وبين طبيعة اللسان الذي تستعمله.
وهذا يعني أن الاستعمال الاجتماعي للسان مرتبط أشد الارتباط بالاستعمال الاجتماعي للجسد. فاللسان الأصلي المتجذر في وجدان الفرد له أيضا جسد أصلي يقابله. (20) وهذا أمر طبيعي أيضا، فالانتماءات المختلفة لا تتجلى فقط من خلال الاختلافات اللسانية فـ” الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين لا يتكلمون لغتين مختلفتين فحسب، بل يسكنون عوالم حسية مختلفة “. (21)
فإذا وقفنا عند حالة من حالات النصوص الصورية التي تقوم بالتمثيل للحضور الإنساني ( من خلال نسخها المتعددة : الصورة الفوتوغرافية، الصورة الإشهارية، الرسم بشقيه الكاريكاتوري والعادي …)، لاحظنا أن مجمل الدلالات في هذه الأشكال التعبيرية تتحدد، أيقونيا، من خلال الشكل الذي يتخذه الجسد الإنساني داخل هذه الصورة.
فالأعضاء الجسدية كيانات قابلة للعزل انطلاقا من ارتباطها بدلالات سابقة. فالعضو، كما هو معروف، يندرج ضمن نشاطين : نشاط عملي من طبيعة نفعية، وهو نشاط يوجد خارج أي تسنين لأنه لا يستجيب سوى للحاجات الأولية التي يتطلبها الوجود الإنساني ذاته. وهناك نشاط آخر من طبيعة ثقافية، وينظر إليه دائما باعتباره حصيلة تسنينات ثقافية مخصوصة. إن الفصل بين البعدين شرط أساس من أجل تحديد الدلالات الإيحائية غير المرئية من خلال التجلي المباشر.
فلا أهمية للعضو في بعده النفعي ولا قيمة دلالية له، فالصورة ليست هنا للبرهنة على وجود إنسان مفرد، بل تشتغل كنص في حدود بنائها لدلالات تتجاوز التمثيل الأول. وفي هذه الحالة، تدخل كل العناصر المكونة للجسد الإنساني في تباري لا نظير له من أجل تسليم نفسها لمتاهات دلالية مفترضة من خلال السياقات التي تبنيها كل ذات مبصرة على حدة ( دلالات الوجه، واليدين، وحالات العين وطبائع النظرة والوضعة (.
وهذا ما يتجلى بوضوح أكبر في الشكل الآخر لإنتاج الدلالات، ويتعلق الأمر بقدرة الوضعة على الإحالة على معاني بعينها من خلال شكل تحققها. فللوضعة علاقة مباشرة بالعين والوجه والموقف من المشاهد. وهذا معناه أن الوضعة لا تكتسب دلالاتها إلا من خلال وجود ذات مبصرة. ذلك أن علاقة المتفرج بالصورة محكومة بقدرته على تحديد موقع النظرة داخل الصورة واتجاهها. استنادا إلى هذا تصنف الوضعة عادة في أشكال ثلاثة، ولكل وضعة دلالات مسكوكة متعارف عليها : وضعة أمامية، وضعة جانبية، ووضعة خلفية.
ففي الحالة الأولى قد تدعو النظرة إلى المشاركة أوالتوسل أو الاستغاثة، كما قد تثير عند المتفرج شعورا بالتحدي والمجابهة. وفي هذه الوضعة توضع ” أنا” الصورة أمام “أنت” المشاهد ضمن خطاب سجالي يحيل على عالمين مختلفين، من حيث القيم والمصير، أو على العكس مدعوين إلى التطابق، كما هو الشأن في كل الحالات التي تقدمها الصورة الإشهارية. فوظيفة الوضعة الأمامية هي إشراك للمتفرج في الوضعية التي يتم تمثيلها، فهي دعوة صريحة إلى تبني القيم التي يمثلها المنتوج المعروض للتداول.
وقد تكون هذه النظرة تجاهلا مطلقا للمتفرج كما هو الشأن مع الوضعة الجانبية. فالنظرة في هذه الوضعة توجد خارج مدار المتفرج، فهي تنساب ضمن فضاء آخر غير فضاء المتفرج. إن المتفرج في هذه الحالة يوجد أمام مشهد مقطعي من طبيعة سردية. إن الصورة تضع “أنا” المتفرج في مواجهة ” هو ” الصورة الذي لا يلتفت إلى الرائي ولا ينتبه إليه. وتذكرنا هذه الوضعة بما يسمى في الإشهار بالتأطير المقطعي، حيث لا تتوقف العين الرائية عند نقطة بعينها بل تمسح فضاء الصورة ضمن حركة انسيابية تبحث عن هدفها خارج إرغامات النظرة الآسرة.
أما الوضعة الخلفية، وهي نادرة، فتحيلنا على دلالات من طبيعة خاصة. ورغم ندرتها، فقد ارتبطت دائما بنهاية مسار، أو نهاية قصة، أو نهاية فعل. كما قد تدل في سياقات أخرى، على التخلي والابتعاد عن المواجهة، أو هي من زاوية ثالثة تشير إلى حرقة الوحدة والمواجهة الفردية للمصير.
لنتذكر أفلام شارلي شابلان، عندما يبتعد ذلك الرجل النحيف موليا ظهره للجمهور، معلنا عن نهاية رحلة عذاب، وربما بداية أخرى. ولنتذكر الصورة الشهيرة لجون كنيدي وهو يتأمل البحر من فوق كثبان الرمال موليا الكاميرا ظهره، ولقد علقت مجلة باري ماتش التي نشرت الصورة بعد وفاته قائلة ” كأنه كان مدعوا إلى عالم آخر “. ومن هذه الزاوية فإن هذه الوضعة – كما هوالشأن مع الوضعة الجانبية – تشير إلى الإمكانات السردية التي تتضمنها الصورة . (22)
وفي كل هذه المواقف البصرية تظل النظرة، باعتبارها خروجا من الفيزيقي البيولوجي ومعانقة للإنساني الثقافي، هي الأساس في تشكل المعاني، ” فهي التي تؤسس وتنظم ما هو موضوع للرؤية، إن الأمر يتعلق بمنظور يحدد الحقل البصري ويبسطه أمامنا، إنه الموقع الذي ننطلق منه لتحديد ما يقع تحت طائلة الأعين”. (23)
وفي ختام هذه الفقرة يمكن القول إن كل التأويلات الممكنة للصورة يجب أن تستند إلى هذه المعرفة الخاصة بالحضور الإنساني داخل الكون من خلال مجمل لغاته، وعلى رأسها لغة جسده. ففهم الصورة وقراءتها مرتبطان بقدرة المتلقي على القيام بالتنسيق بين مجمل العناصر المشكلة لنص الصورة، وهو تنسيق لا يستند إلي ما تعطيه الصورة، بل يستند إلى معاني هذه العناصر خارج الصورة وضمن سياقات الفعل الإنساني المتنوعة.
وبعبارة أخرى، فإن تأويل الصورة، مثل كل تأويل، يحتاج إلى بناء السياقات المفترضة من خلال ما يعطى بشكل مباشر، ولا يمكن لهذا التأويل أن يتم دون استعادة المعاني الأولية للعناصر المكونة للصورة، وضبط العلاقات التي تنسج بينها ضمن نص الصورة.
وفي جميع الحالات فإن الأمر يتعلق باستحضار التمثلات الثقافية الكبرى التي لها علاقة بـ “الأنا” و”الآخر”، ولها علاقة بإكراهات “الزمان” و”الفضاء”، ولها أيضا علاقة بمجمل الروابط الإنسانية وما تفرزه من قيم وأحكام وتصورات يتم إيداعها داخل عضو أو داخل نظرة أو وضعة أو موضوع من الموضوعات المؤثثة للمحيط الإنساني، لتصبح هذه العناصر دالة خارج إطارها النفعي.
ومع ذلك لا يمكن القول إن العلاقات التي تنسجها العلامة الأيقونية بين عناصرها كافية للحديث عن كل دلالي. فالصورة ليست محاكاة لعالم غفل، وليست تمثيلا خالصا للموضوعات، إنها تستعيد مجمل معطياتها الأيقونية ضمن أشكال ومواقع وألوان.
ولهذا نحتاج، من أجل بناء مجمل دلالات الصورة، إلى مساءلة جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب الأيقوني، ونقصد بذلك ما تقدمه العلامة التشكيلية باعتبارها عنصرا يشتغل كأهم مكون داخل عالم الإبلاغ البصري. لذلك فإن للألوان والأشكال والخطوط والتأطير والتركيب أهمية كبيرة في بناء معاني الصورة.
فهذه العناصر هي وحدات داخل لغة بصرية لها قواعدها التركيبية والدلالية وليست مجرد متغيرات أسلوبية، كما كان يُنظر إلى ذلك في مرحلة سابقة في تاريخ التحليل السميائي.
وبناء عليه، يمكن الحديث عن نسق من العلامات يتكون من وحدات “تسند” المضمون الأيقوني للصورة وتحدد طرق تلقيه وتداوله وتأويله. ولا يختلف هذا المكون من حيث أبعاده التدليلية عن المكون الأيقوني، فالقاعدة التي تحكم البعد الأيقوني هي نفسها ما يتحكم في البعد التشكيلي.
فالعلامة التشكيلية تتكون بدورها من وحدات متفاعلة فيما بينها، وقادرة على نسج علاقات متنوعة وفق قوانين تعود إلى التسنين الثقافي أيضا. فالأشكال والخطوط والألوان وطرق إعداد المساحات الفضائية تشير هي الأخرى إلى سلسلة من الدلالات المكتسبة الناتجة عن الاستعمال الإنساني ولا تدل من تلقاء نفسها.
فهذه العناصر لا تدل من خلال مادتها ولا من خلال حدود أشكالها، ولكنها تدل من خلال موقعها داخل الفعل الإنساني، أي تفعل ذلك اعتمادا على مجمل القيم التي أودعها الإنسان داخلها. ولهذا فإن القيم التي تشير إليها الوحدات التشكيلية قيم بالغة التحول والتبدل. فهي لصيقة بالنماذج الثقافية المحلية، ومرتبطة في أحيان كثيرة بالتقطيع المفهومي الخاص بكل لسان.
وهي من جهة ثانية خاضعة لقوانين تركيبية تحدد لها نمط ارتباطها فيما بينها في الحضور وفي الغياب، فـ ” التحقق الفعلي لحدودها البنيوية يتم داخل الإرسالية ” (24) لا خارجها، فلا اللون في ذاته ولا الشكل في ذاته قادران على إنتاج دلالة في انفصال عن بعضهما البعض، فالعلاقة بينهما هي مصدر دلالاتها.
ولقد اقترحت ” جماعة مو” مجموعة من الصيغ النظرية الهادفة إلى تحديد كنه هذه اللغة التشكيلية. وهي صيغ تبدو أنها من الأصالة والجدة ما يجعلها قادرة على إمدادنا بمجموعة من الإجراءات التحليلية التي ستمكننا من فهم إواليات البعد التشكيلي داخل الصورة ( وداخل اللوحة أيضا (.
فالبحث عن المضامين الدلالية للعناصر التشكيلية، في تصور هذه الجماعة، يقتضي تحديد الوحدات الصغرى الدالة التي نستند إليها في تحديد مضمون أالألوان والأشكال والخطوط. فكل عنصر من هذه العناصر يتكون من وحدات أولية صغري(25).
إن الإمساك بجوهر هذه الوحدات الصغرى ونمط اشتغالها هو الذي سيمكننا من التعرف على التحققات الممكنة لهذه العناصر داخل نص الصورة. وعلى الرغم من تعدد النسخ التي تعبر عنها هذه اللغة، فإن > الوحدات الشكلية الصغرى محدودة العدد لأنها بنيات سميائية، لذلك فهي لا توجد معزولة عن بعضها البعض، إنها أشكال ( بالمفهوم الهالسليفي للكلمة ) *، وتشكل البنيات السميائية، من جهتها، إسقاطا لبنياتنا الإدراكية”. (26)
وهذا ما كانت ترفضه النظرية البسيكولوجية التي اعتقدت أن الإدراك هو أساسا تفكيك للمركب، وأن إدراك الشكل يتم من خلال إدراك أجزائه. ” ذلك أن الإدراك هو أساسا جملة من الأحاسيس المتميزة والمتفردة، وتعد هذه الأحاسيس عناصر أولية في الإمساك بالأشكال. ذلك أن إدراك شكل ما هو في الأساس سيرورة للتعرف ناتجة عن تربية خاصة بالعين وبالذهن. فقد اعتادت العين كما اعتاد الذهن على بناء الأشكال انطلاقا من العناصر المكونة لها”. (27)
والحال أن الأشكال لها وجود في ذاتها في انفصال عن أجزائها. وهو التصور الذي جاءت به نظرية الأشكال، ف” فالكل هو حقيقة واقعية بنفس درجة واقعية الأجزاء، والأشكال هي بنيات يجب اعتبارها معطيات أولية دون اللجوء إلى البحث عن جذورها انطلاقا من أجزاء مزعومة “. (28)
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الشكل كيان مستقل قابل لأن يرتبط بمجموعة من المضامين، ويتحدد من خلال عناصر تدركها الذات المبصرة وتتفاعل معها. فالشكل يأتي إلى الصورة باعتباره موقعا واتجاها وحجما. وكل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة مرتبط بسلسلة من الوحدات الشكلية الصغرى التي تحيل على مضامين بعينها.
فموقع الشكل واتجاهه وحجمه عناصر أساسية في فهم البناء التشكيلي للصورة، وهي أيضا أساسية في تحديد المحاور الدلالية المرتبطة بها. فكل محور له علاقة بعنصر من العناصر السابقة، فهناك الإقصاء وهو محور دلالي مرتبط بالموقع، وهناك محورالتوازن ويعود إلى الاتجاه، وهناك الهيمنة وهي محور خاص بالحجم.
وتشير هذه المحاور إلى نمط حضور الأشياء داخل المساحة التي تمثل لها الصورة، وكذا بالعلاقات التي تنسجها هذه الأشياء فيما بينها. فقد تكون هذه العلاقة إقصائية ( وجود الشيء في المركز أو في المحيط) )، “فبما أن الشكل لا موقع له إلا في علاقته بالعمق، فإن التوتر بين هذين المدركين ( الشكل وحدود العمق ) هو ما نسميه بالإقصاء : إن حدود العمق تجنح إلى إقصاء كل شكل يقع ضمن دائرتها. ولهذا المحور تنظيم داخلي فهو إما مركزي وإما محيط، “. (29)
كما قد تكون مرتبطة بالتوازن، وهذا المحور هو “> وليد الإسقاطات البسيكوفزيولوجية المتولدة عن الجاذبية التي تختزنها ذواتنا. والتوازن يتحدد بدوره من خلال متغيرين : احتمالية الحركة واحتمالية والثبات. إن الحصول على توازن كلي يستدعي اتجاها أفقيا، حينها تكون احتمالية الحركة في درجة الصفر ويكون الثبات في أقوى حالاته. ويكون الأمر معكوسا عندما يسير الاتجاه وفق خط منحرف. حينها نكون أمام حالة اللاتوازن”. (30)
وقد تكون مرتبطة بمحور يحيل على الهيمنة. ذلك أن حجم الأشكال له دور كبير في تحديد أهمية العناصر المؤثثة للصورة، فوضع شيئين متفاوتين في الحجم ضمن نفس المساحة معناه خلق تفاوت في الإدراك وفي الأهمية والحضور.
وبما أن الصورة هي واقعة بصرية تدرك في الفضاء، فإن الوحدات الشكلية بعناصرها الأولية المتنوعة لا يمكن أن تدرك إلا ضمن حيز فضائي يحتاج إلى إعداد. ولهذا تحتاج هذه الوحدات إلى إعداد مساحة قادرة على استيعاب مجمل الانفعالات التي تودعها العين المبدعة داخل الصورة. فالتركيب يفترض، قبل كل شيء، إدراكا كليا للموضوع الذي تقدمه الصورة.
فالنظرة التي تقرأ ستتوقف عن الحركة لحظة استيعابها للمعطي الصوري كما يقدمه التركيب، لحظتها تبدأ القراءة. ولهذا البعد أهمية كبرى في الصورة الإشهارية مثلا. فالتركيب داخل الإرسالية الإشهارية مسؤول عن الطريقة التي يقدم من خلالها المنتوج إلى المتفرج.
فقد يكون محوريا ( الشيء أو الكائن يحتل الموقع الذي يتوسط الصورة بحيث إن هذه النقطة تتحول إلى منبه يمسك بالنظرة ويقودها إلى التعرف على موضوع الصورة )، ويمكن أن يكون مبأرا ( الشيء أو الكائن يحتل موقع جانبيا من الصورة، ويتعلق الأمر عادة بأقصى نقطة في يمين أو يسار الصورة )، كما يمكن أن يكون التركيب مقطعيا ( ويتعلق الأمر بتوزيع للأشياء أو الكائنات بحيث إن النظرة تقوم بحركة تقودها إلى عملية مسح لمجموع الصورة على شكل الحرف الفرنسي. (31) Z
ويمكن أن يشتمل التركيب على مجموعة أخرى من أشكال التحقق التي تشير إلى قيم دلالية بعينها. وهي قيم مرتبطة هذه المرة بدلالات الأشكال الثقافية والتاريخية. فالمعروف أن الأشكال والخطوط لها دلالات خاصة هي في الأصل إسقاط لحالات وجدانية إنسانية مصدرها التشابه أو التجربة أو تناظر ما. فأي إدراك للعلامة الأيقونية لا يمكن أن يتم دون الأخذ بعين الاعتبار دلالات هذه الأشكال.
فلا يمكن تصور تمثيل بصري قادر على تجاوز الأشكال أو تجاهلها أو إقصائها. فيكفي أن نشير إلى أن الوضعة – العنصر المميز داخل التمثيل الأيقوني – تكشف عن وجود خطوط وأشكال يرسمها الجسد الإنساني على مساحة الصورة، وعلى هذه الخطوط والأشكال نعتمد من أجل تأويل بعض أبعادها.
إن هذه الأشكال والخطوط والنقط تستوعب مجمل الانفعالات التي يثيرها أي تمثيل بصري، بدءا من النقطة ومرورا بالخط وأشكاله وانتهاء بالأشكال الحرة منها والهندسية. وعلى هذا الأساس يمكن القول > إن الأشكال تدرك باعتبارها ملفوظا أو باعتبار حالتها كتلفظ. في الحالة الاولى يكون الشكل تحقيقا لنوع ثقافي: الدائرة والمربع والمثلث حالات لهذه الأشكال ذات العمق الثقافي.
فبقدر ما يقترب شكل ما من نوع ذي عمق ثقافي بقدر ما يكون التدليل التشكيلي المتولد عن عناصره المحددة مرتبطا بالمدلول الذي أودعته الثقافة هذا النوع. أما في الحالة الثانية، فإن الشكل يشتغل كأثر، فهو قد يدل على سيرورة يتم إسقاطها على الملفوظ : مثلا ربط الشكل الممدود، ذي الاتجاه الواضح والمستقيم، بـ القيمة ” سرعة التنفيذ ” “. (32)
ودون أن نتوقف كثيرا عند التمييزات الخاصة بإنتاج النص الصوري ( التمييز بين الإطار وخارج الإطار والتمييز بين الحقل وخارج الحقل) -رغم أهميتها القصوى – يمكن القول إن الصورة تدل من خلال أشكال وخطوط ونقط تملك دلالات سابقة على وجودها داخل الصورة. فأي حكم على هذا الشكل أو ذاك، وأي تحديد لأي خط أو نقطة إنما يستند إلى تسنين سابق ولا تقوم الصورة إلا باستثمار هذه الدلالات وتوجيهها نحو إنتاج دلالاتها الخاصة.
وفي هذا المجال أيضا ترتبط الأشكال هي الأخرى بمجموعة من ردود الأفعال المتولدة عن تأثيرات هندسية لها وقع خاص في النفس والروح.
فمنطق المقايسة الذي حكم إواليات الفكر الإنساني لفترة طويلة جعل من الخطوط والأشكال تشير، من حيث حجمها أو من حيث نمط تكونها، إلى أحكام سلوكية أو قيمية عامة، وهو الذي يفسر الدلالات المرتبطة بالأشكال في صيغها المتعددة.
استنادا إلى هذه الملاحظة يمكن فهم الدلالات الخاصة بالخطوط مثلا. فبعض هذه الخطوط يشير- عموديا كان أو أفقيا – إلى الهدوء والصلابة والحسم كما هو الشأن مع الخط المستقيم، في حين يشير الخط المنحني إلى اللاتوازن كما يشير إلى الليونة والحنان والأنوثة والدلال.
أما الخط الرقيق فيشير إلى النعومة واللطف. وعلى العكس من ذلك، فإن الخط المدبس يشير إلى العنف والحسم واللاتردد. ونفس الشيء يصدق على دلالات الأشكال كالمربع الذي يرمز إلى الأرض في تقابلها مع السماء، فهو مرتبط في تكونه بالسكونية والثبات، وقد يرمز في سياقات بعينها إلى الصلابة.
وفي حين أن الحركة هي كيان مرن ودائري، فإن التوقف والثبات يردان إلى الأشكال التي تملك زوايا. لذلك، فإن الدائرة ترمز مثلا إلى الكلية غير القابلة للتجزيء، فالحركة الدائرية هي حركة مطلقة الكمال. إنها لا تتغير وليس لها بداية ولا نهاية، الأمر الذي يجعل منها رمزا للزمن الذي يتحدد كتتابع مسترسل وثابت للحظات متشابهة. أما المثلث فيشير إلى العلاقات المنطقية ويحيل على الفكر والتركيز. (34).
ولقد حاول كل من كاندينسكي وإيتن ( kandisky و Itten) إقامة نوع من المطابقة بين بعض الألوان وبعض الأشكال. > فالدائرة هي العالم الروحي للمشاعر والنفحة المتموجة، لذلك فهي تتطابق مع اللون الأزرق، أما المربع فهو العالم المادي للجاذبية والكونية لذلك فهو يتطابق مع اللون الأحمر، أما المثلث فهو العالم المنطقي والفكري، عالم التركيز والضوء،
لذلك فهو يتطابق مع اللون الأصفر. <( 35) وهذا ما يبيح لنا القول إن الوحدات البسيطة، سواء تعلق الأمر بالشكل أو اللون، لا يمكن أن توجد معزولة وخارج أي تحقق. ف”الوضوح” و”الحمرة” و” السواد” و”الانفتاح ” و”العمودية” و”الأفقية” كلها عناصر لا يمكن النظر إليها في ذاتها، بل في تقابلاتها الاستبدالية منها والتوزيعية.
وهذا الترابط بين الوحدات من حيث التحقق واحتمالية التدليل ممكن لتمتع الألوان بدلالات مسبقة. فالألوان ترتبط بالأشكال استنادا إلى وجود قيم دلالية مشتركة بينها أو وجود نوع من التناظر بين ما يحيل عليه اللون وبين ما يحيل علىه الشكل.
وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع > الألوان باعتبار الموقع الذي تحتله داخل ملفوظ ما لا باعتبارها موضوعات محسوسة <(36). فكما لا يمكن تصور أي شيء خارج الأشكال، لا يمكن تصور أي شيء خارج الألوان سواء في حالتها الدنيا ( الأبيض والأسود ) أو في حالتها القصوى ( أطياف اللون(.
إن اللون، كالضوء، يغطي كل شيء ولا يمكن أن يوجد شيء خارجه. ورغم كونيته وارتباطه الكلي بالإدراك الإنساني للأشياء، فإن استيعابه وتمثله ليسا من الكونية في شيء. وبعبارة أخرى، إن إدراك اللون هو إدراك ثقافي، فكل شعب وكل مجموعة بشرية تسند قيما ودلالات للألوان التي تعبر من خلالها عن حالة الفرح والحزن، وعن حالة السعادة والتعاسة وعن حالة الغنى والفقر وعن البرودة والحرارة.
لذلك لا يمكن الحديث عن خطاب كوني موحد حول الألوان. فالدلالات الخاصة بالألوان هي دلالات محلية ومرتبطة بسياق ثقافي بعينه. لهذا لا ” وجود لترسيمة جاهزة ومطلقة لتأويل الألوان، إن الأمر يتعلق بحساسية خاصة تجاه محيط المؤول وتجاه ثقافته وتاريخه وتارخ الآخرين أيضا “. (37) وعليه فإن “الخطاب الوحيد الممكن حول الألوان هو الخطاب الأنتروبولوج” (38).
والخلاصة أن اللون لا يملك دلالة قارة وثابتة ومشتركة بين جميع الكائنات البشرية، فهذه الدلالة ليست سابقة على الممارسة الإنسانية، وليست سابقة كذلك على تجسد اللون في حالة من الحالات الإنسانية. ومن جهة ثانية لا ترتبط الدلالة باللون في ذاته، إنها وليدة التقابلات الممكنة بين الألوان، وهذه التقابلات هي المحددة لدلالة الملفوظ البصري، أي دلالة اللون داخل تحقق خاص.
لهذا لا يأتي اللون إلى الصورة إلا مجسدا في أشياء أو مجسدا في ملابس أو تستوعبه أشكال كالمثلث والمربع والدائرة. وفي كل حالة من هذه الحالات نكون أمام دلالة بعينها أو دلالات. فتمازج الألوان بالأشكال سيؤدي إلى خلق دلالة جديدة. كما أن التقابلات بين الألوان هو ما يمنح الصورة أبعادها الدلالية، فالمزج أوالربط بين الألوان داخل السياق الواحد يؤدي إلى تغيير في دلالة اللون الواحد.
ولقد عبر كاندينسكي عن نمو الأشكال وتداخلها، بنفس روحاني قل نظيره. فالأصل في كل شيء هو تقابل بين صمت وكلام، وبين سكون وحركة، لذلك فإن ” النقطة هي أصل الأشكال، إنها منطلق كل تعبير تشكيلي، لذلك فهي ترمز، خارج أي سياق، إلى الرابط الوحيد والنهائي بين الصمت والكلام وهي، باعتبارها علامة على الوقف، صمت وكلام في الآن نفسه. (…)
ومن النقطة يبنى الخط، والخط هو آثار النقطة المتحركة أي نتاجها، ومع الخط ننتقل من السكونية الى الدينامية. إن الخط، على هذا الأساس، هو نتاج قوة أو مجموعة من القوات : فالخط المستقيم متولد عن قوة واحدة ( أفقية باردة، عمودية حارة، مائلة بحرارة متغيرة )، والخطوط المتقطعة متولدة عن قوتين متعاقبتين، أما الخطوط المنحنية فمتولدة عن قوتين متزامنتين.
وما بعد النقطة والخط تأتي الأشكال : الزاوية الحادة والمثلث مرتبطان بالأصفر، والزاوية القائمة والمربع مرتبطان بالأحمر، أما الزاوية المنفرجة والدائرة فمرتبطان بالأزرق”. (39)
- خلاصة
إن مجمل الدلالات التي تثيرها الصورة من خلال بعديها الأيقوني والتشكيلي ليست وليدة مادة مضمونية دالة من تلقاء ذاتها، وليست وليدة معاني قارة ومثبتة في أشكال لا تتغير، إنها أبعاد أنتروبولوجية مشتقة من الوجود الإنساني ذاته. فهي لذلك ليست سابقة على الممارسة الإنسانية، إنها في الممارسة الإنسانية وجزء منها، إنها مرتبطة بخطاب إنساني يجنح إلى منح الظواهر الطبيعية أبعادا دلالية تتجاوز الأبعاد المادية الوظيفية.
ولهذا فالألوان والأشكال والخطوط تتسرب إلى الصورة محملة بدلالتها السابقة، فالأحمر في الصورة موجود باعتبار دلالته السابقة لا باعتبار وجوده المادي كلون ضمن ألوان أخرى، وكذلك الأمر مع الأخضر والأزرق والأبيض. وما يصدق على اللون يصدق على الشكل الهندسي ( المربع أو المثلث أو المستطيل أو الزوايا )، فلهذه الأشكال دلالات أخرى غير التشكيل الهندسي لفضاءات مقتطعة من كون لا حد له.
وهذه الدلالات تغني البعد الأيقوني وتنوع من دلالاته. وما يصدق على البعد التشكيلي يصدق على البعد الأيقوني، فالخطاب الثقافي هو الذي يحول الوجه والإيماءة والعضو إلى بؤرة لإنتاج الدلالات وتحديد أنماط استهلاكها، وكما أشرنا إلى ذلك في فقرات هذه الدراسة، نحن في حاجة إلى معرفة كبيرة لإدراك كل الإيحاءات التي تثيرها إيماءة عجلى أو نظرة متوسلة أو ابتسامة معلقة على شفاه حزينة.
- الهوامش
1- Régis Debray : Vie et mort de l’image, éd Folio , 1992, p 15 ، قام فريد الزاهي بترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وصدر عن إفريقيا الشرق، 2002.
2- Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, éd Payot, 1972, p 100
3 – نفسه ص 101
4- يقدم سوسير مثال الصيني الذي ينحني أمام إمبراطوره تسع مرات تعبيرا عن الاحترام والتبجيل، وفي تصور سوسير فإن القيمة التعبيرية لهذا الفعل لا تكمن في عدد الانحناءات ولا في الانحناءة في ذاتها، بل في الاستعمال الاجتماعي له، لذلك فإن كل الإيماءات محكومة بمبدأ الاعتباطية. نفسه ص 101
5- J M Flosch : Les langages planaires , in Sémiotique ,l’école de Paris ; Hachette unversité, 1982, p 205
6- Umberto Eco : La structure absente, éd Mercure de France, 1972, ، الجزءالخاص بدراسة الأسنن البصرية ، ص 169 وما يليها.
7- Groupe 5 : Traité du signe visuel, pour une rhétorique de l’image, éd Seuil, 1992, p. 145
8- Umberto Eco : Kant et l’ornithorinque, éd Grasset , 1999, p. 377
9 – Eco : La structure absente, p. 181
* – السنن الأيقوني :code iconique
* – السنن المعنمي : code sémique
10- Eco : La structure absente, p. 176
11- Martine Joly : l’image et les signes, éd Nathan, p. 34
12- انظر Wolfgang Iser : L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, éd Mardaga, 1985, p 248
13- Umberto Eco , Le signe, p 94
14- Iouri Lotman : La structure du texte artistique, in Martine Joly : l’image et les signes, éd Nathan, p.98
15- Eco : La structure absente, p.178 et suiv
*- الوضعة : pose
16-Umberto Eco : La production des signes, éd, Le livre de poche, 1992, p. 55
17- Groupe 5 : Traité du signe visuel, pp.79 -80
* – العلامة الأيقونية : signe iconique
18 – Groupe 5 : Traité du signe visuel, pp.136 – 137
*- العلامة التشكيلية : signe plastique
19- آلن پيز : لغة الجسد، كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم، ترجمة : سمير شيخاني، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص 10.
20- David Lebreton: Des visages, éd Metaillé, 1992, p 141
21- E T Hall : La dimension cachée, éd Seuil, 1971 , p 15
20-انظر في هذا المجال : guy Guauthier : Vingt lessons sur le sens et l’image, éd Médiathèque,1986, p . 90
23 – : d’un regard à l’autre , p 43 Fransesco Casetti
24 – Groupe 5 : Traité du signe visuel, pour un rhétorique de l’image, éd Seuil, 1992, p. 191
25- الشكلم : formème ، اللونم : colorème ، وقد صيغ المصطلحان معا على وزن معنم ( والجمع معانم) . والمعنم هو الوحدة الدلالية الصغرى، وكذلك الشكلم الذي يحدد الوحدة الشكلية الدنيا. فلكي يتم الإمساك بالمضمون الكلي للشكل يجب تحديد وحداته المكونة أي الشكالم.
* – يميز بينفنست في العلامة بين تعبير ومضمون. ويتكون التعبير من مادة وشكل، فالمادة هي المتصل الصوتي غير الدال، أما الشكل فهو الناتج عن عملية تقطيع المتصل. وكذلك الأمر مع المضمون، فهو شكل ومادة. فمادته هي الكتلة الفكرية العديمة الشكل، أما شكله فهو الوحدات الصغرى التي تكون. فنحن لا نعرف عن الخير أي شيء في ذاته، وما نعرفه هو مجموعة من تحققاته، وتعتبر هذه التحققات شكلا.
26- Groupe 5 : Traité du signe visuel, p 211
27- C . R . Haas : Pratique de la publicité, éd Bordas , 1988, p 94
28- نفسه ص ص 94- 95
29 – Groupe 5 : Traité du signe visuel, p. 218
30- Groupe 5 : Traité du signe visuel, p. 219
31- Martine Joly : l’image et les signes, éd Nathan, p.106
32 – 220 – 221 Groupe 5 : Traité du signe visuel, pp.
33- C . R . Haas : Pratique de la publicité, éd Bordas , 1988, p 93
34-ينظر في هذا المجال : Jean Chevalier , Alain Gheerbrant : dictionnaire des symboles, éd Robert Lafont
35- Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de C S Peirce, éd Mardaga, 1990 , p 116
36 – Groupe 5 : Traité du signe visuel, p 227
37- Martine Joly : l’image et les signes, Nathan,1994, p. 104
38- Michel Pastoureau : Dictionnaire des couleurs de notre temps, Symbolique et société, éd Bonneton ,p. 9
39- : Point et ligne sur plan, éd Folio, 1991 , pp . 25 – 26 et 67 et suiv W . Kandinsky
وانظر أيضا Du spirituel dans l’art; et dans la peinture en particulier, pp 61 et suiv