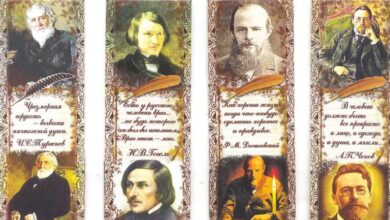الروائي واستدعاء التاريخ

- تقديـم:
يمثل استدعاء التاريخ في الكتابة الروائية المغاربية رصيدًا مرجعيًا، إذ تؤسس الرواية من خلاله عالمها المتخيل بإقامة علاقات مع ألوان إبداعية، الشيء الذي يجعل منها أفقًا مفتوحًا، بداخله ينصهر الأدبي بالفني، والشفوي بالمكتوب، فيأتي هذا النص متعدد المصادر متلون النسيج، يتغذى من التراث الشخصي والمحلي والعام بشتى أصواته ولغاته، ومن حقول التاريخ والأخبار والوقائع.
وأيضًا من التراث الروائي العالمي الإنساني. على اختلاف مراجعه وتشكلاته، أحد مسالك التجريب الروائي التي سلكها كتاب الرواية المغاربية ذات التعبير العربي منذ مطلع الثمانينيات بحثًا عن أفق حداثي في الكتابة يتجاوز المستهلك من أنماط الرواية التقليدية، التاريخي منها والواقعي، ويحد من سلطة المثاقفة الغربية على تشكلات الكتابة الأدبية في المغرب العربي، والروائية منها أساسًا، بجعلها تنفتح على أفق باحث عن التميز عبر المغايرة، وعن الخصوصية عبر تجاوز السائد من طرائق التعبير المستحدثة في الغرب، والتي انفتح عليها هذا الجيل من كتاب الرواية منذ الستينيات.
وهو ما يجعل هذه النزعة في توظيف “التاريخ” تنخرط ضمن مذهب تحديثي في الكتابة الروائية، يتوق إلى تحقيق حداثة متنه الحكائي وأنساق خطابه عبر الارتداد إلى التراث والبحث فيه عما يمكن أن يستوعب إشكاليات الراهن، ويعبر عنها كأشكال جمالية جديدة، تجذر الهوية الثقافية والحضارية أمام تفاقم التحديات المعاصرة. وهو ما يعلل تصدر المسألة الحضارية شواغل كتاب هذه الرواية المغاربية ذات التعبير العربي، وهم يتمثلون التراث من منطلق التوق إلى التجاوز والمحاكاة، ليعبروا بذلك عن موقفهم من الرواية السائدة، والمجتمع الراهن بوسائط الكتابة ذاتها، توقا إلى إنشاء النص المتميز الذي يمتلك الخصوصية.
ويكشف هذا النزوع عن وعي كتابه بكون التراث يمثل السبيل إلى الحداثة وهو ما يوحي بعلاقة ائتلاف بين الروائي والتراثي/التاريخي، لا اختلاف، وتكامل لا تقابل، ذلك لأن إثبات الهوية وتأكيد الأصالة هما السبيل إلى التجاوز والإضافة. إلا أن السؤال المركزي الذي يطرح نفسه. هو كيف يتمكن الأديب من الكتابة عن الوقائع التاريخية بشكل أدبي متميز؟ وإلى أي حد تستطيع الرواية أن تستوعب أحداث الزمن الغابر؟ ثم كيف يشتغل التاريخي ضمن الحدث الروائي التخييلي؟ وكيف يكتب الروائي في مجاله عن حيوات متخيلة وقضايا التاريخ إلى فضاء المتخيل؟.
- 1- تخييل التاريخي وأرخنة الخيـال:
إن الروائي في انتخابه للأحداث التاريخية التي تشد نسيج النص ببنيته العميقة والشكلية المتماهيتين “يقدر المسافات، ويشكل الألوان، ويصور الأماكن والحالات، ويركب الحوارات، ويبني المشاهد، ويتعمق في الأمزجة، ويفسر المواقف، ويصوغ ردود الفعل، وينزل إلى حيث تمفصلات المجتمع في مكان وزمان معينين”1، لينشئ بعد ذلك نصًا إبداعيًا نواته وحدة التجربة الإنسانية، بمعنى أن ثمة أشياء تتجاوز المكان والزمان لتكون الجوهر في الإنسان.
أو ما يصطلح عليه بــ”التخييل التاريخي” بدل مصطلح “الرواية التاريخية”، فهذا الاستبدال يدفع بالكتابة السردية التاريخية إلى تخطي مشكلة حدود الأنواع الأدبية ووظائفها، ثم إنه يفكك ثنائية التاريخ والرواية، ويعيد دمجها في هوية سردية جديدة، ولا يرهن نفسه لأي منهما، وأنه سوف يتجاوز أمر البحث في مدى توفر الكتابة على مبدأ المطابقة مع المرجعيات التاريخية، ومدى الإفراط في التخييلات السردية، إنه ينفتح على الكتابة الجديدة التي تعد حاملة للتاريخ، لا معرفة به، “إنما باحثة في طياته عن العبر المتناظرة، والتمثلات الرمزية، والتأملات والمصائر، والتواترات، والتجارب والانهيارات القيمية، والتطلعات الكبرى، فكل هذه المسارات الكبرى في(التخيل التاريخي) تنقل الكتابة السردية من موقع جرى تثبيت حدوده بصرامة إلى تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على الماضي والحاضر بالدرجة نفسها من الحرية والاهتمام”2.
ويمكن القول إن “التخييل التاريخي” هو المادة التاريخية المتشكلة بوساطة السرد، وقد انقطعت عن وظيفتها المرجعية واكتسبت وظيفة جمالية، فأصبحت توحي بما كانت تحيل عليه لكنها لا تقرره، فيكون التخييل التاريخي من نتاج العلاقة المتفاعلة بين السرد المعزز بالخيال والتاريخ المدعم بالوقائع، وقد ظهر على خلفية من أزمات ثقافية لها صلة بالهوية، والرغبة في التأصيل، والشرود نحو الماضي بوصفه مكافئًا سرديًا لحاضر كثيف تتضارب فيه الرؤى، وتتعارض فيه وجهات النظر، “فوصول الأمم إلى مفترق طرق في مصائرها يدفع بسؤال الهوية التاريخية إلى المقدمة ولكن الخطر ينبثق حينما يروج لوهم مفاده أنه بالارتماء السلبي في أحضان التاريخ يمكن تجنب رهانات الحاضر المعقدة، فيصبح الاتكاء على الماضي ذريعة لإنتاج هوية تقول بالصفاء الكامل والنقاء المطلق. إذ أن وجود الماضي في قلب الحاضر يكون مهما بمقدار تحوله إلى عبرة، وتجربة للتأمل”3.
في هذا الضوء، فإن الوقوف على بنيات اشتغال التاريخ في الرواية المغاربية من شأنه أن ينير جوانب من البعــد الحواري لهذه الرواية، وأن يكشف عن موقعها البيني المتسم بتداخل ميراثين أدبيين هما: ميراث الأدب المغاربي والعربي الشعبي، وهو الأدب الذي ما يزال حيًّا وفاعلاً في الذاكرة الثقافية المغاربية؛ وميراث الأدب الغربي المقترن بالتجربة الكولونيالية.
وذلك انطلاقًا من تجارب تعالقت مع التاريخ على سبيل التمثيل لا الحصر من قبيل “التاريخ”، بحيث استفاد واسيني الأعرج4 في روايته من التاريخ الشعبي للدولة الجزائرية، من خلال التركيز على رسم صورة خارقة للأمير مولاي عبدالقادر، حيث يمتزج السرد بشذرات المتخيل المتجذر في العمق الاجتماعي، وكذلك فقد انتهج عبد الهادي بوطالب5 طريقة مغايرة في التعامل مع آليات السرد وتنضيد المتخيل لإقحامه لسيرة غيرية متعلقة بسجلات ووقائع تاريخية تفتح الأفق الروائي على تمثل سيرة لسان الدين بن الخطيب الملقب بذي الوزارتين، وهو الذي عاش أدق لحظات حكم بني الأحمر بالأندلس واغتيل وأُحرق جثمانه بعدما اتهم بالخروج عن الدين. كما تهتم الرواية بوصف أحداث اجتماعية وسياسية عرفها التاريخ العربي الإسلامي بالأندلس والمغرب خلال فترة معلومة تميزت بالضعف والتفكك والتنافس على السلطة وإدارة الحكم. يتجلى من هذا أن قصد الكتابة ووظيفة سردها التخييلي بإحالته على المنظور الببليوغرافي والتاريخي.
كما خصص “بنسالم حميش “نصوصه الروائية للتاريخ العربي، لا استعادة لمجده أو تذكيرًا بأحداثه، وإنما ليستعير مادة تاريخية محاولاً من خلالها قراءة الواقع السياسي. وهذا ما نجده أيضًا في روايته “مجنون الحكم”6 التي حاولت تصوير الاستبداد والقمع في عهد الحاكم الفاطمي، لتكون تلك الفترة التاريخية لحظة لإدانة الاستبداد والقمع الذي يجد له امتدادا في الفترة التي ألف فيها روايته.
وذلك من منظور امتصاصها واستثمارها لكثير من الصيغ والأنماط والتقنيات الفنية التراثية بوصفها إمكانات لزحزحة تمركز الشكل الغربي7، فمن هذا الموقع الثقافي الهجين –بالمعنى الإيجابي للكلمة- يمكن انجاز قراءة مغايرة للرواية المغاربية. بعيدًا عن التقسيم الثقافي المتقابل والمتناقض. حيث يعيد الروائي في استلهامه للتاريخ ترتيب الأشياء وتوزيع الأدوار كما يريد، تأصيلاً لرؤيته التي يقيم بناءها في معماره الروائي الجديد.
- 2 – بين الرواية والتاريخ: التعالق والتجاوز:
تحتل التخيلات التاريخية منطقة التخوم الفاصلة بين الواقعي والخيالي، ولطالما نُظر إليها على أنها منشطرة بين صيغتين كبيرتين من صيغ التعبير: الموضوعية والذاتية، فهي نصوص سردية أعيد حبك موادها التاريخية، فامتثلت لشروط الخطاب الأدبي، وانفصلت عن سياقاتها الحقيقية، ثم اندرجت في سياقات مجازية، “فابتكار حبكة للمادة التاريخية هو الذي يحيلها إلى مادة سردية، وهذا يعني إعادة إنتاج التاريخ بالسرد، وما الحبكة إلا استنباط للأحداث المتناثرة في إطار سردي محدد المعالم”8.
ولطالما ارتسم، على مستوى الأنواع الأدبية، تناقض واضح بين التوثيق التاريخي، والسردي الخيالي، ذلك لأنهما يختلفان في طبيعة الاتفاق الضمني المنعقد بين الكاتب وقارئه. ومعلوم أن هذا الاتفاق عُرفي لكنه يبنى على توقعات مختلفة من ناحية القارئ، ووعود مختلفة من ناحية المؤلف، فحينما يفتح قارئ صفحات عمل روائي، فإنه يهيئ نفسه ليدخل عالمًا غير واقعي، وفي هذا العالم الجديد “معرفة مكان وقوع الأحداث وزمانها هي مسألة في غير محلها”9، ولكن حينما يفتح القارئ كتاب تاريخ يتوقع أن يدخل، تحت قيادة الأرشيف، في عالم الأحداث التي حصلت بالفعل، فإنه يأخذ حذره ويطلب خطابًا لم يكن صحيحًا بصورة تامة “فعلى الأقل يكون ممكنًا وقابلاً للتصديق ومحتملاً، وفي كل أمينًا وصادقًا”10.
وهذا ما توصل إليه “بول ريكور”، ثم جرى التفريق بين التاريخ الذي هو “خطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن القوانين المتحكمة في تتابع الوقائع، والسرد الذي هو خطاب جمال تقدم فيه الوظيفة الإنشائية على الوظيفية المرجعية”11 كما يقول “محمد القاضي”، فينتج عن هذا أمران، أولهما أجناسي يتصل بـ”العلاقة بين الوظيفتين المرجعية والتخيلية في الخطابين التاريخي والأدبي. فالمؤرخ وإن خيّل يظل متحركًا في مجال المرجع، أما الروائي فإنه وإن رجع إلى الواقع ماضيًا أو حاضرًا يظل خطابه مندرجًا في حقل التخيل. فالتاريخ يقدم نفسه على أنه انعكاس وصياغة لفظية لأحداث واقعة، أما الرواية فتقدم على أنها إبداع وإنشاء لعالم محتمل”12. و
ثانيهما يختص بنظرية الأدب “ومدارها على التناقض بين الخطابين التاريخي والروائي، فليس من شك في أن الرواية التاريخية تنطلق من الخطاب التاريخي، ولكنها لا تنسخه بل تجري عليه ضروبًا من التحويل حتى تخرج من منه خطابًا جديدًا له مواصفات خاصة ورسالة تختلف اختلافًا جذريًا عن الرسالة التي جاء التاريخ مضطلعا بها”13. وعلى هذا يندرج التاريخ في منظومة الأجناس ذات الغاية النفعية، وتندرج الرواية في منظومة الأجناس ذات الغاية الجمالية.
ثم تندمج هذه الثنائية في الرواية التاريخية التي تتميز عن غيرها من أنواع الكتابة التخيلية بكونها، “تعلن استنادها إلى حوادث ماضية دونها السابقون، ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدوران حول هذا النص أو النصوص الماضية، مما يكثف صلتها بهذه الوقائع ويضفي على عالمها صيغة مرجعية واضحة”14، فهويتها السردية تتحدد من خلال التنازع بين التخيلي والمرجعي. فتكون الرواية التاريخية نوعًا من السرد الذي “يرمي إلى إعادة حقبة من الماضي بطريقة تخيلية حيث تتداخل شخصيات تاريخية مع شخصيات متخيلة”15.
يتوخى هذا العمل إذن تشخيص أشكال توظيف وتمثل التاريخ في الرواية المغاربية، انطلاقًا من مقولة أساسية ترى بأن الإبداع المحلي قادر على مقاومة الهيمنة الأدبية وتنسيب السرديات المتمركزة، وكذا خلخلة التصنيفات الأجناسية وكسر المقاييس الشعرية المعيارية16. ذلك أن إنتاج الأدبية مقترن بالسياق الثقافي، إذ لا وجود لأدبية وحيدة تتجاوز الشروط المكانية والزمنية.
وحيث إن الرواية المغاربية جزء من آداب الشعوب المستعمرة، فإن لا شعورها السياسي يتوق عبر التخييل إلى توكيد الهوية ورسم الاختلاف من خلال المقاومة الإبداعية التي تعتبر محاولة لنقض المفهوم الكولونيالي للعالمية. ومن ثم فإن الرد الروائي على العنف المادي للمستعمر، لا يتمثل فقط في الموقف السياسي بل يتجلى أيضًا في ممارسة عنف رمزي قوامه العودة القوية إلى تراث الشعب المقهور، وإبراز عناصر القوة المطمورة فيه، تلك التي يمكنها أن تنافس ثقافة المركز الغازية بل وأن تضاهيها وتكون ندًا لها.
ومن هنا توق الكثير من الكتاب المغاربة إلى الانزياح عن الشكل الروائي المعهود، وذلك من خلال تشييد مساحة فنية جديدة تمكن من زحزحة حركة الحداثة الأوربية الساعية إلى دمج الثقافات كافة في ما تزعمه بالجمالية العالمية، الشيء الذي يدعو إلى إنجاز قراءة قادرة على استكشاف مظاهر الاستفادة من التقنية الروائية الغربية وكذا صيغ تحويرها وتبيئتها، وتهجينها باستراتيجيات نصية محلية17.
- خاتمة:
بناء على ما سبق يتضح لنا أن الرواية شيدت خصوصيتها، من خلال استثمارها للتراث السردي وعلى رأسها “التاريخ”، الشيء الذي يؤكد أن التراث ليس خلفنا بل ما زال ينتظر منا المساءلة والتحليل. وعليه، فإن الرواية أصبحت قائمـة في أساسهـا على تعدّد النصوص وتداخل أشكالها، ولم تعد ممثـّلة لصنف محدّد من الكتابة، أو هي صارت ممثـّلة لتقاطعات أجناسية متنوّعة أو لجنس موسوعيّ تمتزج فيه الأصناف والأنواع.
وهو ما يخرج بالرّواية من إطار جنسها ومواضعاته إلى إطار “النـّص الجمع” القائم على تخوم الأنواع ويضع منظومة الجنس الأدبي، موضع مساءلة وتشكيك، وذلك عبر تأزيم مقولة (النـّقاء النـّوعي) التي كان يراهن عليها التّحقـّق النصّي للرّواية الكلاسيكية.
- الإحالات والهوامش:
1 – محمد أقضاض، الشخصية الروائية بين الكلاسيكي والمنظور الحداثي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1995، ص27.
2 – عبدالله إبراهيم، التخييل التاريخي (السرد والإمبراطورية والتجربة الاستعمارية)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1 بيروت2011، ص 5-6.
3 – فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ (نظرية الرواية والرواية العربية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1،2004، ص133.
4 – واسيني الأعرج: كتاب الأمير- مسالك أبواب الحديد، منشورات دار الآداب بيروت، ط،2008،2.
5 – عبدالهادي بوطالب: وزير غرناطة، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط1، 1960.
6 – بنسالم حميش، مجنون الحكم، مطبعة المعارف الجديدة، 1998.
7 – أحمد فرشوخ، نقد المركزية السردية: اشتغال الأدب الشعبي في الرواية المغربية، ص9.
8 -بول ريكور، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ترجمة فلاح رحيم وسعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 2006، ص58.
9 – سمر روحي الفيصل، الرواية العربية (البناء والرؤيا)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق2003، ص45.
10 – الذاكرة والتاريخ، النسيان، بول ريكور، ترجمة جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ط 1،2004، ص379.
11 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ (دراسات في تخييل المرجعي)، دار المعرفة للنشر، تونس2003، ص23-24.
12 – عبدالله إبراهيم، من الرواية التاريخية إلى التخيل الروائي، مجلة العرب القطرية، عد د28، سنة 2010.
13 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، ص 86-87.
14 -عبداللطيف محفوظ، الرواية التاريخية وتمثل الواقع، مجلة الموقف الأدبي، عدد 438، سنة 2008، ص172.
15 – عبدالملك مرتاض، نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، سلسلة عالم المعرفة، عدد 24، الكويت 1998. ص82.
16 – أحمد فرشوخ، نقد المركزية السردية: اشتغال الأدب الشعبي في الرواية المغربية، آفاق: مجلة دورية ع. 79-80، اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 2010، ص9.
17 – المرجع نفسه، ص8.