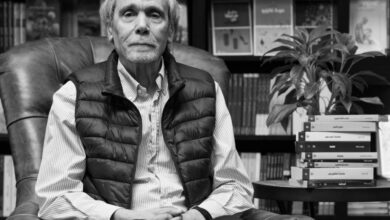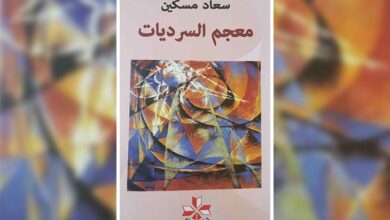الإيداع النصي القرآني

سبق أن كتبت في جريدة «القدس العربي» عن «القارئ الأحد» الذي يمكن أن يتفاعل مع النص بطريقة مختلفة، وأقصد دقيقة، عن غيره من القراء. وكان وراء هذه الفكرة، أن أي نص، كيفما كان جنسه أو نوعه، وهو يتوجه إلى قراء غير محددين يستهدف، بشكل أو بآخر ذلك القارئ الأحد الذي يمكنه استبطان النص وفهمه، بشكل جيد، والعمل على تقريبه إلى غيره من القراء، بكيفية تجعله قابلا لأن يتفاعل معه أكبر عدد من القراء، بهدف تحقيق القصد «الجوهري» أو «المركزي» الذي يسعى إليه النص.
وقد قادني هذا، في اتجاه آخر، إلى اعتبار كل ما يكتبه أي كاتب من مؤلفات متعددة لا تعدو أن تكون نصا واحدا يتوزع في عدة نصوص تتضافر مجتمعة لتشكيل عالم نصي أحد، سواء كان هذا النص الأحد منسجما ومتآلفا، أو كان غير متجانس ولا متسق تبعا لتطور وعي الكاتب، ورؤيته الخاصة للأشياء.
وبمعنى آخر، نرى أن كل كاتب أصيل يُودِع في نصوصه اللاحقة ما أورده في نصوصه السابقة، وإن بطريقة جديدة، بهدف تطوير ما يروم التعبير عنه، والتواصل به مع غيره، وتأكيد مرماه بشكل لم يتحقق في نصوصه السابقة، أو استجابة لدواع حديثة تجعله يطور ما يود إبلاغه إلى قراء جدد.
وجدتني أطور هذه الفكرة، وأعمقها أكثر، من خلال البحث في «سرديات القرآن الكريم»، وأنا أتأمل العلاقة التي تجمع، أو توحد النص القرآني بغيره من الكتب السماوية المنزلة. وتولد لديّ مصطلح: «الإيداع النصي»، من خلال ما أخرجه البيهقي ( ت 458) في شعب الإيمان عـن الحـسن (ت 110) الذي قال: «أنزل االله مئة وأربعة كتب، أوْدَعَ علومَها أربعةً منـها: التـوراة والإنجيل والزبور والفرقان.
ثم أودع علومَ التوراة والإنجيل والزبور الفرقـانَ، ثم أودع علوم القرآن المُفَصّلَ، ثم أودع المُفَصّلَ فاتحةَ الكتاب، فمن علِم تفـسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة».
إذا كنا نتحدث عن «الإيداع النصي القرآني» للدلالة على ترابط النصوص المنزلة من الله لهداية البشرية، نعتبر «الإبداع» مقابله، وهو ما ينتجه الإنسان من نصوص يسعى من خلالها إلى الارتقاء بإنسانيته ضد حيوانيته.
لقد أنزل الله تعالى مئة وأربعة كتب. ولا عبرة في التشكيك في عدد الكتب لأن رقم مئة في القرآن الكريم يدل على الكثرة: «فأماته الله مئة عام ثم بعثه». والأربعة المحددة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن إلى جانب صحف إبراهيم التي لا تقتصر على كل الكتب المنزلة، التي لا يمكننا معرفة عددها بالدقة المطلوبة.
إن القرآن الكريم يوضح لنا أن «الدين عند الله الإسلام»، أي ليس ثمة سوى دين واحد. وأن الله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم، بعث ما لا يحصى من الأنبياء والرسل على أقوام كثيرين، وفي أزمنة وأمكنة متعددة: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» (الإسراء: 15).
وبما أن الحساب يشمل كل الناس، كانوا جميعا قد بلغوا الرسالة «النص الأحد» عن طريق من بعثهم إليهم. ويتأكد لنا ذلك من قوله تعالى موجها الخطاب إلى الرسول وهو يخبره عن الأمم الغابرة: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك» (غافر: 78).
إن كل الكتب أو الصحف التي بعثها الله إلى البشرية في كل أطوار تطورها، سواء كانت مئة وأربعة أو أكثر بكثير من ذلك، أودعها الله كلها علوما كثيرة، لأنها من مصدر واحد، وقد جعلها كلها في أربعة كتب. وكل ما هو في الكتب الثلاثة مودع في القرآن الكريم، الذي أودع كل ما فيه في المفصل منه (البنية الكبرى).
وكل ما في المفصل مودع في أم الكتاب أو فاتحته (البنية الصغرى). إن الإيداع النصي القرآني اختزال لما سميناه «القرآنية» بما هي الخاصية التي تجتمع فيها كل مميزات القرآن الكريم وخصائصه واشتماله على كل ما أنزل على البشرية في كل تاريخها من كتب وصحف بطريقة جديدة تكشف ما فيها، وما لحقها من تغييرات وتحويرات بسبب التدخل البشري الذي لجأ إلى الاختلاف في التأويل، خضوعا لنوازع وأهواء معينة، فكان بذلك انحرافه عن «الصراط المستقيم» الذي جاء النص الأحد ليكون هدى ونورا للإنسان.
تحقق الإيداع النصي زمنيا من الغيب (الأمم الغابرة) إلى الشهادة (عالم النبوة المحمدية)، ونصيا من الأعم (الصحف القديمة) إلى العام (الكتب الأربعة)، إلى الخاص (المفصل في القرآن الكريم) إلى الأخص (الفاتحة). إنها صيرورة متصلة، وحلقات متسلسلة.
ومن «علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير كل الكتب المنزلة». وبما أن الفاتحة ليست سوى بنية من بنيات النص القرآني، كان من فهمها فهم كل بنية من بنيات النص القرآني، سواء كانت هذه البنيات متمفصلة إلى سور أو آيات. ويؤكد هذا الترابط بين مختلف البنيات التي يبنى عليها النص الأحد. وقد وقفت على هذا في ما سميته «النصية الترابطية» في دراسة حول السيرة الشعبية.
إذا كنا نتحدث عن «الإيداع النصي القرآني» للدلالة على ترابط النصوص المنزلة من الله لهداية البشرية، نعتبر «الإبداع» مقابله، وهو ما ينتجه الإنسان من نصوص يسعى من خلالها إلى الارتقاء بإنسانيته ضد حيوانيته.