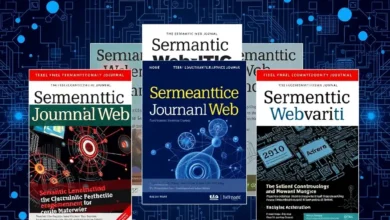نقدم في هذا الفصل مجموعة من المفاهيم التي نعتقد أنها تشكل الحجر الأساس الذي انبنت عليه السميائيات وتشكلت كنشاط معرفي مستقل. وإذا كنا قد أشرنا في فصولنا السابقة إلى الكثير من المفاهيم المتداولة في الأدبيات السميائية، فإن تلك التي سنقدمها هنا لها وضع خاص،
فهي من جهة ليست وحيدة الاستعمال ولا ترتبط بهذا النشاط المعرفي دون غيره، فهذه المفاهيم تستعمل أيضا في الكثير من العلوم الإنسانية (اللسانيات، الأنتروبولوجيا، التحليل النفسي، علم الدلالة …)، وهي من جهة ثانية لا تحيل على نفس المضمون، فالكثير من هذه المفاهيم لها دلالات متعددة وفق استعمالاتها داخل هذا الحقل أو ذاك، وقد يشوش هذا الوضع على الاستعمال السميائي الصرف لهذه المفاهيم.
ومن جهة ثالثة، فإن هذه المفاهيم تشترك في خاصة واحدة : إحالتها على الميكانيزمات الخاصة بإنتاج الدلالة وتداولها واستهلاكها. والحال أن السميائيات في معناها الأكثر بداهة ليست شيئا آخر سوى تساؤلات حول المعنى. إنها دراسة للسلوك الإنساني باعتباره حالة ثقافية منتجة للمعاني. ففي غياب قصدية – صريحة أو ضمنية – لا يمكن لهذا السلوك أن يكون دالا، أي مدركا باعتباره يحيل على معنى.
إن هذه القصدية هي أساس كل القضايا المعرفية التي عبرت عن نفسها من خلال المفاهيم التي نقدمها هنا، وهي مفاهيم، كما يتضح من التعريفات التي سنسوقها في هذا المقال، وثيقة الارتباط بالمعنى من حيث الوجود والمادة والتداول والسيرورة. فالوجود الإنساني، باعتباره وجودا للمعنى وفي المعنى، أنتج مجموعة من المفاهيم المعبرة عن التجليات الممكنة لهذا المعنى باعتباره غطاء سميكا للممارسة الإنسانية.
وعلى هذا الأساس، فإن أي تساؤل عن المعنى هو في واقع الأمر > تساؤل عن معنى النشاط الإنساني وعن معنى التاريخ< (1). وسنحاول فيما سيأتي تحديد بعض مضامين هذه المفاهيم استنادا إلى التصورات التي اقترحتها السميائيات في هذا المجال.
ومع ذلك، يجب أن ننبه على أن ما نقدمه هنا لا يمكن النظر إليه باعتباره عرضا شاملا، إنه جزئي، فهو لا يغطي كل التمييزات الدقيقة الموجودة داخل السميائيات ذاتها، فذاك عمل من طبيعة أخرى، إن الأمر يتعلق بتقديم مجموعة من التوجيهات العامة التي قد تساعد القارئ على فهم الكون المعرفي الذي تحيل عليه السميائيات وكذا طريقتها في التعاطي مع الأنشطة السلوكية الصادرة عن الإنسان.
- المحايثة
يعد مفهوم ” المحايثة ” من المفاهيم التي أشاعتها البنيوية في بداية الستينات، ليصبح بعد ذلك مفهوما مركزيا استنادا إليه يفهم النص وتنجز قراءاته. وأصبح “التحليل المحايث” هو كلمة السر التي يتداولها البنيويون كبضاعة مهربة تشفي من كل الأدواء. ف” التحليل المحايث” هو وحده الذي يجيب عن كل الأسئلة ويدرك كل المعاني.
والمقصود بالتحليل المحايث أن النص لا ينظر إليه إلا في ذاته مفصولا عن أي شيء يوجد خارجه. والمحايثة بهذا المعنى هي عزل النص والتخلص من كل السياقات المحيطة به. فالمعنى ينتجه نص مستقل بذاته ويمتلك دلالاته في انفصال عن أي شيء آخر.
ومع ذلك، فإن المحايثة لها أصول أخرى غير ما أثبتته البنيوية في تفاصيل تحاليلها. فالمحايثة هي ما هو معطى بشكل سابق على الفعل الإنساني وتمفصلاته، فهي، كما يشير إلى ذلك لالاند في قاموسه،(2) مرتبطة بنشاطين : نشاط يحيل على كل ما هو موجود بشكل ثابت وقار عند كائن ما ( والأمر يتعلق برؤية ستاتيكية )، وآخر يحيل على ما يصدر عن كائن ما معبرا عن طبيعته الأصلية ( رؤية دينامية).
وفي الحالتين معا نحن أمام مضامين سابقة في الوجود على الإنسان ومعطاة مع الطبيعة ذاتها. وفي هذا السياق فإن المحايثة هي رصد لعناصر لا تفرزها السيرورة الطبيعية لسلوك إنساني مدرج داخل الزمنية التريخية باعتبارها مدى يخبر عن المضامين وينوعها.
ولقد حاول القديس أوغستين (3) شرح السيرورة المنتجة للتلفظ الإنساني باعتباره مدخلا أساسا نحو الفهم وإنتاج الدلالات، من خلال القول بوجود ” معرفة محايثة” يمتلكها الله ويسربها إلى الإنسان عبر مفصلتها في ألفاظ ثلاثة : لفظ القلب وهو لفظ مفكر فيه خارج أي لسان وهو ما يشبه القدرة التي يملكها الإنسان من أجل اكتساب اللغة، واللفظ الداخلي،
وهو لفظ مفكر فيه من خلال لسان ما، وهو ما يشبه لحظة تصور العالم من خلال حدود لسانية، ثم اللفظ الخارجي، وهو اللفظ الذي ينتسب إليه الفرد اختيارا أو قدرا. والأساس في كل هذا أن المعرفة، من منظور لاهوتي، سابقة في الوجود على السلوك الإنساني ومصدرها محفل متعال، ولا يقوم هذا الإنسان إلا بتصريفها في وقائع بعينها.
وتعد هذه التعاريف مدخلا رئيسا لتحديد مضمون هذا المفهوم في مواقعه الجديدة كالتحليل السردي مثلا، حيث يشار إلى مفاهيم مشتقة منه ولا تدرك إلا في علاقتها به من قبيل “الدلالة الأصولية” و”مستويات التحليل” و”النص ومستوياته”. ولقد كانت السميائيات السردية، خاصة تحت تأثير يالمسليف، الذي كان يقول بضرورة دراسة اللسان دراسة محايثة بعيدا عن كل العناصر الخارجية، سباقة إلى الاستفادة من المردودية المعرفية والتحليلية لهذا المبدأ في تحديد مستويات الدلالة وأنماط تشكلها.
فاستنادا إلى روح هذا المفهوم تبلورت الفكرة القائلة بأن الدلالة لا تكترث للمادة الحاملة لها، ولا دور لهذه المادة في ظهورها وانتشارها واستهلاكها. وهذا معناه أن هناك سقفا مضمونيا ( مادة مضمونية محايثة ) يتحدد من خلال ثنائيات توجد خارج مدارات التحقق.
وعلى هذا الأساس كان الحديث عن المحايثة والتجلي باعتبارهما يغطيان نمطين للوجود في حياة الدلالة وتجليها عبرالوسيط السردي : المادة المضمونية العديمة الشكل، وهي المادة التي يستند إليها المبدع بدئيا من أجل إنتاج نصوص مخصوصة. وهناك الأشكال المضمونية التي تشير إلى التحققات الخطابية المخصوصة، وهي ما يخبر عن التلوين الثقافي الخاص بتوزيع المادة المضمونية.
على أن المادة المحايثة في هذا المجال لاعلاقة لها بمضامين إلهية أو غيرها. إن الأمر يتعلق بالنماذج السلوكية التي تفرزها الممارسة وتضعها أساسا لكل تواصل. فمن نافلة القول إننا نتواصل من خلال النماذج لا من خلال النسخ المتحققة. والحاصل أن المادة التي نتحدث عنها هي وليدة ممارسة سابقة تمكن السلوك المفرد من التحقق المعقول وتغتني في ذات الوقت من خلال كل تحقق.
- السميوز (السيرورة المنتجة للدلالة)
لقد نبهنا في مقالاتنا السابقة على أن الدلالة هي سيرورة وليست معطى جاهزا وسابقا على الفعل، فالسلوك السميائي ذاته ليس سوى خروج عن إكراهات البيولوجي والطبيعي والولوج إلى عالم ثقافي مفتوح على كل الاحتمالات. ( انظر الفصل الأول من هذا الكتاب : السميائيات وموضوعها). وبهذا المعنى فإن كل واقعة تستند، من أجل إنتاج دلالاتها، إلى سيرورة داخلية تجمع بين العناصر المكونة لها ضمن ترابط جدلي لا تنفصم عراه.
إن هذه السيرورة هي ما يطلق عليه في السميائيات السميوز ( بورس ) أو الوظيفة السميائية ( هالمسليف). استنادا إلى هذا التصور، فإن السميوز، أو التدليل، في تصور بورس هي ” السيرورة التي يشتغل من خلالها شيء ما كعلامة”، وتستدعي ثلاثة عناصر يُنظر إليها باعتبارها الحدود التي من خلالها تستقيم السيرورة وتتحول إلى نسق يتحكم في إنتاج الدلالات وتداولها. وكمثال على ذلك فإن كلمة ” شجرة” تدل لأنها تشتمل على العلاقات التالية :
1- متوالية صوتية تشتغل كتمثيل رمزي متعارف عليه عند مجموعة لغوية بعينها ( المجموعة اللغوية العربية في حالة كلمة ” شجرة”).
2- موضوع يستند إليه التمثيل من أجل إنتاج الصور الذهنية، وهو ما يشكل أساس المعرفة، فالمعرفة التي لا تستند إلى موضوع لا يمكن أن تكون معرفة.
3 – مفهوم يحول الموضوعات إلى صور ذهنية تغنينا عن الوقائع، وتمكننا من التخلص من ربقة ” الأنا” و” الهنا” و”الآن”.
إن الترابط بين العناصر الثلاثة، وفق تأليفات دلالية مفتوحة على كل الاحتمالات، هو ما يشكل المضمون الحقيقي للسميوز. فالسميوز لا تقف عند حدود رصد المعنى الأولى الذي يحيل عليه التمثيل من خلال إحالته الأولى، بل تشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات دون انقطاع إلى ما لا نهاية.
ولقد كان بورس أو من أدخل مفهوم السميوز إلى الدراسات السميائية الحديثة، وهو الذي جعل منه الحجر الأساس الذي تنبني عليه التصنيفات السميائية للعلامة كما هو مثبت في كتاباته المتعددة. فالسميوز سيرورة منفصلة عن مادة الدلالة، إنها المبدأ الذي يتحكم في إنتاج الدلالات وتداولها لا جوهرا مضمونيا. ولذلك فهي لا تكترث لمادة الدلالة كما لا تقتصر على الوقائع اللفظية، فكل الوقائع محكومة بقانون السميوز.
إن كل ما يُتداول ضمن الممارسة الإنسانية ويستعمل باعتباره علامة يشتغل باعتباره سيرورة سميوزية. وعلى هذا الأساس فإن، مفهوم العلامة في تصور بورس مثلا، لا يمكن أن ينفصل عن سيرورة السميوز، فخارج هذه السيرورة لن تحيل الوقائع إلا على تجربة صافية خالية من الفكر والقانون، وستنتفي بانتفاء الشروط التي أنتجتها.
ولقد كان بورس من السميائيين الأوائل الذين أدخلوا مفهوم السميوز إلى الدراسات السميائية الحديثة. فالعلامة التي تتكون من ماثول وموضوع ومؤول ليست سوى الوجه المرئي لسيرورة تخفي داخلها فعل الإدراك ذاته. فالذات الإنسانية تحتاج إلى سيرورة ( غير مرئية) لكي تحول الوقائع الموجوده في العالم الخارجي إلى مفاهيم تحل محل هذه الوقائع وتمنحها بعدها السميائي. ولهذا فإن السيرورة التدليلية ( السيموز) تشتغل هي الأخرى باعتبارها استعادة للمقولات الإدراكية التي يطلق عليها بورس ” المقولات الفينومينولوجية”.
وهذه المقولات هي التي تستند إليها الذات من أجل إدراك نفسها وإدراك العالم المحيط بها. فكل ما يجربه الإنسان وكل ما يؤثث كونه يدرك باعتباره تداخلا لمستويات ثلاثة : أول يحيل على ثان عبر ثالث ضمن سيرورة لامتناهية. فالأول وحده لا يشكل سوى أحاسيس ونوعيات مفصولة عن السياقات المخصوصة، أما الثاني فيحيل على الوجود الفعلي، إنه يحيل على الواقعة المادية كما هي باعتبارها تستوعب الأحاسيس والنوعيات من حيث كونها توفر الأسس المادية التي تتجسد فيها المعطيات الموصوفة في الأول.
أما الثالث فهو الذي يبرر العلاقة بين الأول والثاني، وهو الذي يحول التجربة إلى واقعة فكرية، وبدونه لا يمكن لهذا الوقائع أن تدرك استقبالا. فالعين لا تلتقط موضوعات مادة، بل تحتفظ بنسخة ثقافية منها.
إن هذه المعطيات هي التي تشكل عصب السميوز ومضمونها الحقيقي، فما ندركه نحن كدلالات مرئية يشكل في واقع الأمر الأساس الذي ينبني عليه إنتاج المعرفة : المعرفة الخاصة بالعالم الخارجي وطرق استيعابه من لدن الذات المدركة. وعلى هذا الأساس فإن التركيب الثلاثي للسميوز هو نفس الركيب الثلاثي الذي يتحكم في عملية إدراك العالم الخارجي.
- المعنى
استنادا إلى مفهوم المحايثة ومفهوم السميوز يمكن تناول المعنى وتحديد مداراته وأشكال تجليه. فالمعنى من المفاهيم التي تستعصي على التحديد والضبط. ورغم أن الاستعمال العادي لا يميز إلا نادرا بين المعنى والدلالة ( كما قد يحدث لنا نحن أيضا في هذا المقال نفسه)، فإن الفرق بينهما واسع وكبير.
ولا عجب أن نجد يالمسليف، وهو صاحب مدرسة قائمة الذات في التحليل الدلالي، يجعل من المعنى المادة التي تشتق منها الدلالات. وباعتباره كذلك، فإنه قريب من مفهوم “الشيء في ذاته” كما يتصوره كانط، فبالإمكان أن نتعرف على الطاولة من حيث الامتداد والمقاومة واللون والذوق ( وهي ما يحدد الشيء) ولكننا لا نستطيع قطعا التعرف على جوهر الطاولة باعتباره الشيء في ذاته.
ولعل هذا ما دفع گريماص مثلا إلى النظر إلى المعنى من زاويتين : ” أولا باعتباره ما يسمح بالقيام بعمليات الشرح والتسنينات التي تنقلنا من سنن إلى آخر، وثانيا باعتباره ما يؤسس النشاط الإنساني منظورا إليه كقصدية. فلا شيء يمكن أن يقال عن المعنى قبل أن تتم مفصلته على شكل دلالات”. (4)
ويضعنا هذا الأمر أمام تقابل جديد يصف العلاقة بين المعنى باعتباره مادة، وبين الدلالة باعتبارها شكلا لهذا المعنى ومشتقة منه. ولهذا فإن ما تدرسه السميائيات، في تصور گريماص على الأقل، ليس جواهر مضمونية مكتفية بذاتها؛ إنها تدرس، على النقيض من ذلك، أشكالا مضمونية، وهي ما يشير إلى التحققات الممكنة للمادة الأصلية ( ما نعرفه عن الخير ليس مادة، بل أشكال تتحقق في الصيغ التي يتم من خلالها تجسيد فكرة الخير).
أما داخل الاستقطاب الثنائي الشهير الذي يميز بين بعد تقريري وآخر إيحائي، فقد نُظر إلى المعنى من زاوية ضيقة جدا. فما يفهم بشكل مباشر من الواقعة دونما استعانة بشيء آخر يطلق عليه المعنى، في حين تعد الدلالات غير المعطاة بشكل مباشر معاني ثانية، أو دلالات مصدرها الثقافة والتاريخ، وهي دلالات يتم الحصول عليها من خلال تنشيط ذاكرة الواقعة والدفع بها إلى تسليم كل دلالاتها. ففي الحالة الأولى يطلق على المعنى التقرير، ويطلق عليه في الحالة الثانية الإيحاء.
وليس بعيدا عن ذلك ما نعثر عليه في التراث العربي حيث ميزت الشعرية العربية ممثلة في أحد رموزها الشامخة بين “المعنى” و”معنى المعنى”، فالكلام عند عبد القاهرالجرجاني مثلا على > ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وضرب آخر يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض (…) فها هنا عبارة مختصرة وهي أن نقول : ” المعنى” و” معنى المعنى”، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، و”بمعنى المعنى” أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر< (5).
فالمعنى الأول كما يتجلى من خلال فعل الإحالة الأولى هو الإحالة المباشرة التي تتم داخل العلامة وبشكل مباشر، أما معنى المعنى فهو الدلالة التي تشير إلى السياقات الممكنة التي تشتمل عليها العلامة.
وتلك هي المنطلقات الأساس التي انبنت عليها فكرة السميوز، أي السيرورة التي تشترطها الدلالات لكي توجد. فالأصل واحد، أي معنى معطى من خلال لحظة الإحالة الأولى، والامتدادات متنوعة. وهو أمر لا يخص كلمات اللسان فحسب، بل يشمل كل ما تنتجه الممارسة الإنسانية من أشياء وإيماءات أو كلمات أو طقوس.
وفي هذا المستوى يقف التدليل عند حدود رصد النفعي المباشر في السلوك الإنساني، أما في المستوى الثاني فيتم التخلص من العام المكره والضروري للإيغال في المحلي والثقافي والخاص. حينها تبرز قيمة المتعة التي تولدها الدلالات غير الإكراهية. في الحالة الأولى يشار إلى تأويل مباشر وعفوي، ويشار في الحالة الثانية إلى تأويل حيوي ينشط ذاكرة الكلمات والوقائع والموضوعات.
- الدلالة
تحيل الدلالة على مفهوم رئيس في تصور العلاقات بين الحدود المنتجة للقيم المضمونية وتداولها، ويتعلق الأمر ب”السيرورة”، فلا يمكن تصور ” كم معنوي” خارج مدار سيرورة تتمحور حول مفهوم العلاقة باعتبارها الحد الأساس في إنتاج أي نشاط دلالي. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم ” الدلالة مفهوم مركزي ينتظم حوله النشاط السميائي في مجمله “. (6) بل يمكن القول إن رصد شروط إنتاج الدلالة، هو رصد للضوابط الثقافية التي تشتغل كقوانين يتم استنادا إليها تأويل كل الوقائع.
وعلى هذا الأساس، إذا كان المعنى يشير، كما رأينا ذلك أعلاه، إلى كم مادي عديم الشكل وسابق على التمفصل، فإن الدلالة هي الناتج الصافي لهذه المادة وهي وجهه المتحقق. ولهذا فهي من جهة، ليست مفصولة عن شروط إنتاجها، فكل نسق له إرغاماته الخاصة، وله أنماطه في إنتاج دلالاته،(النصوص والصور والوقائع الاجتماعية والموضوعات …)، وليست مفصولة، من جهة ثانية، عن التدليل ذاته، فالدلالة ليست معطى جاهزا، بل هي حصيلة روابط تجمع بين أداة للتمثيل وبين شيء يوضع للتمثيل ضمن رابط ضروري يجمع بين التمثيل وما يوضع للتمثيل، أي ما يضمن الإحالة استقبالا على نفس الموضوع في حالاته المتنوعة.
ولأن الدلالة هي ” سيرورة لإنتاج المعنى” من خلال تحويله من طابعه المادي إلى أشكال مضمونية تدرك ضمن السياقات المتنوعة، فإنها ليست مفصولة عن حقل دلالي غني بمفاهيم تشير كلها إلى طبيعة هذه السيرورة وأنماط وجودها. وهكذا استنادا إلى مفهوم الدلالة تم نحت مجموعة من المفاهيم التي تحيل على نفس النشاط منظورا إليه في حالات تحققه المتنوعة من قبيل “الوظيفة السميائية” (يالمسليف)، و “السميوز (بورس) و”الاندلال” (بارث). وكلها مفاهيم تدل – ضمن سياقاتها النظرية الخاصة- على السيرورة والشروط التي تنتج ضمنها الآثار المعنوية.
وهذا أمر بالغ الأهمية، فالسيميائيات لا تبحث عن دلالات جاهزة أو معطاة بشكل سابق على الممارسة الإنسانية، إن السميائيات بحث في شروط الإنتاج والتداول والاستهلاك، مع كل ما يترتب عن ذلك من تصنيفات تطال الدلالة كما تطال السلوك الإنساني ذاته. فما يستهوي النشاط السميائي ليس المعنى المجرد والمعطى، فهذه مرحلة سابقة على الإنتاج السميائي، بل المعنى من حيث هو تحققات متنوعة ميزتها التمنع والاستعصاء على الضبط.
ولقد ارتبط مفهوم الدلالة عند بورس بمفهوم السميوز، وهو مفهوم يشير، من جهة، إلى القدرة على إنتاج دلالة ما استنادا إلى روابط صريحة هي ما يشكل جوهر العلامة وشرط وجودها، ويشير، من جهة ثانية، إلى سيرورة التأويل التي تعد إوالية ضمنية داخل أي سيرورة لإنتاج الدلالة. فبما أن الموضوع المطروح للتمثيل يتجاوز بالضرورة أداة التمثيل، فإن تصور إحالات متتالية تستعيد ما تم إهماله في الإحالة الأولى أمر ممكن، بل هو أمر ضروري. ومن هنا ارتبطت فكرة التأويل عند بورس بفكرة إنتاج الدلالة ذاتها. وهذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية.
- التأويل
إن مفهوم التأويل شديد الارتباط بالتصورالذي نملكه عن الدلالة وعن شروط وجودها وأشكال تحققها. فالمعطيات الأولية، في مجال اللسان على الأقل، تشير إلى أن الكلمة لا يمكن أن تقف عند حدود التعيين المحايد لمرجع موضوعي مستقل.
فبالإضافة إلى حالة التعيين هاته، تشتمل هذه الكلمة على مجموعة من السياقات المحتملة القابلة للتحيين مع أبسط تنشيط لذاكرتها. فالمعانم ( الوحدات الدلالية الصغرى ) تنقسم إلى قسمين : ما يحيل على جوهر الظاهرة وأصلها ( تثبيت حالة خاصة بالشيء الذي نحتت من أجله الكلمة )، وما يحيل على سياقات ضمنية هي من صلب الثقافي والذاتي أي ليست أصلية. ولعل أبسط التعابير الدالة على التأويل وضروراته هي الإجماع على القول بالتعددية الدلالية، سواء تعلق الأمر بالكلمة أو بالوقائع غير اللسانية.
وعلى هذا الأساس، إذا كان من الممكن الحديث عن وجود ثابت لكل ظاهرة، فإن الوجود الأصلي ” المحايد” في كل عملية تدليل يتشكل من العناصر المحددة للماهية الوجودية للظاهرة في ذاتها، وهي العناصر التي لا يمكن التصرف فيها دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالجوهر المحدد لهذه للظاهرة.
إن هذا المبدأ المحدد لوجود الظواهر قابل للتعميم على كل الأشكال التعبيرية والوظيفية التي يتوسل بها الإنسان من أجل التواصل وإنتاج الدلالات : هناك لحظة أولى للتعيين المرجعي ” المحايد”، وهناك لحظة ثانية خاصة بإنتاج الدلالات المرتبطة بخصوصية الفعل المندرج ضمن وضع ثقافي خاص. إن الوجود الأول يشير إلى المعنى المباشر الذي يمكن اعتباره قاسما مشتركا لكل الدلالات التي تتبناها مجموعة لغوية ما، في حين يمكن التعامل مع المعاني الثانية باعتبارها قيما مضافة تعد نتاجا للوضع الخاص للإبلاغ.
ولقد طور التقليد اللاهوتي الغربي تصورات غنية للتأويل ( الذي يطلق عليه عادة الهرمنطيقا). فلقد انبنى التأويل داخل هذا التقليد على وجود استقطاب ثنائي يجمع بين معنى خفي وآخر مباشر. فشراح الكتاب المقدس كانوا يتصورون أن الحدود اللغوية التي صيغ فيها هذا الكتاب تحتوي على معنى ظاهر، هو المعنى الحرفي، ومعنى خفي، هو سر الكلمات وجوهرها، ودور المؤول يكمن في الكشف عن المعنى الثاني لأنه هو الذي يحتوي على القصدية الحقيقية للذات الإلهة. ومن هنا كانت نظرية المعاني الأربعة ( المعني الحرفي والمعني الروحي والمعني المجازي والمعنى الأخلاقي ). فكلمات الله تحتاج إلى تدبر وتأويل لكي تسلم بعض أسرارها.
وهذا المعنى قريب جدا من السياق الذي يشير إلىه صاحب لسان العرب ( مادة أول) حيث ارتبط التأويل عنده بالتفقه وتدبر نصوص القرآن، ف> المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهراللفظ<.
إن هذه المعاني الثانية يجب التعامل معها باعتبارها منطلقا للبحث عن > حقيقة غائبة ومستعصية على الإدراك <. فحقيقة التأويل هي ربط المتحقق بكل الإحالات الممكنة. وفي هذه الحالة، فإن ما يمثل أمامنا باعتباره نسخة متحققة لا يشكل سوى ذريعة الهدف منها إطلاق العنان لدلالة منفلتة من عقالها قد لا تتوقف عند حد بعينه.
إلا أن التأويل باعتباره نشاطا معرفيا لم يعد محصورا ضمن حدود هذا الاستقطاب الثنائى، كما لم يعد يبحث في النصوص الدينية عن سر أو أسرار تختفي في تلابيب المعني الحرفي، لقد أصبح التأويل نشاطا ضروريا تستند إليه كل العلوم الإنسانية من أجل فهم أفضل للتراث الإنساني قديمه وحديثه. وفي هذه الحالة، فإن التأويل لن يكون مجرد تحديد لمعنى لا يُرى بشكل مباشر، إنه حالة وعي فلسفي لا ترى في المحدد بشكل مباشر سوى حالات رمزية تحتوي هذه المرة على ” أسرار الإنسان” الثقافية والاجتماعية والدينية. وهي أسرار يجب الكشف عنها من خلال امتلاك المفاتيح الضرورية للتأويل.
ولقد قسم إمبيرتو إيكو (7)التأويل إلى تيارين كبيرين :
– تيار يرى في التأويل فعلا حرا لا يخضع لأية ضوابط أوحدود. فالسيرورة التأويلية تتطور خارج قوانين انسجام الخطاب أو تماسكه الداخلي. > فمن حق العلامة أن تحدد قراءتها حتى ولو ضاعت اللحظة التي أنتجت ضمنها إلى الأبد، أو جهل ما يود الكاتب قوله، فالعلامة تسلم أمرها لمتاهتها الأصلية > (8).
وفي هذه الحالة، فإن التخلص من اللحظة التلفظية الأولى سيقود القراءة إلى استحضار كل التأويلات الممكنة استنادا فقط إلى رابط دلالي يفصل بين المعرفة التي تقدمها العلامة في حالتها البدئية وبين المعرفة التي تقترحها المدلولات التالية الناتجة عن فعل ( أو أفعال ) التأويل.
– وهناك تيار ثان يعترف بتعددية القراءات ولكنه يسجل في الوقت ذاته محدوديتها من حيث العدد والحجم وأشكال التحقق. فعلى الرغم من تسجيل أحقية النص في التمنع والتردد في تسليم أسراره، فرننا لا يمكن أن نتجاهل أنه يحتوي على مجموعة من ” التعليمات الضرورية ” التي توجه قراءاته الممكنة. فنحن لا نؤول خارج كل الغايات، إن التأويل مرتبط بغاية، وهي”غاية توجد خارج السميوز ” كما يقول بورس.
وهذه الغايات هي التي تجعلنا نقبل ببعض التأويلات ونرفض أخرى، أو قد نقبل بها في هذا السياق ونرفضها في سياق آخر. وعلى هذا الأساس يجب الحديث عن سيرورات تقودنا إلى نسج علاقات غير مرئية من خلال التجلي المباشر للنص. وهذه العلاقات لا قيمة لها إلا داخل هذه السيرورة، فأي تغيير يلحق هذه السيرورة سيؤدي إلى بروز علاقات جديدة بدلالات جديدة.
ويمكن القول، في جميع الحالات، إن التأويل ليس ترفا ولا يمكن أن يكون إضافة غير ضرورية لفعل إنتاج الدلالات، إنه على العكس من ذلك حاجة إنسانية، من خلاله يتخلص الإنسان من إكراهات النفعي المباشر .
- مستويات الدلالة
لقد خلصنا إلى القول في الفقرة السابقة إلى أن التأويل يشكل حاجة ضرورية تتطلبها الأبعاد المتعددة للكائن الإنساني ذاته. ولهذا يجب التعامل معه باعتباره يندرج – في السميائيات على الأقل- ضمن ما نطلق عليه ” التنويع الدلالي”. والتنويع الدلالي ذاته يعبر عن استقطاب ثنائي يميز الذات الإنسانية عن غيرها من الكائنات الحية.
فتعريف هذه الذات يشير إلى أن الإنسان موزع في وجوده بين حاجتين : ما يعود إلى النفعي المباشر والصريح، وهو نشاط مرتبط بتلبية الحاجات الحياتية الأولية، وما يعود إلى لحظات توجد خارج النفعي، وتشير إلي المتعة واللذة وكل ما يمكن الذات من التخلص من ربقة الغريزي وإكراهات النفعي.
وهذا الاستقطاب هو ما أطلقنا عليه في الفقرة السابقة الوجود الأصلي للظاهرة، لكي نميزه عن العناصر الإضافية التي تعلق بالفعل ضمن حالات ثقافية بعينها. وهذا ما ينعكس على فعل الوصف والتعيين وكل الأنشطة المنتجة للمعاني المباشرة. فنحن نميز بين اللحظة الخاصة بالتعيين المرجعي ” المحايد”، وبين اللحظة المنتجة لدلالات إضافية تستجيب لحاجات لا علاقة لها بالجوانب النفعية والغريزية المباشرة.
وعلى هذا الأساس وجب الفصل بين مستوى دلالي يكتفي بإنتاج وحدات قيمية من طبيعة تعيينية، وبين مستوى ثان يشير إلي قيم مضافة تدرج الفعل الإنساني ضمن وضع ثقافي خاص. ونطلق على المستوى الأول التقرير( dénotation) ونطلق على المستوى الثاني الإيحاء ( connotation).
فالتقرير من زاوية لسانية ” هو قدرة العلامة على الإحالة على قسم من الأشياء، ما يشكل مجموع السمات المعنوية التي تسمح لنا بتسمية مرجع ما ( التسنين ) والتعرف عليه ( فك التسنين )، أي تحديد مجموع الوحدات ذات الطابع التعريفي البحت “. (9) وبهذا المعنى فإن التقرير يُنظر إليه باعتباره معنى أساسيا داخل الواقعة الإبلاغية، فلا يمكن للتواصل أن يتم في غياب وحدات تقريرية صريحة.
وهو أمر يعد نقيضا للحالة التي يعينها الإيحاء، فالإيحاء، على العكس من ذلك، يتشكل من وحدات “عرضية” و”خجولة” و” محتشمة”، عادة ما يُنظر إليها باعتبارها قيما ثانوية ولا تدرك ضمن السجل التعييني للمراجع الخارجية، بل تستدعي استحضار النص الثقافي الذي تستعمل داخله.
استنادا إلى هذا التمييز، فإن إمكانات التنويع الدلالي المستند إلى أصل ثابت يشكل ما يطلق عليه في الأدبيات السميائية مستويات للدلالة. والحديث عن “المستويات” معناه الأقرار صراحة بعدم وجود ظاهرة تدل من خلال مستوى واحد، وفي هذه الحالة يستحيل الحديث عن معنى واحد ووحيد، لأن ذلك مناف لطبيعة المعنى ذاته، فتصور مدلول نهائي كلي وثابت يسير في الاتجاه المعاكس للمعنى كما يقول ر. بارث. ومن ثم، فإن هذه المستويات تشير إلى وجود مسار تأويلي يقود من الأصل الأول المشترك إلى العنصر الموغل في الخصوصية لارتباطه بسياق ثقافي هو الذي يمنحه كامل دلالاته.
ومن هذا المنطلق، فإن التقرير يشكل، بعبارات بسيطة، الحد الأدنى الدلالي الذي يسمح بتحديد شكل أولي سيكون هو المنطلق نحو تحديد الأشكال الدلالية الثانوية والعرضية. إن هذا الأمر لا يتعلق فقط باللسان وقوانينه، إنه يتجاوز هذا النسق الإبلاغي ليشمل كل الظواهر الأخرى. فالبعد الدلالي داخل الجسد الإنساني مثلا يتحدد من خلال مجموعة من الإيماءات التي لا تقوم إلا بضمان استمراريته في الوجود وهو ما نطلق عليه المستوى النفعي الذي يستجيب للحاجات الأولية التي يتطلبها الاستمرار في الحياة.
إلا أنه بالإمكان الحديث عن أبعاد أخرى هي الأبعاد الثقافية المشكلة لمستوى دلالي ثان، ولا تدرك هذه الأبعاد إلا من خلال تحديد المضمون الثقافي الذي تؤول عبره. ونفس الشيء يمكن قوله عن الصورة واللوحة ومجمل الموضوعات التي تؤثث هذا العالم.
وإذا أخذنا اللسان في الاعتبار- لكونه يمثل أرقى شكل داخل الأنساق التواصلية والدلالية- فإن نسق اللغة التقريرية سيكون هو الأصل وهو المنطلق. إنه كذلك لأنه يشكل القاعدة الثابتة لكل الدلالات التي تمنح لعلامة لسانية ما. فما دامت المعاني الثانية هي، بتعبير أوراكشيوني، قيم إضافية تمنح للوحدات اللسانية (10)، فإن وجود نواة دائمة أمر في غاية الأهمية.
فتعريف كلمة ما يشكل المدخل الثابت الذي تنضاف إليه المعاني الأخرى، أي ما يشكل السياقات التي ستشكل لاحقا الذاكرة الحية لهذه الوحدة اللسانية. فأن تدل الشجرة مثلا على الأصل أو على الخصوبة أو على رموز دينية أخرى، فإن ما هو أساس في كل هذه الدلالات يتشكل من المدخل الأول الذي يغذي مجمل التحققات الأخرى، أي وجود معنى تقريري سيظل ثابتا ضمن النسق الدلالي للسان ما. إن الوحدات الإيحائية، بتعبير استعاري، هي محميات دلالية نهرع إليها كلما حاصرتنا الحياة بمقتضياتها النفعيةالجافة والروتينية.
- الرمز
لعل أكثر استعمالات الرمز شيوعا هي تلك التي تستند إلى صور تناظرية تربط بين وحدات مجردة وأخرى محسوسة، تنوب فيها الثانية عن الأولى وتقوم مقامها. وفي هذه الحالة ينظر إلى الرمز باعتباره صورة دالة تستعمل للإحالة على مدلول يقابلها عن طريق العرف والتواضع ( الميزان للدلالة على العدل والحمامة للدلالة على السلم …).
ولقد أسهمت الأنتروبولوجيا المعاصرة في الكشف عن الكثير من أبعاد هذا التصور وقدرته على إجلاء الكثير من الأسرار الثقافية والحضارية الخاصة برحلة الإنسان على الأرض. فلقد أودع الإنسان، وهو يتلمس طريقه وسط غابة من الظواهرالطبيعية والاجتماعية غير المفهومة، الكثير من الأشياء قيما دلالية تكشف عن نمط حضوره في هذا الكون.
إن الرمز، من هذه الزاوية، يشير إلى الدلالات التي يمكن أن تتسرب في غفلة منا إلى الكلمات والأشياء والطقوس والحركات. إنه فعل يمنح الأشياء أبعادا تخرجها عن دائرة الوظيفية والاستعمال إلى ما يشكل عمقا دلاليا يحولها إلى رموز لحالات إنسانية.
ووفق هذه السيرورة فإن كل شيء يمكن أن يصبح رمزا لحالة إنسانية وفق شروط ثقافية بعينها، يكفي في ذلك أن نحدد الرابط الدلالي الذي يمَكن من الانتقال من العنصر الرامز إلى العنصر المرموز له. فاليأس والأمل والحب والتشاؤم والشجاعة والنبل كلها مفاهيم انتقلت من مواقعها المجردة لكي تسكن أشياء وأشكالا وألوانا وسلوكات.
إن الرمز من هذه الزاوية يعبر عن ميل الإنسان الشديد إلى تحويل حقائق أو أحكام مجردة إلى كيانات مجسدة من خلال أشياء أو سلوكات محسوسة. فالصليب هو رمز للمسيحية والهلال رمز للإسلام والحمامة رمز للسلام والذهب رمز للنقاء. ويمكن أن نأتي بحالات أخرى تهم أشياء ومجالات متعددة، فيصبح الكلب إثر ذلك رمزا للوفاء والأسد رمزا للشجاعة والثعلب للدهاء والغراب للشؤم وهكذا دواليك. والخلاصة أن العبور من المجرد إلى المحسوس لا يتحقق إلا من خلال الرمز وداخله.
إن هذا التعريف بالغ الدلالة، فهو يشير إلى مرحلة كانت النظرة التناظرية إلى الكون هي أساس كل معارفنا السابقة على الفكر العلمي. فالفكر التناظري الشعبي هو الذي يفسر هذا السيل من التقابلات بين كيانات محسوسة وأخرى مغرقة في التجريد. فما يستعصي على الضبط العلمي، يعوض بكيانات ترصد المفهومي المجرد من خلال الواقعة المحسوسة. فالتشابه بين الأسد والشجاعة وبين الدهاء والثعلب، وبين الصليب والمسيحية لا يمكن الحصول عليه من خلال برهنة علمية، بل هو تشابه مفترض يقود إلى ربط سلوك ممكن للأسد وبين صورة مثلى للشجاعة.
ويعتبر إرنست كسيرير ( فيلسوف ألماني 1874 – 1945) من الفلاسفة الأوائل الذين أشاروا إلى تصور جديد للرمز من خلال محاولة تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين الإنسان وعالمه الخارجي. فعلاقتنا بهذا العالم، كما يرى هذا الفيلسوف، ليست مباشرة، ولا يمكن أن تكون مجرد رابط آلي يجمع ذاتا بموضوع.
فما يفصل الإنسان عن عالمه ليس حواجز مادية تتشكل من الأشياء والموضوعات، بل هو الطريقة التي تتم بها صياغة الواقع صياغة ثقافية تنزع عنه أبعاده المادية لتكسوه بطبقة من الرموز هي ما نعرف عنه وما ندرك في نهاية المطاف.
فلم يتخلص الإنسان من المملكة الحيوانية ويتجاوز دائرة الإمساك اللحظي بالأشياء والظواهر، لكي يلج عالم الثقافة إلا عندما بلور، إلى جانب العلامات ( الإرث المشترك بينه وبين باقي الكائنات الأخرى ) فعالية جديدة يطلق عليها كاسيرير الوظيفة الرمزية.
وعلى هذا الأساس، فإن اللغة والدين والأسطورة والخرافة وكل السلوكات الثقافية هي أشكال رمزية تقوم، لحظة إدراكها لما يوجد خارجها، بدورالوسيط بين الإنسان وعالمه الخارجي. لهذا فإن كاسيرير لا يتردد في تعريف الإنسان بأنه كائن رمزي، فهو لايعيش الواقع في ماديته، بل يعيش ضمن بعد جديد للواقع هو البعد الرمزي (11) .
فهو يحيط كينونته ويداريها داخل سلسلة لا متناهية من الرموز. وبعبارة دقيقة، >إن السلوك الإنساني هو سلوك رمزي في جوهره، ولا يمكن للسلوك الرمزي أن يكون سوى إنساني <. وبهذا المعنى، فإن الثقافة ذاتها ليست سوى نسيج مركب من الأنظمة الرمزية على حد تعبير كلود ليفي شترواس.
والواقع أن الأمر لا يتوقف عند حدود إدراك ما يوجد خارج الذات الإنسانية، بل يتجاوزه إلى تحديد طبيعة الدلالات ذاتها. فلا يبدو أن كاسيرير كان منشغلا بتعريف الرمز في ذاته أو في علاقته بالظواهر الإبلاغية الأخرى.
فما كان يشغل باله هو الطريقة التي ينتج بها الإنسان معانيه من خلال منحه للأشياء دلالات معينة. فما يصدر عن الإنسان وما يجربه وما يحيط به ليس أشياء معزولة تتخبط في ماديتها، بل إحالات رمزية على دلالات بالغة التنوع.
فالمعنى لا يوجد في الشيء وليس محايثا له، إنه حصيلة ما يودعه الإنسان هذه الأشياء من قيم ثقافية هي ما يشكل الذاكرة الإنسانية للكون. فمن > خلال الرمز وداخله استطاع الإنسان أن ينظم تجربته في انفصال عن العالم.
وهذا ما جنبه التيه في اللحظة، وحماه من الانغماس في مباشرية الـ “الهنا” والـ” الآن” داخل عالم بلا أفق ولا ماضي ولا مستقبل. فكما أن الأداة ( outil) هي انفصال عن الموضوع، فإن الرمز هو انفصال عن الواقع <( 12).
وليست الدلالة وطرق إنتاجها وسبل تداولها سوى حصيلة حركة ” ترميزية” قادت الإنسان إلى التخلص من عبء الأشياء والتجارب والزمان والفضاء.
استنادا إلى هذا الاختلاف بين عمومية الظاهرة وطبيعة الدلالات التي تنتجها الظواهر المختلفة، يمكن القول إننا بمجرد ما نغادر التصور الذي يجعل من السلوك الإنساني في رمته سلوكا رمزيا ( وهو تصور نسبي لأن هناك في السلوك الإنساني ما يحيل على أبعاد طبيعية خالية من أي حكم ثقافي مسبق )، نكون مضطرين إلى التمييز بين ما ينتمي إلى الرمز، وما ينتمي إلى ظواهر دلالية أخرى لها طبيعتها ووظيفتها وأشكال وجودها.
فعلى الرغم من الأهمية الإبستمولوجية الكبيرة للتعريف الذي يقدمه لنا كاسيرير، فإنه لا يمكن أن يشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها من أجل التمييز بين الدلالات وتصنيفها. وهذا ما ستحاول اللسانيات ومن بعدها السميائيات القيام به.
فالمعروف أن الإحالات على المعاني ليست واحدة وتختلف من علامة إلى أخرى. فعلى الرغم من أن الدلالات لا تكترث للمادة الحاملة لها، فإن أشكال وجود هذه الدلالات لا يمكن أن تكون مفصولة عن السيرورة المولدة لها. فالأيقون يستند، من أجل إنتاج دلالاته، إلى التشابه. والمعرفة التي تأتينا عبر الأمارة تستند إلى إجراء استدلالي يتخذ من التجاور منطلقا له. في حين تحيل العلامة اللسانية على مدلولها عن طريق الاعتباط، فلا رابط عقلي بين المتوالية الصوتية والمدلول الذي نملكه عن شيء ما.
ولعل هذا ما يفسر التردد الذي عبر عنه سوسير وهو يبحث عن تسمية للوحدات اللسانية بين استعماله لكلمة “رمز” أو كلمة “علامة”. وسيتبنى كلمة ” علامة” مستبعدا كلمة رمز لأن الرمز في نظره ليس فارغا، فهو يشير إلى بقايا تعليلية تجعل من إحالة الدال على المدلول إحالة محكومة بمبدإ التعليل، في حين أن اللسان في جوهره ظاهرة اعتباطية. فالميزان الذي هو رمز للعدالة لا يمكن أن نعوضه بأي شيء آخر، دبابة مثلا (13)
لقد كان سوسير يدرك أن الأمر مع الرموز لا يتعلق بعلامات تملك وجودا يمنحها إمكانية اكتساب دلالات متنوعة وفق اندراجها ضمن هذا السياق أو ذاك، فالرمز، في اشتغاله ووجوده، إحالة على سياقات ثقافية هي وحدها التي تجعل من هذه العلامة أو من هذا الشيء رمزا وتنفي هذه الصفة عن علامة أخرى.
وعلى النقيض من الرموز، فالعلامات وثيقة الصلة بالاستعمالات، وأي تغيير للسياق هو في واقع الأمر إحالة على مدلول لم يكن متوقعا في لحظة التمثيل الأولى. وكما كان يقول فتغنشتاين، لا وجود لعلامات، هناك فقط استعمالات، والاستعمالات هي سلسلة من السياقات التي تشير إليها الحاجات الإنسانية المتنوعة.
وهذا بالضبط ما يجب الوقوف عنده من أجل التمييز بين العلامة كما هي محددة في اللسانيات والسميائيات وبين الرمز في استعمالاته الانتروبولوجية والتحليل النفسي مثلا. فالعلامة تشير إلى شيء ( أو على الأقل تحيل على التصور الذي نملكه عن شيء ما)، وفي هذه الحالة، فإن المعنى معطى من خلال تجلي العلامة ذاتها.
فلا شيء يمكن أن يقف حاجزا بين العلامة ومعانيها، ف”السقوط ” هو السقوط قبل أن يصبح دالا من خلال إحالة رمزية على حالة نفسية تشير إلى التخلي أوالاستسلام أو الرذيلة. في حين لا يسلم الرمز دلالاته بسهوله، فهو من جهة شيء محسوس له وجود في ذاته بعيدا عن أية دلالة ( الصليب شيء قبل أن يكون رمزا للمسيحية أو التضحية )،
وهو من جهة ثانية مرتبط بثقافة، أي بالمجموعة البشرية التي تستعمله. فإذا كانت العلامة اللغوية /أسود/ تحيل على ما يفيد رتبة من رتب الألوان، فإنها لن تصبح رمزا للحزن أو الحداد سوى عند المجموعة البشرية التي تستعملها، فهي وحدها تمنح للسواد قيمته الرمزية، ودليلنا في ذلك أننا نحن المغاربة لا نتشح بالسواد لكي نعبر عن أحزاننا، ربما لأننا نتوفر على طرق أخرى للتعبير عن هذا الإحساس.
ويمكن الحديث في هذا السياق عن الرمز عندما ” تنتج اللغة علامات من درجة مركبة حيث لا يكتفي المعنى بتعيين شيء ما بل يعين معنى آخر لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال غاياته”. (14)
وفي هذا السياق يشير مجدي وهبة في قاموسه إلى قدرة الرمز على إنتاج دلالاته من خلال كل المحسنات البلاغية، فهو ” يشمل أنواع المجاز المرسل والتشبيه والاستعارة بما فيها من علاقات دلالية معقدة بين الأشياء بعضها ببعض”.
ومن جانب آخر فإنه يميزه عن العلامة التي ترتبط في وجودها الأصلي بدلالة واحدة، فالعلامة ليس لها” سوى دلالة واحدة لا تقبل التنويع ولا يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر ما دام المجتمع قد تواضع عليها، فالمصباح الأحمر في الطريق تعارف الناس على أنه إشارة إلى معنى ” قف” وليس له معنى آخر. أما إذا علق على باب بيت في بعض المجتمعات فيدل على أنه بيت دعارة.
وعلى الرغم من اختلاف معناه بحسب المكان الذي يوجد فيه، إلا أنه في كل مكان على حدة لا يعني سوى أمر واحد”. (15)
أما بالنسبة لشارل ساندرس بورس، فالأمر على خلاف ذلك. فالرمز عنده يدخل ضمن الثلاثية الثانية الخاصة بالتوزيع الذي تخضع له العلامة في مستوياتها الثلاثة : الماثول والموضوع والمؤول. ومن هذه الزاوية فهو مرتبط بالموضوع، أي بما يشكل موضوعا لإحالة الماثول على شيء ما في العالم الخارجي.
لذلك فهو يصنف ضمن الثانيانية التي تشمل الموجودات الفعلية. ويدرج ضمن هذه الثلاثية ثلاثة أقسام من العلامات : الأيقون والأمارة والرمز. والرمز يشكل قسما خاصا يختلف عن القسمين الأول والثاني من حيث كونه يعتبر علامة اعتباطية قائمة عل العرف. فالرمز يحيل على موضوعه استنادا إلى قانون.
ولهذا فهو ينحدر من طبيعة عامة ومجردة، إنه ينتمي إلى مقولة الثالثانية، والثالثانية في تصور بورس هي مقولة الفكر والضرورة والقانون الذي يحكم الوقائع استقبالا. ومن خلال وضعه هذا فإنه لا يستند إلى حدث ولا إلى نوعيات أو أحاسيس لكي يوجد، بل يكتفي بالإشارة إلى القانون والضرورة اللذين بموجبهما يحيل شيء ما على شيء آخر.
ولهذا فإن العلاقة القائمة بين الماثول الرمزي وموضوعه لا تستند إلى التشابه ولا إلى التجاور، بل تستند إلى العرف الاجتماعي الذي يعد قانونا وقاعدة. ولهذا فإن > الرمز هو ماثول يكمن طابعه التمثيلي في كونه قاعدة تحدد مؤوله. فكل الكلمات والجمل والكتب وكل العلامات العرفية الأخرى تشتغل كرموز. فنحن نتحدث عن كتابة أو نطق كلمة “رجل ” و لكننا في واقع الأمر لا ننطق ولا نكتب إلا نسخة أو تجسيدا لهذه الكلمة”.(16)
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الرمز هو تجسيد لرابط دلالي بين عنصرين، ويعد هذا الرابط عنصرا ثابتا داخل ثقافة ما، وذلك لاعتباطيته. فالأمة تنتقي رموزها استنادا إلى قاعدة عرفية لا إلى منطق أو استدلال عقلي. ( حالات التعبير عن الحزن المشار إليها ).
فالرمز على خلاف الأيقون ( دلالة قائمة على التشابه) والأمارة ( دلالة قائمة على التجاور)، يقوم بإرساء قاعدة عرفية يتم على أساسها تداول المعرفة والسلوكات بين أفراد الأمة الواحدة، أو ربما بين أفراد المجموعة السكانية الواحدة فقط، فقد يحدث ألا يكون الرمز مشتركا بين أفراد الوطن الواحد.
فإذا كانت علاقة الماثول ( وهو ما يقابل الدال في التصورالسوسيري ) بموضوعه ( المرجع في التصور السوسيري) داخل العلامة الأيقونية قائمة على التشابه، وإذا كانت هذه العلاقة داخل العلامة الأمارية قائمة على التجاور الوجودي، فإن العلاقة داخل العلامة الرمزية من طبيعة عرفية.
فالأمم والشعوب تخلق، انطلاقا من تجربتها، سلسلة من الرموز تستعيد عبرها قيم تاريخها، فتسقط من خلالها المستقبل وتفهم من خلالها الحاضر. ومن هذه الزاوية فإن ” الماثول الرمزي نفسه من طبيعة عامة أو هو قانون أو علامة قانونية. إنه ليس فقط عاما ومجردا ومحروما من أي سياق، ولكن موضوعه أيضا يجب أن يكون من طبيعة عامة : أي مفهوما”.(17)
ولهذا، وكما كان الحال مع كاسيرير، فإن بورس يرى في الرمز أداة حاسمة في تنظيم التحربة الإنسانية. فلكي تُبلغ هذه التجربة وتصبح عامة وكونية تحتاج إلى أن تصب في أبعاد رمزية. ” فالرمز يمكن الإنسان من التخلص من التجربة الظرفية والمباشرة، كما يمكنه من التخلص من الكون المغلق للتناظرات. فمن خلال الرمز تتسرب ذاكرة الإنسان إلى اللغة، وعبره يدرج الإنسان رغبته ضمن أفق مشاريعه الخاصة “(18).
- الهوامش
1- A J Greimas : Sémantique structurale, éd, Larousse, Paris , 1966,p.5
2- André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article Immanence
3- انظر Tzvetan Todorov : Théorie du symbole , éd Seuil , 1977, pp 34 et suiv
4-A J Greimas, J Courtès , Dictionnaire raisonné de la théorie du langage , sens
5- عبد القاهرالجرجاني : دلائل الإعجاز، منشورات مكتبة الخانجي،القاهرة 1984، صص 264 – 265
6- A J Greimas, J Courtès , op cit, signification
7- انظر أمبيرتو إيكو : التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنگراد، المركز الثقافي العربي، 2000
8- دريدا ذكره إيكو المرجع السابق ص 132
9- Catherine Kerbrat-orecchioni : La connotation , éd P U L , 1977, p 12
10- نفسه ص 12
11- Ernest Cassirer : Essai sur l’homme, ed minuit, 1975, p . 43
12- Jean Molino : interpréter, in L’interprétation des textes , ed minuit, 1989, p. 32
13- Ferdinand De Saussure : Cours de liguistique générale , ed Payot, 1972 , p .101
14- Paul Ricoeur : De l’interprétation, Essai sur Freud, éd Seuil, 1965, p. 26
15 – ومجدي وهبة : قاموس الألفاظ الأدبية، مدخل رمز
16- Charles Sanders Peirce : Ecrits sur le signe, éd Seuil , 1978 , P .161
17- Enrico Carontini : L’Action du signe, éd Cabay, Brux-elles, 1983 , p. 44
18- C . S . Peirce : Ecrits sur le signe, éd Seuil , 1978 , P .141