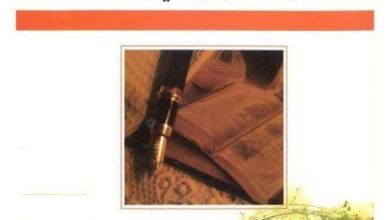“الحريم اللغوي”: عندما تصبح اللغة أداة تمثيل وهيمنة رمزية
"اللغة" .. سجن النساء

صدر للأستاذة يسرى مقدم، عن شركة المطبوعات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، كتابا جديدا يحمل عنوانا بالغ الدلالة: “الحريم اللغوي“(1)، وهو الكتاب الثاني الذي تخصصه الكاتبة لدراسة قضية من أشد القضايا تعقيدا. يتعلق الأمر بنمط اشتغال اللغة وآلياتها في تمثيل الوجود من حيث هو موجود في اللغة وبها، ومن خلالها يُعرف ويُتداول ويُستهلك.
فقد سبق أن أصدرت كتابا آخر حول الثيمة نفسها بعنوان: “مؤنث الرواية”، تناولت فيه بعض القضايا الخاصة بتمثيل “التجربة النسوية“، كما يمكن الكشف عنها في قطاع مخصوص هو قطاع الإنتاج الأدبي، والسرد الروائي في المقام الأول.
ولهذا الاهتمام ما يبرره، فلا شيء يمكن أن يستقيم خارج اللغة وبدونها، فهي” سر يفشي كل الأسرار …. ووجود يمتلئ بوجودنا” ( ص20)، لذلك لا نستطيع معرفة العالم إلا من خلال ما يسمح به اللسان ويجيزه، بل إن إمساكنا بالمدرك الواقعي لا يتم إلا من خلال التوسط الرمزي، أي اللسان،
وهو أرقى الأشكال الرمزية التي مكنت الإنسان من التخلص من طبيعة خرساء تكتفي بإعادة إنتاج نفسها، لينتج تاريخه الخاص. لذلك، فإن ما تقوله اللغة ليس وصفا لعالم معطى خارج الذات، إنها تمسك بمعرفة تخص هذا الواقع. فما يتسلل إلى اللغة هي رؤيتنا للأشياء لا الأشياء فحسب.
وما يميز هذا النص الممتع حقا هو رؤيته التحليلية الجديدة التي تجعل الواقعة اللغوية منطلقا للحجاج لا الموقف الإيديولوجي المسبق، فلا قيمة للإيديولوجيا خارج محدداتها في الوقائع الثقافية المجسدة، بما فيها الاستعمالات الرمزية للأشياء والأفعال التي تقود إلى تحديد دوائر المؤنث والمذكر استنادا إلى فكر تناظري “شعبي” لا حظ له من العلم. وهذه الروح هي التي أضفت على هذا الكتاب صبغة علمية ومنحته قوة حجاجية من الصعب التشكيك فيها أو الرد عليها خارج ما يمكن أن تسنده اللغة ذاتها.
يتوزع الكتاب على مجموعة من المباحث تروم جميعها الكشف عن آليات الوجود النسائي في اللغة بكل امتداداتها فيما هو أبعد من التصنيف والتسمية والفصل بين الظواهر. والأمر لا يتعلق بالإحالة على ما يميز المرأة عن الرجل في التركيبة البيولوجية أو المظهر الخارجي، أو ما يفصل بينهما في اللغة ذاتها من حيث وجود ضمائر دالة على متكلم بعينه.
إنها تتناول اللغة باعتبارها حاضنة، من خلال التمثيل ذاته، لدوائر ثقافية/رمزية تتجاوز الفصل البيولوجي لكي تسرب إيديولوجيا قائمة الذات يتحدد وفقها موقع المذكر والمؤنث ضمن دينامية التبادل الاجتماعي وتوزيع الوظائف داخله.
بل إن الوجود النسائي الرمزي،كما تؤكد ذلك المؤلفة، يبدو أكثر حضورا في الوعي اللغوي من حضوره في الواقع، فزمن اللغة غير زمن الأشياء، فما يتسلل إليها يستعصي عادة على الحذف والإلغاء. “فالعادات اللسانية هي دائما أعراض أساسية لأحاسيس لم يتم التعبير عنها” على حد تعبير أمبيرتو إيكو.
لذلك فانتفاء شروط القهر والدونية والسلبية ( اليافطات القانونية والسياسية التي تدعو إلى حق المرأة في الوجود الكامل) لم يعلن عن انتفاء ذلك في الذهنيات، فاللغة حمالة لاضطهاد من نوع آخر يجعل الأصل مذكرا والفرع مؤنثا.
لذلك، فما هو أساسي في تصور المؤلفة، وفي تصور كل باحث يتمتع بقدر بسيط من الحس السليم، ليس وجود المؤنث في ذاته في اللغة وخارجها، فمن حق كل لغة أن تبني قواعدها استنادا إلى تقطيع الامتداد الزمني والفضائي والفصل بين الظواهر والأشياء، ومنها الفصل بين الضمائر المحددة للواحد والمتعدد والجامد والحي والغائب والحاضر، إن الأساسي في تحليل الظاهرة اللغوية هو الكشف عن الأسباب غير اللسانية التي تبرر وجود هذا المؤنث داخل اللغة وخارجها.
ذلك أن المؤنث ليس خانة للتصنيف يضع المرأة مقابلا لما ليس هي. فقد جاء في لسان العرب التعريف التالي: “الأنثى خلاف الذكر في كل شيء، والذكر خلاف الأنثى”، وهو تعريف طوطولوجي في ظاهره، لأنه لا يزيدنا معرفة بالرجل والمرأة، ولكنه تمييزي عنصري في عمقه؛ فالخلاف المشار إليه في تعريف المذكر والمؤنث على حد سواء لا يعني التمييز من خلال التساوي بين كائنين مختلفين فعلا.
بل هو كذلك من خلال مفاضلة أحدهما على الآخر. وانطلاقا من تمييز المفاضلة هذا حاولت المؤلفة إعادة صياغة الإشكالية من خلال حدود جديدة تشكك في التمييز الأصلي وتنسف كل الأسس التي قام عليها. ومن أجل ذلك رصدت وجود بعدين رئيسيين عبرت عنهما بلغتها الخاصة من خلال الفصل بين القوي والضعيف، وبين الأساسي والتابع:
1- فالمرأة، في نظر النحاة ومشتقاتهم، ضعيفة بالطبيعة لا بالاكتساب، فهي كذلك وتبقى إلى الأبد، ومن هذا الضعف استمدت صفتها تلك، فهي أنثى لأن الأنيث في اللغة هو الضعيف والسهل والمنبسط وغير القاطع (فالمرأة سميت أنثى من البلد الأنيث على زعم ابن الأعرابي).
في حين أن المذكر دال بالضرورة على القوة قبل أن يكون دالا على الذكر من ناحية النوع ( “فالرجل الذكر واليوم المذكر والسيف الذكر والقول الذكر والفلاة المذكار التي لا يدخلها إلا الذكر من الرجال”، كلها صفات دالة على قيمة دلالية واحدة تقابل بين الضعف والقوة كما هو ثابت في لسان العرب). إن الأمر يتعلق في واقع الأمر بتقابل يجمع بين السلبي والإيجابي، بين الفاعل والمنفعل، بين السابق واللاحق.
فنحن في الحالتين معا، كما تؤكد ذلك المؤلفة بلغتها “النضالية” المتميزة، أمام سلسلة من التحديدات المنفتحة على سياقات بالغة التنوع قد تشمل الاستعمالات الاستعارية لأشياء الكون وكائناته ذاتها. فسواء تعلق الأمر بالذكر أو بالأنثى، فإن هذه السياقات، رغم تنوعها وتعددها واختلافها، لن تحيل في نهاية الأمر سوى على كون دلالي واحد ووحيد يوحد بين مقامات القول والفعل ضمن دائرة مفهومية واحدة تفصل بين الضعيف والقوي والسيد والتابع والأصل والفرع، “ولقد تعينت الذكورة صفات/أسماء القوة والسيطرة وصارت طبعا مألوفا عند الذكور وسمة طبيعية لسلوكاتهم ” ( ص 105).
2– لذلك لا يحيل الزوج المرأة /الرجل ( الذكر /الأنثى) على طرفين داخل معادلة تستمد وجودها من الترابط الوجودي بينهما، بل تستند إلى وجود ما يمكن أن يجمع بين أصل ثابت وكلي ومطلق في الوجود، وبين فرع لاحق وعرضي خلق في البداية لتلبية حاجات توجد خارجه.
لذلك فالمذكر أصل والمؤنث فرع، وهو ما يعني تبعية المرأة للرجل في الواقع الفعلي، لا في القاعدة النحوية فحسب، “فتذكير المؤنث واسع جدا لأنه رد فرع إلى أصل، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب”، كما يقول ابن جني في خصائصه، أما “إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على المؤنث لأنه هو الأصل والمؤنث مزيد ” ابن الأنباري ( انظر الفصل الذي خصصته للمؤنث 45 -58).
وقد فككت المؤلفة بدقة علمية كبيرة كل الآليات التي تحمي هذا التمييز وتعمل على تأبيده بما فيها حكاية الأصل التي تجعل حواء منبثقة من نفس آدم ( الضلع). ف”الزوج” لا يعني انبثاق أول عن ثان، لأن الانبثاق سيكون في هذه الحالة منافيا لمنطق التوالد ذاته، بل يحيل على تكون تزامني يجعل هذا دليلا على وجود ذاك،
وهو أمر يمكن أن يدرج ضمن “التناقض التكويني” الذي لا يستقيم وجود طرف داخله دون وجود الطرف الآخر ( لا وجود لرجل بدون امرأة، ولا يمكن أن توجد المرأة بدون الرجل)، وهو ما يعني استبعاد “التناقض الإقصائي” الذي لا يستقيم وجود أحد طرفيه إلا بإقصاء الطرف الآخر ( الخير باعتباره نقيضا للشر).
والحال أن العديد من التأويلات، كما تلاحظ ذلك المؤلفة، ذهبت في اتجاه تأويل تكذبه وقائع الممارسة الفعلية، ومع ذلك تقبل به الذهنيات العتيقة التي ترى في الأنثى عنصرا لاحقا مشتقا من نفس أولى سابقة عليها في الوجود. واستندت في ذلك إلى وقائع عديدة منها ما يقوله مفسرو النص القرآني أنفسهم، فقد أكد العديد منهم عكس ما ذهبت إليه تأويلات غلاة التقليديين.
ف”النفس” كما وردت في الآية القرآنية: “خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها” دالة على “عين الشيء أي مصدره”، والمصدر أصل مطلق يشمل الذكر والأنثى، فلا مجال إذن للحديث عن أسبقية آدم على حواء واعتبار النفس دالة عليه وحده ( ص41). وقد أوردت المؤلفة الكثير من التفسيرات التي تؤكد هذه الحقيقة ( الصفحات 41-42-43 ).
وبناء عليه، فالقاعدة التي يقوم عليها التفضيل قاعدة فاسدة في أساسها، ولا يمكن أن تقوم شاهدا على وجود مفاضلة بين الرجل والمرأة استنادا إلى ما ورد في قصة الخلق التي لا تشير أبدا إلى خرافة الضلع ومشتقاتها من أفعى وتغرير بآدم وإغرائه الخ، فلا ذكر لحواء أصلا في النص القرآني. وهذا ما يجعل “استعارية المؤنث لا تنبع من طبيعته الإنسانية ولا من حقيقته الأصلية ( …) بل مما صورت عليه طبيعته وحقيقته في آن، صيرناه فرعا مشتقا/ضلعا ناقصة، تبعا لحكاية الخلق ” ( ص 87).
لذلك فما يستوقف الكاتبة حقيقة ليس المبرر في ذاته، فكل إيديولوجيا تقوم، بشكل صريح أو ضمني، على التبرير، بل كون هذا التمييز لم يكن نابعا من ضرورة لغوية يقتضيها التقعيد ويتطلبها، فهو يمتد لكي يشمل كل التصورات التي يملكها المذكر عن المؤنث ( التعريفات التي تقدمها المؤلفة، وهي مأخوذة من كتب مخصصة للمذكر والمؤنث). فمن الواضح في تصورها أن ما يشتق من اللغات قد يكون بعضه من طبيعة اللغة ذاتها، وهذا أمر طبيعي، لكن بعضها الآخر يستمد وجوده من أحكام سابقة،
هي في الأصل تعبير عن حالة حضارية يحتل داخلها الطرفان موقعين متميزين، أي وجود سلطة يمارسها الذكر على الأنثى وفق منطق الثقافة السائدة آنذاك. ويكفي أن نشير إلى قلة النساء اللائي اشتغلن بالنحو العربي إن لم نقل انعدامهن، لندرك أن القواعد والتسميات والصفات أيضا هي من صنع الرجال.
ولهذا السبب “ليس لسؤال المؤنث والمذكر أن يقف عند حدود اللغة ولا أن يتصل بمسائل الصرف والنحو وحسب، اللهم إلا إذا نظرنا إلى اللغة باعتبارها بنية مجردة جامدة ومحايدة، ثم ابتنينا على ذلك رؤيتنا إلى مبانيها الصرفية والنحوية ما يحيل السؤال إلى مبحث قواعدي محض” (ص15). وتقدم المؤلفة حالة كلمة ” أم” دليلا مضادا على ما يقوله النحاة ويبررون به الفصل بين المؤنث والمذكر.
“فالأم في لسان العرب مثلا هي أصل الشيء “فكل شيء أصله وعماده، وكل شيء انضمت إليه أشياء فهو أم لها، وأم القوم رئيسهم”(…) فكيف لهوية هذا الشيء، الأصل، العماد، الرئيس، الذي يحيل على الأم معنى وصفة ألا يحظى بما حظيت به هوية الأصل المذكر، الذكر “؟ ( ص52 -53).
بل هناك ما هو أكثر من هذا، فصورة الواحد المطلق الذي عنه يفيض الكون، الله الذي هو مذكر بضرورة اللغة لا بضرورة الوجود، تُسقط على الرجل ويصبح المذكر صورة ثانية لأصل يستمد منه خصوصيته في الوجود وفي دوائر الفعل. فتذكير الله، أي منحه صفات المذكر، يجعل الرجل أقوى منزلة من المرأة استنادا إلى أحكام لا يقبلها العقل ولا يقبلها الله نفسه : “فالذي ليس كمثله شيء” لا يمكن أن يكون صورة للمذكر، لأن عدم تشابهه مع أي شيء في الوجود ينفي عنه الذكورة والأنوثة في الوقت ذاته.
وهكذا، واستنادا إلى الفصل الأصلي بين المذكر القوي والمؤنث الضعيف، نبني، في تصور المؤلفة، واقعا رمزيا من خلال اللغة وداخلها، ونضفي عليه صفات الواقع الفعلي. والحال أن ما يبنى داخل اللغة هو ما يتم تداوله، واستنادا إليه تتم الأحكام الخاصة بالمرأة وأفعالها،
بل ويتم توقع ما يجب أن تقوم به وما لا يجب أن تفعله. والخلاصة أن المرأة لا تحيل على كائن، بل هي دالة على معرفة مبرمجة داخل التصنيف اللغوي وأحكامه، إن الافتراضية ليس مصدرها المقام الفعلي، بل هي الذاكرة المشتركة التي تحدد للمؤنث دوائر بعينها.
فالوضع الرمزي/الثقافي لا يكترث للحقائق الموضوعية، بل يستمد مضامينه مما توفره الرموز والعوالم المخيالية. وقد اتخذ هذا الأمر صفة “الطبيعية” عند المرأة نفسها، فقد بنيت حقائق الكون استنادا إلى نظرة ذكورية، فالرجل هو الذي أدخل العالم إلى اللغة وهو الذي صنفه وفق حاجاته ورغباته الصريحة منها والضمنية.
ولم تقف هذه التصنيفات الثقافية عند حدود تعيين كائنات أو أشياء، بل امتدت إلى التمثلات الرمزية ومنها في المقام الأول تمثلات المحيط بأشيائه وصفاته، الألوان والأشكال والرقة والليونة ( الخطوط الأنثوية الرقيقة في مقابل الخطوط الواقفة الذكورية) والفاعل والمنفعل، والولوجي والاستيعابي ( الذكر والأنثى في كل شيء)، وهي كلها تصنيفات تضع المؤنث في أغلب الحالات في وضع التابع المنفعل.
لذلك تجد المرأة نفسها في حالة الإبداع محاطة بسلسلة لا متناهية من القيود، وفي مقدمتها إكراهات اللغة وما تشتمل عليه من تصنيفات مسبقة مخزنة على شكل أحكام وتقويمات قطعية، بل وصفات أيضا، فالفتنة التي هي “أشد من القتل” تعتبر صفة من صفات المرأة “الفاتنة” التي تفتن الناس وتصدهم عن أعمالهم وتشتت أسرهم.
بل إنها، وقد أقصيت من فضاءات كثيرة، تجد نفسها عاجزة عن تصوير ما يعود إلى هذه الفضاءات التي تحولت إلى ملكية خاصة للرجل يصفها كما يشاء. “فمن باب الحيرة … يدلف الجسد الأنثوي إلى مؤنث الكتابة الروائية ، جسدا استعاريا يلتحف بثوب العفة مرة وبرداء الفجور مرة، وفي المرتين لا يبدو جسدا حقيقيا حرا، بل اقرب إلى تمثيل كنائي لطهرانية مقنعة أو لرغبة حقيقية تحجب خلف المجاز خوفا من حقيقتها ” ( ص 180).
والخلاصة أن اللغة لا تعين فحسب، إنها تسرب الأحكام من خلال التسمية ذاتها أيضا ( فاتنة للجميلة، والفتنة للجمال)، إنها تنزعنا من عالم “طبيعي” و”موضوعي” لتقذف بنا داخل عالم “ثقافي” نكتشف داخله أبعادا جديدة في الآخر وفي العالم المحيط بنا، كما يشير إلى ذلك إيكو. وعلى هذا الأساس، فإن كل “التمييزات” ( أو التصنيفات) اللغوية المرتبطة بهذه العوالم تكشف عن نظرة تصنيفية تمييزية: إنها في غالب الأحيان احتقارية من هذا الجانب (جانب المؤنث) وتمجيدية من الجانب الآخر (جانب المذكر).
وأدوات هذا التمييز متنوعة. إنها تتسرب عبر التسمية والتباينات التي تخفيها أولا، وتبدو من خلال خزان اللغة ومرجعها ثانيا، أي القاموس بمداخله وإيحاءاته وتداعياته. فالتعريف ذاته يشتمل على أولى التمييزات ( كما هو الحال في تعريف المذكر والمؤنث)، فكلمة “رجل” تدل في اللغة الفرنسية مثلا على “الإنسان” وعلى المذكر في الوقت نفسه، ولا تدل كلمة “امرأة” إلا على ما يحدد الجنس، وليس لها في العربية جمع من طبيعتها.
ويضاف إلى التعريفات الأولى سلسلة من بالإيحاءات (كل القيم المضافة المشكلة للمعاني الثانية ) حيث لا تدل المرأة إلا على الضعف والوهن والجبن، ثم تتسرب بعد ذلك إلى الذاكرة سلسلة من التداعيات ( المرادفات والأضداد) حيث ترتبط كلمة امرأة بالشر والخديعة والتحايل والمكر وكل الصفات التي تعج بها القواميس ( انظر الفصل السادس ” تقصير المؤنث إبداعا ونقدا” ).
وفي نهاية هذا العرض المختصر جدا الذي لا يغني عن قراءة الكتاب، بل يحفز عليها، نقدم ملاحظتين. فهناك أمران، نعتقد أنهما في حاجة إلى تدقيق :
– فالتمييز الذي تقيمه المؤلفة بين اللغة ونظامها قد لا يستقيم في التحليل العلمي، ومن الصعب القبول به. فاللغة كل تام ولا يمكن فصل قواعدها عن وحداتها، فنحن لا نعرف أين تنتهي اللغة الصافية ويبدأ النظام “الظالم”. فالنظام جزء من التصور العام الذي تحتضنه اللغة، فاللغة تقطيع للمدرك الحسي وفق إواليات خاصة، هي في نهاية الأمر جزء من تصور للعالم.
والأمر لا يتعلق بقضايا المثنى والمذكر والمؤنث فقط، وهي قضايا توقفت عندها المؤلفة طويلا وقدمت في شأنها تأويلات بالغة الأهمية، بل يشمل مجمل التمثيلات بما فيها اللون والقياس والأحجام والتسميات ذاتها ( ما مقابل صعلوك في الفرنسية التي تجهل كل السياقات التي أنتج ضمنها لفظ “صعلوك”؟). ” فالعلامة ليست غطاء تمنحه الصدفة للفكر، بل هي عضوه الأساسي والضروري، فهي لا تستعمل من أجل إبلاغ مضمون فكري منته، إنها الأداة التي يتخذ من خلالها الفكر شكلا ” كما يقول كاسيرير.
فليست هناك في اعتقادي لغة صافية وطاهرة يأتي بعد ذلك النظام ليلوثها، فنظام الفكر من نظام اللغة ذاتها. والذي سمى هو الذي صنف وعزل وقعد أيضا. فاللغة لا تختصر في قواعدها، فهناك مفاصل أخرى لها علاقة بما يمكن أن نسميه لاوعي اللغة، ومصدر هذا اللاوعي هو الاستعمالات الإنسانية للغة وفق شروط الوجود ذاتها، أو وفق ما تسمح به المعرفة الإنسانية. ولا يبدو أن هذا الأمر غاب عن المؤلفة، فربما دفعها حبها للغة العربية، وخوفها من أن تتهم بمعاداتها ، إلى القيام بهذا التمييز الذي لا يقلل أبدا من قيمة التحليلات التي قدمتها.
-الأمر الثاني يخص الإجحاف الذي لحق المؤنث من حيث وصفه بالتبعية والطابع العرضي. فلا أعتقد أن الأمر يتعلق ب”مؤامرة” واعية حاكها أناس يعملون في السر ضد المرأة التي كانت تحتاج إلى أكثر مما يمكن أن يبيحه المتاح المعرفي الإنساني لتلك المرحلة. فنحن نتبنى كلية كل التحليلات التي قدمتها الأستاذة مقدم، ونعتبر تأويل الفصل بين المذكر والمؤنث تأويلا بالغ الأهمية، وهي حالة لم تعد مقبولة وتعبيراتها مرفوضة على مستوى اللغة والواقع.
فذاكرة اللغة قادرة على إقصاء الضار من التداول وتثمين المفيد، فأن تكون الغلبة للمذكر في الفرنسية مثلا، لم يمنع المرأة الفرنسية من استعادة الكثير من حقوقها لا بسلطة الدولة، كما يتم ذلك في بعض البلدان التي بدأت تفرض كوطات قادت في أحيان كثيرة إلى انتخاب أصوليات تعملن ضد مصالح المرأة ذاتها، بل بمنطق التطور الحضاري الذي جعل المرأة كيانا مستقلا بالمعنى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
فالحكم على هذه التقعيدات يجب أن يستند إلى نظرة تاريخانية تعتمد المتاح الحضاري أساسا للحكم على الظواهر، فلم يكن من الممكن أن تعرف البشرية هذه المساواة التي ننادي بها الآن في ظل شروط اجتماعية تجهل كل شيء عن المساواة والتحرر واستعادة الجسد.
فالنحوي لم “يتآمر” على المرأة، بل عبر عن وعي، نعتقد اليوم أنه وعي خاطئ ومجحف، ولكنه لم يقم بذلك ضدا على حقائق الواقع. دليلنا في ذلك أن أغلب اللغات الإنسانية احتوت، بهذا القدر أو ذاك، على نصيب من احتقار المرأة وازدرائها. إن الأمر لا يتعلق بإلغاء القواعد، بل يستدعي الوعي بتبعاتها الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك، يمكن القول إن يسرى مقدم من خلال كتابها هذا فتحت سبيلا جديدا في البحث ستكون له نتائج بالغة الأهمية. وهو لا يقل أهمية عن كتاب آخر صدر منذ سنوات خلت في فرنسا يحمل عنوانا شبيها بهذا هو ” الكلمات والنساء” لمارينا ياغلو، وهي باحثة فرنسية لها باع طويل في ميدان اللسانيات، تناولت فيه هي الأخرى مبررات اضطهاد المرأة كما تكشف عن ذلك اللغة الفرنسية ( لم يترجم إلى العربية مع كامل الأسف).