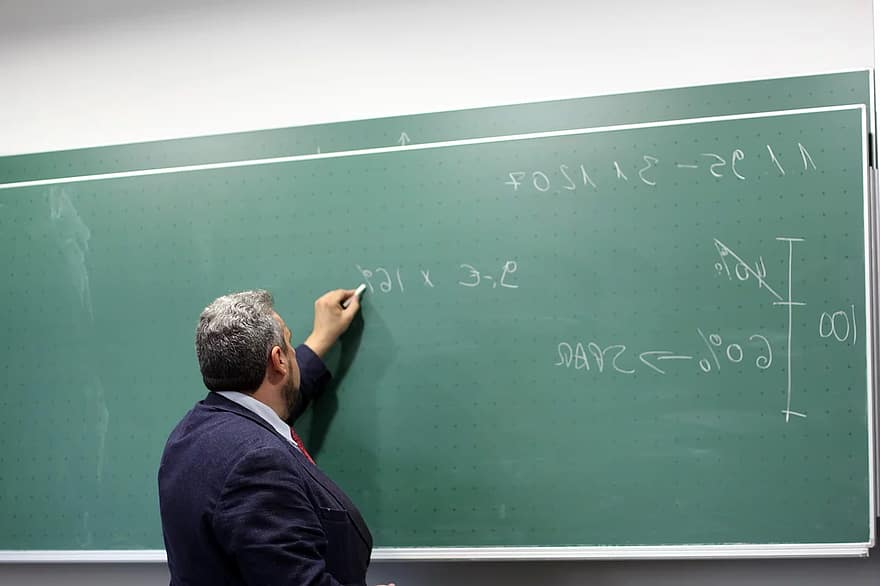الدراسات الأدبية وأقسام اللغة العربية

منذ أن تأسست كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الوطن العربي مع الجامعة المصرية في سنة 1908 والدراسات الأدبية التي يضمها قسم «اللغة العربية وآدابها» لم تعرف أي تغيير جذري.
ورغم تأخر بعض أقسام اللغة العربية في الظهور في بعض الجامعات العربية التي لم تتأسس فيها الجامعة إلا في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، فإنها اتخذت نموذج الجامعة المصرية، وبذلك فإن المقررات الدراسية للأدب واللغة، على المستوى العربي، تسير وفق التصورات التي مورست منذ التأسيس.
ورغم التغييرات الطفيفة التي طرأت على بعض المواد، فإن صورة الدراسات الأدبية ما تزال على سابق عهدها، ولم تصاحب التغيرات الجذرية سواء على مستوى تحول المجتمعات العربية، أو الدراسات الأدبية على المستوى العالمي.
كان من نتائج ركود مقررات الدراسات الأدبية العربية الجامعية وعدم مجاراتها التحولات أن ظل الإبداع الأدبي العربي الحديث والمعاصر يسير في اتجاه، والدراسات الجامعية في اتجاه مختلف. تطور الإبداع العربي، وتأخرت الدراسات الأدبية، وكان الأحرى، على الأقل، أن تواكب هذه الإبداعات بدل أن تتخلف عنها، ما دامت غير قادرة على توجيهها والعمل على تطويرها.
يبدو لنا هذا الركود وعدم المواكبة على مستويين اثنين. يتصل أحدهما بالوعي بالأدب، وبالقراءة، والكتابة، وضرورتهما في الحياة العربية. إن أمة «اقرأ»، لا تقرأ، قولة صارت متداولة على الألسنة. أما الثاني فيرتبط بتأخر المعرفة الأدبية العربية، وعدم تطورها. وحين نقول تأخر المعرفة الأدبية نقصد أيضا تأخر اللغة العربية عن مواكبة التطورات المعاصرة.
إن أقسام اللغة والأدب، على المستوى العالمي، هي الوجه الحقيقي لتطور المجتمعات وبها تتمايز عن بعضها البعض. ولما كان قياس تطور قسم اللغة والأدب يرتبط بتطور العلوم والمعارف في مختلف الاختصاصات كان في ذلك ما يقضي بأن تطور العلوم والمعارف لا بد أن يواكبه تطور على المستوى اللغوي والأدبي. وهذا هو ما نجده لدى كل الأمم المتقدمة.
من آثار هذا الوضع الذي تعرفه أقسام اللغة العربية وآدابها، على المستوى العربي، غياب رؤية دقيقة لمتطلبات هذه الأقسام ومقاصدها. لقد كان من وراء تأسيس هذه الأقسام، في بداية عهدها، تكوين أطر تحمل معلومات حول عصور الأدب وترجمات الأدباء، وحفظ نصوصهم، بهدف تلقينها لتلاميذ الإعدادي والثانوي والعالي.
ولذلك كانت المقررات تقدم من خلال محاضرات تلقينية هدفها تقديم المعلومات الأدبية، وتجميعها واستظهارها. وكان ذلك يتم من خلال رؤية خطية لتطور تاريخ الأدب العربي من السنة الأولى إلى السنة الأخيرة. بمعنى أن الطالب حين يدخل إلى قسم اللغة العربية وآدابها في سنته الأولى يقدم له الأدب الجاهلي ويتدرج حسب السنوات، ليجد نفسه في السنة الأخيرة أمام الأدب الحديث، وليس المعاصر.
أي أن الطالب، خلال أربع سنوات، وهي أزهى فترات تكوينه الجامعي، حسب النظام القديم، يجد نفسه مفصولا نهائيا عن الإبداع الأدبي والدراسة الأدبية المعاصرة له. قد يواكب جديد هذه الدراسات في المجلات والصحف والكتب، ولكنه لا يتعامل معها في الجامعة التي ترهقه بالرجوع إلى المصادر والمراجع التي تدور في فلك المقررات القديمة المفروضة عليه. فإذا بطالب الأدب الجاد يعيش زمنين مختلفين: زمن قديم داخل الجامعة، وآخر حديث خارجها.
أتذكر الآن، كيف كنا نعيش هذين الزمانين المنفصل أحدهما عن الآخر، فإذا بنا نساهم في الكتابة عن الإبداعات المعاصرة، ونطلع على جديد النظريات والعلوم الأدبية من خلال قراءاتنا الخاصة بعيدا عن الجامعة. لذلك كان تطور الدراسة الأدبية العربية يتم خارج الجامعة، وليس من داخلها.
لم يدرس جيلي البنيوية التكوينية، ولا البنيوية، ولا السيميائيات ولا السرديات في الجامعة، ولكنه اطلع عليها خارج أسوارها. تأتى لنا ذلك لأن جيلنا، تشكل وعيه الأدبي من خلال اهتمامه الثقافي والسياسي، أي أن وعيه تحقق من خلال الساحة الثقافية، ولم تلعب الجامعة أي دور في تشكيل هذا الوعي.
عندما حاولنا إدخال بعض هذه المواد الجديدة، وجعل الدراسة الأدبية مواكبة لما يجري في العصر الذي نعيش فيه، بقيت الخطية التاريخية تفرض نفسها علينا، وكان الاتجاه التقليدي الذي هو ضد التجديد يقبل هذا النوع من الدراسات الجديدة على مضض، وينتهز أي فرصة للإجهاز على التجديد والتطور.
وعندما اقترحنا تدريس مادة «الأدب والتكنولوجيا»، في بداية هذه الألفية، اعتذرت العديد من أقسام العربية في بعض الكليات المغربية على عدم اعتمادها بذريعة غياب الأساتذة المتخصصين، ثم في «إصلاح» موالٍ تم حذفها نهائيا على الصعيد الوطني، وتم الرجوع إلى المقررات القديمة.
ويبدو أن معاكسة التطور تأتي من الأساتذة أنفسهم لأنهم لا يريدون أن يجددوا تكوينهم، أو يطوروا معرفتهم الأدبية.
طرأ أمر جديد لم يكن مطروحا في أواخر القرن الماضي. لقد صارت الجامعات العربية تهتم كثيرا الآن بأن يكون لها موقع ضمن تصنيف الجامعات على المستوى العالمي. وها هي «تتنافس» الآن لكي تصبح قابلة لأن تصنف عالميا وتكون في موقع مقبول. لكن بأي طريقة؟ وبأي رؤية؟ هنا نجد أن الذين يسهمون في وضع المخططات والمقررات ويعملون على تجديد الدراسات الأدبية غير مؤهلين لذلك علميا وتربويا، لأن رؤيتهم تقليدية.
ولذلك نجد، رغم كل الأموال الطائلة التي تهدر في هذا السبيل، كل تلك المجهودات تذهب سدى. وأول عائق يكمن في كون الأساتذة ليسوا في المستوى الذي يؤهلهم لمجاراة التطورات، وهم متخلفون عنها، وغير قادرين على تجديد تكوينهم وتطويره باطراد.
إن تجديد الدراسات الأدبية مطلب حيوي وضروري لإعطاء الدراسة الأدبية العربية موقعها المناسب وسط الاختصاصات المعاصرة، وفي الحياة العامة. ولعل أول مظهر لذلك يتجلى في اعتماد خطية عكسية لما مورس منذ تأسيس كليات الآداب في الوطن العربي.
إن على طالب الأدب، اليوم، أن يتعرف في السنة الأولى، ومنذ الفصل الأول، ليس على الأدب القديم ونقده، ولكن على الأدب المعاصر، وعلى العلوم الأدبية الجديدة، أي أن ينطلق من العصر، ليذهب إلى التاريخ. علينا أن نعطيه في بداية تكوينه إمكانية اختيار العلم الذي سيتخصص فيه: السيميائيات، السرديات، البلاغة الجديدة… وبواسطة هذا الاختصاص أو ذاك يمكنه أن يتعامل مع أي نص، أو ظاهرة، قديمة أو حديثة.
ونتدرج في تكوينه من الحديث إلى القديم، فيمتلك في نهاية تكوينه الأدبي القدرة على التعامل مع الإبداع والفكر الأدبي وفق رؤية معرفية محددة ودقيقة.
وبذلك يكون الهدف من تكوينه ليس تقديم المعلومات، ولكن تعليمه كيفية التفكير في الأدب، عن طريق امتلاك العدة المنهجية والنظرية، وأن يصاحب ذلك التمرس على تحليل النصوص. بمعنى أن تعتمد الدروس ليس على التلقين الذي يؤدي إلى تجميع المعلومات، ولكن على التفكير في القضايا الأدبية المختلفة، بغض النظر عن الجنس الأدبي، أو العصر الأدبي.
إن الدراسة الأدبية التي نتحدث عنها، تتأسس على الاختصاص العلمي المضبوط، وليس على المادة المدرسة. وبذلك سنتجاوز من يقول لنا: إنه متخصص في الأدب العباسي، أو النقد القديم، من ينطلق من علم أدبي محدد يمكن أن يدرس الأدب العباسي والأندلسي والشعر المعاصر. وصاحب أي اختصاص يمكن أن ينفتح على اختصاصات أخرى.
تطور المجتمع العربي رهين بتطوير الجامعة، وهي رهينة بتطور الدراسات الأدبية.