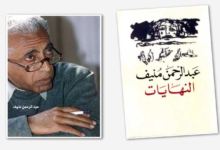إن الجلوسَ إلى مكتبٍ أو منضدةٍ عليها رُزمةٌ من الأوراق البيضاء؛ وتحريضَ المُخيِّلة لطرح فكرةٍ أو حدثٍ يكون نواةً لرواية؛ والشروع في الكتابة إلى آخر ورقة. لا يُعدُّ عملاً روائياً بالمفهوم الدقيق والحديث والطبيعيٍّ[1] للرواية.
فالرواية ليست كتابة جيدة؛ وليست لغةً ولا بلاغة. الرواية شيءٌ مختلفٌ تماماً عن السّرد. الرواية إحساسٌ ووعيٌ قبلَ كلِّ شيء. الرواية إحساسٌ بالواقع ووعيٌ به. إنها كائن حيّ؛ إنها مخلوقٌ حقيقيٌّ يحثُّنا على الانفعالِ له والتفاعلِ معه.
بالاطلاع على عينات من الكمِّ الكبير من المنشورات التي تُطبع تحت مُسمى “رواية”؛ لا تجدُ عملاً روائياً حقيقياً يحمِل شروطَ ومحدّدات وقواعد الكتابة الروائية المتعارف عليها كجنس أدبي، كما لا تَجدُ موضوعاً تستشفُّ من حُبكتِه تَمَكُّنَ الكاتب منه تَمكناً وافيا، لا يَبْلُغُه الكاتب إلا بعدَ جُهدٍ جهيد من القراءة والبحث والتوثيق والمعاينة؛ فضلاً عن حصيلةٍ مُعتبَرةٍ من التجربة والمِراس.
صار جنس الرواية حائطاً قصيراً يقفز عليه كلُّ كاتب يكتب شيئا؛ ولا يستطيع مَوْضعتَه ضمن جنس أدبي مُعيَّن. فصارت كلُّ كتابةٍ لا أجناسية روايةً.
في المقابل؛ لا تعدو الكتابات التي تغزوا أسواق الكتب العربية طيلة العقدين الماضيين تحت مُسمى روايات؛ لاتعدوا كونَها سُروداً تستقي من المُخيلة مادَّتَها للتسلية والترويح عن النفس، ولا تَصلُح لتصويرِ واقعٍ أو تحليلِ فكرةٍ أو تشريحِ موضوع، وهي عن الرواية أبعدَ ما تكون.
أصبح مجرَّدُ الاطلاع على ما يَجِدٌّ من أعمالٍ روائيةٍ؛ عملاً مُرهقا بسبب كثرة الرداءة والتفاهة التي تغزوا سوق الرواية العربية اليوم.
لقد راودتني في كثيرٍ من الأحيان ومنذ سنوات؛ فكرةَ كتابة “رواياتٍ” وليس رواية واحدة، وقد شرعتُ فعلا في الكتابة في مناسباتٍ كثيرة؛ وكلما أمعنتُ في القراءة أكثرَ وأكثر؛ أنتهي دائما بالتوقف عن الكتابة هكذا فجأة، لأسباب كثيرة؛ بعضها مُرتبط بما أريد وما أستطيع؛ خصوصا عندما أقارن ما أكتب بما أقرأ.
وبعضُها يتعلًّقُ بغياب أسئلةٍ حقيقيةٍ وجوهرية؛ مِن المفروض أن تُجيب عنها الرواية التي أنا بصدد كتابَتها. بتعبيرٍ أكثر دقة؛ غيابُ موضوعٍ يستحق أن تُكتب حولَه رواية، غيابٌ مَردُّهُ؛ عدمُ وجودِ تجربة غضة ووعيٍ تامٍّ وكاملٍ بهذا الموضوع !.
كان الربيع العربي مناسبةً حقيقيةً لإحياء مشروع كتابةِ “رواية“، وكانت هذه المرحلة من تاريخ العرب الحديث حُبلى بالمواضيع والأحداث والهزات التي تستحق أن تتحول إلى عمل روائي حقيقيّ من قبيل؛ (الثورات المضادة)، (بؤس الديمقراطية العربية)، (الطائفية والقبلية العربية)، (الإسلام السياسي)، (السجن السياسي)، (الأقليات العرقية والدينية في الجغرافيا العربية)…،
لكن الموضوع الذي شدَّني كثيراً وكان أكثر أسىً وإيلاماً، وتجسّدت فيه كل أوصاف المأساة الحقيقة والمعاناة الكاملة؛ كان مشهدُ النزوح المؤلِم والمتكرر في أكثر من دولة عربية؛ جراءَ تغوُّل الجيوش العربية على شعوبِها؛ وتحوُّلِها من مؤسسة وطنية؛ إلى مُجرَّدِ شركاتِ أمنٍ خاصة لحماية الديكتاتوريات العربية والمصالح الغربية مِن الشعوب التي تنادي بالحياة والحرية والكرامة والديمقراطية.
تابعتُ موضوع النزوح وفِرارِ حشود كبيرةٍ من العرب عموماً؛ ومن الأقليات العرقية تحديدا (الأكراد – الغجر ..)؛ الفارِّين والهاربين من بطش حُكامهِم ووحشية جيوشِهم؛ ومن إرهاب التنظيمات الدينية المتطرفة (داعش، النصرة، الحشد الشعبي، الحوتي، حزب الله، فيلق بدر، مُرتزقة الجنجويد، كتائب التشاد ،،،) في كلٍّ من العراقِ، سوريا، اليمن، ليبيا وشمال سيناء في مصر.
كانت المعاناة لا توصف ولا تتوقف؛ وكان طريق النزوح طويلاً صعباً، مَحفوفاً بالألم والعذاب والمعاناة، وخطرِ الموت والخوف من الاسترقاق والعبودية للتنظيمات الدينية المتطرفة والمُتوحشة. كان مشهدُ النزوح ذاك؛ أشبهَ بصراطِ يوم القيامة، محفوفاً بالموت تحت البراميل المتفجرة أو بنيران وقصف الفصائل والتنظيمات المقاتلة، أو بأسلحة جيوش العالم التي حجّت من كل حدب وصوب إلى هذه البلدان لحماية مصالحِها المزعومة؛ بتثبيت أركان الديكتاتوريات العربية،
وكان للرمال وللأسلاك الشائكة والألغام والأسماك أيضا؛ نصيبٌ معلومٌ من لحم النازحين والهاربين شبابا وأطفالا؛ نساءً وشيوخا؛ الذين يُلقون بأنفسهم إلى المَفازات وإلى الحدود وإلى البحر هرباً من القنابل والقذائف والقتل والترويع والاسترقاق.
كان هذا المسلسل الكامل من العذاب والمعاناة باديا لكل ذي منطق وقلب، بل إنه من الهزات الديمغرافية الفارقة في عصرنا الحديث، حدثَ مِثلَهُ في محطاتٍ تاريخية معلومة؛ وكانت له نتائج بالغة الأثر. وكثيرٌ مما يحدث اليوم؛ وثيقُ الصلة به.
لقد فرّ الملايين من المهاجرين العرب (سوريا – ليبيا – تونس – الجزائر– المغرب) إلى أوروبا، وأعادت ملايين أخرى التموقع في نطاقات جغرافية عربية (سوريا – العراق – اليمن – مصر)؛ وغير عربية متاخمة للعرب؛ (تركيا – إيران). وكان هذا الموضوع بحق؛ يستحق أن تُحشد له كل إمكانيات الكتابة الأدبية الحقيقية؛ وكل وسائل البحث العلمية من توثيق وجمع المعطيات والمعلومات الوافية عن موجات النزوح العربية، وتعقُّب البيانات والأرقام من مصادرِها الرسمية والخاصة؛ ومن المصادر التاريخية بدرجة أكبر،
خصوصاً؛ ما تعلَّق باضطهاد الأقليات العربية وغير العربية التي تعيش في النطاقات العربية، وتفريغ مئات الوثائق المكتوبة والشواهد المصوّرة التي ترصد معاناة النازحين في كلّ قُطر؛ وما تعرَّضوا له من تهجير وتقتيل وانتهاكات وسبي وتعذيب واستغلال، بالإضافة إلى الحصول على شهادات حية ممن نزحوا، أو المُخاطرة وخوض تجربة خاصة في النطاقات التي مازالت تشهدُ موجات نزوج متواصلة، وعيشِ تجربةٍ حقيقيةٍ مع النازحين.
إن كتابة روايةٍ حول هذا الموضوع أو ما يُشابِهه؛ تكتسي خطورةَ وصعوبةَ النزوح نفسِه، بل كلُّ روايةٍ تُريد أن تعالج موضوعاً أو ظاهرة مُماثلة؛ لا بد لها أن تمر في مخاض عسير؛ لما تتطلبُه من جُهد وكدّ وتعب حقيقيّ في تجميع المادة أولا، وقد يستغرق هذا شهوراً من العمل الدؤوب والمتواصل، وشهوراً أخرى لتفريغ وفرز هذه المعطيات والوثائق وانتقاء الأصلح والأنسب منها للمادة الروائية.
فكان لزاماً عليَّ إن أنا فعلا قرَّرتُ الكتابة في هذا الموضوع؛ أن أحشد له من الجهد والوقت والتحضير والتعقُّب والجمْع؛ ما يتناسبُ مع حجمِه وأهميَّتِه وخطورَته. ناهيك عمَّا يحتاجُه من خِبرةٍ ودُربة ومهارة في الكتابة الروائية. وهذا ما لم يتأتَّ لي حتى الآن، وسأكونُ غيرَ جديرٍ بالكتابة عن هذا الموضوع وأنا لا أستطيع أن أحيط به تمامَ الإحاطة.
إنه لا يجدر بنا أن نكتبَ عن شيء لا نستطيع تَمثُّلهُ بالقدر الكافي؛ خصوصاً إذا لمْ نَكُن قد عِشناهُ أو عايَشناه.
إن من الجيد جدا أن يتولى هذا الموضوع نازحٌ ذو مهاراتٍ أدبية وكتابية جيدة، يُجسد بها تجربَته ويُحوِّلها إلى وعي. وأنا صراحة؛ لا أرى أي مشكلة في أن يضطلع بهذا العمل روائييْن أو ثلاثة روائيين من ذوي التجربة والباع في الكتابة الروائية.
يضطلع كلُّ واحدٍ منهم بفصل أو موضوع أو مرحلة أو محطة من هذا “النزوح“. وهناك نماذج من الأعمال الروائية الناجحة التي اشترك في تأليفها كاتبان أو أكثر (رواية “عالم بلا خرائط” إبراهيم جبرا بالاشتراك مع عبد الرحمن منيف).
إننا بهذا العمل لا نَخرُج أبدا عن مُحددات الكتابة الإبداعية إلى الكتابة العلمية التوثيقية، بل على العكس؛ إن الرواية بمفهومِها الحديث عمل إبداعيٌّ بالدرجة الأولى، لكنها أيضا عمل توثيقي يرُوم الكشف عن الواقع في علاقتِه بالإنسان.
من خلال رصد الظواهر والهزات الكبرى التي تُصيب هذا الإنسان أو التي يتسبب هو فيها في محطات تاريخية فاصلة وفارقة؛ ويَطالُ تأثيرُها قطاعاتٍ واسعة من الناس. هذا الواقع؛ يُمكن فهمُه في سياقات عديدة أهمُها؛ السياق التاريخي.
والرواية؛ هي أقدرُ الأجناسِ الأدبية على تَمثُّلِ هذا الواقع؛ من خلال تقديم رؤية خاصة عن الحياة؛ سواءً أكانت حياة سعيدة أو تعيسة أو مضطربة. وعندما تعجز الكتابة السردية عن تقديم هذا المعطى تمامَ التقديم والإحاطة؛ فهي غيرُ جديرةٍ بالانتساب إلى جنس “الرواية“.
والمنجز الروائي العالمي والعربي فيه الكثير من النماذج الجيدة؛ التي جسَّدت الواقع أيَّما تجسيدٍ؛ وصارت أعمالاً أصيلة لا يُبْليها الزمن ولا يطويها النسيان ولا يستغني عنها باحث أو مُتذوق أو كاتبٍ للرواية. وهذه الأعمال هي وحدَها ما يستحق أن يُطلَقَ عليه اسم “رواية“.
ونحن إذ نُطلق هذا الحُكم؛ لا نبغي احتكارَ صفة (الرواية) وتوزيعَها حسب الهوى أو الميول أو الانطباع، ولكن إذْ نَفْعَلُ ذلك؛ نروم إلى فرز الأعمال ونقدِها، فليس من المنطق ولا من العدل والإنصاف وضعُ عملٍ جيد، رصينٍ وأصيلٍ يَنبض بالحياة؛ بُدل فيه من الجُهد والوقت والتفكير والتحضير والإنجاز الكثير؛ مع عَملٍ آخرَ رديءٍ وتافه لا روحَ فيه ولا حياة، كُتبَ على عجلٍ ولا يَحمِل أيَّ مُقوماتِ الإبداع والخلق؛ ووضعُهما معاً في المرتبة أو الخانة نفسِها.
- نماذج غربية وعربية مُقارنة
سيسهُل علينا كثيرا توضيح وِجهة نظرنا حول (الرواية؛ وكيف يجب أن تكون). وذلك بالعودة إلى بعض النماذج الروائية الأصيلة لكُتابٍ كبار؛ غربيِّين وعَرب.
- دوستويفسكي
لقد كتب دوستويفسكي بضعة أعمالٍ توّزعت بين القصة (13 قصة) والرواية (17 رواية)، إضافة إلى الترجمة وكتابات أخرى يندرج بعضُها ضمن “السيرة الذاتية” والبعض الآخر عبارة عن مقالات، لكنها على قّلتها؛ بوَّأته مكانة عالية، وجعلتْه من أعظم الروائيين النفسانيين في روسيا والعالَم، ومن بين أعظم الكُتاب في الأدب العالمي في كلّ العصور. وقد تُرجمت كُتبه لما يقرُب من مئتيْ (200) لغة.
لم ينل دوستويفسكي هذه الحظوة مجاملةً أو بِمحضِ الصُّدفة، وإنما من خلال وعيِه وصِدقِه وواقعيتِه في الكتابة عموماً؛ وفي كتاباتِه الروائية على وجه الخصوص. ونحن اليوم عندما نريد أن نكتشف رُوسيا القرن التاسع عشر؛ ونقف على تفاصيلِها الصغيرة سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، نفسيا، دينيا، أدبيا، ثقافيا وفنيا؛ من خلال بوابة الأدب، فلا بد لنا قسراً؛ أن نمر من خلال إنتاجات دوستويفسكي وأعمالِه الروائية.
لقد كانت كتابات دوستويفسكي خلاصة تجاربِه في الحياة، حياةً حافلة بالمعاناة والسجن والفقر والمرارة والمنفى والضياع، ومن جهة أخرى؛ بالأمل والانعتاق والحب والإنتاج والخلود.
لقد عاش دوستويفسكي السجن، وواجَه عقوبة الإعدام، وتم تخفيفُه إلى السجن مع الأشغال الشاقة، ثم إلى التجنيد القسري في المنفى. عمل صحفيا وأدمن القمار، وامتهن التسوُّل بعد إفلاسِه. هذه المحطات الفارقة في حياتِه جسَّدَها كلَّها إلى وعي، من خلال كتاباتِه الروائية. فرائعتُه “الجريمة والعقاب / 1866″؛ تأتي في سياق مرحلة نُضج ووعي دوستويفسكي بالإدمان كحالة نفسية والفقر كواقع مَعيش.
فالرواية تُركّز على التقلبات النفسية التي تنتاب شخصية فقيرة تسعى إلى الخلاص من الفقر بقتل شخصية غنية والاستحواذ على ثروتِها. وبحكم قوتِه وبراعتِه في التحليل النفسي، إضافة إلى افتقارِه ومديونيَّته؛ فقد استطاع دوستويفسكي التعبير عن نفسية الفقير وتقلباتِها وتشخيصِها بدقة مُنقطعة النظير.
تزامناً مع كتابتِه لرائعتِه “الجريمة والعقاب“؛ كان دوستويفسكي يجِدُّ في الانتهاء من كتابة روايتِه “المُقامر” التي ضمَّنها خلاصة تجربتِه الصعبة مع إدمان القمار الذي أدخلَه في متاهة من الديون استمرَّت معه سنواتٍ؛ وباعَ بسببها مُعظمَ مُمتلكاتِه وممتلكات زوجتِه.
كما أن رائعتَهُ “الشياطين” والتي تعدُّ أفضل الروايات السياسية-الاجتماعية وأكثرِها إثارة للتقدير والإعجاب عبر التاريخ، خرجت من رحم معاناتِه في الاعتقال تحت التعذيب والأشغال الشاقة والتجنيد الإجباري في المنفى.
حيث تَنبَّأت الرواية مبكِّراً وبدقة متناهية بالصراع الطبقي المأساوي، والصراع العنيف على السلطة في روسيا، وصوّرت بشاعة القتل وسفك الدماء وإبادة البشر وتسلُّق الجثث للوصول للسلطة.
لقد كانت رواية “الشياطين” بِحق؛ بمثابةِ تحذيرٍ مُبكِّرٍ من دوستويفسكي للمجتمع الروسي وللطبقة الارستقراطية؛ من خطورة إشاعة العدمية وتوظيف الطبقات الاجتماعية لتصفية الخصوم، وإشاعة الفوضى واللاقانون للوصول إلى السلطة من خلال الإبادة. وهذا ما حدث فعلا إبّان سيطرة الشيوعية على الحُكم في روسيا، حيث راح ضحيتَها عشرات الملايين من الأبرياء في روسيا الشيوعية.
لقد أحدثت كتابات دوستويفسكي هزّة كبيرة في الكتابة النثرية، ونقل الرواية من سِرداب الكلاسيكية الفيكتورية إلى شرفة الحداثة والمعاصَرة والواقعية. وشرَّحت رواياتُه الإنسان بما هو إنسان، وأزاحت الكثير من الحُجب والغموض عن النفس البشرية وحلَّلت أنواعَها وحالاتِها وتناقُضاتِها..،
أحدث دوستويفسكي كل هذا التحوُّل في ثلاثين سنة فقط، واليوم؛ وبعد قرنيْن من الزمن، لا يزال دوستويفسكي الكاتب الأكثر مقروئية ليس في العالم فقط؛ وإنما في التاريخ. ولا زالت أعمالُه الروائية أعمالا أصيلة تنبض بالروح والقوة؛ وتتمتع بِنفس الزخم الطبيعي والواقعي الذي كُتبت به أول الأمر، والذي أهلَها لأن تتحول إلى وعي.
- عبد الرحمن مُنيف
لا تخلوا التجارب الروائية العربية من الفَرادة والقوة والأصالة والتميّز، لا يتسع المَقام لعرضِها هنا جميعًا، لكن؛ سنقتصر على تحليل نموذجٍ واحدٍ، ويكفي الاطلاع على بعض الأعمال الروائية الناجحة ل؛ حيدر حيدر، غسان كنفاني، إبراهيم جبرا، صنع الله إبراهيم، يوسف إدريس، إدوار الخراط،،، وغيرِهم من الروائيين العرب الكِبار؛ لتكتشف الفرق بين الرواية العربية؛ وغيرِها من الكتابات السردية العربية لتي تتستر خلف حِجاب الرواية، وما هي مِن الرواية في شيء.
لقد كتب عبد الرحمن مُنيف روايته “شرق المتوسط” وبذل فيها من الجُهد ما وسِعهُ أن يَبدُل، لتصوير ظلمات السجون العربية وما فيها من ألوان التعذيب وأشكال التنكيل وأصناف القهر والإذلال والإهانة، فاستحق بذلك لقب مُبتكر “أدب السجون” في العالم العربي، ورائد الرواية السياسية العربية.
إلا أن عبد الرحمن منيف على عُلو كعبِه في الكتابة الروائية، اضطر إلى كتابة رواية أخرى حول نفس الموضوع (أدب السجون) بعد 15 عاما؛ سَمَّاها “الآن .. هنا“. جسد فيها نُضج واختمارَ تجربتِه في الكتابة الروائية، وحصيلة درايتِه ومعلوماتِه بالحالة السياسية وحقوق الإنسان في البلاد العربية؛ وعلاقة السلطة بالمواطن العربي، التي تُلخصها الرواية في الاستعباد والاعتقال والسجون والحبس والتعذيب والإهانة والإذلال.
وأنت تقرأ الرواية (الآن .. هنا) سَتُحس بِبُرودة أرضية الزنزانة، وألم الحبال والأصفاد وهي تخترق جِلد ولحم السجين وكأنه أنت، ستحس بالموت البطيء وهو يلتهمُك قضمة قضمة، ستحس بدونيَّك وأنت تُستجوب مِن مُخبرٍ سافلٍ قذر..، ستُحس بالاختناق قبل أن تُتم القراءة، اختناقٌ لا تستطيعُ دفعَه بالكف عن قراءة الرواية وإعادتِها للرف، ولكن؛ بحجم النفس الذي ستحتاجُه لهضم كل هذا الظلم والعذاب والإهانة إلى أن تبلغ آخر صفحة في الرواية.
ستُحس كذلك بحجم الجُهد والكدِّ والعمل الذي بذلَهُ “مُنيف” لإخراج هذا العمل الفني الأصيل والخالد المحفوف بالمأساوية؛ وبالقبح الذي سيَظل وَصمَة عارٍ على جبين جنوب وشرق المتوسط إلى الأبد.
لم يكن عبد الرحمن مُنيف يكتب ليُؤلف ويُنتج ويُكثِر فحسب، لكنه كان يُمارس السياسة التي امتهنها وخبرَها وآمن بها، من خلال الكتابة، بعد أن أيقن أن ليست ثمة ما يُمكن عَمَلُه في ظل أنظمة عربية قمعية؛ شمولية وديكتاتورية، تُسيطر على كلِّ شيء، ولا تؤمن إلاَّ بالحزب الواحد والشعار الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد.
وتراهنُ على تغييبِ وعي الشعوب للاستمرار في السلطة ونهب الثروات. فكان مشروعُه هو تشريح الوضع العربي وإبراز مواطن التحول ومكامن الخلل فيه مِن خلال الرواية، هذه الرواية التي وظّفها “مُنيف” لتحويل خلاصة تجاربِه في الحياة إلى وعيٍ قدْرَ المُستطاع.
هذا الوعي؛ أحدث هزةً عميقة في الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، من خلال رصدِها الدقيق والعميق لكل مظاهر التحول الحضاري والاقتصادي والثقافي العربي عموماً والخليجي على وجه التحديد، خصوصا الوفرة المالية التي اجتاحت المجتمع الخليجي مع اكتشاف النفط.
هزةٌ؛ تُضاهي الهزة التي أحدثها نجيب محفوظ في النصف الأول من القرن العشرين، والذي عُنيت رواياتُه بتشريح بنية المجتمع العربي عموما؛ والمصري على وجه الخصوص.
لقد طور مُنيف الرواية العربية وتقدم بها عقوداً إلى الأمام، واقعيتُه وطبيعيته وتجريبيتُه في الكتابة، جعلت القارئ العربي العادي قبل المتخصص يُقبل على قراءة أعمالِه بنهم شديد. وله يرجع الفضل في كسر حاجز التعقيد والغموض والنخبوية في الرواية السياسية، وتقديمِها بأنماط سردية جديدة، واقعية ومثيرة للقارئ العربي العادي.
بهذه الإضافة النوعية؛ بل الفارِقة في السرد الروائي، استحق مُنيف موقعَه المتميّز ضمن كبار الروائيين العرب في القرن العشرين، وأشهرِ رُواةِ تاريخ الجزيرة العربية المعاصر، من خلال خُماسيته “مدن الملح“، وهي أهم سرديةٍ تاريخيةٍ كُتبت عن الخليج العربي في العصر الحديث.
كما عُدَّ واحداً من أعظم الروائيين في كل العصور، وأُدرِجتْ أعمالُه الروائية ضمن (الروايات المئة الأعظم عبر العصور)، وتُرجمت إلى عشرين لغة حية عبر العالم، واعتُمِدت غالبية أعمالِه ضمن برامج التعليم في عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية.
لقد ترك لنا عبد الرحمن مُنيف ميراثا سرديا قليلا نسبياً؛ لكنهُ مُفعمٌ بالروح والإحساس والواقعية، ويَنمُّ عن وعيٍّ دقيقٍ وعميقٍ جداً بالحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العربية. فأنت عندما تقرأ “الآن .. هنا” أو “مدن الملح” أو “الأشجار واغتيال مرزوق“؛ تُحس كما لو أنها كُتبتْ توّاً، لأنها تُحاكي واقعنا العربي اليوم كما حاكتْه وتوَقعتْهُ قبل خمسين سنة.
إنها ليست مُجردَ أعمالٍ روائية؛ إنها وعي عميق بالحالة العربية ونفسية الإنسان العربي حاكماً كان أو مَحكوماً؛ ظالماً كان أو مظلوماً. هذا الوعي؛ هو ما يَجعل مِن عملٍ ما؛ روايةً حقيقية.
وهذا ما ندعو إليه من خلال مقالنا هذا، أن تتمتع الأعمال التي تُنجز بنصيب وافر من الواقعية والطبيعية؛ وأن تنال حقَّها من التحضير والإعداد.
إن أهم ما في الرواية أن تكون قابلة لأن تتحول إلى وعي، ولن يتأتَ لها هذا؛ ما لمْ تكن نابضة بالحياة؛ ولكي تكون كذلك؛ لابد لها أن تتسلح بالواقعي والطبيعي، وعندما تعجز عن ذلك؛ فإنها تولد ميتة وتتحول تلقائيا إلى رزمة من الورق؛ شراؤُها مَضيعةٌ للمال؛ وقراءتُها مَضيعةٌ للوقت
إننا في أمس الحاجة إلى روائيين طبيعيين؛ واقعيين؛ من أمثال دوستويفسكي وعبد الرحمن مُنيف، روائيين وَاعِينَ بالدرجة الأولى، وَعْياً يُمَكِّنهم من الإحاطة الوافية بالأفكار والموضوعات التي يريدون الكتابة حولها. أكثر من حاجتِنا إلى كُتابِ مُخترعين يعتمدون الخيال وحده.
إذ يجب على الكاتب أن يُعايش أعمالَه مدة طويلة من الزمن؛ حتى يألفَها وتألفُه لكي تكشفَ له عن خباياها وتفاصيلِها الصغيرة والدقيقة؛ قبلَ أن يُحرِّرَها ويُطلقها للقارئ.
[1] الرواية الطبيعية كما يُحدّدُها إميل زولا. يُرجى مراجعة؛ Zola Emile, Du roman et autres essais critiques.