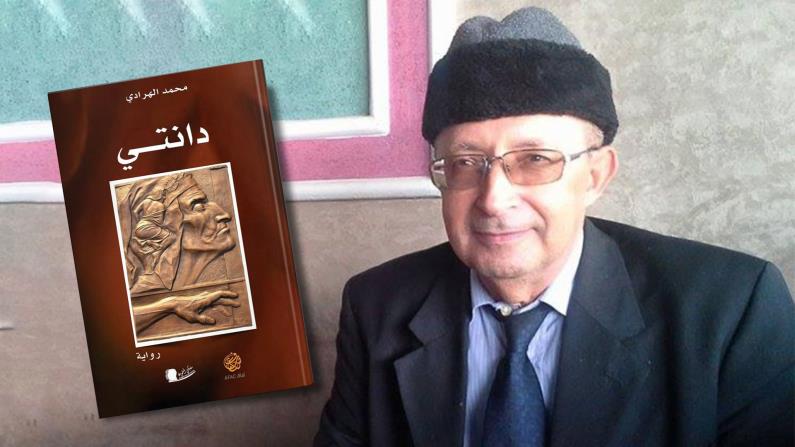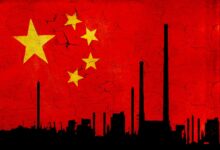- تمهيد:
يعرف فيليب لوجون السيرة الذاتية بأنها محكي استرجاعي نثري، ينجزه شخص واقعي عن وجوده الخاص، حينما يشدد على حياته الفردية أو تاريخ شخصيته[1]، ق منطق أساسه الصدق والتطابق، مما يجعل منه محكيا يعتمد الوثيقة والشهادة، ويستبعد التخييل؛ لأنه يندرج ضمن نمط أدبي مرجعي يدعي قول كل شيء، والتزام الدقة المتناهية والشفافية التامة في الوصف والحكي معا، إلى درجة الاكتفاء بسطحية الحدث، والوقوف عند رتابة اليومي[2].
ومن المؤكد أن فيليب لوجون قد انتهى إلى هذا التعريف بعد استقرائه لمجموعة من النصوص التي تنخرط في سجل الأدب الشخصي، حيث أسفرت هذه المقاربة عن إمكان بلورة تحديد للسيرة الذاتية، يميزها عن باقي الأشكال التي تحيط بها وتغذيها في الآن ذاته؛ نحو الرواية الشخصية، والسيرة، والاعتراف، والمذكرات، واليوميات.
والواقع، أن لوجون استطاع أن يستخلص من المتون المعتمدة للدراسة، سلسلة من التعارضات الشعرية، وعددا من الخصائص المتحققة كلية في النص الأطوبيوغرافي، والمنعدمة في غيره من النصوص التي تنتسب إلى الأنواع الأخرى[3]؛ كمسألة التماهي في هوية الاسم بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية، سواء كان ذلك التطابق صريحا أو ضمنيا[4].
هناك أيضا نوعية الميثاق الذي يتعهد به الكاتب تجاه القارئ، في صيغة عنوان فرعي يتصدر واجهة الغلاف، أو بعض الإشارات المبثوثة داخل العمل ذاته[5]، حتى يضمن استقبالا واضحا لمقصديته الأوطوبيوغرافية، ويشرك المتلقي في لعبة تحيين آليات هذا الجنس[6]، من خلال إقناعه بالمطابقة الموجودة بين البطل الورقي والكائن التاريخي الذي يحيل عليه.
ويبدو أن هذا العقد الذي تنعدم فيه الحدود بين الأدبي والأخلاقي، يلزم صاحب السيرة بمصادرة حريته، ككاتب، في إعادة ترتيب الوقائع وتغييرها، أو حذف بعضها جملة أو تفصيلا، نظرا إلى أن “السيرة الذاتية لا تحتوي على درجات: إنها كل شيء أو لا شيء”[7].
والحاصل، أن هذا الأفق النظري الذي يتغيا تغطية حقبة تاريخية معينة في سيرورة الأدب الشخصي الأوروبي[8]، لن يتناسب حتما مع النصوص التي تتميز بانتماء زمني أو جغرافي أو ثقافي مختلف. كما أن النقاش النقدي الذي أعقب هذه النمذجة التي اقترحها فيليب لوجون، كان يتمحور في معظمه حول قابلية السيرة الذاتية لمعالجات تمتح من حقول معرفية متعددة[9]: تاريخية، ولسانية، وسيكولوجية، وسوسيولوجية؛ تضيء كل معالجة منها بقعة صغيرة داخل النص الأوطوبيوغرافي ذي الطبيعة الغنية والمعقدة.
وبالتالي، فإن هذا الأخير يعد أكبر من أن ينضبط لتصور أجناسي واحد ووحيد، مهما اتسعت القاعدة النصية التي تسنده، ورصن الهاجس العلمي الذي يحركه، والأدوات المنهجية التي يتوسل بها.
وتأسيسا عليه، يستعصي الاعتقاد في وجود شعرية نهائية للسيرة الذاتية قادرة على احتواء مختلف لوينات المتن المنجز والآتي، بما أن النوع الأدبي كيان تاريخي شبيه بسفينة “آركو” الشهيرة. فهو دائم الحركية والتحول، من جراء انفتاحه على الممارسة التجريبية التي تضطلع هي الأخرى بمهمة تطوير النوع من جهة عناصره الشكلية وأفق انتظاره[10].
ذلك أن النص لا يستحيل أثرا خالدا في مملكة الأدب إلا حينما يحمل إضافة جديدة على مستوى البناء النظري، وخلخلة جمالية لطرائق القراءة، وسنن التلقي السائدة.
إن الإقرار بغياب نموذج مثالي للسيرة الذاتية يدفعنا، حتما، إلى الاعتقاد بوجود تجليات إقليمية[11] لهذا الجنس، ونماذج لا ترتهن بمفهوم قبلي متعال، بقدر ما تأخذ ملامحها وتستقي ثوابتها من شبكة العناصر المتكررة والناظمة لركام معين من النصوص.
كما تخضع للسياقات السوسيو-ثقافية العامة والإيديلوجية الأدبية التي تعمل، بواسطة سلسلة من المواضعات والقيم والأحكام[12]، على الإحاطة بالنوع الأدبي من حيث: تاريخ تشكله، وطبيعته، ووظيفته، وآليات استقباله، وعلاقته الجدلية بباقي الأنواع[13].
استنادا إلى ما سبق، تستمد الكتابة عن الذات بالمغرب مشروعية انخراطها ضمن أنماط الأدب الشخصي عموما، والسيرة الذاتية على وجه الخصوص، علما بأن سجالا نقديا قد طال هذه التجربة منذ إرهاصاتها، وأضاء مسارها الفتي، دون أن يحط أصبعه على مواطن الوجع والاعتمال، ويثمر معرفة حقيقية ورصينة بصدد قضاياها الجوهرية، نحو أسئلة التجنيس والتأسيس والتجريب.
وهكذا، تم رصد المكون الأوطوبيوغرافي –سواء كان مهيمنا أو ضامر- في التجربة السردية المغربية، انطلاقا من ثلاث زوايا للنظر على الأقل:
أ – زاوية النظر الدوغمائية:
تستقي إطارها النظري وجهازها المفاهيمي من المد الكاسح للواقعية الاشتراكية، التي غمرت المجال النقدي في سنوات الستينيات والسبعينيات بوعي يحتفي بالقيم الجماعية، ويدعو إلى الانصهار الوجداني للفرد داخل قضايا المجتمع الملحة وتطلعاته التقدمية، بحيث كان الكاتب المغربي مطالبا بالتعبير عن الهم الوطني أو القومي، واستنساخ طموحات الجماهير.
وكانت الكتابة مجبرة على المساهمة في الجدال السياسي، إلى جانب باقي قوى التنوير والتغيير[14]. ذلك أن الحديث عن العالم الجواني، واستحضار ذكريات الطفولة، ودقائق الحياة الشخصية، ومختلف مظاهر تضخم “الأنا”؛ كلها مصادر لا ترقى إلى خلق رواية مغربية تعكس الثورة والصراع الطبقي ووسواس التاريخ، وإنما تسعى إلى تكريس روح رومانسية حالمة، يجسدها جنس السيرة الذاتية بامتياز[15].
بناء عليه، أقام النقد الإيديولوجي مفاضلة بين الرواية والسيرة الذاتية، توحي بالتراتب المعتبر وقتئذ بين “النحن” و”الأنا”، وتؤشر إلى الطفرة التي مست المناخ الثقافي، وهو يتأرجح بين رومانسية الخمسينيات وواقعية الستينيات. إذ لم يستسغ دعاة هذا الاتجاه نصا أو طوبيوغرافيا كـ”في الطفولة” إلا لكونه يمثل –في رأيهم- عتبة للمسيرة الروائية المغربية، وقالبا فنيا ملائما لمرحلة كانت الرواية فيها ستأتي[16].
ولعل ولوج طور الرواية، ظل مرتهنا بمدى قدرة المبدع على تجاوز ذاته، وإنكار لا شعوره، وكف إسقاطاته الخاصة ورؤاه الحميمية تجاه الكون والأشياء، حتى لا ينعت بأنه مجرد كاتب لسيرته الذاتية[17].
ب – زاوية النظر الأجناسية:
لا تبحث في شروط تكون النوع، كما لا تعير الأهمية لوظيفته الاجتماعية، ولكنها تحول المنظار النقدي صوب التركيز على ثوابت السيرة الذاتية ومتغيراتها، في ضوء قواسم الوصل والفصل التي تربطها بالرواية.
ويستند دعاة زاوية النظر الأجناسية إلى تصورات نظرية جاهزة، تجد منبتها في شعرية الأنواع الأدبية، أو سوسيولوجيا الأدب، أو التحليل النفسي للإبداع الفني.
وإذا كان بعض النقاد المغاربة يتثبتون بركائز الميثاق الأوطوبيوغرافي كما حددها فيليب لوجون، وينتصرون لصفاء السيرة الذاتية، ولاستقلالها عن الأنواع المجاورة[18]، فإن نقادا آخرين يقولون بمبدأ التداخل والاختلاط بين السيرة الذاتية والرواية، ويذهبون إلى استحالة الحديث عن نقاوة الجنس، في ضوء التلاحم الحتمي بين الأنا والنحن، الفردي والجماعي[19]، أو التعالق العضوي بين الحقيقة والوهم، وبين صدق الذاكرة وعمل المخيلة[20].
ولعل أكثر النماذج اتساقا وشمولية، في هذا الصدد، التصور الذي بلوره الناقد حميد لحمداني اعتمادا على طروحات فرويد، ولاكان، ولوكاتش، وكولدمان، ومرجعيات نظرية أخرى، حيث تغدو العناصر السيكولوجية والسوسيولوجية والشكلية، سواء كانت موضع وعي من قبل المبدع أم قسرية مفروضة عليه[21]، حواجز تحول دون كتابة السيرة الذاتية الخالصة، وتكشف بالتالي، عن بعدها الروائي.
ينطلق الناقد حميد لحمداني من الريبة في صدق تصريحات الكاتب والشك في اعترافاته، نظرا إلى أن فعل الكتابة يتلبس بمجموعة من الإرغامات تمنع من استحضار وقائع اليومي وتفاصيل الماضي، بالأمانة والدقة اللتين تزعم امتلاكهما الذاكرة، أو توهمنا بهما اللغة[22].
إن المسافة المفترضة بين زمن الحدث وزمن السرد، تتخللها الثقوب والبياضات وعوامل النسيان. إنها مجال يتحكم فيه النظام الرمزي للغة والطابع القسري للاشعور[23]؛ لأن المبدع غالبا ما يتذكر واقعة فعلية ويجد نفسه يتحدث عن أخرى تكاد تكون وهمية، بعدما خضعت للتقليم والترميق والتحريف الإداري واللاإرادي[24]، فلا يتبقى منها عند الكتابة إلا ما تسمح به حدود العبارة.
وإذا كانت أساليب التعبير الأدبي وتقنياته لا تسعف المؤلف على قول كل شيء، فإن صرامة الأعراف وحدة الموانع الأخلاقية أو الإيديولوجية المترسخة في المجتمع تجعل صاحب السيرة يمارس الرقابة الذاتية على مختلف الأحاسيس والأحداث والوضعيات والمواقف التي لا يجرؤ على الإفصاح عنها صراحة، أو من شأنها أن تعريه أمام الآخرين[25].
من هنا، يخلص الناقد حميد لحمداني إلى أن تضافر هذه العوامل جميعها، يسوغ قلة النصوص الأوطوبيوغرافية الخالصة وفق المقاييس التقليدية، ويفسر عزوف الأديب المغربي عن الكتابة حول الذات، والبوح بأسرارها وحميميتها لجمهور القراء والمتلقين، وتشديده في المقابل، على التجارب الغيرية والأحداث المتخيلة، مما يمنح كتابته هوية أجناسية مزدوجة، مزوعة بين السيرة الذاتية والرواية[26].
ج – زاوية النظر التجنيسية:
يعيب دعاة التجنيس على المقاربتين السابقتين كونهما تحومان على النصوص، من غير أن تستطيعا الدخول إليها توا، والإصغاء إلى بنياتها المحايثة ومستوياتها الفنية والتعبيرية[27]. فالممارسة النقدية التي تضع نفسها خارج النص، لا يمكنها أن تكتنه طبيعة جنسه، ولا شبكة الاقتباسات والامتدادات والتنويعات، وكل العناصر التناصية التي تصله بكوكبة من النصوص[28] يؤسس بمعيتها حساسية جمالية أو ذوقا أدبيا، قد لا يندرج في خانة أحد الأنواع الجاهزة.
وهكذا تقترح هذه المقاربة إعادة النظر في التصنيف الأجناسي الذي طال المتون السردية المغربية، وتشكك في المواثيق(رواية، سير ذاتية، قصة..) التي تتصدر أغلفتها، بما أنها لا تحيل على حقيقة النصوص، بقدر ما تشي برغبة في التودد إلى الفكر النقدي الذي كان سائدا في مرحلة معينة.
كما أن تدخل بعض الناشرين في تحديد هوية عدد من الأعمال الأدبية لاعتبارات تجارية محض[29]، قد يكشف لا محالة الطابع الاعتباطي بل العبثي الذي وسم عملية تجنيس التراكم السردي بالمغرب.
من ثمة، تفيد القراءة المباشرة لنتاجاتنا الأدبية، أن معظم الروايات ليست سوى سير ذاتية مقنعة، أو شكل من أشكالها[30]. وبالتالي، يغدو التساؤل عن قلة الأعمال الأوطوبيوغرافية، تساؤلا بلا موضوع، وطرحا متجاوزا. إذ إن العديد من الروائيين المغاربة يصرحون الآن، بأنهم كتبوا سيرهم بدون قصد أو قرار مسبق، وإنما استدرجتهم الكتابة كي لا يتحدثوا عن شيء آخر سوى ذواتهم، حتى حينما كانوا يزعمون الحديث عن غيرهم.
يقول الميلودي شغموم:
“..المبدع لا يمكنه أن يكتب إلا عن نفسه. بمعنى أن ذاته بكل ما تجيش به من ماض وأحداث وتوترات واستيهامات ومخاوف، هي المكون الأساسي لعالمه المفضل الذي يتكرر في أعماله. وهذا العالم حاضر في نسج الشخوص وتحريكها ورصد انكساراتها، التي لا تعدو أن تكون غير انكسارات المبدع..”[31].
وجدير بالملاحظة هنا، أن السعي النقدي إلى “لبرلة” الكتابة الأدبية المغربية كان في الجوهر نتيجة حتمية عن هذا المسار الجمالي الذي اختطفته النصوص وأصلته، في غياب معرفة رصينة، وأداة تحليلية، تستقطران التجربة في مختلف تحققاتها، وتزيحان الغشاوة عن عين الخطاب الواصف الذي ما فتئ يعتبر السيرة الذاتية والكتابة عن الأنا معبرا نحو تأسيس النوع الروائي، وطفولة أدبية سرعان ما تزول[32]؛ بيد أن التحولات الإيديولوجيا والفلسفية والسوسيو-ثقافية عموما، التي لاحت في الأفق منذ أواخر الثمانينيات، وما ترتب عنها من تصاعد ملحوظ في وتيرة إنتاج السيرة الذاتية –مضمونا وميثاقا- تؤكد –مصححة- أصالة ذلك المسار،
وتجذر هذا القالب الفني بوصفه كيانا مستقلا، يستدعي البحث في تجلياته، والكشف عن ملامح تمييزه، وتتبع مظاهر تطوره، حتى نستدرك الفراغ المعرفي الذي واكبه، ونستخلص الآليات المنهجية الملائمة لدراسة قضاياه الموضوعاتية والشكلية.
واللافت، أن مجموعة من الدارسين والنقاد قد تفطنوا لهذه الحاجة، فوجهوا اهتمامهم صوب التحققات النصية انطلاقا من ذلك المنظور القرائي، وخلصوا –في إحاطاتهم لمتون تمتد زمنيا من الماضي إلى الحاضر وتنتمي إلى أشكال تعبيرية وسردية قديمة وحديثة- إلى جملة من النتائج الجمالية والأسلوبية والفكرية القمينة بتأصيل وتأسيس ما يمكن توصيفه بـ”السيرة الذاتية المغربية” بحصر المعنى[33].
وصفوة القول، إن المبدع المغربي رغم وعيه بمركزية الذات في فعل الكتابة، فإنه لا يحسم، عادة، في جنس ما يكتبه،كما يتردد، غالبا، في إلحاق المادة الحكائية بنمط تعبيري محدد. إذ يتملكه وعي مضاعف بأن الذات كينونة يطبعها التشذر والتعدد واللاتجانس، وبالتالي لا يمكن للسيرة أن تكون مجرد سرد لشجونه الشخصية، أو لاعترافات مهووسة بنقل الحقيقة؛ لأنها “نموذج مبنين”[34] يضمنه المبدع شيئا من أوهامه وشكوكه وأحلامه وهذيانه، وبعضا من تجاربه المختارة، وطفولته “الموضبة”، وغيضا من طاقته التخييلية.
يستحضر الناقد محمد برادة، محددات السيرة الذاتية كما تتمظهر في تجربة محمد شكري، مستطردا:
“..عندما نجري وراء عمر كان اسمه حياتنا، نجهد في الإمساك به، فيمعن في الإفلات، ونسائله فيلاحق الصمت، ولا يتبقى –يا لنعمة الكتابة- إلا أن نحور ونضيف، ممارسين حرية تكشف عن المحلوم به والمكبوت والمؤمل.
[…] هكذا تحكي حياتك قبل أن تكتبها، وعندما تكتبها تأتي مغايرة لما حكيته شفويا، وما تحكيه لا يطابق “أصلا”، لأن الكلمات والإشارات وسياق الكلام تخلط المعيش بالمتخيل، فلا نكاد نميز ما وقع ذات يوم عما يمكن أن يحدث الآن أو غدا بطنجة أو تطوان أو العرائش، وأين تقع “حياتك” من كل ذلك؟”[35].
إن النص الأوطوبيوغرافي بهذا المعنى، لا يستمد أدبيته من خلال تأريخه لشخص المؤلف، وإنما لكونه ممارسة أسلوبية تروم الاشتغال على اللغة في مستوياتها: النحوية والتركيبية والدلالية[36]. وكأن الكتابة مهما كانت طبيعتها أو توثق صلتها بالذات والحياة والذاكرة، لا بد أن تستغرقها “قوة محايدة” تنأى بها عن حميمية تلك الذات، نحو مدارات النسيان والفقدان والغياب[37]، بدءا من اللحظة التي تتحول فيها من محكي استرجاعي خام إلى أثر فني ونتاج أدبي[38]. يؤشر الميلودي شغموم إلى قدرية هذه “القوة المحايدة” التي نسميها “الأدب”، قائلا:
“..أنا حاضر في (مسالك الزيتون)، وبعض شخوصها حقيقيون، لكن بعضها الآخر، هو تركيب لشخصيات أخرى أعرفها في الواقع وأعايشها. وفي عملية التركيب والحذف والانتقاء والإضافة والاستيهام والدفع بالأمور إلى حدود متعالية عن التجربة الواقعية، يدخل عمل الروائي، وتبتدئ التجربة الإبداعية..”[39].
والملاحظ، أن إحساس كاتب السيرة بحدة هذه المفارقات، وتمثله لمقتضياتها، يفسر –دون شك- مشاكسة المتن المغربي للتصنيفات النظرية التي تقر بمبدإ النموذج ومقولة الجنس، وتنطعه على التصورات النقدية التي يحكمها فهم بسيط وساذج لماهية الذات وكيمياء الكتابة. علما، بأن التراكم المتحقق لحد الآن على مستوى النصوص يشف عن روم إبداعي لنحت قالب مرن قادر على تنضيد هذا التسيب الأجناسي؛ من أجل استخراج ثوابته ومتغيراته، والإحاطة بمختلف مكوناته الجمالية المتوارية.
ولعل الاستئناس الأولي يؤكد أن جل الأعمال الأوطوبيوغرافية بالمغرب تتشاكل في تبنيها للاختيارات التالية:
1 – لا ينبغي للسيرة الذاتية أن تكتفي باستذكار الواقع الملموس والموضوعي لحياة الكاتب، وتقتصر على الوقائع الكبرى التي كان لها تأثير في شخصيته؛ لأن الحديث عن الذات يتغذى –موازاة مع ذلك- من ذاكرات أخرى متساوقة؛ تنهل من الجسد وكفاياته وملكاته، وتمتد إلى عالم الأحلام بهواجسه واستيهاماته، وتتلبس بالمتخيل في أنماطه الرمزية والسلوكية.
كل هذه الكثافة التي تنبجس من المسار الحياتي للكاتب كجزء لا يتجزأ منه، تلملم مجموع المصادر الناظمة للنص الأوطوبيوغرافي، وتمنح الطاقة التخييلية مشروعية المساهمة في تشكيل عوالمه، باعتبارها لونا داخل فسيفسائها[40].
2 – إن الإقرار بكون العمل الأوطوبيوغرافي ينهل من ذاكرات المبدع ويمتح من حيواته، من شأنه أن يضعنا أمام أنماط متعددة من السيرة الذاتية: السيرة الجسدية، والسيرة الذهنية أو الفكرية، والسيرة الجيلية، والسيرة الشعرية أو الفنية، والسيرة السياسية أو الثقافية..إلخ، حيث يشدد كل نمط على وجه معين للمبدع، على حساب الوجوه الأخرى. الأمر الذي ينفي إمكانية وجود سيرة ذاتية كلية أو مطلقة[41].
3 – إذا كان التلازم الطبيعي بين الأوطوبيوغرافي والتخييلي في بنية أي نص، هو جوهر أزمة الأنواع السردية، فإن مفهوم السيرة الروائية[42] يفرض نفسه كشكل قادر على تجاوز الإكراهات الأجناسية، واستيعاب المواثيق المزدوجة سواء كانت علنية أو مضمرة، واحتواء انزياحات الكتابة التي لا تعدو أن تكون سوى ثوابتها الخالصة، في ضوء انسياق التسميات وراء “الموضات” السائدة، والأذواق المتجددة، وخضوعها لما يعرف في تاريخ الأدب بسيرورة استهلاك الأجناس، وقابلية النصوص للتقلب على أكثر من نوع أدبي، دياكرونيا وسانكرونيا.
4 – استبدال المبدعين لللشفافية المرجعية بالكثافة الأوطوبيوغرافية، وكأنهم مقتنعون باستحالة كتابة سيرة ذاتية وفق المقاييس الكلاسيكية، وواعون أن النص الذي يزعم الوضوح والشمولية والأمانة يعرض تجربته للفشل على المستويين: الأدبي والمرجعي التاريخي.
وبالتالي، فإن التخييل والحلم والاستيهام والغيرية وإرغامات الكتابة؛ تصبح جميعها مواصفات جديدة للسيرة الذاتية المغربية الحديثة والمعاصرة.
[1] – LEJEUNE (Philippe), Le pacte autobiographique, coll. Poétique, Ed. Seuil, Paris, 1975, p14.
[2] – LEJEUNE (Philippe), Moi aussi, Ed. Seuil, Paris, 1986, p19-20.
[3] – LEJEUNE (Philippe), Le pacte autobiographique, op., cit., p14-15.
[4] – LEJEUNE (Philippe), Le pacte autobiographique, Idem, p16 et ss.
[5] – Idem, p27.
[6] – Idem, p44.
[7] – Idem, p25.
[8] – حوالي مائتي سنة، ابتداء من 1770، أنظر: Idem, p13.
[9] – يشير فيليب لوجون ذاته إلى هذه المسألة في مقدمة كتابه: Le pacte autobiographique, p7.
[10]– DUCROT (Oswald) et TODOROV (Tzvetan), Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, coll. Points, Ed. Seuil, Paris, 1972, p195-196.
[11] – يرى الناقد أحمد اليبوري أن “جنس السيرة الذاتية كتقليد أدبي عرف صيغا عديدة في العالم الإسلامي، بدءا من الغزالي (المنقذ من الضلال) مرورا بابن خلدون (التعريف)، وبعبد الرحمان التنمارتي (الفوائد الجمة)، وغيرهم من الكتاب والفلاسفة الذين كانت تتمحور بعض إنتاجاتهم الأدبية حول (التعريف) الذي يرتبط بتوثيق أحداث عامة أو خاصة و(الاعترافات) لا في معناها المسيحي، ولكن في مدلولها الإسلامي الذي يرتبط أساسا بمفهوم (التوبة)”. راجع كتابه: دينامية النص الروائي، الطبعة الأولى، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 1993، ص31.
[12]– CLAUWE (Jean-Michel), «Les genres littéraires», In Introduction aux études littéraires: méthodes du texte, sous la direction de Maurice Delacroix et Fernand Hallyn, Ed. Duculot, Paris-Gembloux, 1987, p.149-151.
[13] – CALUWE ( Jean-Michel), « Les genres littéraires », op.cit., p152-153.
[14] – الخطيب (إبراهيم)، الرواية المغربية المكتوبة بالعربية” الرغبة والتاريخ، ضمن مجلة أقلام (المغربية)، العدد الرابع، يبراير 1977، ص3.
[15] – المرجع نفسه، ص4.
[16] – المديني (أحمد)، في الأدب المغربي المعاصر، سلسلة دراسات تحليلية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985، ص42-43.
[17] – أزرويل (فاطمة الزهراء)، مفاهيم نقد الرواية بالمغرب: مصادرها العربية والأجنبية، نشر الفنك، البيضاء، 1989، ص101.
[18] – المرجع نفسه، ص102.
[19] – اليبوري (أحمد)، دينامية النص الروائي، الطبعة الأولى، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 1993، ص25-27.
[20] – لحمداني (حميد)، في التنظير والممارسة: دراسات في الرواية المغربية، الطبعة الأولى، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، 1986، ص66.
[21] – المرجع نفسه، ص62-63.
[22] – لحمداني (حميد)، في التنظير والممارسة، دراسات في الرواية المغربية، الطبعة الأولى، عيون المقالات، البيضاء، 1986، ص64.
[23] – المرجع نفسه، ص63.
[24] – نفسه، ص61-62.
[25] – لحمداني (حميد)، “السيرة الذاتية، الرواية المغربية ولعبة الميثاق المزدوج”، حوار أنجزه هشام العلوي، ضمن العلم الثقافي، عدد يوم السبت 8 أكتوبر 1994، ص5.
[26] – لحمداني (حميد)، في التنظير والممارسة، مرجع مذكور، ص66.
[27] – الشاوي (عبد القادر)، أسئلة النقد الروائي المعاصر بالمغرب، محاضرة نظمتها جمعية الباحثين الشباب في اللغة والآداب، برحاب كلية الآداب بمكناس، عشية يوم 21 أبريل 1995. (تسجيل صوتي رقم: 2/95).
[28] – Cf. SOMVILLE (L), Intertextualité, in Introduction aux études littéraires : méthodes du texte, sous la direction de Maurice Delacroix et Fernand Hallyn, éd., Duculot, Paris, Gembloux, 1987, p129.
[29] – الشاوي (عبد القادر)، أسئلة النقد الروائي المعاصر بالمغرب، مرجع سابق.
[30] – لحمداني (حميد)، السيرة الذاتية، الرواية المغربية ولعبة الميثاق المزدوج، مرجع سابق.
[31] – وارد ضمن: العلوي (هشام)، “السيرة والتجليات: قراءة في تجنيس المتن الأوطوبيوغرافي المغربي”، العلم الثقافي، عدد عاشر (10)، ماير 1997، ص10. قد لا تفاجئنا هذه النزعة “التذويتية” للإبداع، عندما نجد (ميشال فوكو) على سبيل المثال، يعترف بأنه كلما حاول إنجاز عمل نظري، إلا وكان ذلك انطلاقا من حياته الشخصية، وفي تعالق دائم مع مقاطع من سيرته الذاتية، انظر:
BROCHIER (Jean-Jacques), «Les dits et les écrits de Foucault», in Magazine littéraire, n°325, Octobre 1994, p21.
[32] – يكفي أن نشير، في هذا الصدد، إلى ما قاله عبد الغني أبو العزم غداة صدور سيرته “الضريح”، سنة 1995، بأن السيرة الذاتية هي طفولة المسار السردي لكل كاتب، ولكل أدب”. أو ما عبر عنه محمد الدغمومي في أحد الحوارات الصحفية، بأن “الرواية تبتدئ حينما يتحرر الكاتب من ثقل حياته الشخصية”. ضمن العلم الثقافي، عدد (16) أكتوبر 1993، ص4.
[33] – راجع الدراسة الرائدة لعبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود: السيرة الذاتية في المغرب، الطبعة الأولى، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1999.
[34] – Modèle structuré, Cf. Frye (Northrop), Anatomie de la critique, Ed., Gallimard, Paris, 1969, p307.
[35] – برادة (محمد)، تقديم شكري (محمد)، زمن الأخطاء، سيرة ذاتية روائية، الطبعة الثانية، 1992، ص9.
[36] – تودوروف (تزفتان)، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، الطبعة الأولى، دار الكلام، الرباط، 1993، ص42-43.
[37] – بلانشو (موريس)، مقاطع في الكتابة والغياب، ترجمة بسام حجار، ضمن الفكر العربي المعاصر، العدد 36، خريف 1985، ص70.
[38] – يرجع فيليب لوجون، السيرة الذاتية إلى نظامين مختلفين:
ـ نظام مرجعي “واقعي” يأخذ فيه الالتزام الأوطوبيوغرافي قيمة عقد، حتى وإن خضع للكتابة.
ـ نظام أدبي لا تطمح فيه الكتابة إلى الشفافية، وإن بإمكانها أن تحاكي النظام الأول وتتداول قناعاته، أنظر: Moi aussi, op., cit., p22.
[39] – وارد ضمن: السيرة والتجليات، مرجع سابق.
[40] – أليس التخييل، كما يذهب إلى ذلك فرانسوا مورياك، “هو وحده الذي لا يكذب، [لـ] لأنه يشق بابا سريا في حياة إنسان ما، تلج منه روحه المجهولة، خارج كل مراقبة”، ص41؛ ألم يفصح جان بول سارتر عندما أراد أن يكمل سيرته “الكلمات” بأن “الوقت قد حان أخيرا لكي أقول الحقيقة، لكن لا يمكن أن أقولها إلا في عمل تخييلي”، ص42. أنظر: Le pacte autobiographique.
[41] – عندما نقرأ سلسلة المذكرات التي أصدرها محمد شكري عن جان جنيه، وتينيسي وليامز، وبول بولز، نفهم بأن الخبز الحافي وزمن الأخطاء لم يكونا سوى سيرة انتقائية، قفزت على العديد من المحطات الدالة في حياة المؤلف.
[42] – يتساءل فيليب لوجون بصدد الفصل القسري والمفتعل بين السيرة الذاتية والرواية وبالتالي بين الأوطوبيوغرافي والتخييلي: هل سيؤدي اجتماعهما معا إلى خلق نوع أدبي أكثر دقة وغموضا وصحة وتعقيدا وعمقا؟ أنظر: Le pacte autobiographique, Idem, p42.