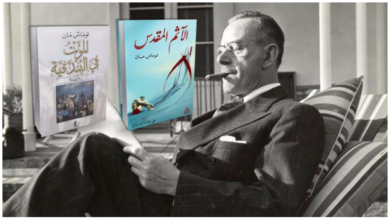هدى فخرالدين: في تراثنا الأدبي العربي إرث نقدي مُهمّ

تعدّ الباحثة والأكاديميّة اللبنانية هدى فخر الدين ناقدة ذات نزوع إنساني. وهي حائزة على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي والأدب المقارن من جامعة إنديانا بلومنغتون (2011) وعلى شهادة الماجستير في الأدب الإنكليزي من الجامعة الأميركية في بيروت (2002)، وتعمل منذ عام 2014 أستاذة للأدب والنقد العربيين في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، كما درّست اللغة العربية وآدابها في جامعة ميدلبري من عام 2009 حتى عام 2014.
هنا حوار معها بالتزامن مع صدور كتابها الجديد “قصيدة النثر العربية بين النظرية والتطبيق”، بالإضافة إلى صدور الترجمة العربية من كتابها “الميتاشعرية في التراث العربي.. من الحداثيين إلى المحدثين”:
- شعراء العصر العباسي
(*) ما هي استراتيجيتك في النقد؟
النقد، في أول المقام وآخره، قراءة. وكل أدب حقيقي يخلق أسسًا نقديةً لقراءته، كما يخلق ذوقًا جديدًا ليصاحبه. نادرًا ما تُنتج المشاريع النقدية أدبًا حقيقيًا. الأدب الحقيقي هو الذي يضع الأسس النقدية. فالنظرية الأدبية لا بدّ لها أن تنطلق من قراءات في نصوص بعينها.
وفي تراثنا الأدبي العربي إرث نقدي مهمٌّ تعلّمنا تجاهله والاستخفاف به، لأننا واقعون تحت هيمنة الآخر الغربي. وقد تبنّينا مثال النقد الغربي وتوهّمنا أنّ النقد والتنظير الأدبيين، إما أن نستوردهما أو نسعى إلى تقليدهما والتمثّل بهما.
ثورة الشعراء المحدثين في العصر العباسي أحدثت صدمة نقدية أجبرت معاصريها من النقاد المعارضين أو المناصرين لها، على مواجهة أسئلة نقدية عميقة تتعلق بجوهر الشعر واللغة الشعرية ومعايير القراءة والتلقّي. وقبل هذا، ألمْ يكن القرآن ثورةً خلقت في إثرها علوم اللغة والنحو وطرحت أسئلة نقدية ملحّة كان لها أثر عميق في الشعر والنثر العربيين؟
مع هذا، يمكننا أن نشير إلى افتقار للمقاربة النقدية الحقّة لأدبنا الحديث والقديم معًا. ليس لدي استراتيجية سوى القراءة النقدية المخلصة لجماليات النص المبتعدة عن إسقاط المقاربات النظرية المسبقة على النص.
(*) لو نظرنا حولنا سوف نجد أننا نُشكِّل سوقًا للغرب، ولا سيما في استهلاك الآداب والفنون، وبما تحمل من مواضيع لتفتح عقلنا ووعينا أو لتُغلق عليه. ما رأيك؟
نحن سوق استهلاك في مختلف جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية…. وليس في مجال الآداب والفنون فحسب. وهذا لأسباب تاريخية نعرفها جميعًا. تاريخنا الحديث تاريخ خضوع وخيبات. ولا أمل لنا في مجابهة هذا والخروج من موقع الضعف إلّا من خلال تعزيز لغتنا وعدم التخلي عن تراثها الغني.
لا فرصة لنا للمنافسة إلّا في لقاء اللغات والآداب. وذلك إذا أدركنا طاقة لغتنا الحيّة وتمسّكنا بقدراتها الإبداعية العظيمة. ولا أقصد هنا التمسك القومي الضيق، بل أعني الارتباط الوثيق بهذه اللغة العصية على التاريخ والتي ظلّت حيةً، متجددةً مهما جار الدهر على أبنائها. هي سلاحنا الأنجع في مواجهة الدهر، كما كانت لمن سبقونا منذ الجاهلية.
هي ذخرنا في تعاملنا مع لغات الآخرين وثقافاتهم مهما تفوّقوا علينا اقتصاديًا أو عسكريًا. وهي الفضاء الرحب الذي يتيح لنا التواصل مع الآخرين بنديّة. وعلى النقد الحقيقي أن يكون تفكّرًا مخلصًا في اللغة وخيالها. هكذا يكون النقد قوةً، بل أكثر من هذا، يكون سببًا لإبقاء اللغة – ذاتًا مفكّرةً، متأهبةً، متجددةً، حيةً.
(*) لو عدنا إلى الفكر النقدي العربي، ألم يكن الماضي/ القديم، الذي جاء كمثال بعبد القاهر الجرجاني، فكرًا حداثيًا؟
طبعًا، ولذلك أرى أن المقاربة التاريخية قاصرة عن دراسة التراث الشعري دراسة نقدية جمالية. فالمقاربة التاريخية للموروث الشعري العربي والثقافة العربية بشكل عام، غالبًا ما تُـحيل التراث الشعري إلى مجرد فئة كلاسيكية، ما يجعله – بحكم التعريف- نقطةً، على الشعراء العرب المعاصرين أن يتجاوزوها، أو يرتقوا عنها في سعيهم لتبوّء المنزلة والأهمّية في عالم اليوم.
هذه حجة كتابي الأول “الميتا شعرية في التراث العربي” الذي نُشر أصلًا بالإنكليزية عن دار بريل عام 2015 وبترجمة عربية عن دار أدب عام 2021. حاولت في هذا الكتاب الفصل بين مفهوم الحداثة الشعرية والتاريخ. وعدت إلى دراسة الشعر العباسي بشكل خاص والحركة النقدية التي حفّزها أو تسبب بنشوئها.
وبدأت هذه الجدالات المحتدمة حول شعر بشار بن برد وشخصيته، لتصل ذروةَ احتدامها حول شعر أبي تمام. أدى هذا فيما بعد إلى نظرية شعرية متكاملة عند عبد القاهر الجرجاني. ففي سياق بحثه في إعجاز القرآن، قدّم الجرجاني نظرية ناضجة في الشعرية ما زلنا نستفيد منها ونهتدي بها ونحن ندرس سر اللغة الأدبية في الشعر أو النثر. الحداثة الأدبية إذًا ليست متعلقة بالتأخر والتقدم في الزمن.
وليس كل جديد حديثًا بالضرورة، كما قال لنا النقاد منذ الصولي حتى أدونيس. وأبلغ من أثبت لنا هذه الفكرة هم الشعراء المحدثون العباسيون أنفسهم. الشعر يحوّر مسار التاريخ، فلا يتتالى الماضي والحاضر والمستقبل، بل ينبع الزمن كله من لحظة الشعر. فالشعر في علاقته مع الزمن كما في بيت أبي تمام هذا:
يَشتاقُهُ مِنْ كماله غَدُهُ ويُكْثِرُ الوجدَ نحوه الأمسُ
أفهم الحداثة على أنها خرق أو تمرد فني على القوالب القائمة والذوق السائد. فنجد أمثلة كثيرة ً على ذلك في التراث العربي في الشعر والنثر والنقد، لا تقتصر على فترة زمنية معينة. الفن بشكل عام بحث عن التجديد والاختلاف دومًا – الاختلاف مع الذات في الدرجة الأولى. الجديد الحقّ ذو الأثر والعواقب الطويلة الأمد هو الذي يقوم على مساءلة نقدية عميقة شجاعة للذات، فرديةً كانت أو جماعية، ولتراثها وذاكرتها اللغوية.
ولذلك قدمت دراسةً لمفهومي الإبداع والتجديد في تجربة الشعر الحر في القرن العشرين، وفي الشعر المحدث في العصر العباسي، جنبًا إلى جنب، على أمل أن تتيح لنا هذه المقاربة فهمًا أعمقَ لما يعنيه الحديث أو المحدَث، بمعزل عن الاعتبارات الزمنية وثنائية القديم والحديث.
إنّ مشروعَي الحداثة هذين يشتركان في طرح أسئلة نقدية تتعلق بتعريف الشعر وما يكابده الشاعر في سعيه نحو لغة شعرية متجددة وما يؤرّق الناقد في بحثه عما يضفي على اللغة سحرًا أو إعجازًا فيحولها إلى فنّ، شعرًا كان أو نثرًا.
الحداثة ليس حكرًا على أحد
(*) الحداثة تمرُّ علينا ولكنَّنا لا نمنحها أو لا نستحصل لها على براءة (اختراع)، كأننا خارج الصراع التنافسي في لعبة الحضارة؟
نسقط من لعبة الحضارة أو نخرج منها حين ندخلها عُزلًا، غير مدرّعين بتراثنا وبلغتنا وبذاكرة هذه اللغة الأدبية والنقدية. تسير “لعبة الحضارة” دوننا حين نقاربها مفتقرين لما لدى الآخرين، متجردين مما يمكّننا من المساهمة الفعّالة. الحداثة ليس حكرًا على أحد لنستحصل على “براءة اختراع”.
فكل تقليد أدبي يملك حداثته الخاصة به، وكل لغة تكون حديثة ومتجددة على طريقتها، في حوار كتّابها مع تراثهم. لا شكّ في أن اللغات والآداب تتفاعل وتتأثر بعضها ببعضها الآخر، وأن العلاقات بين الثقافات ليست علاقة نديّة بسبب المؤثرات التاريخية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك.
فهناك الخاضع والمهيمن، المسيطر والمأخوذ، إلّا أن الخروقات الأدبية وخاصة في مجال الشعر والتي لها أن تنجو من لحظتها وظروف كتابتها المباشرة، هي التي تتعامل مع هذه المؤثرات تعاملًا خلاقًا وتحدث أثرًا جماليًا في لغتها. فتتغلب بذلك على المعايير التاريخية بالإنجازٍ الجمالي، فتبقى وتخلد وتكون مشاركة فعالةً في ما نسميه الأدب العالمي والذاكرة الأدبية الإنسانية.
(*) أنتِ اشتغلتِ في نقد الحداثة الشعرية من خلال كتاب “الميتا شعرية في التراث العربي”. فهل وجدتِ أن العقل العربي النقدي كان يمشي في خطوط موازية للحداثة؟
“الميتاشعرية” مصطلح يشير إلى التنظير أو الوصف أو الكلام على الشعر في النص الشعري نفسه، أي “الشعر على الشعر” أو “القصيدة في القصيدة”. لم أقصد في هذا الكتاب إقحام هذا المصطلح اليوناني أصلًا في الشعر العربي أو إسقاطه عليه، بل على العكس، سعيت إلى الكشف عن وجود هذا المفهوم وهذه الممارسة لدى الشعراء العرب ولا سيما المحدثين العباسيين الذين قدّموا لنا في قصائدهم تنظيرًا عميقًا ومركّبًا للشعر والقصيدة واللغة الشعرية والعلاقة مع التراث.
وقد استعنت بالميتاشعرية كإطار نظري لأربط بين تجربة الحداثة في القرن العشرين وتجربة الحداثة العباسية، لا لأقارن بين الاثنتين، بالمعنى المباشر السطحي، ولا لأثبت تأثير واحدة على الأخرى، بل لأتحدى المقاربة التاريخية التي تعيق دراسة الشعر كاستمرارية أو كحوار خلاق بين الشاعر وأسلافه. فكل نص شعري حقيقيٍّ حاضرٌ وطارئ وجديد في كل زمن، ومشارك فاعل في حركات التجديد.
فإذا كان الدهر يبلي كل شيء، كما يقول بشار بن برد،” فلا يبلى على الدهر القصيد”، بل على العكس، لحظة الشعر تتجاوز التاريخ وتعيد خلقه دومًا. ومن هنا يمكننا أن نشير إلى مشروع تجديد أو حداثة عربي أصيل، لا يتوازى مع أي مشروع آخر.
إذا جرّدنا مصطلح الحديث أو المحدث من دلالاته الزمنية التي تربطه بما هو متأخر أو ما هو غربي، وفهمنا الحداثة على أنها خرق أو تمرد أو تخطٍ لما هو سائد أو متعارف عليه، نجد أمثلة كثيرة على التجديد في التراث الشعري العربي من الجاهلية حتى زمننا هذا.
الشّعر سعيٌ دائم لتجاوز الحدود
(*) ما رأيك بوجه عام في قصيدة النثر العربية؟
الشعر في جوهره هو سعيٌ دائم لتجاوز الحدود التي توضع له. ومن هنا كانت الأنواع الشعرية مجرد دعوات للتحدي والتخطّي. ونرى هذا في أكثر الشعر “كلاسيكيةً”، إذا صح التعبير. هناك شعراء عرب من الجاهلية إلى عصر النهضة بحثوا عن طرق لتجديد الشكل الشعري مهما بدا ذلك الشكل ثابتًا أو جامدًا. وهؤلاء هم الذين أبقوا القصيدة العربية حيّة ومتجددة، من أمثال أبي تمام والمعرّي.
نرى شاعرًا متقدمًا كعنترة مثلًا يتساءل عمّا يمكن له أن يضيفه إلى ما قاله الشعراء قبله. نراه يبحث عن رؤية جديدة خاصة به وإن كان المشهد الذي يراه هو نفسه الذين وقف عليه كثيرون قبله:
هل غادر الشّعراءُ مِنْ مُتَردم أمْ هَل عَرَفْتَ الدّارَ بعد تَوّهُمِ
وقصيدة النثر هي امتداد طبيعي لمساءلة الشعر نفسَه وسعيه إلى التجاوز والتخطي المستمرين. وكل مشاريع التجديد تخريبٌ وبناء، خطأ وإصابة. التخريب ضرورة لا بد منها، قد يقود أحيانًا إلى بناء جديد وقد يبقى تخريبًا عقيمًا. من هنا كانت سمة التجريب هي الغالبة على كل مشاريع التجديد الشعري ولا سيما مشروع قصيدة النثر بشكل عام.
في حالة الشعر العربي تحديدًا، كان من المتوقع أن تبرز قصيدة النثر، بتأثيرات غربية، نعم، ولكن المحفز الأقوى لها هو قصيدة التفعيلة العربية. فقصيدة التفعيلة، وإن كانت هي كذلك متأثرة بنماذج غربية، إلّا أنها محنةٌ شعريةٌ عربيةٌ بامتياز. فهي التي اشتبكت اشتباكًا نظريًا وعمليًا مع عروض الشعر العربي وكانت توسيعًا وخلخلة له إلى حد. هذا الحد، أي نظام التفعيلة، كان لا بدّ له أن يستفزَّ مشروعًا أكثر خلخلةً وتوسيعًا أكثر كقصيدة النثر العربية.
لا أعوّل كثيرًا على ما يُسمى “الإرادة الجماعية” في الشعر، فهذه نادرًا ما تنتج شعرًا. الشعر ينبع من ممارسات فردية، من تجارب وإخفاقات ومجازفات وما يتضمن كل هذا من إصابات، مهما كانت قليلة. لدينا شعراء ولدينا شعر يتأتى من بعض المجازفات الناجحة والتجارب التي تصيب.
يجب أن أقول هنا في النهاية، إنه بعد ما يقارب الخمسين عامًا على طرح قصيدة النثر كقصيدة عربية منافسة أو بديلة، حان الوقت للبدء في تقويم هذه التجربة الشعرية ومساءلتها انطلاقًا مما قدمته من نصوص، بمعزل عن طروحاتها النظرية التي قد تكون أخّاذة أو مستفزة. وهذا ما دفعني إلى كتابة كتابي “قصيدة النثر العربية بين النظرية والتطبيق” الذي صدر عن دار جامعة أدنبره في مارس/ آذار 2021.