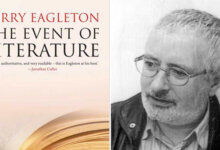ثلاثون سنة على تحليل الخطاب الروائي

كثيرا ما ننسى الزمن أو نتناساه، في حمأة الانخراط في الحياة. قد يكون هذا مفيدا أحيانا حين نكون نعمل أبدا لزمن آخر غير الذي ولى. لكنه قد لا يكون مفيدا حين نكون ضائعين في متاهات الزمن الذي نعيشه بلا زمن.
فيكون الترتيب الزمني، في هذه الحالة، ضروريا للإعداد لانطلاقة جديدة لا يمكن أن تتأسس إلا على عدم نسيان أو تناسي الزمن الذي ولى. وبما أننا أحيانا نعيش الزمن الذي نختطه لأنفسنا، نحيا، أحيانا أخرى، الزمن الذي يفرضه علينا الآخر.
كلما انتهيت من دراسة أو كتاب، أعتبر ذلك ماضيا انقضى، لأنني وأنا أشتغل في ما صار ماضيا الآن كنت أعمل في الوقت نفسه بما هو ممكن التحقيق في المستقبل. لذلك لا أعود لما انتهيت من كتابته ونشره، وإن فعلت يكون ذلك جزءا من ذاكرة مستقبلية. لم أنتبه إلى أنه مرت أكثر من ثلاثة عقود على صدور “تحليل الخطاب الروائي” و”انفتاح النص الروائي”.
طبع الكتابان سنة 1989، بعد أن انتهيت منهما قبل سنتين، لأن تاريخ مناقشتهما كرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا (الماجستير) كان سنة 1988. وخلال اشتغالي بهما معا، كنت منخرطا في الإعداد لشهادة دكتوراه الدولة من خلال السيرة الشعبية، ومنغمسا، تبعا لذلك، في التراث السردي العربي محاولا رصد العلاقات الكائنة أو الممكنة بين سرد قديم وحديث من أجل نظرية تتبلور في المستقبل.
وصدر ما نتج عن ذلك كتابا “مقدمة للسرد العربي”، و”قال الراوي” (1997). وبهذه الكتب الأربعة، أساسا، كنت أشتغل في نطاق السرديات، وفي الوقت نفسه، بما صار يسمى بعدها. يتضح هذا بجلاء في الكتابين الأولين حيث كان الأول في الخطاب، والثاني في النص حسب إجراء خاص اعتمدته للتمييز بين البنيوي، والوظيفي، أو بين التركيبي والدلالي.
وكنت في ذلك منتبها إلى التمييز بين السرديات الحصرية والتوسيعية. اعتبرت جيرار جنيت، وخاصة في كتابه المؤسس “الخطاب السردي: مقال في المنهج”، يشتغل في نطاق السرديات الحصرية، أو البنيوية. ولذلك عملت على تجاوز التقسيم الثنائي (قصة/ خطاب) الذي اعتمده إلى تقسيم ثلاثي (قصة/ خطاب/ نص)، على غرار ما سارت عليه ميك بال، وشلوميت ريمون كينان، وإن كنت أختلف معهما في توظيف هذا التقسيم الثلاثي.
يجمع مؤرخو السرديات، في العالم أجمع، رغم الاختلافات بينهم في تحديد السنوات، وتعيين الاتجاهات والمقاربات، على أنها مرت بحقبتين كبيرتين: مرحلة البنيوية في الستينيات وحتى الثمانينيات، ومرحلة ما بعد البنيوية بدءا من أواخر التسعينيات.
صارت تسمى المرحلة الأولى بـ”السرديات الكلاسيكية” بدل التسميات التي كانت شائعة مثل الشكلية، والبنيوية، والحصرية كما كان يسميها جنيت. بينما اعتبرت المرحلة الثانية حسب دافيد هيرمان “السرديات ما بعد الكلاسيكية” سنة 1997، والتي طورها في كتاب له حولها سنة 1999. وهناك من يتحدث عن حقبة ثالثة هي التي تسود الآن.
وجدتني، وأنا أركز حاليا على ما جرى في تاريخ السرديات وقد صارت “إمبراطورية” عالمية كما سماها رفائيل باروني (2016) لإنهاء كتاب في هذا النطاق، أسترجع الزمن: زمن اشتغالي بتحليل الخطاب. فأغلب المراجع التي اعتمدتها فيه تتراقص أمامي، وعلى رأسها، وبدون منازع جيرار جنيت.
كما وجدت الأفق الذي قدمته بهدف توسيع السرديات، من خلال ما أسميته آنذاك “السوسيو سرديات” في انفتاح النص الروائي، وما يطرحه ذلك من مشاكل معرفية، هو ما يُتداول فيه الآن، مع فارق أساسي هو أن السرديات انفتحت على قضايا لا حصر لها، وعلى الاشتغال بنصوص غير أدبية، وإن كنت، منذ كتاب “من النص إلى النص المترابط” (2005)، قد طرحت ضرورة انفتاح السرديات على الثقافة الرقمية بهدف الاشتغال على السرد حيثما وجد، وأيا كان الوسيط.
كان من بين ما أثارني، لاسترجاع زمن الثمانينيات، عنوان دراسة لجون بيير (2018) تحت عنوان “عقدان من الزمن على صدور كتاب مونيكا فلوديرنيك” حول “السرديات الطبيعية” (1996)، وصدور عدد جديد (2019) من مجلة “كلمة ونص” تحت محور خاص بـ “السرديات ما بعد الكلاسيكية”، وكتبت مقدمته أرلين إيونيسكو تحت عنوان: “السرديات ما بعد الكلاسيكية: بعد عشر سنوات”.
وهناك الكثير من الدراسات التي تسير على هذا النمط، والتي تؤرخ لظهور حركات، أو ميلاد مصطلحات، مثل ما ذهب إليه ريتشارد بريان، وهو يقدم حصيلة منجزات ما تحقق في “السرديات اللاطبيعية” منذ 2013 إلى 2019، محتفيا بعدد السنوات التي برز فيها هذا الاتجاه، واعدا بصدور كتاب جامع في هذه السنة.
إن كل هذه الإشارات تدل على العلاقة بالزمن في صيرورته وتطوره. والاحتفاء بسنوات التأسيس لمذهب أو مدرسة أو اتجاه ما، استذكار، واستحضار، واستشراف. ولعل هذا يفسر لنا بجلاء لماذا يتطورون هناك بتطور الزمن الذي يمسكون به.
ولماذا نتناسى، أو ننسى علاقتنا بالزمن، فلا نجني من وراء ذلك غير التيهان، ليس فقط في الأدب والسرد، ولكن في مختلف جوانب الحياة. إننا كما “نفكر” في الأدب، ونشتغل به نمارس السياسة والإيديولوجيا والاجتماع، بلا رؤية للماضي، ولا قراءة للحاضر، ولا استشراف للمستقبل. والنتائج المحصل عليها، منذ عصر النهضة إلى الآن: الخروج من دائرة الزمن.
وأنا أتابع التقييمات والتقويمات التي جرت حول السرديات الكلاسيكية، والنقاشات الدائرة، والردود على الدراسات، والمؤتمرات العالمية التي تقام حول السرديات ما بعد الكلاسيكية، وما تفرضه من مشاكل معرفية وإبستيمولوجية، وانخراط دارسين من العالم أجمع في هذه النقاشات، جعلني أستعيد علاقتي بالسرديات، منذ بداية الثمانينيات في الوطن العربي: تذكرت مجلة “فصول”، حين كان يشرف عليها عز الدين إسماعيل، و”علامات” نادي جدة، مع عبد الفتاح أبو مدين.
تذكرت المؤتمرات النقدية في البحرين، وجلسات المربد، والنقاشات الحامية التي كانت حول البنيوية. استرجعت عبد الله الغذامي ومحمد مفتاح، وسيزا قاسم، واللائحة طويلة في تونس والمغرب. ولم أنس المجلات وما كان يروج في الجرائد. أين انتهى كل هذا التراث؟ هل تنوسي أم نسي؟ من يتذكره الآن، أو يفكر في قراءته من أجل المستقبل؟ هل نعيش بدون ذاكرة؟ ما أكثر ما يُكتب حاليا عن الذاكرة، والتاريخ والمستقبل! ولكن بأي معنى؟
أذكر الآن أن الكثيرين ممن عايشوا الحقبة البنيوية، وكتبوا عن السرد يتنكرون لتلك الحقبة. ما أكثر من أعلن منهم “موت البنيوية”، و”موت السرديات”، وهم الآن منخرطون في موجات جديدة لا علاقة لهم بها تاريخيا ولا مستقبلا. المنبت لا أرضا يقطع، ولا زرعا يُبقي.
بعد أكثر من ثلاثين عاما على صدور “تحليل الخطاب الروائي”، ما يزال رنين السؤال الذي طرحته في انفتاح النص الروائي: كيف ننتقل من البنيوي إلى ما بعد البنيوي؟ يشغل تفكيري، وقد أجبت عنه من خلال ما سميته “السرديات الاجتماعية”. وأعتبر كل النقاشات الجارية، بحدة وعنف، حاليا حول السرديات ما بعد الكلاسيكية، هي طرح لهذا السؤال، وسعي للجواب عنه، وفي ذلك كثر الاختلاف، وتعددت الاجتهادات المفتوحة على المستقبل.
عندما أقارن ما يتحقق عالميا، عبر التفكير في السرديات، وفي أي شيء، بما يجري في الوطن العربي، أرى أن مشكلتنا الجوهرية تكمن في علاقتنا بالزمن. إننا نعيش بلا تصور للزمن.