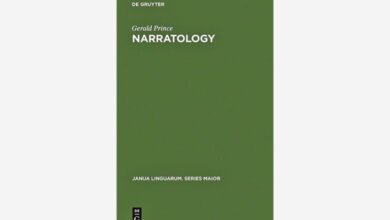الشعراء والساردون والطبقات الجديدة

طرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته الفاضلة لأن الشعراء يفسدون أخلاق الشباب، فالشعر بالنسبة له هو نموذج للمحاكاة السيئة حيث “يتحرر الشاعر من التزام الصورة المثالية كي يحاكي صورًا وشخصيات أخرى لا تثير انفعالاتها التطهر المطلوب ولا تقدم حقيقة عقلية، الشعر يقضي على ثبات النفس حين يكون تراجيديًا ويحث على الضحك حين يكون كوميديًا والضحك لا يليق بالإنسان الحر”.
الشعر هو شر عصره، كما كان يراه أفلاطون في مدينته الفاضلة، إلا إذا تم الإشراف عليه من المربين والساسة للتأكد من خلوه من قيم مفسدة لأخلاق الشباب والأطفال. تعامل أفلاطون مع الشعر بوصفه خطرًا، حله الوحيد هو الحجب والطرد خارج أسوار الجمهورية أو المدينة الفاضلة، لكن الشعر المخصص للآلهة بوصفه تراتيل أو تسابيح في مديح الصالحين، مرحب به ضمن أسوار الجمهورية.
لا تختلف الآية الكريمة في سورة الشعراء (والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)، عن رأي أفلاطون في الشعراء. فالشعراء، في سورتهم أيضًا، لا يلتزمون بالصورة المثالية ويقولون ما لا يفعلون ولا يقدمون ما يطهّر النفوس، ويغوون الآخرين الذين يصدقونهم فيبعدونهم عن الطريق القويم.
طرد الله تعالى الشعراء من الجنة مثلما طردهم أفلاطون من جمهوريته الفاضلة، واحتفظ فقط بمن مدح الرسول وصدق دعوته ومشى على الطريق القويم، أي أن من سيدخل الجنة من الشعراء هم الشبيهون بمن بقوا داخل الجمهورية الأفلاطونية الفاضلة. في المكانين (الجنة والجمهورية الفاضلة) لا يوجد متسع للشعراء الخارجين عن المسطرة الأخلاقية والقيمية المطلوبة، مثلما لا يوجد متسع لمن يتبعهم.
وضع ابن المعتز، وهو عبد الله بن الخليفة المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، وهو الناجي الوحيد بعد جده الأكبر هارون الرشيد، ذلك أن أباه وجده وجد أبيه قد ماتوا قتلًا بعد استلامهم الخلافة بوقت قليل، أما عبد الله بن المعتز فقد شغله الأدب والمعرفة عن السياسة فنجا من الموت قتلًا، ووضع عدة كتب منها كتاب “طبقات الشعراء”.
ويتحدث فيه عن شعراء العصر العباسي، ولكن حصرًا أولئك الذين كتبوا المدائح في الخلفاء والأمراء والوزراء من بني العباس، كما يقول في مقدمة كتابه، أما من لم تجد قريحته في مديح بني العباس كديك الجن الحمصي مثلًا فقد أهمل ابن المعتز ذكره، وطرده من “طبقات الشعراء”، ذلك أن من لم يمدح بني العباس لا يستحق الذكر، ولا يختلف عن الشعراء الذين لم يرتلوا للآلهة زمن أفلاطون.
كما أنه لا يختلف عن الذين لم يمدحوا الرسول إبان الدعوة، هؤلاء جميعهم يستحقون الحجب من الذكر والطرد من المدينة الفاضلة المتخيلة، سواء أكانت جمهورية أم جنة أم كتابًا مدونًا.
لم يخل عصر من عصور التاريخ المدون من علاقة إشكالية مع الشعراء، كان الشعراء في واجهة التاريخ مثلما كان الشعر لسان حال الزمن والتاريخ وأحداثه لوقت طويل، وربما ليس من قبيل المصادفة أن الملاحم والأساطير القديمة الكبرى، والكتب المقدسة كلها دون استثناء، قد كُتبت شعرًا، وبنفس المنهج والطريقة التي كان الشعر يكتب فيها في زمن نزول الكتاب المقدس.
وقد وردت كلمة شعر أو شعراء في القرآن الكريم عدة مرات، ومعظمها في نفي صفة الشعر عن القرآن الكريم وصفة الشاعر عن النبي محمد، وذلك بسبب أن القرآن الكريم نزل وحيًا على النبيّ كما وحي الشعر على الشعراء، ونزل شبيهًا بالشعر الجاهلي من حيث بعض الأوزان والقوافي، حتى أن أعداء الدعوة قالوا عنه إنه “لشعر يوحى”، فنزلت الآيات التي تنفي ما يقولونه.
تغير الأمر مع العصر الحديث، وتراجعت مكانة الشعر لا لأن قيمته تراجعت بل لأن تغيرات كثيرة طرأت عليه شكلانيًا وفنيًا ولغويًا ووظيفيًا، ظهرت أنماط جديدة للقصيدة، وتحررت من قيودها الشكلانية والوظيفية معًا، وهذا التحرر كان بمثابة طوق النجاة للشعر.
إذ أبعده عن الأسطرة، وأبعد عنه النقد الأخلاقي ومسطرة السراط المستقيم، وأسس لطبقات جديدة مختلفة للشعراء سوف تذهل ابن المعتز لو أن من باتوا في العالم الآخر يتاح لهم معرفة ما يحدث في الحياة، فلو أراد أحدهم الآن ترتيب الشعراء حسب طبقاتهم لوضع المداحين في الطبقة الدنيا من طبقات الشعراء، المداحين للسلطة بجميع أشكالها.
بما فيها سلطة الإله والدين، ولوضع صعاليك الشعراء بقديمهم وحديثهم في المرتبة الأولى، ضاربًا بجمهورية أفلاطون الفاضلة عرض الحائط، ذلك أن الشعر يقترب من الزندقة لفرط حريته، وهل سيدخل الزنديق الجنة؟ لا بأس لم يعد الشعر يهتم بهذه الانحيازات الأخلاقية.
ذلك أن التطهر الذي أراده أفلاطون ومن بعده الأنبياء برسالاتهم الدنيوية والسماوية كان سببًا في الديستوبيا الحالية، ينأى الشعر بنفسه عن هذه الصراعات، ويقابل ما يحدث بابتكارات مدهشة في اللغة والشكل، ويحطم من جديد كل تصنيفاته ممتنًا لتراجع مكانته التاريخية، إذ أخرجه هذا حتى من التاريخ لصالح كينونة النفس البشرية بما هي الكون كله.
احتلت الرواية مكان الشعر، وصار التدوين روائيًا سرديًا بعد أن كان شعرًا، ويمكن الافتراض أنه لولا أن النبيّ محمد كان خاتم المرسلين لنزل كتاب سماوي سردي حاليًا.. تخيلوا هذا!! ودخلت الرواية في فخ التراتبية الطبقية مع دخولها فخ الجوائز وأفضل المبيعات، صار الروائيون يصنفون حسب أكبر عدد من ترشيحاتهم للجوائز المختلفة، وهو ما لم يحدث للشعر يومًا.
فلا توجد جائزة شعرية على طريقة البوكر أو نجيب محفوظ أو كتارا أو غيرها من الجوائز الكبيرة، حتى عالميًا، جوائز الشعر تكاد تكون نادرة. في بلادنا اخترعوا جوائز للشعر المقاس بمسطرة الأخلاق والعروض ومدح الأنظمة ودعمها والوقوف معها، على طريقة أفلاطون أو ابن المعتز، بعد أن طردوا الشعر المنزاح خارج أسوار المال والجوائز.
هكذا انتهى عصر طبقات الشعراء ليبدأ عصر طبقات الروائيين وكتاب القصة القصيرة، أو عصر الساردين، إن صح القول، ولا أظن أن هذا سوف يطول كثيرًا ذلك أن القادم يبدو كما لو أنه يحمل معه موت اللغة لصالح الرموز الافتراضية، فهل ستنتهي اللغة فعلًا بتحولها إلى رموز كما بدأت برموز كهفية مع الإنسان القديم؟ إن صح ذلك فالشعر باختزالاته قد يتأقلم مع الرموز، لكن ما مصير الرواية بصفحاتها التي لا تنتهي وبجملها الطويلة التي تعادل كتابًا كاملًا في الشعر؟