الانقلاب على التنوير
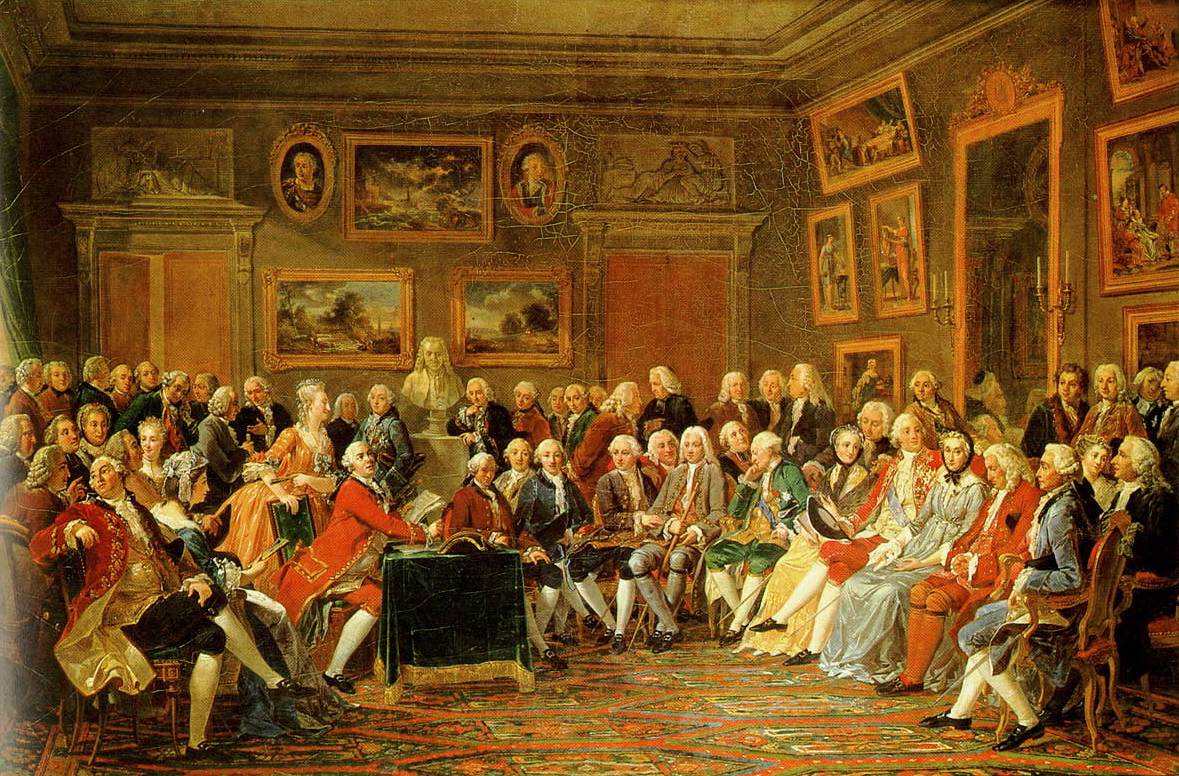
في الواقع لا يمكن اعتبار المفاهيم منجزات ثقافية نهائية، فالنهائي هو الميت، وكان لا بد من إعطاء الفرص في تطويرها أثناء ممارستها، وهذه الفرص لا يمكن نقضها لأنها محمية بالمساواة، حيث أنها جوهر المفاهيم التنويرية، والمادة الأولية الأساسية لحدوث “المجتمع” بمعناه الحديث والمجدي، فكان لا بد من تقاسم المهمة بين الفئة الأقوى فيزيائيًا، وأصحاب الأفكار التطويرية من فلاسفة ومفكرين ومنظرين.
وهذا التقاسم هو جوهر الانقلاب على المفاهيم التنويرية من قبل الفئة القوية، التي تحتاج بقوة وبالضرورة لهذه المفاهيم لتطوير هيمنتها في الواقع، فهناك انتخابات وديمقراطية ومساواة، ولكن فقط إذا تم النضال من أجلها كل مرة، نضالًا سلميًا يشكل انقلابًا لينًا وأبيض، يقدم منتجات التنوير (خصوصًا تكنولوجياته الاستهلاكية) كوقود لاستمرار الجدل والصراع.
فالتهديد الأكبر الذي يواجه التنوير هو انتصاره النهائي لمرة واحدة وأخيرة، وعليه يبدو التنوير سلسلة من الأفعال المعرفية والثقافية يجب أن لا تنقطع لأي سبب، وهنا يكمن جوهر هذا النوع من الانقلاب على التنوير عبر تعطيل مستحقاته، وذلك عبر إظهار منتجات له تعتمد عليه نظريًا (وهذا مجال واسع للتلفيق)، ولكنها مضطرة لممارسة عكسه،
وهذا أيضًا ما نفح الحياة في تيارات اللاتنوير، ليبدو الصراع معها كبديل عن عدم انقطاع سلسلة الارتقاء عبر الجدل. ليتم تجاهل نوعية الصراع ووسائله ونتائجه، بناء على تبادل المصالح بين القوى المهيمنة.
على الأقل هذا ما حصل في الكثير من البلدان، فالتنوير كوصفة علاجية أثبت جدواه في الكثير من البلدان على الرغم مما سبق، فالتنوير وصفة عالمية يمكنها الحفاظ على الهويات المجتمعية دون جهد خاص، فالهوية إذا كانت أصلية وقوية لا يمكن التأثير بها أو عليها، بضمانة ارتقاء مفاهيم التنوير التي كُسرت للعديد من المرات مثل (الفاشية والنازية والفرانكوية وهذه في إطار فعالية مجتمعية واحدة فقط).
ولكن التنوير استمر كأحسن وصفة موجودة حتى الآن، ونجحت الكثير من البلدان التي تعاملت معه بإخلاص في تجاوز واقعها المرير فعلًا.
هذا ما يعطينا لمحة عن التنوير المشروط الذي نعرفه، ونتائجه التي نعرفها، كما يعطينا فكرة عن تكتيكات واستراتيجيات هذا التنوير المشروط، (هذا ما توضحه إعلانات التنوير العالم ثالثية، بواسطة كلمات ملحقة على شعاراتها، مثل الشعبية، أو التوافقية إلخ وصفًا للديمقراطية، وكذلك كلمات توصيف الحرية، إلخ).
فالتنوير العالمثالثي الذي ابتدأ انقلابيًا على تنوير آخر سبقه، لم يعطه فرصة للجدل التنويري (أنموذج ناصر 1952) بل صادره وجيّر منجزاته لنفسه في شعارات هوياتية لم يثبت لها أي جدوى في القضايا المصيرية حتى الآن، لا بل صارت الأوضاع أسوأ، في الحالة الحقوقية للسكان، أو الحالة الإنتاجية لقواه،
بما فيها التحرير وتقرير المصير، وهذا ما يعد انقلابًا كاملًا على التنوير بما أنه تكنولوجيا حقوقية يمكن تطبيقها، دون الشعور بالعظمة والفخامة المستنبتة من كتب التراث.
ربما من بين كل مفهومات التنوير، التي وصلت إلى العالم الثالث ولم يتم ممارسة غالبيتها، كان مفهوم البقاء للأقوى، الذي فُهم ومورس بمظهره الإطلاقي على الكائنات بكل مستوياتها، فالأقوى ليس معنيًا بتقديم مكتسبات التنوير الحقوقية والأخلاقية، فهو القانون والأخلاق معًا، مانعًا الخصومة والتنافس عن الأداء السلوكي للسكان، فاتحًا الساحة للعداء والتحدّي وتحديدًا الاقتتال.
ومن هنا يمكن لنا الإطلالة على الانقسام العمودي الثقافي والسلوكي لهذه الشعوب، فالقيمة التنويرية المفروضة للصراع هي “البقاء للأقوى”، كقيمة اجتماعية ووطنية وثقافية، لا بل إنسانية أيضًا، لتظهر ثقافة الاستياء الكامنة وراء السلوك العلني الكامن وراء التجمعات الثقافية، التي لا تلبث أن تفهم أن الحل الوحيد هو العنف والاقتتال.
إن لم يكن على سبيل التغيير، فعلى سبيل الانتقام، ليتحول جدل الارتقاء بالتنوير، إلى اقتتال حول أولوية تجميده، وإطلاق العنان للاستدامة كوعد لتحقيق الإستراتيجيات، بشرط الخضوع لهذه الاستدامة.
المشكلة أن الجميع يتقاتل على إحلال التنوير ومستحقاته كونه الطريق للشبع والمنعة، وليس من أحد يقبل به إلا بشروط تقود بالبداهة الى التخلف والانهزام. إذ لا يقبل أن يكون شرط الحرية هو الاستبداد، ولا شرط الكرامة هو الإذلال، ولا شرط العدالة الأحكام العرفية المستدامة… إلخ.
على خط موازٍ، ومن داخل التنوير الآنف، وعلى صعيد تقديم هبات تكنولوجياتية للشعوب، يبدو النقص الفاضح في ممارسة المفهوم، فعلى الرغم من مشاريع التعليم الضخمة (مثالًا)، لم يزدهر التعليم، ولم يمكن توظيفه، أو ربطه بالمجتمع.
ولم يكن التصنيع ذا جدوى حيث تتآكله المنافسة الخارجية في التكلفة والمواصفات أيضًا. كله أدى حتمًا إلى فشل السلطات في تحقيق تكتيكاتها الآنية، وحاجتها الدائمة والملحة للبروباغندا، لسد الشقوق التي سببها التنوير.
اليوم… تبدو هذه البلدان “بالمعيار التنويري” منكشفة حتى أمام تنويرها المشروط، الذي أتاح لها التلاعب بقيم التنوير والالتفاف عليها، مما يجعل الحياة في الواقع رحلة عذاب مكبوتة بالقهر والإصمات.
ففي المقام الأول يجب أن يتلقى السكان مكافآت التنوير من حيث الحرية والشبع والكرامة وإلى ما هنالك من “حقوق” أصر التنوير على وجود مقابل لها هو “الواجبات”، فإذا لم ينصع الأقوى لمستحقات التنوير فالمصيبة حالّة لا محالة، مهما كان في البلدان من إمكانيات.
لم تولد الهجرة من هذه البلدان البارحة، لقد ابتدأت مع فشل هذا النوع الخبيث من التنوير، ولم تذهب هذه الهجرات إلى بلدان مشابهة لبلدها الأم، بل ذهبت إلى أمكنة وبلدان معاكسة تماما له، لتبدو كألطف الحلول العنيفة ضد هذا التنوير.
التنوير هو حال من الدقة والدراية والإخلاص والعزيمة، لا ينفع معها حالات أنصاف وأرباع التبني، فالتنوير نوعي، وليس كميًا يتراكم كالتبرعات الخيرية، ويأتي كاملًا وليس بالتقسيط، والدستور هو نص واحد غير متناقض حتى في أقصى التفاصيل، والإخلاص للدستور هو العملية الأولى من إنتاجات هذا التنوير.














