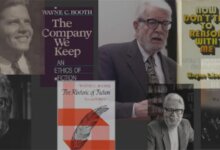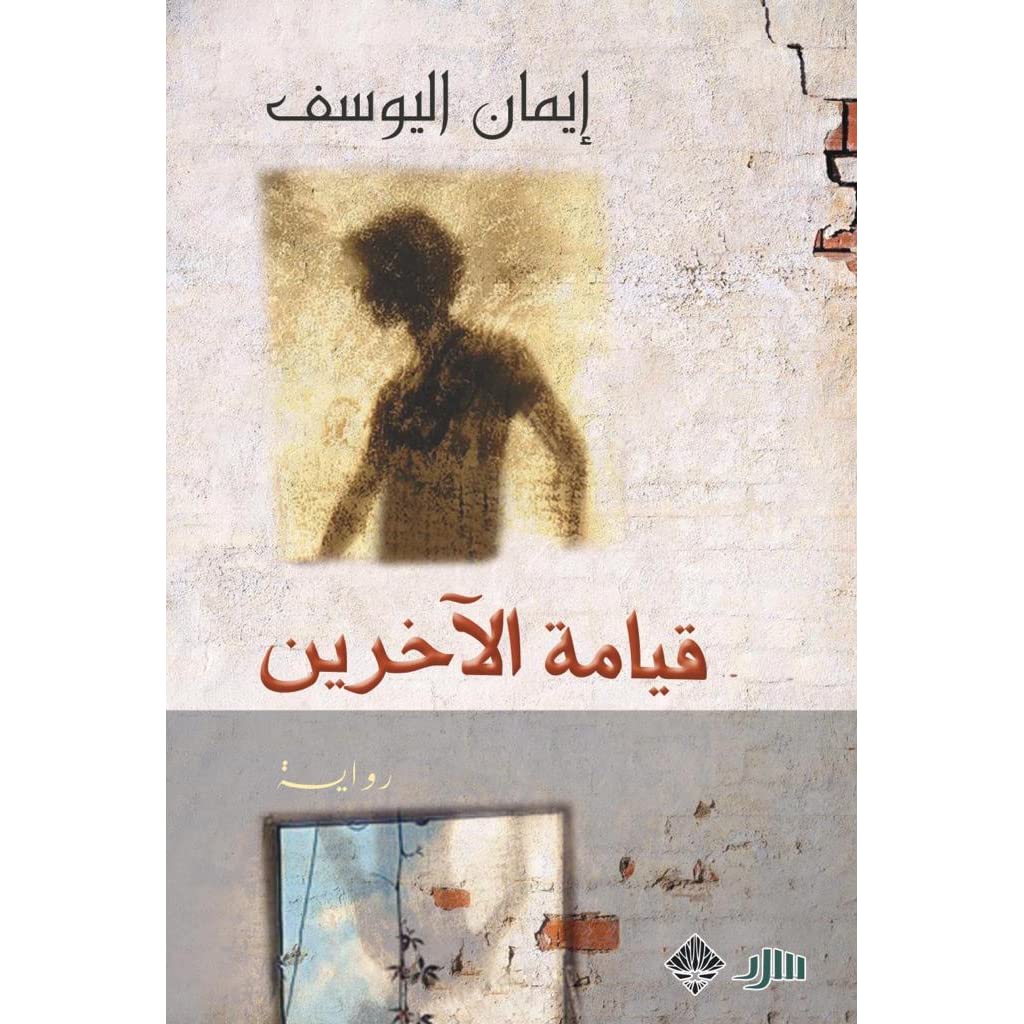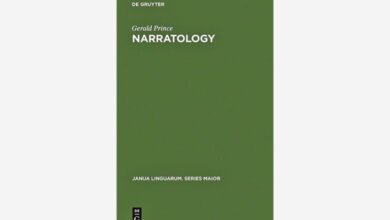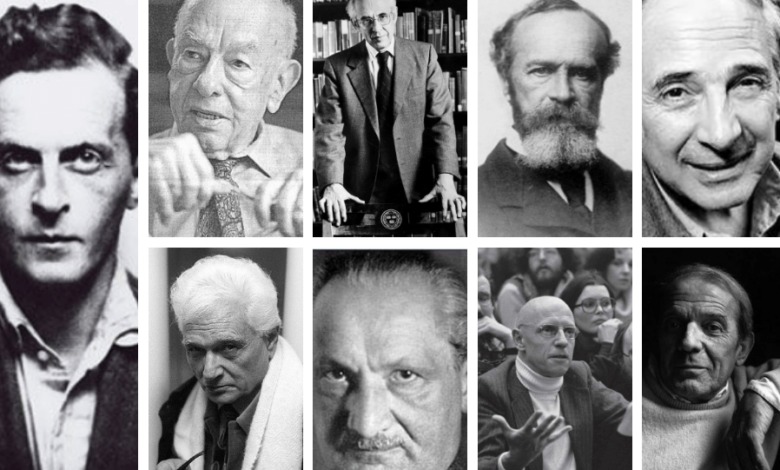
جاك دريدا، جاك لاكان، لوسي إريجاري، رولان بارت، ميشيل فوكو، جوليا كريستيفا، وجيل دولوز. لقد شهدت الستينيات جيلًا من المفكرين الفرنسيين الذين نضجوا في مرحلة هي ربما مرحلةُ أعظم الازدهارات الفكرية في التاريخ.
وستقوم هيلين سيكسو، واحدة من جماعتهم، بتسمية هذا الجيل: “غير القابلين للفساد”. وسيتدفق أثرهم، بخيره وشرّه، من أقسام الفلسفة إلى الأدب، السينما، دراسات الجندر، دراسات ما بعد الكولونيالية، والثقافة الشعبية.
لقد وضع كلّ واحد من هؤلاء اللغةَ والخطاب في مركز تحليلاتهم، على نحو شديد الجدية وشديد الهزل، سواء أكان دريدا مناقشًا أنه “ما من شيء خارج النص”، لاكان قائلًا إن “اللاوعي مبني مثل لغة”، أو كريستيفا طارحةً فكرة “التناص” في كتابها “الرغبة في اللغة”.
كما أن الحاجز بين الفلسفة والأدب يصبح نَفوذًا أكثر فأكثر، و”لذة النص”، إذا استخدمنا تعبير بارت، تصبح أكثرَ إغراءً مما هي عليه. فبالنسبة إلى كلّ من أولئك المفكرين، الكلماتُ هامة؛ وأكثر من ذلك، الكلمات هي المادة التي نبني بها أنفسنا وعالمنا.
ليست مصادفة إذًا أن حيوات أولئك الفلاسفة قد سُلبت لكي تُستَخدم في روايات. وكانت كريستيفا نفسها من بين الأوائل الذين فعلوا هذا. ففي روايتها “الساموراي” (1992) صوّرت نسخًا مموَّهة قليلًا من بارت (الكاتب المثليّ الدمث أرمان بريال)، لاكان (موريس لوزان بردائه وسيجاره) ودريدا (السيميائي غريب الأطوار سايدا، مخترع “التفكيك البنائيّ”).
كما تصادف أن تكون أولغا، بطلة رواية كريستيفا، مفكرّةً من دول أوروبا الشرقية تعيش في باريس، وهو ما يحمل شبهًا كبيرًا بالمؤلفة. وقد تزوجت من هيرفي سينتوي، الذكي والمثير ومحرر الصحيفة الأدبية “الآن”؛ وكلّ هذا يحمل شبهًا غريبًا بزوج كريستيفا، فيليب سولِرس، محرر مجلة “تيل كيل” (التي يعني اسمها “بالحالة الراهنة”).
غير أنها رواية سيئة إلى حد ما، تضلّ طريقها آخذةً جانب القيل والقال والنكات الخاصة بالمجموعة، وتصوّر مشاهد جنسية رهيبة ليس لها، على حدّ قول صحيفة نيويورك تايمز، “أي مثيل في الأدب الحديث”. لكن، ربما تكون المقالة ذاتها قد تمادت قليلًا في وضع “الساموراي” في مجموعة واحدة مع قتل لوي ألتوسير لزوجته وفضح بول دو مان كنازي معتلٍّ اجتماعيًا، ضمن ما كانت “سنة سيئة بالنسبة إلى أبطال أوروبا الخارقين الأكاديميين”.
في مرحلة أحدث، تأتي رواية باتريشيا دونكر المقتضبة والمعقدة “الهلوسة بفوكو” (1996) لتستعرض هوسًا بمن هو ربما الأكثر هوسًا بين أولئك المفكرين؛ إذ يصبح بطل الرواية مجهول الاسم مستنزفًا من الفيلسوف المسمّى وكتاباته. رواية دونكر استكشافٌ للحب بين المؤلف والقارئ، وعلى حدّ تعبير الرواية: “تسألني ما هو أكبر مخاوفي…إنه فقدان قارئي، الإنسان الذي أكتب لأجله”. وكما قال فوكو نفسه ذات مرة: “أنا لا أكتب كتابًا لكي يكون الكلمةَ الأخيرة؛ أنا أكتب كتابًا لكي تكون كتبٌ أخرى ممكنة؛ كتبٌ لست أنا بالضرورة من يكتبها”.
وفي وقت لاحق، رواية “الوظيفة السابعة للغة” (2017) للفائز بجائزة غونكور، لوران بينيه، تنسج حكاية تشويقٍ تاريخية من موتِ مؤلفِ “موت المؤلف”، رولان بارت. معروف بالطبع أن بارت مات بعد أن دهسته شاحنةُ مصبغة في أثناء عودته إلى المنزل بعد غداء مع المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا ميتران. لكن، في رواية بينيه، موت بارت هو جريمة قتل.
ويكلّف ضابطا شرطة متنافران على نحو مسلٍّ، المحافظ بيّار ومساعده هيرزوغ، ومعهما خريج جامعي يساري، بمهمة حلّ اللغز. هل قُتِل بارت لأنه كان على وشك اكتشاف “الوظيفة السابعة للغة”، لتضاف إلى الوظائف الست التي وضعها رومان جاكوبسون؟ وظيفة تتيح لمستخدمها أن يقنع أي شخص بأي شيء، من خلال براعة بلاغية محضة؟ دريدا، فوكو، وكريستيفا ذاتها، يخضعون جميعًا للاستجواب.
ويُسخَر من سولِرس بلا رحمة، في حين تصبح نظريات بارت ذاته دلائلَ لحلّ الألغاز. إنها رواية شيّقة، حتى وإن كان خداعها قد يزعج بين الفينة والأخرى؛ لكن هذا الخداع المزعج، قد يُقال، له صلة معينة بـِ”غير القابلين للفساد”.
ولا أحد ينطبق عليه ذلك أكثرَ من المحلل النفسي جاك لاكان. فلكونه معقدًا، مبهمًا، ومنفّرًا – ككاتب وكشخص- يمكن أن تثير كتابة لاكان المكثفة الخوفَ والحنق حتى عند أصلب قاطني الفلسفة الفرنسية في أواخر القرن العشرين. وقد يبدو هدفه المعلَن-“العودة إلى فرويد”- بسيطًا للغاية.
لكنْ، في هذا المسعى تكمن عاصفةٌ من المفاهيم المستغلقة والمتكلفة، من “اسم الأب” إلى “الموضوع A”، من “المتعة” إلى “الإدراك الزائف”. كما قد تتداخل هذه المفاهيم مع مخططات شبه رياضية مثل “رسمٍ بياني للرغبة” (وهو تمثيلٌ مسطح لسلسلةٍ دالة أثناء عبورها موجِّه الرغبة) أو “عقدة بورومين” التي تمثّل بنية الذاتية البشرية.
ثمة هنا مياه محفوفة بالمخاطر للسباحة فيها. مع هذا، رواية سوزان فينلي الجديدة “مؤسسة جاك لاكان” (2022) تفعل ذلك، لا برباطة جأش وحسب، بل كذلك بطريقة فكاهية مُضحكة للغاية، من صورة كيت موس ذات العينين الواسعتين كعيني الظبي على الغلاف وصولًا إلى حبكة عبثية على نحو عجيب تُبقي نفسها على هذا الجانب من السهولة.
| رواية “الوظيفة السابعة للغة”(2017) للفائز بجائزة غونكور، لوران بينيه، تنسج حكاية تشويقٍ تاريخية من موتِ مؤلفِ “موت المؤلف”، رولان بارت |
إن هذه الرواية، من صيحتها الافتتاحية “فِرْج!”، متبوعةً بإيماءة مباشرة للوحة غوستاف كوربيه “أصل العالم” (1866) – التي كانت معلّقة لبعض الوقت في منزل لاكان الريفي- هي جولة جامحة، تُبلي ذكاءها قليلًا في حين تستمر بتقديم نقدٍ تفصيلي لعالمٍ فيه السياسة، والرأسمالية، وصنع الصورة هي تقريبًا غير قابلة للتمييز واحدتها عن الأخرى.
العام في الرواية هو 2018، ونيكي سميث – التي تسمي نفسها “ليتُس كرويدن سميث” لأسباب تتعلق بطبقتها وخطئها الفادح في الاصطلاح- هي امرأة بريطانية شابة حصلت لنفسها بالتملق على “عمل ساحر منخفض الأجر” في مؤسسة جاك لاكان في تكساس. وكانت سابقًا تعمل في متحف فرويد في لندن حيث “فشلت في استيعاب الفروق الدقيقة بين نظريات المحللين النفسيين المختلفة، أو حتى الفروق الدقيقة بين تفسيرات مختلفة لنظريات المحلل النفسي ذاته”.
في مؤسسة جاك لاكان، يكلّفها أرباب عملها – إثر انبهارهم بسيرتها الذاتية، كما يجب أن يكونوا- بمهمة ترجمة دفترِ ملاحظات لاكان المكتشف حديثًا والأخير – أو هل هو كذلك؟- على الرغم من أنها، كما نعلم ولا يعلمون هم، لا تتقن الفرنسية. ولذلك، تضطر للاعتماد على مترجم غوغل (ثمة، كما تشير نيكي، “بعض الرياضيات” المزعجة، والتي تُضطر لأجلها إلى استبدال E=MC2). ومن هو الغامض بيبِه؟ ومن هو الغامض آلان- جاك؟
لكن، وإذا كانت نيكي/ليتُس غافلة عن دقائقِ لاكان، فإن فينلي ليست كذلك. هو ذا عالم يمرّ بمرحلة المرآة – تلك اللحظة الفارقة في وجود الطفل حيث لا يدرك ذاته في مرآة، حرفيًا، وحسب، بل يأخذ مكانه كذلك في النظام الرمزي، قادرًا على رؤية نفسه من الخارج- وهو موقع أفضليّة نضطر لاتخاذه أكثر فأكثر بينما نحن مرميون خارج أنفسنا، إذ تكدّسَ التاريخُ وجعل حتى أكثر لحظاتنا عاطفيةً تبدو ثانوية.
إن عالم نيكي هو عالم كل شيء فيه هو صورة عن ذاته وإحالة إلى شيء آخر؛ عالمٌ تستطيع نيكي فيه أن تقود سيارتها مارّةً “بمزرعة كان من الممكن أن تكون في أغنية مصورة لموسيقى البلوغراس الريفية، وبناطحة سحاب كان من الممكن أن تكون في فيلم من الثمانينيات يتحدث عن محامين بارعين”.
وفي ذلك العالم، تشعر نيكي بالقلق من أن حياتها قد تكون “مجرد سلسلةٍ من المشاهد الوجودية جدًا على طريقة فيلم من أفلام الموجة الجديدة أو إعلانٍ تجاري عن عطر”، وحيث يدخن الناس سجائر “هيبيّة إلى درجة أنها تكاد تكون صحية”.
كل شيء يُفعَل لأجل التأثر أو التأثير؛ نيكي ليست مصابة باضطراب ما بعد الصدمة، إنها مصدومة بأنها مصابة باضطراب ما بعد الصدمة. ودييغو، حبيبها “نوعًا ما”، فتى إصلاح مكيفات الهواء (أو هل يجب أن تقولَ “رجل” إصلاح مكيفات الهواء؟ تفكر) وصانعُ الأفلام (“نوعًا ما”)، يكشف لها أنه فقد والدته، ولهذا يفهم مشاعرها حول فقدان والدها جرّاء إصابته بالسرطان (والذي قد تكون هي أيضًا، على نحو شبه مؤكد، مصابة به).
حينها، تفكر أنه في فيلم حياتهما “ستكون هذه لحظة مثالية لأريح رأسي على كتفه. كنت لأسأله عن طفولته، وكان ذلك ليُفضي إلى العديد من الرؤى الهادية التي ستساعد كل واحدة منها في شرح الحكاية وتشكيلها…لحسن الحظ، كان كلانا أقلّ تكلّفًا من أن نكون تقليديين…”.
ومع غرق نيكي أكثر في ألغازِ دفتر ملاحظات لاكان، وتمضية وقتها في مشاهدة إعلانات كيت موس التجارية، وتخيّل نفسها تصبح سلفًا تقريبًا نجمةَ الأفلام التي يصنعها حبيبها سلفًا تقريبًا (“مثل ليدي ماكبث، إنما النسخة المؤثرة المثيرة حقًا منها”)، عليها أن تبقى متقدمة بخطوة على لاكانيين عديدين (واللاكانيون هو الاسم الجمعيّ التي قررت له أن يكون “قطيع ثعالب”)، أو ربما خلفهم بخطوة.
وأثناء ذلك، تصبح الرواية تدريجيًا – على نحو محتوم وعجيب- فيلمَ طريق/قصة انتقال من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش/رواية كوميدية رومانسية ذات نهاية سعيدة، كما هو مقدّر لها أن تكون. أو هل تصبح كذلك حقًا؟
إن رواية “مؤسسة جاك لاكان” هي جولة مرحة عبر الثقافة والسياسة المعاصرتين، وهي تتناول عمل لاكان بكلّ ما فيه من مرح، وتنتقده بكل ما فيه من تفاخر. لكن، يتبقى فيها بعض اليأس لحياة الشخصيات إذ أن حيواتهم الخيالية والرمزية، وفق تعابير لاكان، تستمر بالتسارع مقابلَ الواقعي و”أشكالَ أكثر شخصيّة من العدم”، على حد تعبير نيكي. إن دراما مرحلة المرآة هي الخطوة الأولى في اغتراب الذات.
يكره المرء نسخة من ذاته لم تعد ذاته، راغبًا في الوقت ذاته بأن يكون جميع تلك النسخ، تامة وكاملة. لكنْ، ورغم ذلك كله، تبقى هذه رواية ظريفة ومثيرة؛ رواية تفيض بالمتعة. ولاكان ما كان ليكرهها. أو هل كان ليفعل؟
بيتر سالمون: كاتب استرالي يعيش في المملكة المتحدة ويدرّس الكتابة الإبداعية. كتبَ للراديو والتلفزيون وله بعض القصص القصيرة. روايته الأولى هي “قصة القهوة” (2011)، وأحدث كتبه “حدثٌ ربما: سيرة شخصية لجاك دريدا” (2020).
المصدر: ضفة ثالثة