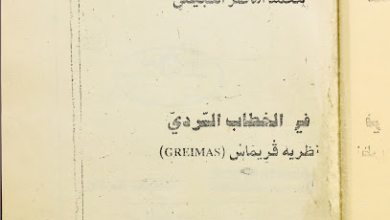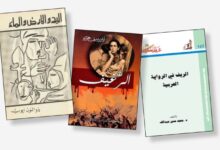فلوديرنيك وسرديات «السرد الطبيعي»

تشكلت السرديات الكلاسيكية خلال هيمنة الإبدال البنيوي الذي لعبت فيه اللسانيات دور العلم الطليعي الذي انبنى على أساس التمييز بين الدال والمدلول كما حدد ذلك دو سوسير. لكن السرديات ما بعد الكلاسيكية بدأت تتبلور مع بروز علوم جديدة مثل المعلوميات والعلوم المعرفية (وضمنها اللسانيات المعرفية)، وغيرها.
ولقد أدى هذا التحول إلى ظهور ثنائية جديدة تعتبر السرد والاستعارة وجهين لعملة واحدة يمكننا من خلالها تغيير تصوراتنا إلى السرد، باعتبارهما يشكلان المعرفة الإنسانية التي تتحقق بواسطة السرد، وبذلك كان الانتقال من الإبدال اللساني إلى المعرفي. نجم عن هذا التحول احتلال «العقل السردي»، كما عمل مارك تورنر وفوكونيي على تطويره، المكانةَ التي كانت للسرد باعتباره لغة تتمفصل إلى دال ومدلول، أو قصة وخطاب.
في سياق هذه التحولات تولدت الاجتهادات السردية مع مونيكا فلوديرنيك التي تمثلت السرديات، ومختلف النظريات السردية، وسعت إلى تقديم نموذج سردياتي تستفيد فيه من مجمل هذه التغيرات وفق إطار تصوري خاص بها تنطلق منه نظريا وتطبيقيا. لذلك أعتبر مشروعها، حسب تصوري، من أهم التصورات التي عملت على تطوير السرديات وتوسيع مجالها.
لقد جمعت بين ثقافتها الجرمانية، وامتلاكها الإنكليزية بسبب تدريسها إياها، وساهم ذلك في تثبيت حضورها النوعي عالميا من خلال مساهماتها المتعددة والمتنوعة في مختلف المؤتمرات والنقاشات التي بدأت منذ التسعينيات من القرن الماضي حول السرديات. هذا إلى جانب إنتاجاتها الغزيرة في مختلف القضايا المتعلقة بالسرد، والتحليل السردي.
انخرطت فلوديرنيك في السرديات ما بعد الكلاسيكية قبل بروز هذا المصطلح. كما أنها اقترحت الانطلاق من العلوم المعرفية في تحليل السرد، قبل ظهور ما سيصبح اتجاها خاصا تحت عنوان «السرديات المعرفية» بسنة كاملة. يبدو لنا ذلك بجلاء في كتابها «نحو سرديات الطبيعي» سنة 1996. ومنذ ظهور هذا الكتاب وهو يثير النقاش، ويحث على تفكير جديد في السرد.
وعلى غرار العلماء الذين يفكرون في مشاريعهم وفق مقتضيات البحث العلمي، أوضحت خلفيتها المعرفية، وخطوات وإجراءات عملها بدقة متناهية. لذلك فإن النقاشات معها تؤسس لمعرفة جديدة، وتخلق أفقا للتفكير والبحث في السرد، عكس بعضهم ممن دخل السرديات ما بعد الكلاسيكية من باب لا يسمح بالنقاش العلمي، ولكن بالسجال الذي لا يقدم ولا يؤخر.
بنت مونيكا نموذجها السردياتي أو إبدالها على ثلاثة أصول، وهي من جهة، السرد الحواري أو «الطبيعي» كما نظَّر له وليام ليبوف، باعتبار هذا السرد هو النموذج الأعلى أو الأنموط (Prototype) الذي يتأسس عليه السرد، أيا كان نوعه. تكتب الباحثة: «إن الإطار المعرفي للسرد الطبيعي يمكن تطبيقه على أي عمل سردي».
ومن جهة ثانية على خلفية اللسانيات الطبيعية أو المعرفية. وثالثا على مصطلح «التكييف» (Naturalization) الذي اقترضته من جوناثان كالر، وهو يعني به العملية التي بمقتضاها يعمل القارئ على الحصول على تفسيرات وشروح «يكيِّف» بواسطتها ما استعصى عليه فهمه في العمل السردي سالبا عنه ما يراه غير منسجم لتحقيق التواصل معه على طريقته الخاصة، والتي تختلف من شخص إلى آخر.
في ضوء هذه الأصول انطلقت الباحثة من مصطلح «السردية» الذي وظفته السرديات الكلاسيكية رابطة إياه ليس بالحبكة، أو القصة، كما تقول. ولكن بما أسمته «التجربية». وفي الواقع فإن من ربط السردية بالحبكة هم السيميائيون، أما السرديون فقد جعلوا موئلها هو الخطاب.
إن ربط السردية بالتجربية جعلها ترى بأن أي شخص يُولَد مجهزا بملَكة فطرية تجعله قادرا على سرد قصة معبرة عن تجربة أو على التفاعل معها بواسطة التلقي.
وهي بذلك تربط هذه التجربية بـ«قابلية الحكي»، من جهة، و«الفائدة»، من جهة أخرى، كما استعملهما ليبوف ومحللو الخطاب. إن التجربية هي الخاصية الأساسية لأي عمل سردي لأنها تتجسد عن طريق الأحداث غير المتوقعة والتي تثير المشاركين، والتي تجد لها حلولا بواسطة ردود أفعالهم مما يعطي للقصة فائدة دالة تربط فعل السرد بسياقه الذي يتحقق فيه.
وما دام مصطلح «التكييف» عند كالر يرتبط بتجربة القارئ التي يقيمها مع العمل السردي، فقد استبدلت مفهوم «التكييف» بمصطلح «التسريد»، والمقصود به ما نقوم به لجعل النص السردي يتناسب مع شكل التجربة المعهودة عندنا، عن طريق تكييفه لها مع تجربته الخاصة، ويؤدي ذلك، في النهاية إلى فهمنا للعمل السردي والتفاعل معه.
إن التسريد يجعل قصة ما مفهومة لدينا بما يمكن تسميته بـ«ميتا قصة» التي يمكننا النظر إليها بصفتها ذاك النموذج الأعلى المتوفر لدينا لأنه جزء من ثقافتنا ومجتمعنا، وهو أيضا تعبير عن تجربة حياتية يتصل فيها السرد بالحياة.
انطلقت الباحثة من «السردية»، وحولتها من «الحبكة» (المتصلة بالعمل السردي في ذاته) إلى «التجربة» الإنسانية. وحولت «التكييف» إلى «التسريد» الذي يجعل «السردية» تعبيرا عن تلك التجربة المعرفية العامة التي تتجاوز السرد في خصوصيته اللغوية.
واضح هنا ربطها السرد بالحياة في شموليتها، وأنه ليس فقط إنتاجا لغويا، مؤشرة بذلك على تطوير نظرتنا إلى السرد، ودافعة في اتجاه تحليل سردي ينبني على إبدال معرفي جديد. وفي ضوء هذا التصور فإن السرديات المعرفية تبين لنا أن قارئ النص السردي يتعامل معه ليس على أساس أن يمتلك خصائص سردية، ولكن على خلفية بسط أطر سردية معرفية تدفعه إلى تأويل الحيوانات، مثلا، في أمثولة، على أنها شخصيات، مثلها في ذلك مثل الشخصيات البشرية تقوم بدورها في العمل السردي.
لقد استفادت الباحثة من مختلف التصورات المعرفية سواء اتصلت باللسانيات المعرفية أو بغيرها من العلوم التي تعاملت معها، ودافعت عن تداخل الاختصاصات عن طريق الحوار البناء بين علم النفس وعلم الاجتماع واللسانيات والسيميائيات ونظرية التواصل، والإثنوغرافيا والذكاء الاصطناعي وفلسفة الذهن في نطاق العلوم المعرفية.
كما بينت أن «بناء العالم السردي» يؤدي إلى تشكيل مقاربة متعددة الاختصاصات، حيث تتحرك عدة إطارات للتحليل لمعاينة أو معالجة قضايا مركبة تقع في الملتقى الذي يجمع السرد بالذهن. وهي في دفاعها عن تعدد الاختصاصات تُسلِّم بأن الحوار بينها لا يعني اقتراض مفاهيم أو مصطلحات من جانب اختصاص ما، وفرضها على السرد لأن ذلك لا يؤدي إلى تحقيق الملاءمة العلمية.
وتضرب لذلك مثال دراسة تأويل السرد، مناقشة ما قدمته دوريت كون التي ترى بأن التأويلات تعمل على إدماج مختلف أنماط الإشارات النصية المتعلقة بالعوالم السردية، وذلك عن طريق الربط المؤقت بين هذه الإشارات واشتغال أذهان بعض الناس (عمل المؤلف، أو الراوي مثلا) لإنتاج أنماط الإشارات المطلوبة. لكن الفرضية التي تنطلق منها فلوديرنيك، على النقيض من ذلك.
إنها تؤكد أن تأويل السرد يستدعي، ويتطلب بشدة إسناد أسباب الفعل السردي إلى الفاعل الذي يضطلع به في النص: فأدوار الراوي أو المؤلف قد تلتقي أحيانا، وقد تتعارض أحيانا أخرى. لذلك فإن إدماج مختلف تلك الإشارات التي تتحدث عنها دوريت كون، لا تربط إسناد أسباب الفعل السردي للفاعل وفق تجربته الخاصة في ضوء الإشارات المقدمة في النص.
جئت بهذا المثال لإبراز الطريقة التي تشتغل بها الباحثة في مناقشة الآراء، وتقديمها لتصوراتها وفق المنطلقات الإبستيمولوجية التي تتبناها في تحليل السرد.