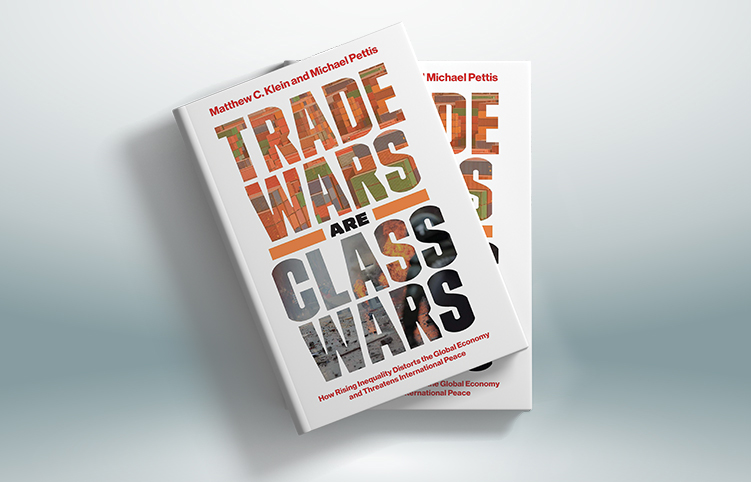دُروس في الأخلاق – أُمبيرتو إيكو

يضم هذا الكتاب الذي نقدم ترجمته لقراء العربية؛ خمس مقالات كتبها أمبيرتو إيكو، على فترات متباعدة، تتناول سلسلة من القضايا الخاصة بالوجود الإنساني، منها الأخلاق والعلمانية والتدين والثقافة والمثقف والعلاقة مع الآخر وغيرها من الموضوعات ذات الطابع القيمي العام.
وليس في نيتنا تقديم ملخص لهذه المقالات أو بسط القول فيها، فهذا أمر لا ترجى منه فائدة، فالنص يُغني عن التلخيص، والتلقي المباشر أهم من وساطة “أنا” عارضة لا يمكن تبرئة ذمتها، فهي تنتقي ما يشتهيه، لا ما يضمه الكتاب بالضرورة ..
ومع ذلك، فإن ما يقوله العنوان وحده كاف لأن يثير الكثير من التساؤلات حول مقولة الأخلاق، فهي تكاد تكون الثيمة الرئيسية للكتاب كله. فمقولات من قبيل “سوء الفهم” و”الجهل” بخصوصيات الآخر و”الدونية الحضارية” و”التفوق العرقي” تعبر عن مواقف تندرج كلها ضمن ما يمكن أن يشكل أخلاقا تُعتمد في الحكم على الآخر وتصنيفه.
فالـ”نحن” غامضة دائما، لأنها تعتمد معاييرها للحكم على الآخر وتحديد المقبول والمرفوض والمحبذ والمكروه عنده. وباسم هذه الرؤية تمت في كثير من مراحل التاريخ مقاضاة الآخرين والحكم على سلوكهم، بل وإعلان الحرب عليهم. فالـ”نحن” التي أعلنت الحرب في أفغانستان والعراق وغيرها من مناطق العالم ليست آتية من خارج التاريخ، إنها ثمرة من ثماره، وجزء من سيرورة حضارية تشكلت باعتبار هويتها تلك في علاقتها بالآخرين لا في انفصال عنهم.
ولذلك، لا يمكنها أن تتحدد باعتبار ذاتها، أي باعتبار المخزون الأخلاقي عندها، بل يجب أن تقيس أخلاقها بأخلاق الآخر ( إن العزلة لا تقود إلا إلى الفاشية).
وهو ما يعني استحالة تحديد الدوائر الأخلاقية لـ”الأنا” دون الإشارة إلى تلك التي تخص “الآخر”. فهذه الدائرة ممكنة الوجود في حدود وجود أخلاق أخرى، لا تناقضها بالضرورة، ولكنها قد تجعل منها أمرا ممكنا، أو تكشف عن تهافتها.
فمن السهل جدا اتهام الذين كانوا يقدمون أبناءهم قربانا للآلهة بالهمجية والتوحش، لأنهم ذبحوهم أو القوا بهم في البحر أو النهر. وفي المقابل، سيكون من الصعب أيضا إقناعهم بأن إلقاء قنبلة ذرية على مدينة وتدميرها بمن فيها وما فيها يدخل ضمن شرعية استعمال العنف من أجل درء عنف أشد.
والحاصل، أنه إذا كانت المبادئ الأخلاقية كونية من حيث إنها دالة على وعي الذات بحدودها في علاقتها بالآخر، ومن حيث كونها تشير إلى إحساس إنساني يكشف عن تقدير الذات لنفسها في المقام الثاني، فإنها مع ذلك، ليست كذلك إلا في الظاهر؛ فهي تختلف بالضرورة باختلاف الأسس العقدية والثقافية والمعرفية التي تقوم عليها.
فأخلاق الدين ليست هي أخلاق العلمانية، فهي في الدين تعاليم فوقية أصلها غيبي، أما في الموقف العلماني، فلا علاقة للمضامين الفعلية للسلوك الأخلاقي بالأصل العقدي الذي يسندها.
وهي حقيقة يفسرها اختلاف الأديان في تقويمها للمبدأ الأخلاقي، فهي لا تنظر إلى السلوك الإنساني من المنظور ذاته إلا في النادر من الحالات. ومثال البوذية بالغ الدلالة في هذا السياق، فقد أسست نظاما أخلاقيا دون أن تولي أهمية تذكر لفرضيات الآخرة والحساب والعقاب، بل إن الله ذاته لا ذكر له في هذا المعتقد، فالجهاد ضد النفس وحده يعد أساسا للأخلاق وهو مضمونها الأول والأخير.
فليس الدين هو من يمنعنا من ارتكاب المجازر، إن الشر فينا، “إنه غريزة تسكن حتى أولئك الذين يؤمنون بمقولة للخير قائمة على أسس دينية”؛ فما يميز هذا السلوك عن ذاك، هو قدرة الفرد على تصور الشر ضارا والخير مفيدا، دون تبرير ذلك خارج السلوك ذاته.
وهذا أمر بالغ الدلالة، فالدين يحتكم إلى مقولتي الحلال والحرام، أو ما يندرج ضمنهما بالصراحة أو التلميح، من أجل تقويم السلوك الفردي والجماعي، بينما يحتكم السلوك الوضعي إلى المصلحة، مصلحة الفرد والجماعة ولا شيء غيرهما.
لذلك، فإن الإنسان حاضر في النظام الأول باعتبار التزاماته تجاه الله، وهو في الثاني محكوم بالقواعد التي تنظم السلوك اليومي وفق ما تعارف عليه أفراد مجموعة بشرية ما خارج أية مردودية سوى مردودية هذا السلوك في الوجدان ورضا النفس والآخر، دون أن يعني ذلك حرمان الفرد من حقه في أن يؤمن بما يشاء من العقائد. لذلك، فإن الدين ينتج مؤمنا لا يراقبه إلا الله، أما الموقف العلماني فيبني مواطنا خاضعا للقانون.
وتلك هي الحدود الفاصلة بين فضاء عمومي يحتضن الفرد ويحمي خصوصيته ويمنحه الحق في إعلان اختلافه في الرأي والمعتقد، وبين قانون اجتماعي يجعل هذا الفضاء ملكا للدولة والدين والمجتمع. فكل شيء يبدأ من هذا الفضاء وينتهي عنده، وما يتبقى بعد ذلك، فإن مثواه قناعات الفرد وحريته في تدبير شؤون إيمانه وفق ما يشاء. علينا أن نعيش الدين باعتباره قناعة فردية، لا باعتباره إكراها اجتماعيا.
استنادا إلى ذلك، فإن حديث المؤلف عن المثقف والانتماء والصحافة والنـزوح والهجرة والتسامح وغير المسموح به، لا يمكن فصله عن الخلفية الثقافية/ الحضارية التي تشكل عنده غطاء قيميا مخصوصا يتباهى به الغرب اليوم ويعتبر كونيتَه انتصارا لحضارة جاهدت، على مدى خمسة قرون ( وهي القرون التي تؤرخ للنهضة الأوروبية )، لإرساء أسسه وقواعد تطبيقه في كل ربوع أوروبا. بل إنها تطمح اليوم، في بداية القرن الحادي والعشرين، إلى تعميمه باعتباره أداة “لتوحيد” العالم حول قيم كونية تحتفي بالإنسان وحده خارج كل الإكراهات عدا الاستجابة لكرامته وحريته.
ومع ذلك، وباسم هذا الغطاء أيضا، يتم التدخل بقوة السلاح والسياسة والاقتصاد، في مناطق مختلفة من العالم، لتغيير الخرائط أو محاصرة “العصاة” واستبدال أنظمة بأخرى، كما حدث ذلك منذ الخمسينات من القرن الماضي في كوبا، وحدث بعد ذلك في العراق وأفغانستان والكوسوفو والبوسنة وغيرها من المناطق. “فللمجموعة الدولية” رأي في كل ما يجري في الكون.
ولهذا، فقد “تبين لهذه المجموعة أن الوضعية في هذه المناطق وصلت درجة لا يمكن التسامح معها، وقررت التدخل من أجل وضع حد لما يعتبره الضمير المشترك جريمة”، كما يشير إلى ذلك المؤلف. ( يتحدث إيكو عن التدخل العسكري في الكوسوفو ( قوات الناتو)، وعن حرب الخليج لإخراج القوات العراقية من الكويت ( قوات التحالف)).
ولكن هذا “الحد” غامض ومبهم ولا نستطيع تحديد درجاته القصوى والدنيا إلا من باب الاجتهاد، أو من باب ما يمكن أن توحي به المصالح. وبعبارة أخرى، قد لا نعرف دائما متى ينتهي القتل باسم الإنسانية ومتى يبدأ القتل باسم المصالح ؟ لذلك، لن يقود “التفكير في الحرب”، في جميع الحالات، إلى تمجيدها أو اعتبارها قدرا لا راد لقضائه، فهي سيئة بالنسبي والمطلق، كما يؤكد ذلك إيكو.
فلا رابح في الحرب الحديثة، فهي مضادة للبيئة والإنسان، رغم “ذكائها”. فعلى الإنسانية إذن أن تتخلص من تراثها الدامي لترسي قواعد جديدة من أجل إدارة طاقات العنف داخلها، بما في ذلك إمكانية تحريم الحرب واعتبارها “طابو”، كما اقترح ذلك ألبيرتو مورافيا.
فقد يكون ما وقع في الكوسوفو والبوسنة مسا بالإنسانية، فالناس تحدثوا هناك عن التطهير العرقي والديني والقتل الجماعي وعن الاغتصاب والتنكيل والتهجير، ولكنه لم يكن ذلك، في كثير من الأحيان، سوى ذريعة تستعمل من أجل الدفاع عن مناطق نفوذ دول تكيف مصالح العالم وفق ما تشتهيه مصالحها، وتديره وفق ما يستجيب لها ويحميها. فالظاهر أن لكلٍ إنسانيته، و”للمجموعة الدولية” الحق في انتقاء إحداها: قُتل مئات الآلاف من قبيلة التوتسي في مجاهل إفريقيا دون أن تتحرك “المجموعة الدولية” لتضع “حدا لما يعتبره الضمير المشترك جريمة”.
ومع ذلك، وسواء صح ما تدعيه هذه “المجموعة الدولية” أم لا، فإن ما يعنينا من السياقات القيمية الذي تحتكم إليها هذه المقالات هو مجموعة من المبادئ التي تعد في تصورنا إرثا مشتركا للبشرية جمعاء. إنها مبادئ تخص الإنسانية باعتبار ذاتها، لا باعتبار صفات من ينتمون إليها.
فمن حق كل الناس في مغارب الأرض ومشارقها الاحتكام إلى الديمقراطية والعقلانية والتعدد والعلمانية في تدبير شرطهم الإنساني. بل إن هذه المبادئ ذاتها هي التي يجب اعتمادها من أجل الدفاع عن الخاص والمحلي في القيم والثقافات. ف”الكوني” ليس كذلك إلا من خلال ما يخصص ويميز ويفصل هذا اللون عن ذاك.
وليس غريبا أن تتبنى إنسانية الحاضر “الاختلاف” كحق، وتستبعد التسامح باعتباره هبة من القادر. فالأول صفة للأقلية المتميزة، أما الثاني فسمة للقوي الغالب.
إن وحدة العلمانية هي غير وحدة الدين، إن العلمانية لا تقصي المختلف باعتباره خارجا عن “الصف” العقدي، بل تستوعبه ضمن ممكنات الوجود الاجتماعي الذي يجب أن يتسع للجميع ضمن ثوابت الإنسانية وحدها. فالوحدة ليست انصهار الواحد في ذاته، بل هي طريقة في ارتباطه مع الآخر، “فالآخر هو من يحددنا” كما يقول إيكو، فبدونه سنصاب بالجنون أو الهوس. لذلك فكل وحدة إنما تقوم على المتعدد في الوجود والمظاهر والاشتغال، “فلا شيء مثير للحزن أكثر من شعور أمة بوحدتها”، بتعبير ليفي شتراوس.
وبعبارة أخرى “إن وجود البعد الأخلاقي مرتبط بظهور الآخر. فالغاية من كل قانون- أخلاقي أو حقوقي – هي تنظيم العلاقات بين الأفراد، بما فيها العلاقة مع آخر هو من يفرض هذا القانون”. فقد تختلف أشكال القيم لكن مضامينها ستظل واحدة. إن الخير خير والشر شر في مشارق الأرض ومغاربها.
لذلك، لا يجب أن تثنينا بشاعة “عولمة الحرب” عن تبني منجزات القيم السابقة عليها، ومنها الحقوق والديمقراطية ورفض القتل باسم الدين والعرق والهوية الثقافية. فلا شيء يمنعنا من استنبات هذه المبادئ في تربتنا الثقافية وفق خصوصياتنا كما تأتي من اللغة والتاريخ والثقافة، لا كما يمكن إسقاطها من خارجها. فلا “خصوصية” في العدل والمساواة والحرية والديمقراطية إلا ما يتعلق منها “بخصوصية” ما يمكن أن يخدم بأفضل الطرق مصالح الناس وكرامتهم.
إن مكمن الخصوصية واقع متحرك لا ذهن جامد يكيف الآتي وفق القوالب القديمة. فنحن جزء من الإنسانية، ولا يمكن أن نفكر خارج المعايير التي بلورتها في كل الميادين على مدى آلاف السنين. فعبقريتنا وفننا وخيرنا وشرنا وصدقنا كلها مفاهيم دالة على مضامينها ضمن ثوابت الإنسانية لا خارجها. وهذا ما يجعلنا نهتز طربا ونحن نستمع بموسيقى لا نعرف كلماتها.
وهذا يعني عدم الخلط بين الحضارة التي أنتجت هذه القيم وبين ما يرتكبه المنتمون إليها من جرائم خارج حدودهم. فلن يقود هذا الخلط في نهاية الأمر سوى إلى تبرير وجود طغاة يحكمون شعوبهم بعبث سلطوي لا نظير له في التاريخ. فباسم الخصوصية الدينية والتميز الثقافي، يبررون الاستبداد والتخلف والانكفاء على الذات خارج مجريات تاريخ يُصنع في غيابنا، وخارج قدرتنا على مجاراة إيقاعه.
وتلك هي المبادئ التي يجب، في عرف المؤلف، أن يتحمل عبئها المثقف قبل السياسي. فللمثقف اختيارات لا يحكمها التقدير الظرفي للأشياء والكائنات، ولا يستند إلى حكم مسبق لبلورة مواقفه والدفاع عنها. فإذا كان الفعل الإنساني “عرضة للالتباسات والغموض والتأويل، فإن وظيفة المثقف تكمن في الكشف عن هذه الالتباسات بالذات.
إن واجب المثقف هو في المقام الأول انتقاد رفاقه”: يقدم لنا نعوم تشومسكي، اللساني الشهير، حالة مثقف نادر الوجود في التاريخ. لقد وقف في وجه الشطط الأمريكي بكل قواه، وفضح أساليب حكومته في التدخل في شؤون الأفراد والجماعات والدول. ولم تمنعه يهوديته من الوقوف ضد إسرائيل دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته.
وبعبارة أخرى، إن المثقف فاعل أخلاقي لا يتقيد بحالات انتماء زائل لهذا الموقف أو ذاك، ولا بحالات التصنيف “العفوي” ضمن أصل “عرقي” هو بالضرورة من باب التضليل، أو من باب التصنيف الثقافي المسبق الذي لا يمكن، رغم وجوده الفعلي، أن يحل محل كل القيم النبيلة التي أفرزتها الممارسة الإنسانية الممتدة عميقا في التاريخ. لقد مات سقراط دفاعا عن حق الإنسان في التفكير الحر، ورفض الفرار من سجنه حتى لا يشككون في مبادئه.
وعلى هذا الأساس، فإن ما يفصل بين السياسي والمثقف هو الفاصل بين “الولاء” وبين “الحقيقة”، فالولاء عند إيكو مقولة أخلاقية، أما الحقيقة فمن طبيعة نظرية. الأولى للسياسي( فهو يتحرك ضمن تراتبية السلطة أو تراتبية الحزب) أما الثانية فمن نصيب المثقف (فهو لا يهتم سوى بالقيم التي تحمي الإنسان من الظلم والانتقاص من حريته وكرامته). ولا سبيل إلى الخلط بين ما يأتي من الولاء، وما تقود إليه الحقيقة. إنه الفاصل بين إكراهات السياسة واختيارات الثقافة.
وهذا الفصل بين المقولتين هو الذي يفسر تردد الكثير من المثقفين العرب في اتخاذ موقف من الحرب على العراق. لقد أدانوا غزو صدام للكويت، فهو أمر عبثي، ولكنهم لم يباركوا قتل الشعب العراقي، لأنه أمر مأساوي. لقد كان الولاء يدفعهم إلى الدفاع عن العراق، دون التضحية بمصالح الشعب الكويتي، وكانت الحقيقة تدفعهم إلى ضرورة إسقاط نظام فاشي دون مباركة الغزو الأمريكي.
استنادا إلى كل ما قلناه، فإن هذا الكتاب يقدم حقا دروسا في الأخلاق. وقد لا نتفق مع كل ما ورد فيه، وهذا أمر مؤكد، فالتلقي النقدي يمنعنا من ذلك، ولكننا لا يمكن أن ننكر أن الكتاب يعلمنا كيف نفكر وكيف ندير اختلافاتنا مع الآخر ضمن ضوابط الإنسانية لا خارجها أو ضدا عليها. فلا شيء يبرر قتل آلاف الضحايا الأبرياء ” انتقاما من أمريكا الظالمة”، كما حدث ذلك في نيويورك ومدريد مع بداية هذا القرن.
وفي هذا المجال، يقدم لنا إيكو سبلا في كيفية التعاطي مع الذات ومع الآخر. إنه يتحدث عن الدين ولا يخفي عدم إيمانه بحلوله، ولكنه يبجله في شخص كل المتدينين الذين “تغاضوا” عن انتماءات الآخرين وقدموا لهم في ليالي الشتاء الباردة غطاء ووجبة ساخنة : فعل ذلك الأب بيير في فرنسا لمدة نصف قرن، وفعلته الأم تيريزا في مجاهل الهند لسنوات طويلة وهي تضمد جراح المهمشين والمنبوذين.
ولكنه يمجد العلمانيين أيضا، أولئك الذين ماتوا دفاعا عن حق الإنسان في العيش الكريم، ولكنه لا يخفي ماضيه الروحي، أو ما يسميه “دينِيَّتي” العلمانية، فلا يخلو قلب الفرد من مقدس ما.
إن الكتاب لا يقدم دروسا من باب “يجب…”، بل يستحضر تجارب التاريخ ويتأملها، إنه لا يمجد أخلاق الدين، ولا يحط منها، ولكنه يجعل الفرد مسؤولا عن سلوكه. “فهناك أشخاص لا يؤمنون ولكنهم حريصون على إعطاء معنى لمماتهم، وهناك مؤمنون مستعدون لانتزاع قلب طفل صغير لكي يظلوا هم أحياء. إن قوة الأخلاق تقاس بسلوك القديسين، لا بما يفعله الحمقى الذين هم، في نهاية الأمر، من مخلوقات الله”.
أتمنى أن نكون بترجمتنا لهذا النص الرائع؛ قد قدمنا ما يمكن أن يساعدنا في فهم أفضل لأنفسنا وللآخر، الآخر المختلف ثقافيا ولغويا، لا الآخر الذي يغتصب الأرض والأوطان.
- محتويات الكتــاب
-التفكير في الحرب
-الفاشية الأبدية
-حول الصحافة
-الأنا والآخر