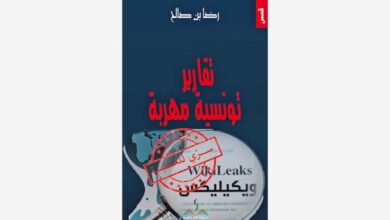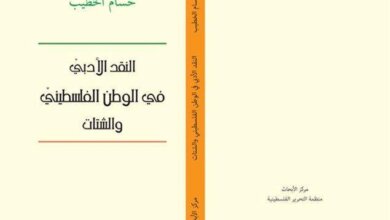اقرأ… سنُقرِئُك

يفتتح إيريش آويرباخ كتابه الذي يعد من الكلاسيكيات الحديثة، «محاكاة: تمثيل الواقع في الأدب الغربي»، ببحثه حول ندبة أوديس في الملحمة اليونانية الأوديسة، مقارنا إياها بما ورد في الكتاب المقدس حول محاولة تضحية سيدنا إبراهيم بابنه إسحاق، فيستنتج استغراق الملحمة في ذكر مختلف التفاصيل والجزئيات التي تعود في لحظة من تطور الملحمة إلى فترة في الماضي لاسترجاع قصة الندبة في فخذ البطل، بينما الحوار بين الرب وإبراهيم يقدم بدون تحديد لأهم مفاصل تطور القصة.
ويمكننا أن نخرج من هذه المقارنة بأن الخطابات تتباين حسب خصوصيتها ومقاصدها. فالخطاب الملحمي، والكتاب المقدس يختلفان عن بعضهما البعض. ويمكن قول الشيء نفسه، عن الخطاب القرآني وغيره من الخطابات الشعرية العربية. ولو أتيحت لآويرباخ المقارنة بين قصة سيدنا إبراهيم ومحاولته ذبح ابنه إسماعيل، في القرآن، مع القصة الواردة في العهد القديم لوقف على عناصر مختلفة تتعدى النتائج التي انتهى إليها وهو يقارن بين الملحمة والعهد القديم.
تبين لنا هذه المقارنة وهي تميز بين الخطابين من خلال قراءة داخلية تسعى للتمييز بينهما واستجلاء خصوصية كل منهما أن قراءة النص من الداخل، أيا كان جنسه تختلف عن القراءات التي تسعى إلى تقديم قراءات خارجية مثل تلك التي ترمي إلى دراسة القرآن الكريم مثلا. لقد توقفت في مقالة سابقة حول سؤال يتعلق بمؤلفي القرآن الكريم، وتبين لي أن ادعاء العلمية في القراءة ليس مبررا لعدم تناول القرآن في ذاته، ومن الداخل.
بل إن تلك القراءات الخارجية، أيا كانت مصادرها أو مقاصدها، حين لا تربط ما تدعيه بما يتقدم إلينا من داخل النص ستظل ضربا من التأويلات التي يمكن نقضها بسهولة لأن المواد المستشهد بها لإثبات فكرة يمكن العثور على ما يناقضها لإبراز عكسها. ولذلك نجد مثلا أن الدراسات الاستشراقية حول القرآن الكريم كانت لها مقاصد وطرائق محددة في القراءة والتأويل.
وفي كل مرة تقدم لنا معطيات جديدة على شكل وثائق حديثة لتأكيد المزاعم القديمة عينها للتشكيك في أصالة القرآن الكريم، مؤكدة عدم صحة الدراسات السابقة حول الموضوع نفسه، واختلافها معها في المعطيات التي اعتمدتها في زمن سابق، وإن كانت النتائج التي تنتهي إليها هي عينها التي كانت مدار الدراسات السابقة.
إن البحث عن الحقيقة العلمية مطلب ضروري، ولا يمكن لأي كان أن يتخذ منه موقفا سلبيا. لكن أي حقيقة، كيفما كان نوعها تظل مرتبطة بالعصر المعرفي الذي ظهرت فيه. لذلك تظل جزئية وقابلة للدحض في أي وقت. وما يجري على الأمور الطبيعية ينسحب على ما يتصل بالإنسانيات، ومن بينها القضايا الدينية.
لقد عمل الكثير من المستشرقين المسيحيين، بصورة خاصة، على البحث على ما يؤكد تصوراتهم التقليدية عن القرآن الكريم من أنه مؤلف من لدن الرسول (ص)، وبعض صحابته.
بل نجد من بينهم من يذهب إلى أن بعض سور القرآن كتبت قبل بعثته، بل إنها كانت موجودة حتى قبل ولادته. والآراء هنا لا حد لها، ومقاصدها واضحة. تنبني هذه المواقف على تصورات جاهزة حول الكتاب المقدس وتحاول إسقاطها على القرآن الكريم.
يعني ذلك أن هذا النوع من القراءات أسير تصورات خاصة للقراءة تتحكم فيها الرؤية اليهودية ـ المسيحية لنصوصهم المقدسة كما هي متداولة بيننا إلى الآن. إن الرؤية المشتركة تقضي بأن الكتاب المقدس وحي من الله تدخلت في تأليفه الأيدي البشرية.
وهم لذلك ينكرون كون القرآن كلام الله كما هو بيّن من خلال النص ذاته. ومختلف ما يتصل بهذا المنطلق يتم تدعيمه بتأكيد مختلف الدعاوى التي يعبرون عنها حول التأليف البشري للقرآن الكريم، وما يزخر به من تناقضات وتكرارات ونقائص لا يمكن إلا أن يدل على تدخل الإنسان في تأليفه. كما أن تأكيدهم على أن هذا التأليف كان يستند إلى نصوص سابقة على البعثة تم الانطلاق منها في التأليف يأتي لتدعيم تصوراتهم المختلفة عنه.
إن قراءة الكتاب المقدس بعهديه تؤكد لنا بجلاء أننا أمام راو يحكي عن الله وعلاقته بالأنبياء والرسل الذين بعثهم، وأن كلام الله جزء من كلام الشخصيات المختلفة فيه. وأي مقارنة بين هذا الكتاب والقرآن الكريم على مستوى الخطاب تبين لنا التفاوت الكبير بينهما. فالله، في القرآن، هو المتكلم والرسول ليس سوى مبلغ عنه. لذلك، رأينا أن حضور النبي (ص) كمتكلم لا وجود له.
وأن الأمر بالقول الموجه إليه يكشف لنا، ضمنا أو مباشرة، أن ما يقوله الرسول ليس كلامه، وإنما هو فقط مبلغ له. وما صيغة الأداء: قل، سوى خير دليل على ذلك.
إذا انطلقنا من كون أول ما نزل على الرسول في سورة العلق: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. (5، سورة العلق)، نجد أن الأمر بالفعل كان هو (القراءة)، وليس الكتابة. وأن القراءة باسم الرب الخالق والمعلم. والتأكيد على هاتين الصفتين: الخلق والتعليم دليل على أن لا خالق إلا الله، وأنه المعلم الذي ميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على التعلم والتفكير. إن الأمر بالقراءة هنا متصل بما سيلقيه الله على رسوله ليبلغه للناس.
وما سيبلغه الرسول محمد (ص) لقومه في بداية الدعوة سبق أن علمه الله لغيره من الناس عن طريق الأنبياء والرسل الذين كان يبعثهم إلى أقوامهم ليعلموهم العلم نفسه. نقرأ في سورة الأعلى، وهي ثامن سورة بعد العلق، ما يؤكد ذلك: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (…) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (…). إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى». (19 الأعلى).
إن الأمر بالتسبيح يناظر الأمر بالقراءة، إلا أن الفعل جاء هنا متعديا، عكس الأمر بالقراءة الذي جاء لازما. وفي هذا الأمر تأكيد على الخالق الذي سيتكلف بإقراء الرسول ما كان متحققا في الصحف السابقة عليه، ومنها صحف إبراهيم وموسى. بمعنى أن كلمة الله تحققت في كتب كثيرة، والقرآن من بينها. لذلك فالنص القرآني يتصل بالكتب بالسابقة، وهو امتداد وتصحيح لما لحق بها من اليد البشرية.
إن طريقة التعبير القرآني، في ذاتها، تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي نجدها في الكتاب المقدس، وعلى كل المستويات الشكلية والدلالية. ولو أردنا مقارنة الكتاب المقدس بما ورد متصلا بالقرآن الكريم، لوجدناه ليس في القرآن، ولكن بكيفية مختلفة نسبيا بما جاء في الحديث النبوي، بصورة عامة، أو بالسيرة النبوية بكفية خاصة، حيث نجد حضورا أساسيا للرواة، ولحضور كلام الرسول (ص)، تماما كما نجده في الكتاب المقدس.
فإذا عدنا إلى صحيح البخاري في عرضه لبداية البعثة لوجدناه يأتي بتفاصيل وجزئيات لا تتضمنها سورة العلق. ويمكننا قول الشي نفسه، وإن بصورة أكثر تفصيلا، عند قراءة سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام متصلا بالسورة نفسها، أو غيرها من السور والآيات القرآنية حيث نجد تعدد الروايات، وتغير العبارات.
إن قراءة النص القرآني في ذاته مطلب ضروري لتجاوز نقائص القراءات الخارجية وحدودها التي تنهض على الإسقاط والاجتزاء.