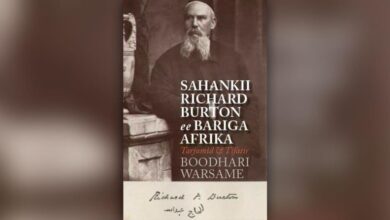“إدوارد سعيد” والعودة إلى الفيلولوجيا
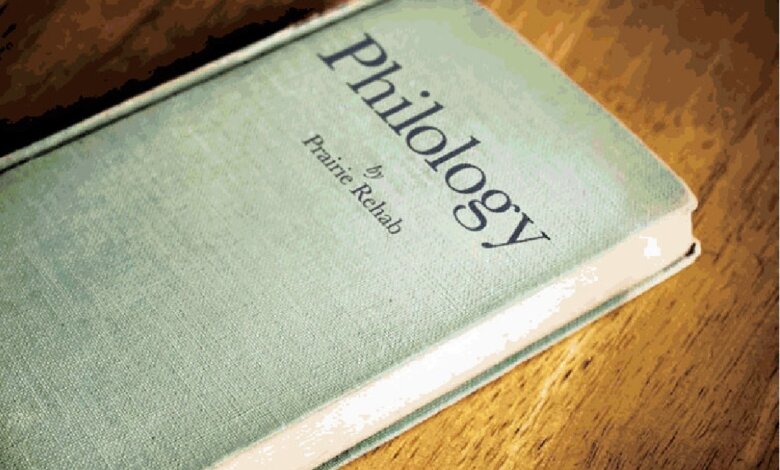
لم يكن أحد من متتبعي المسير النقدي والفكري الحافل لإدوارد سعيد ينتظر أن يخصَّ علم الفيلولوجيا بإحدى المحاضرات التي ألقاها في جامعة كولومبيا (قبيل وفاته سنة 2003 بمدة وجيزة)، ويتوقف فيها عند أهمية الإمكانات القرائية التي اكتسبها هذا العلم من التقاليد الثقافية العريقة والمتعددة التي اقترن بها على امتداد تاريخه، ومن بينها التقاليد العربية الإسلامية.
إذ كيف يمكن لمن انتقد المؤسسةَ الاستشراقية الغربية في مجموعة من أعماله وفكك مضمراتها الاستعمارية، وهي المؤسسة التي تصدر في تأويلاتها للثقافات الشرقية عن النزعة الفيلولوجية، كيف يمكنه أن يدافع عن ضرورة “العودة إلى الفيلولوجيا” والإفادةِ منها.
لا ريب في أن مثل هذا السؤال قد خطر ببال بعض من جاء لمتابعة المحاضرة، خصوصا وأن علاقة سعيد بالفيلولوجيا لم تصبح موضوع أبحاث واضحة وكافية من قبل الدارسين في الغرب إلا بعد هذه المحاضرة.
أما في التلقي العربي لأعماله المتصلة بالنقد والآداب المقارنة فلا يوجد اهتمام صريح بالمكانة البارزة التي تشغلها فيها الفيلولوجيا ولا بأبعادها الفلسفية والتأويلية سواء قبل هذه المحاضرة أو بعد صدور ترجمتها العربية سنة 2005 إلى جانب محاضرات أخرى.
ونعتقد أن الأسباب المفسرة لهذا الغياب في عالمنا العربي كثيرة لعل من أبرزها ما يرتبط أولا بالأحكام السلبية الذائعة عن الفيلولوجيا عموما إن في اقترانها باللسانيات أو بالدراسات النصية، وما يرتبط ثانيا بطبيعة البرامج الجامعية التي ينعدم فيها تدريس الفيلولولوجيا[2].
فضلا عن أن التقاليد الجارية في تحليل النصوص داخل فصولنا الدراسية مبنية عادة على تغليب نزعة تخصصية صارمة لا تتوافق مع سعة الفيلولوجيا ولا مع تعدد المعارف والتخصصات التابعة لها.
لكل ذلك شعر إدوارد سعيد، وهو يسعى في البداية إلى عرض بعض الحجج الداعمة لوجاهة العودة إلى الفيلولوجيا ولمدى الحاجة إليها في مستهل قرن جديد، كما لو أنه يدافع عن فكرة محبطة وقليلة الإغراء.
فالشائع عن الفيلولوجيا أنها أمست معرفة متقادمة و”منتهية الصلاحية”، وأنها بمقتضى هذا لن تقوى على الصمود في وجه تحولات عصر تأويلي تفككت فيه المرجعيات التقليدية، وتهاوت أسسها وأنظمتها المعرفية.
لذلك التمس من الحاضرين أن يتحلوا بما يملكون من قدرة على التحمل حتى يساعدوه على تبديد فكرة كون الفيلولوجيا مجرد معرفة غابرة لا قيمة لها ولا جاذبية. فبدأ بالإشارة إلى إحدى النواحي المثيرة للاهتمام في الحياة العلمية والفلسفية لنيتشه، وهي أنه كان يَعدُّ نفسه فيلولوجيا قبل أي شيء آخر. يقول سعيد في هذا الصدد: إن «نيتشه،
وهو الأكثر جذرية وجرأة بين جميع المفكرين الغربيين تقريبا خلال المئة وخمسين سنة الأخيرة، كان يرى إلى نفسه على أنه فيلولوجي أولا وأخيرا قبل أي شيء آخر. فحري أن يبدد هذا فورا أي فكرة مترسبة ترى إلى الفيلولوجيا على أنها لون من التعليم الرجعي»[3] الذي لا جدوى منه ولا فائدة.
واضح هنا أن الإحالة على نيتشه لا يُتوخى منها التحصن بفيلسوف له اهتمامات فيلولوجية مثلما هو شأن عديد من الفلاسفة أو غيرهم من النقاد ومؤرخي الآداب والفنون، إنها إحالة بالأحرى على ما أحدثه نيتشه من مراجعات جذرية في الفكر الغربي بفضل توسله بالفيلولوجيا وتفعيله الناجع لآلياتها النقدية والتأويلية.
فجذرية نيتشه نابعة من إتقانه أدوات القراءة الفيلولوجية، وإبداعِه في تطبيقها على التراث الإغريقي وعلى مجمل إنتاجات الفكر الغربي وآثاره.
ولهذا فالمغزى العميق والاستشرافي من إحالة إدوارد سعيد في مقدمة محاضرته على جذرية نيتشه يكمن في توخي نزعِ الطابع التقليدي والمحافظ الملتصقِ بالفيلولوجيا في أذهان كثير من الباحثين، والإلماعِ بطريقة غير مباشرة إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد حكم مسبق يفتقر إلى البحث والتثبُّت شأنه شأن عامة الأحكام الشائعة حول الفيلولوجيا.
من زاوية أخرى لا يندرج حديث إدوارد سعيد عن الفيلولوجيا في نوع من “الافتتان” الطارئ الذي يمكن أن يخالج أيَّ ناقد حين يهتدي بنحو من الأنحاء إلى تصور نظري أو إلى منهج يقتنع به، لأنه يجد فيه ما يسعفه على فهم النصوص وتحليلها بدرجة ما من الكفاية. هذا الأمر غير وارد لديه؛ لأن علاقته بهذا العلم جزءٌ من تكوينه الأكاديمي، وهي ممتدة في معظم أعماله التي تطلبت منه منذ البداية الاحتكاك بكبار الفيلولوجيين[4].
ولذلك ظل مقتنعا طوال حياته الفكرية بأهمية الفيلولوجيا في دراسة الآداب والثقافات العالمية، متخذا منها حافزا للتفكير في “نزعة إنسانية منفتحة” قادرة على تجاوز القبليات النمطية والأحكام المسبقة ذات الطبيعة الإقصائية والعنصرية.
وهو في هذا يستوحي المعنى الواسع الذي اكتسبته الفيلولوجيا في عصر الأنوار حين اقترنت بنزعة إنسانية ورثت مجموع ما نقله النهضويون الأوائل في أوروبا من نصوص وآثار ومعارف تعود إلى التراث الإغريقي. وهذا المعنى هو الذي سيتطور في القرن التاسع عشر لتؤول معه الفيلولوجيا إلى دراسة شاملة «لمجموع تعبيرات العقل الإنساني في المكان والزمان[5]».
لعل ما يستحق الاهتمام في تعريف دقيق وشامل كهذا أن عالم الآثار ومؤرخ الفنون الفرنسي سالومون ريناك (1858-1932) خلص إليه في سياق إيبستيمولوجي دقيق يتحدث فيه عن “طبيعة الفيلولوجيا وموضوعها”، وعن الموقع الذي ينبغي أن تشغله في العلوم ذات الصلة بالإنسان.
فهو يقترح لهذه العلوم ثلاثة موضوعات هي: الله والطبيعة والإنسان، فإذا كان الله من اختصاص الثيولوجيا فإن الطبيعة من اختصاص الفيزياء والإنسان من اختصاص علم النفس.
لكن المثير في هذا التقسيم أن الفيلولوجيا تبقى علما خادما لهذه العلوم وغيرها، لذلك جاءت القضايا التي تدرسها في التعريف أعلاه غير منحصرة في موضوع محدد، بل تشمل مختلف التعبيرات والإبداعات التي تصدر عن العقل الإنساني في زمان ومكان محددين.
وفي هذا الخصوص لئن جاز لنا أن نستعير من قدمائنا تحديداتهم لأوجه تعلق العلوم بعضها ببعض لأمكننا القول إن الفيلولوجيا بقدر ما تمثل علما مقصودا لذاته ومستأثرا بموضوعاته الإنسانية المتعددة والمتنوعة، تمثل أيضا علما مقصودا لغيره من جهة تعلقها بعلوم أخرى ومساعدتها على دراسة موضوعاتها، وذلك بفضل ما تتسع له من أدوات نقدية وإمكانات قرائية.
ولهذا نعتقد أن الفيلولوجيا التي يستحثنا إدوار سعيد على استلهامها هي التي يرتبط معناها بالتحديد السابق القائم على نزعة إنسانية متجددة ومتحررة من كل مركزية عرقية أو ثقافية أو لغوية. وهو المعنى الذي ظل مقتنعا به طوال حياته الفكرية،
ودافع عنه بحس يستشرف المستقبل في المقدمة التي كتبها (قبل رحيله ببضعة أسابيع) بمناسبة إصدار طبعة فرنسية جديدة لكتاب “الاستشراق”، حيث أكد أنه على الرغم من كون «الفيلولوجيا توحي للشباب من الجيل الحالي بأنها علم عتيق ومتقادم، فإنها مع ذلك تعد من أكثر المناهج التأويلية حيوية وإبداعا»[6].
2
لكن ما الذي وجده إدوارد سعيد في الفيلولوجيا أكثر من كونها أداة نقدية وتأويلية؟ لقد وجد فيها بالفعل أكثر من ذلك، وجد فيها أداة مقاومة ضد مختلف أشكال الاستعلاء والتراتب، وضد أي أصولية فكرية قائمة على نفي الآخر وطمس غيريته سواء أكان هذا الآخر ثقافة من الثقافات أم مجتمعا من المجتمعات أم نصا من النصوص.
إذ في خضم ما يلاحظ من توجه كاسح يسير بالعالم نحو مزيد من عنف “التنميط” في كل مناحي الوجود والحياة، تبقى الفيلولوجيا بالنسبة إلى إدوارد سعيد واحدة من أنجع الوسائل المنهجية والتأويلية وأقدرِها على مقاومة ذلك التنميط من خلال تعرية خلفياته الإقصائية، وتقويض أسسه الاستئصالية.
فما كان يشده إلى أنبغ الفيلولوجيين من أمثال فيكو G. Vico وأوغست وولف F. A. Wolf وغوته W.V. Goethe وهومبولدت V. Humboldt ونيتشه F. Nietzche وليو سبيتزر L. Spitzer وأورباخ وغيرهم أنهم كانوا جميعا يجعلون من المقاربة الفيلولوجية لا أداة لفصل النصوص عن مبدعيها وعزلها عن السياقات الزمنية التي تنتسب إليها من أجل ردها إلى نواة تتوحد عندها وتتطابق،
وإنما كانوا يجعلون منها مسلكا قرائيا منفتحا لإبراز الفروق الإبداعية المباينة بينها والإعلاء من شأن الاختلافات المتأصلة فيها.
ولذلك نبه سعيد إلى أن المطلب الجوهري في المقاربة الفيلولوجية لا يتوقف فحسب على التبحر في العلوم والتوسع في معرفة ما يكفي من المعلومات التاريخية والوقائع التي لها صلة بالنص المدروس وصاحبه، بل يتوقف أيضا على الكيفية التي ينفذ بها الفيلولوجي في هذا النص ويوغل من خلالها في عوالمه.
فالفيلولوجي لا يملك اقتناعات ولا مسلمات جاهزة يريد أن يُمليَها على النص المقروء وينفذ إلى عوالمه وهو مدجج بها؛ إنه يملك “ثقافة تأويلية” يستمدها من مختلف العلوم التي لها مدخل مباشر أو غيرُ مباشر إلى دراسة النصوص، وهو لا يتخذ من هذه الثقافة سلطة تأويلية يبغي بها السيطرةَ على هذا النص أو ذاك وتشديدَ القبضة عليه، بل يتخذ منها “أفقا قرائيا” يسمح للنص المقروء بأن يفصح عن تجربته الحية في خلق معانيه وإبداعها.
وبهذا تتعارض المقاربة الفيلولوجية مع الإيغال العنيف والمتشدد في النصوص، لأنها تتعامل مع كل نص على أنه ممارسة إبداعية تحمل في طياتها فرادةً ما نابعة من نقض المواضعات والأعراف النصية الجارية في سياق زمني محدد.
هذا النهج من القراءة الفيلولوجية هو الذي التزم به في تقدير إدوارد سعيد فيلولوجي لامع كإريك أورباخ وهو يدرس الآداب العالمية، والتزم به عديد من المتقدمين عليه. فهو نهج يأخذ على عاتقه الاقتراب من النص استنادا إلى ميثاق تأويلي قوامه الود والمشاركة والتعاطف (empathie)،
وقوامه مراعاة المنظور العام للعصر الذي ينتسب إليه هذا النص والمنظور الخاص للمؤلف الذي أبدعه وأخرجه إلى الوجود[7].
فلطالما كشف الفيلولوجيون عن مدى الجهد المضني الذي يبذله المؤلفون في مسوداتهم قبل أن يختاروا كلمة ما أو عبارة من العبارات، فلا ينتهون إلى هذا الاختيار أو ذاك إلا بعد مسلسل من عمليات الحذف والتغيير وإعادة الكتابة.
هذا الجهد الدقيق والشاق هو الذي لمسه إدوارد سعيد عن كثب في مخطوطات أعمال جوزيف كونراد J. Konradودفعه إلى القول إن ما من كلمة أو عبارة أو استعارة أو غيرها إلا وهي اختيارات وقرارات اتخذها المؤلف من بين عدد من الإمكانات الأخرى التي تظهر مقدار ما صرف من جهد ووقت في عملية الاختيار والكتابة.
ولذلك وجب على القارئ أن «يبذل جهدا مماثلا لاستبطان لغته (أي لغة المؤلف)، إذا جاز التعبير، بحيث نفهم لماذا صاغها على هذا النحو المخصوص ولكي نستوعبها كما جرى تأليفها»[8].
إن القراءة الفيلولوجية التي يصدر عنها إدوارد سعيد تتعارض في الصميم مع القراءات التفكيكية التي ترى إلى كل تعلق بالوجود الذاتي للنص أو بتجربة مؤلفه على أنه ضرب من “الوضعانية الواهمة“، ذلك أن التحقق الفعلي للنص لا يتأتى حسب التفكيكيين إلا داخل تجربة المؤولين وخبراتهم الذاتية التي يستندون إليها في كل فعل من أفعال القراءة والتأويل[9].
وهي الخبرات التي يفقد فيها النص ملامحَه الوجودية سواء في علاقته بذاته أو في علاقته بمؤلفه ليؤول إلى صناعة تأويلية خالصة تخضع لسلط المؤولين وتوجهاتهم القرائية.
هذا القول بأن النص لا يتحقق وجوده إلا داخل الأفعال القرائية التي تُنجز حوله وفي انفصال عن سياقه الخاص وعن مؤلفه كثيرا ما انتقده سعيد مشهرا في وجهه قاعدة فيلولوجية أثيرة لديه تقضي بأن معاملةَ النصوص على أنها تجارب دنيوية حية تنتسب إلى العالم،
والتنبهَ الدائم إلى صيغ اللغة وصورها البلاغية على نحو ما تستعملها ذوات تعيش في التاريخ هما السبيلان الكفيلان بإدراك الأسس المتغيرة للممارسة الإنسانية في أبعادها الحياتية والقيمية[10]، لا الأسس الثابتة والخالدة التي تكرسها الميتافيزيقا وتؤبِّدها.
لذلك نعتقد أن تشغيل إدوارد سعيد لهذه القاعدة الفيلولوجية العامة في ممارسته النقدية والتأويلية هو الذي جعل منه واحدا من ألمع فيلولوجيي النصف الثاني من القرن العشرين الذين حرروا الفيلولوجيا من الارتباط بالماضي والانقطاع لآثاره، وقذفوا بها نحو الانتماء إلى الحاضر والانهمام بشجونه وشؤونه.
وهو في ذلك يلتقي مع زوندي P. Szondi وصديقه جون بولاك J. bollack في مناداتهما بوجوب دفع الفيلولوجيا إلى الاشتباك بالحاضر وتجديد أدواتها في ضوء تجاربه الإبداعية المختلفة.
وقد تحقق لهما ذلك من خلال اهتمامهما بأعمال صديقهما المشترك الشاعر الكبير بول سيلان P. Cellan حيث أثمر هذا التفاعل فيلولوجيا متجددة يُصطلح عليها اليوم بالتأويلية الفيلولوجية[11].
[1] أستاذ اللسانيات والتأويليات، جامعة عبد المالك السعدي.
مدير مختبر التأويليات والدراسات النصية واللسانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان.
[2] هذا الغياب التام لتدريس الفيلولوجيا في جامعاتنا العربية على المستوى البيداغوجي يوازيه أيضا غياب شبه كامل للاهتمام بها في بنيات البحث ومخابره. ذلك أن البحث العلمي في فيلولوجيا ظاهرة من الظواهر اللغوية أو الأدبية أو الثقافية أو العلمية يحتاج إلى مدى زمني طويل وإلى مجموعة من التخصصات الدقيقة والمتكاملة.
وهو ما لا تسمح به الصيغ القانونية المنظمة لهذه البنيات والمخابر، ولا أيضا الإمكانات المرصودة لها. إذ لا يمكن في أحد المخابر البحثية التابعة للجامعات الأوروبية على الأقل أن نعثر على مشروع بحثي أُنجز أصالة في الفيلولوجيا أو في الإفادة منها دون أن يكون قد استغرق من الباحثين الذين أنجزوه وقتا طويلا وأنفقوا فيه جهدا علميا كبيرا.
ولنا أمثلة حية في ما يُنجز في المدرسة الفيلولوجية التابعة لجامعة ليل Lille الفرنسية، أو ما ينجز بالتعاون بين جامعيين ألمان وفرنسيين حول الأعمال الفيلولوجية المبكرة لنيتشه، أو ما تنجزه المستعربة الألمانية أنجليكا نيورت Angelika Neuwirth بمعية فريق واسع من الباحثين حول “المدونة القرآنية” (Corpus Coranicum)…
هذه الأمثلة وغيرها كثير تظهر مدى الحيوية البحثية التي باتت تستعيدها الفيلولوجيا في عديد من الأوساط الجامعية الغربية من خلال تجديد طرائقها ومناهجها في التعامل مع موضوعاتها، وتظهر أيضا مدى الإقبال المتنامي على دقتها العلمية ورحابتها التأويلية.
ولذلك نعتقد أن الجدوى البيداغوجية والعلمية من إدراج الفيلولوجيا في برامجنا الجامعية لا تنحصر في التعرف على الإمكانات النقدية والتفسيرية التي يتسع لها علم محدد في فهم النصوص فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى حقول علمية أخرى. فالمشتغل اليوم بالترجمة أو بالآداب المقارنة أو بتاريخ العلوم أو بتاريخ الفن أو بتحقيق نصوص التراث أو بحقول أخرى لا يمكنه أن يستبعد الفيلولوجيا ويتجاهل أهميتها…
[3] إدوارد سعيد، الأنسنية والنقد الديمقراطي، ترجمة فواز طرابلسي، ط. 1، ص 79، دار الآداب، بيروت، 2005.
[4] بدأت هذه العلاقة واضحة في أعمال سعيد منذ أواخر الستينيات حين ترجم إلى الإنجليزية بمعية زوجته السابقة ماري جانوس Maire Janus “فيلولوجيا الأدب العالمي” (Philology and Weltliteratur) لإيريك أورباخ، وجاء تقديمهما لهذه الترجمة بعنوان: “أورباخ والتقليد العام للفيلولوجيا الألمانية”. ثم توالت علاقة سعيد بالفيلولوجيا ولم تنقطع في أعماله اللاحقة كـ”الاستشراق”، و”بدايات”، و”العالم والنص والناقد” وغيرها… لمزيد من التوسع يراجع:
- Pascale Rabault-Feuerhahn (dir), Théories intercontinentales : Voyages du comparatisme postcolonial, Editions Demopolis, Paris, 2014.
[5] Salomon Reinach, Manuel de la philologie classique, T. 1, p. 1, 2° édition, Librairie Hachette, 1883.
[6] صدرت هذه المقدمة التي تعود إلى سنة (2003) في:
- W. Said, Orientalisme : L’Orient crée par l’Occident, p. VI, Seuil, Paris, 2005.
[7] إدوارد سعيد، المرجع السابق، ص VII-VI.
[8] إدوارد سعيد، الأنسنية والنقد الديمقراطي، ص 83.
[9] يراجع:
- Stanley Fish, Quand lire c’est faire : L’autorité des communautés interprétatives, (1980), fr., préf. d’Yves Citton, postf. De St. Fish (inédite), Les Prairies ordinaires, 2007.
[10] إدوارد سعيد، الأنسنية والنقد الديمقراطي، ص 82.
[11] عن علاقة الفيلولوجيا بالحاضر يراجع:
- Christoph Kӧnig et Denis Thouard (éds), La philologie au présent : Pour Jean Bollack, Presses Univ. du Septentrion, 2010.