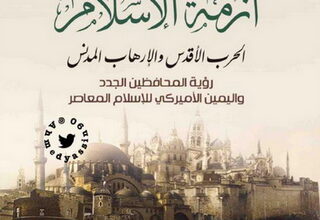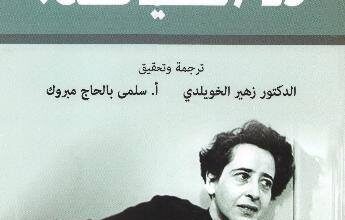إضاءات على بعض أسباب فشل الثورة السورية

مع بداية العام العاشر للثورة السورية، تطرح بعض الأسئلة الملحة نفسها ثانية. أسئلة النجاح والفشل، أسئلة النتائج النهائية، أسئلة الأساليب والوسائل، وحتى أسئلة المشروعية ذاتها.
عندما تكون أهداف الثورة تحقيقَ الانتقال السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي، لكنها تصل إلى تكريس أنظمة حكم محلية متناحرة؛ يكون للسؤال نصيب معقول من الوجاهة. عندما تسعى الثورة لتحقيق كرامة الإنسان، لكنها تصل به إلى قعر الانحطاط والفاقة والجوع والخنوع؛ يكون للكلام طعمٌ مرّ كالعلقم.
عندما تنشُد الثورة دولة حرة مستقلة ذات سيادة على جغرافيتها وحدودها ومواردها وثرواتها، لكنها تصل إلى تقسيم فعلي بين قوى احتلال أجنبي دولي وإقليمي بل ميليشياتي؛ يكون للنصر والهزيمة طعمٌ واحد. عندما تصبح التضحيات المبذولة شعاراتٍ زائفةً، والعذابات المعيشة حالةً ثابتةً لجمهور كبير وواسع من المواطنين، داخل أسوار الوطن – السجن وخارجه؛ يكون للكلمات معنى العدمية والهباء فقط.
ثمة أسباب كثيرة لا حصر لها لما وصلنا إليه من مآل، وكثيرون منا فكروا وناقشوا ونظروا لها، من الفرقة والتشرذم، إلى انعدام الخبرة ونقص التجربة، إلى قلة الموارد، إلى عدم نضوج الظروف الموضوعية، إلى طبيعة الصراع ذاته، إلى شراسة الخصوم، إلى عشرات بل مئات الأسس التي بُنيت عليها النتائج المترتبة. لكن ثمة عوامل ذاتية فينا -كأفراد وجماعات- قلما تم البحث فيها وتأصيلها، لمحاولة الكشف عن دورها في ما وصلنا إليه حتى الآن.
لم نتمكن -السوريين- من بناء أسباب الثقة بيننا، لا كأبناء ثورة، ولا كمعارضين سياسيين مخضرمين، ولا كأحزاب وجماعات وتيارات. لقد بات ممجوجًا ومكررًا القول بأن التصحر السياسي الذي خلقه نظامُ الاستبداد طوال خمسين عامًا هو السبب وراء ذلك، لأن الرد عليه من أصغر طفل حافي القدمين في مخيم أطمة أو الزعتري سيكون: وماذا فعلتم منذ عشرة أعوام؟ ألم يتسنّ لكم ممارسة السياسة حتى تتعلموها؟ ألم تلتقوا وزراء خارجية وسفراء ومبعوثي أعظم وأقوى دول العالم؟ ألم تحضروا آلاف الاجتماعات واللقاءات والدورات التدريبية؟ ألم تؤسسوا آلاف الكيانات والأجسام والهيئات والمؤسسات والمنظمات؟
ثمة خللٌ حقيقي في نمط التفكير، وفي السلوك الجمعي السوري، وربما في السلوك الفردي أيضًا، وإذا كان بعض الظن إثمًا؛ فإن بعضه من حُسن الفِطَن. ليس هذا جَلدًا للذات ولا تشاؤمًا، إنه وصف لحالات وتجارب لا تُعد ولا تحصى من محاولات العمل الجماعي التي باءت بالفشل، بسبب أداء الأفراد ذاتهم، لا بسبب أي شيء آخر. ما السبب في كل هذا الخراب وهذا الفشل؟ أليست هذه ظاهرة تستحق التأمل والبحث؟
يقول الدكتور عزمي بشارة، في دراسة له نشرت بتاريخ 20/1/2020 في موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تحت عنوان “الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية”، ما يلي:
“ظاهرة الشعبوية السياسية نمطٌ من الخطاب السياسي، يتداخل فيه المستويان الخطابي والسلوكي بشكل وثيق. وقد يتفاعل هذا الخطاب مع عفوية تقوم على مزاج سياسي غاضب لجمهورٍ فقد الثقة بالنظام والأحزاب السياسية القائمة والنخب الحاكمة، كما يوظف بوصفه استراتيجية سياسية في مخاطبة هذا المزاج هادفة إلى إحداث تغيير سياسي عبر الوصول إلى الحكم. ويتحول هذا الخطاب إلى أيديولوجيا في الحالات المتطرفة”.
يتبين للملاحظ عن كثب أن الشعبوية قد طغت على خطاب ليس فقط قادة المعارضة السياسية التقليدية السورية، ولا المعارضة الناشئة التي أفرزتها سنوات الثورة فحسب، بل أيضًا على خطاب الثائرات والثائرين من أول أيام الثورة حتى اللحظة. يكاد المرء لا يعثر على أي نسق فكري متوازن بعيدٍ عن هذه الديماغوجيا المستشرية، وإن وجدت في فترة ما -كما حصل مع خطاب بعض فئات المعارضة أيام مؤتمر القاهرة الأول، حين تم إنجاز ما عُرف لاحقًا بوثائق القاهرة- فإنها تبقى واحاتٍ متناثرة في صحراء الهباء والعدم، أشبه بومضات برق لم يعقبها مطرٌ يغيث.
منذ أن تبنى ما عُرف لاحقًا باسم “المؤتمر الوطني السوري”، بوصفه أول محاولة لبناء كيان سياسي سوري في إطار الثورة، شعارَ إسقاط النظام الذي رفعه المتظاهرون الأوائل في شوارع درعا بعد أسبوع من اندلاع التظاهرات، حتى آخر الكيانات أو الهيئات التي أفرزتها الثورة أيضًا، أي هيئة التفاوض، ما زلنا نسمع ونقرأ الخطاب الشعبوي نفسه. وعندما يطرح أي امرئ نقده لمفردات هذا الخطاب الخشبي؛ يُشْهَرُ في وجهه سيفُ الاتهام بالتخلي عن ثوابت الثورة!
لكن ما هي ثوابت الثورة، ومن يحددها، وكيف يمكن قياسها، وما هو الثابت في الثورات، وما هو المتغير أو المتحول فيها؟ وهل الثورة غاية بحد ذاتها؟ وسواء أكانت كذلك أم لم تكن، هل هي مقدسةٌ أم غير ذلك؟ وهل هي الطريق الوحيد للوصول إلى المطالب والحقوق، أم هناك طرقٌ أخرى غيرها؟ وهل هي وسامُ شرفٍ وميزةٌ، أم هي فعل اجتماعي له قواعده وأصوله؟ عشرات الأسئلة التي لو أجيب عليها مبكرًا؛ لما كنا وصلنا إلى ما نحن به اليوم، ولما كانت هذه حالنا.
لماذا لم تستطع المعارضة السياسية السورية إنشاء خطاب موحد، أو بناء مؤسسات سياسية حقيقية، أو المساعدة في توحيد الخطاب الثوري على الأقل، خاصة أن أغلب القوى السياسية المعارضة كانت أو أصبحت مقيمة خارج سورية، وأغلبها موجودٌ في دول تسمح أنظمتها السياسية بهامش كبير من حرية التفكير والعمل؟
هي إذن حالة من الفشل الواضح والناتج عن فقدان الثقة بالنفس، التي بدورها ناتجة عن إدراك مبهم غير واضح لفقدان الشرعية، تلك التي جعلت السياسيين، أو من دفعتهم الأحداث إلى تصدر المشهد السياسي، يتصرفون بشعبوية مفرطة لكسب ودّ الجمهور الثائر الغاضب، ويتعاملون معه باعتباره على صواب في كل ما يقول ويفعل، حتى ذهب الأمرُ ببعض أبرز قادة المعارضة السياسية التقليدية (الذين دفعوا حقًا من أعمارهم وحيواتهم في سجون الأسدين الأب والابن باهظ الأثمان) إلى أن يعتبروا “جبهة النصرة” أحد فصائل الثورة السورية، ويدافعوا عنها في العلن أمام ممثلي الدول التي تصنفها كتنظيم إرهابي متفرع من تنظيم القاعدة الأم!
لا تفشل الثورات من تلقاء ذاتها، أو لأسباب تخصها أو تتعلق بطبيعتها وبالظروف المحيطة بها فقط، بل تفشل أولًا، لأنها لا تجد قادة قادرين على استثمارها، واستثمار غضب صناعها ووقودها بشكل صحيح، وتحويله إلى مكاسب سياسية. إنّ فشل الدفاع عن القضايا العادلة يوجب تغيير المحامين المدافعين عنها، لا تغييرها، فهل آن الأوان لأن نتغير؟