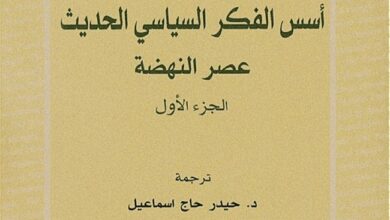ثورات “الربيع العربي”: عودة إلى ملاحظات هوبزباوم

لم يثبت أن ثمة إجماعًا ناجزًا على توصيف مسبق أو تنميطات معينة للثورات، مع التقدير للمنظّرين، على اختلاف اجتهاداتهم وخلفياتهم، إذا تجاوزنا الوصفات العامة والشائعة، والتي تصلح لأي حالة في أي زمان ومكان.
ولعل أنسب دليل على ذلك حقيقة أن التراث النظري، المتعلق بالثورات، والذي راكمته التجربة البشرية، كان يأتي تاليًا وليس سابقًا لها، مثلما حصل في التنظير للثورتين الأميركية والفرنسية (القرن الثامن عشر)، ثم للثورات الأوروبية (القرن التاسع عشر)، كما للثورة الروسية (في القرن العشرين) وما بعدها.
هذا ما حاوله، مثلًا، كل من لينين في مجمل كتبه التي خطّها بعد ثورة 1905، مثل “ما العمل”، و”خطتا الاشتراكية الديمقراطية”، و”خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء”، و”الدولة والثورة”، وحنه أرندت في كتابها “في الثورة” الذي تحدثت فيه عن معنى الثورة والتي لخصتها بالحرية، ثم غوستاف لوبون في كتابه “روح الثورة الفرنسية”، الذي تحدث عن انعكاسات الروح الثورية على نفسية طبقات المجتمع وعلى المنخرطين في الثورة، وبعده كريس برنتين في كتابه “تشريح الثورة”، الذي حاول فيه تحليل ونقد الثورات الأربع الإنكليزية والأميركية والفرنسية والروسية واستخلاص مقاربات في ما بينها، مؤكدا عدم وجود ثورات نمطية، وأخيرًا أريك هوبزباوم في كتابه “عصر الثورة”، وهو جزء من رباعية أرّخ فيه للتحولات الثورية، بكل أبعادها، في أوروبا في الفترة بين 1789 – 1848.
- الثورات لا تأتي وفقًا لمساطر معينة
مناسبة هذا النقاش هي تعرّض ثورات “الربيع العربي”، منذ اندلاعها من تونس إلى مصر ثم اليمن وليبيا وصولًا إلى سورية، إلى نوع من النقد السياسي الذي يتبرّم منها، أو يقلّل من أهميتها، أو ينزع عنها شرعيتها. وقد انصبّ هذا النقد على عدة مسائل، أهمها افتقاد هذه الثورات للتنظيم (الحزب الطليعي) وللنظرية الثورية، اللذين يشكلان معا الترسيمة التقليدية اللازمة للثورات، بحسب النظرية اللينينية.
المشكلة أن هذا النقد أتى من حيث لا يحتسب أحدٌ، أي من أصحاب وجهات النظر الثورية، أو الكيانات اليسارية تحديدًا، وقد نسي هؤلاء أنهم كانوا يبشّرون بالثورة منذ عقود، وأنهم لطالما اتهموا شعوبهم بالقعود، واستمراء الواقع الظالم، بدل الثورة عليه، وأنهم هم بالذات يتحملون بعضا من المسؤولية عن قصور أي حالة ثورية؛ هذا أولًا. وثانيًا، تناسى هؤلاء أن الثورات لا تأتي وفقا لحسابات مسبقة، أو وفقًا لمعايير ثابتة، أي لا تأتي وفقا لمساطر معينة، إذ ليس ثمة تعريف جامع مانع للثورة، لذا فهي توصف كذلك لأنها تعبّر عن قيامة معظم الشعب في شكل مفاجئ، وعفوي، وعاصف، بطريقة عنيفة أو سلمية، لإسقاط سلطة معينة، أو لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد. ثالثًا، لا توجد في التاريخ ثورات هادئة ونظيفة وكاملة وناجزة، فالثورات تتشبّه بمجتمعاتها، وتتمثّل تناقضاتها ومستوى تطورها السياسي والاجتماعي والثقافي، أي أنها لا تأتي بحسب الرغبات، أو النظريات، وهذا ما حاول أن يقوله هوبزباوم وبرنتين وأرندت.
رابعًا، الأهم من كل ذلك أن نجاح الثورات ليس مضمونًا، أي أنه لا يمكن الاشتراط عليها، فهي يمكن أن تنجح ويمكن أن تخفق، كما يمكن أن تحقق أهدافا جزئية، أو تدخل في مساومات أو تتعرض لتلاعبات، كما يمكن أن تنحرف. والفكرة هنا أن الموقف العقلاني من الثورات قبل اندلاعها، أو للتمهيد لها، هو أمر محمود ومطلوب، في حين مطلوب لدى اندلاعها الموقف الأخلاقي، إلى جانب الموقف العقلاني، وهذا ما يفسّر موقف ماركس من “كومونة باريس”، إذ رغم مخاوفه قبلها، ومآخذه عليها، أبدى حماسته لها، بتحيته أبطال الكومونة “الذين هبوا لمناطحة السماء”. خامسًا، لعل أهم ما ينبغي إدراكه هنا أن الثورة ليست خيارا بين خيارات، وإنما هي بمثابة ممر إجباري، لكسر الانسداد في التاريخ، أو في التطور، والذي يمثله النظام السائد، وهذه هي لحظة الأزمة الثورية، بحسب المفهوم اللينيني، حيث لا تعود الطبقات المحكومة والمظلومة قادرة على العيش على النحو الذي كانت تعيش به، ولا تعود الطبقة الحاكمة والمهيمنة قادرة على الحكم والسيطرة.
معنى ذلك أنه لا توجد هندسة معيّنة للثورات، ومن يبحث عن حالات كهذه لن يجدها، لسبب بسيط مفاده أنها حينها ستكفّ عن كونها كذلك، لأن الثورات أصلًا تأتي كحالات انفجارية، فجائية وصادمة وعنيفة، ومن خارج التوقّعات، قوتها بقدر الطاقة المحتبسة فيها، لذا لا يمكن التحكم بها.
- خارج الترسيمة اللينينية
مفهوم أن تعاليم فلاديمير ايليتش لينين، قائد ثورة أكتوبر (1917)، حول الثورة، تتضمن عنصرَيّ الوعي والتنظيم، عبر الحزب الثوري، وهو توصيف محبّذ وصائب عمومًا، لكن مشكلته أنه لا يجاوب على كل الأسئلة، وأنه يفترض اشتراطات مطلقة أو حتمية. فمثلًا هو لا يجيب عن مشروعية الثورة على الظلم والاضطهاد، بغض النظر عن مستوى التطور السياسي والثقافي للشعب المعني، وبغض النظر عن وجود عنصري النظرية والتنظيم، كما لا تجيبنا هذه النظرية عن الواقع الذي يكون فيه شعب ما محرومًا من السياسة ومن الحياة الحزبية، أو عن الموقف السياسي والأخلاقي من شعب قرر أن يثور على واقعه، بأية طريقة كانت، وتحت أية شعارات. ولعل هذا كله يحيلنا، أو يحفّزنا، بدوره على مراجعة التنظير للثورات، من خارج الترسيمة اللينينية، أو التنظير للثورات بالشكل الذي حصلت عليه.
أيضًا ربما يجدر لفت الانتباه هنا إلى ملاحظة هوبزباوم، المؤرّخ، بأن الثورات هي وليدة المجتمعات الحديثة، وتطور العمران البشري وتمركزه، أي أنها نتاج قيام المدن وتطور الصناعة ووسائل المواصلات واختراع الطباعة وانتشار التعليم والانقسام الطبقي وظهور الطبقة الوسطى وتزايد الوعي بالحقوق والحريات الفردية والسياسية، ما يجعل منها حالة مرتبطة بالحداثة، وبمفهوم السلطة والدولة، على خلاف التمردات الشعبية التي عرفتها العصور السابقة.
إلى ذلك فإن المجتمعات العربية التي تأخّرت كثيرًا في إدراكاتها وخبراتها السياسية، تأخرت أيضًا في إدراكها معنى الثورة، ومتطلباتها، ما يفسّر بعض المشكلات والنواقص التي تحيط بثورات “الربيع العربي”، التي تحصل بطريقة فجّة، وقاسية، ومكلفة.
المشكلة أن المجتمعات المعنية إزاء كل ذلك وجدت نفسها أمام خيارين، فإما مواصلة العيش على النحو السابق، والبقاء على هامش التاريخ العالمي، أو كسر الجوزة الصلبة التي تمثلها النظم الاستبدادية، وهو ما حصل، رغم الأكلاف والتحديات التي نجمت عن ذلك.
فضلًا عن ذلك فإن التحديات والمشكلات التي تواجه الثورات العربية لا تقلل من مشروعيتها، أو من نبل مقاصدها، رغم الإحباطات والثغرات، لا سيما أن هذه هي أول تجربة سياسية للمجتمعات العربية في العصر الحديث، وأول إطلالة لها على مسرح التاريخ بوصفها فاعلا سياسيا، وأول محاولة في العالم العربي لإسقاط أنظمة تسلطية، ويكفي أن هذه الثورات عمقت الإدراكات السياسية في أذهان المواطنين، بمقدار عقود أو قرون.
لكن من الذي قال إن الثورات في الغرب، في بريطانيا في القرن السابع عشر، وفي الولايات المتحدة وفرنسا في القرن الثامن عشر، وثورات 1848 في أوروبا، وكومونة باريس والثورة البلشفية في روسيا، في مطلع القرن العشرين، كلها كانت وفق تلك المعايير والمقاييس؟ مع ذلك فإن أحدًا لم يشكك بهذه الثورات وقتها، أو يأخذ عليها، غياب عنصري الوعي والتنظيم، لسبب بسيط وهو أن الترسيمة اللينينية جاءت فيما بعد، أي بعد ثورة 1905 (بروفة ثورة 1917) في روسيا.
مثلًا الثورة الفرنسية (1789)، التي تعتبر بمثابة أيقونة الثورات العالمية، لم يقدها أمثال مونتسكيو ولا فولتير ولا روسو ولا ديدرو، وإنما قادها روبسبير ودانتون وأضرابهما، وهذه الثورة، كما أرّخ لها هوبزباوم، كانت قد نجحت في البداية في شكل جزئي، بإسقاط الملكية، لكن سرعان ما دبّت فيها الفوضى والعنف والتصفيات المتبادلة، الأمر الذي أدى إلى إعدام روبسبير على المقصلة ذاتها التي أزهقت روح الملك، ما مهّد لإزاحة القوى الثورية ومجيء الضابط نابليون بونابرت الذي ما إن تمكّن حتى نصّب نفسها إمبراطورًا. وبالنتيجة فقد احتاجت فرنسا إلى الكثير من الثورات، ومسافة قرن تقريبًا، كي تتمثل قيم الثورة الفرنسية الأولى.
وهكذا في كتابه “عصر الثورة (1789 ـ 1848)”، كتب هوبزباوم عن الثورة الفرنسية (1789) قائلا: “الثورة الفرنسية لم تحدث على أيدي حزب أو حركة قائمة بالمعنى الحديث للكلمة، ولم يتزعمها رجال يحاولون تنفيذ برنامج منهجي منظم. بل إنها لم تطرح “قيادات” من النوع الذي عودتنا عليه ثورات القرن العشرين، إلى أن ظهرت شخصية نابليون ما بعد الثورية” (ص 102).
والفكرة الثانية التي يتحدث عنها هوبزباوم تتعلق بمآلات الثورات، إذ يقول: “كانت الثورة الفرنسية بين الثورات المعاصرة لها وحدها التي حملت رسالة رسولية، فقد انطلقت جحافلها من أجل ثورنة العالم، وقد أفلحت أفكارها في تحقيق ذلك. أما الثورة الأميركية، فقد ظلت حدثا مصيريا في نطاق التاريخ الأميركي، ولم تخلف وراءها غير آثار أساسية قليلة خارج هذا الإطار… لقد كانت الثورة الفرنسية علما ومعلما في جميع البلدان، وخلافا لنتائج الثورة الأميركية…” (ص 130). والجدير بالذكر أن هذا الكلام يكتسب أهميته أو مغزاه مع معرفتنا بأن الثورة الأميركية انتصرت في حين انهزمت الثورة الفرنسية.
- الحلم أقوى
برغم ذلك، ثمة في بعض ما كان يصح على فرنسا آنذاك، يصح على ثورات “الربيع العربي”، ولا سيما على سورية، رغم كل الفروقات، بمعنى أن الثورات لا تقاس فقط بوقائعها، وتداعياتها الآنية، الأليمة، والمكلفة، وإنما تقاس، أيضًا، بقدرتها على فتح أفق، والدخول في التاريخ العالمي. وعندنا، فإن هذا يحصل بقيامة الشعب، من بعد موات، وبكسر الحلقة الصلبة، التي تمثلها سلطة الاستبداد والإفساد، التي تقف حاجزًا أمام تطور المجتمع والدولة وظهور المواطن.
وتعتبر الثورة الفرنسية، وشعاراتها “الحرية والإخاء والمساواة”، والتي استمرت وقائعها عشرة أعوام (1789- 1799) بمثابة أيقونة الثورات الأوروبية، كون تأثيراتها عمّت القارة. وقد ابتدأت هذه الثورة بإلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الأرستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي، وتوحيد السوق الوطنية، ووضعت أسس الديمقراطية السياسية وأعلنت حقوق الإنسان، وأقرّت الزواج المدني. لكن هذه الثورة شهدت اضطرابات شديدة إذ عرفت ثلاثة أنواع من الحكم، أولها الملكية الدستورية (حيث تم تقييد سلطة الملك)، وثانيها إقامة نظام جمهوري متشدّد بعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة بالملك لويس السادس عشر (1893)، وثالثها، سيطرة البرجوازية على الحكم، حيث استعانت بعدها بالضابط نابليون بونابرت الذي قام بدوره بتتويج نفسه إمبراطورا فيما بعد. واللافت أن قائد الثورة روبسبير أعدم بالمقصلة التي أعدم فيها الملك، والتي كان أعدم فيها دانتون، أحد قادة الثورة ورفيقه (خلال تسعة أشهر حُكم رسميًا على 16 ألف شخص بالموت). وكان روبسبير، على ثقافته ومواهبه، شديد الاندفاع وعصبي المزاج، ومغرورًا ومدّعيا (ربما على طريقة القذافي) إذ اعتبر أن فرنسا تسبق الدول الأوروبية بألف عام، وأراد جعل تاريخ فرنسا يبدأ من موعد الثورة، وحاول اتخاذ ديانة جديدة اسمها عبادة العقل، وقطع علاقة فرنسا بالفاتيكان، وأغلق الكنائس، كما أعاد ترتيب الشهور وأسمائها، وجعل أيام الأسبوع من 7 أيام إلى 10، وظل الأمر كذلك حتى مجيء نابليون عام 1804.
يقول هوبزباوم: “عندما يفكر الشخص العادي المتعلم في الثورة الفرنسية، فإن أول ما يرد إلى ذهنه يتمثل في أحداث عام 1789، ولا سيما جمهورية اليعاقبة للسنة الثانية. وتبرز في هذا السياق صور جلية شتى: روبسبير المتأنق، ودانتون الجسيم الداعر، وسان – جوست الثوري الجليدي الأنيق، ومارا الفظ، ولجنة السلامة العامة، والمحكمة الثورية والمقصلة. وقد انقرض كثير من الأعلام الثوريين المعتدلين.. ولم يعد يذكرهم إلا المؤرخون” (ص 149).
ومع أن الثورة الفرنسية انهزمت، من الناحية العملية، مع صعود نابليون كإمبراطور، فإن هوبزباوم يرى ذلك على نحو آخر، في قوله: “نابليون دمّر شيئًا واحدًا فحسب، هو ثورة اليعاقبة، حلم المساواة والحرية والإخاء، وحلم الشعب الذي أعلن الثورة الجليلة ضد الاستبداد”. لكنه يستدرك قائلا: “لقد كان الحلم أقوى وأبقى أثرًا من أسطورة نابليون، ذلك أن الحلم، لا ذكرى نابليون بعد سقوطه، هو الذي استلهمته ثورات القرن التاسع عشر، حتى في بلاده فرنسا” (ص 163).