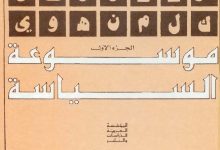حكومة جديدة لمشاكل متقادمة

في إحدى قصص المنفلوطي، ومن يذكر الآن المنفلوطي أو يقرأ نصوصه؟ التي أحببناها، نجد «الحلاق الثرثار» الذي اتخذ رأس زبونه، وهو يحلقه، خريطة يفسر من خلالها، إبان الحرب العالمية الثانية، مواقع الصراع بين الروس واليابانيين، منشغلا بذلك عن القيام بواجبه نحو الزبون الذي ضجر منه، وخرج هاربا، وهو يقول: «لعن الله السياسة والسياسيين، والروس واليابانيين، والناس أجمعين».
كان هذا لسان حال المغاربة، وهم يُدعون إلى المشاركة في انتخابات الثامن من أيلول (سبتمبر) 2021. كان الجميع متخوفا من عدم الإقبال على صناديق الاقتراع، كما صار يجري في مختلف البلاد العربية، تعبيرا عن رفض ما آل إليه الوضع العام من فساد متواصل، وتدهور مستشر.
لكن المغاربة، لعنوا السياسة والسياسيين بعد أن أعطوا أصواتهم بكثافة، في مرحلة، للمعارضة الاشتراكية، وفي مرحلة لاحقة لمن اعتبروا «إسلاميين».
لقد تبين بالملموس أن السياسة صارت بقرة حلوبا للمتفرغين لشؤونها من «السياسيين» في الأحزاب، والنقابات، ليس بهدف تدبير شؤون البلد والمساهمة في تنميته، ولكن بقصد تحقيق المطالب الخاصة، ومراكمة الامتيازات.
لعن المغاربة السياسة والسياسيين في الانتخابات الأخيرة من خلال نفض اليد نهائيا عن العدالة والتنمية. ولم تكن مشاركتهم الكثيفة، عكس ما كان متوقعا، سوى تأكيد على أن إسقاط أسطورة الإسلاميين كان هو الهدف الأساس من المشاركة. جاءت الحكومة الجديدة، وأعتبرها جديدة رغم مكوناتها القديمة والتقليدية، لأنها تولدت في سياق جديد، قوامه الإعلان عن فشل الرهانات التي كانت معلقة على المعارضة، أي معارضة، من جهة.
ومن جهة ثانية لتكون تأكيدا للطريقة التي اشتغلت بها الدولة في تدبير شؤون البلاد، سواء على المستوى الداخلي من خلال تحديث البنيات التحتية، والتفكير في استراتيجيات بعيدة المدى للتنمية المستدامة، وعلى المستوى الخارجي عبر تحقيق نجاحات باهرة على مستوى القضية الوطنية، وكسب ثقة المجتمع الدولي. هذا هو السياق الجديد الذي تأتي في نطاقه هذه الحكومة الجديدة.
بعد أحداث الربيع المغربي في 20 شباط (فبراير) 2011 مباشرة، كتبت أولى مقالاتي التي بينت فيها أن الشعب قال كلمته في هذا التاريخ، وأن الملك قال كلمته في 9 آذار (مارس)، استجابة لكلمة الشعب، وكان من ثمة الاستثناء المغربي الذي جنب البلد الكوارث التي ما تزال تهيمن في بعض الدول العربية، وتساءلت عن كلمة المجتمع السياسي؟ إن المجتمع السياسي، إلى جانب الأحزاب المختلفة، كان المقصود به هو المعارضة الاشتراكية التي ما إن ذاقت حلاوة السلطة حتى تنكرت لكل تاريخها النضالي، وما قدمت فيه من تضحيات جسيمة شكلت رصيدا ظل الشعب المغربي يعترف به ويثمنه. وجاء الدستور الجديد حاملا طموحات كثيرة من أجل بناء مغرب جديد.
حمل الربيع المغربي الإسلاميين إلى السلطة، وأبانت التجربة عن فشل ذريع في تنزيل الدستور، وفي تحقيق المطالب التي كان الشعب يراهن على تحقيقها على أيديهم. بل إنهم ظهروا غير مختلفين عن غيرهم في التعاطي مع الواقع السياسي والاجتماعي. وتكشف للجميع أن ليس في القنافذ أملس.
قد يُبرَّر هذا الفشل بسبب هيمنة الدولة في اتخاذ القرارات، وجعل الحكومات المتعاقبة لتصريف الأعمال فقط. ولنا أن نتساءل لماذا؟ هل لأن الدولة لها تصور معين لضبط الواقع وحفظ التوازن؟ أم بسبب ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على خلق النخبة القادرة على المبادرة وتخليق الحياة العامة؟ أسئلة لا نجيب عنها بالشكل المطلوب.
من السهولة بمكان إلقاء اللائمة على الآخر دون تحميل الذات عجزها عن الارتقاء إلى المسؤولية الملقاة على عاتقها من خلال ما قدمته لها صناديق الاقتراع، وما يخوله لها الدستور من إمكانات للعمل.
أعتبر الحكومة الحالية جديدة كما كان بإمكاننا النظر في التحالف التوافقي باعتباره حكومة جديدة، وكذلك حكومة العدالة والتنمية جديدة. ولكل جدة سياق ومسار. فهل ستكون الحكومة الجديدة كنظيراتها في السياقات السابقة؟ إذا كانت الحكومة «الإسلامية» جاءت بعد تغيير الدستور، وعجزت عن تنزيله، أو الوفاء بوعودها، أرى أن الحكومة الجديدة تولدت في سياق إنجاز النموذج التنموي الجديد الذي حرصت الدولة على تهييئه عبر تكوين لجنة خاصة.
ولم يكن أمام هذه الحكومة، إلى جانب الوعود التي رفعتها بعد تشكلها، سوى الإعلان عن تطلعها إلى تنزيل ما قدمه النموذج التنموي الجديد. ويحق لنا هنا أيضا أن نتساءل: لماذا تعمل الدولة على ما لا يقوم به المجتمع السياسي بمختلف أطيافه واتجاهاته؟ هل وصل البؤس السياسي، لدى الأحزاب، إلى حد اختزال السياسة في الوصول إلى الحكومة، عن طريق توافقات أو انتخابات تفصل على قدر التحولات؟ لماذا تأتي كل المبادرات من الدولة مساء، وتأتي صحف الأحزاب للدفاع عنها صباحا؟ لماذا لا تتحرك بعض المجالس أو الجماعات إلا بعد «الغضبات الملكية»؟ ولماذا لا تنفذ حتى بعض المشاريع الملكية؟
أسئلة كثيرة يفرضها واقع التحولات التي عرفها المجتمع السياسي المغربي. ولعل آخرها يتجلى في السؤال: إلى متى سيظل هذا المجتمع على حالته منذ أن أصبح الحديث عن التوافق والتناوب بوابة انتظار الفرصة للوصول إلى السلطة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة يفرضها واقع الحكومة الجديدة وهي تسعى إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد. فهل ستكون في مستوى التحديات الداخلية والخارجية؟ لا يمكن التكهن بأي جواب في هذا الوقت. لكن أهم ما يمكن أن تعيه الحكومة الجديدة جيدا هي أنها جاءت لتضع حدا لمن أعطى ظهره لانتظارات الشارع المغربي وتوقعاته، ولم يكن مصيره سوى التنكر والاستنكار، وأن الحس الشعبي يقظ وإن كان يبدو غير آبه بما يجري.
ولعل أهم ما يمكن أن تعمل هذه الحكومة على تحقيقه على مستوى علاقتها بالشعب يكمن في إعادة ثقته في السياسة والسياسيين. ومدخل ذلك هو تخليق الحياة السياسية عن طريق الإنصات إلى صوت الوطن وانتظارات المواطن. فإلى جانب العمل على التفكير في القضايا المتقادمة، والتي لم ينفع معها التجريب والاستعجال مثل: التعليم والصحة، والشغل لا بد من خلق مناخ جديد لإشراك المجتمع في تحمل مسؤولياته في مواجهة كل التحديات عن طريق الحوار والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن على الأحزاب التي وجدت نفسها في المعارضة أن تعي أيضا مسؤولياتها الجديدة التي فُرضت عليها، بعد أن تم إقصاؤها من المشاركة في الحكومة، وهي التي ظلت تحلم وتسعى بكل الوسائل لتكون ضمنها، أن تضع نصب عينيها مسؤولية إعادة النظر في بنياتها وتجديد مكوناتها ومقاصدها، وأن تتخلى عن تلخيص كل مطامحها في أن يكون لها موقع في اقتسام الغنيمة.
إن الافتقاد إلى الحس الوطني والشعبي، وعدم القدرة على أن يتحول الحزب إلى مدرسة لتكوين المواطنين القادرين على رفع التحديات، والإسهام في بناء الوطن، لا يمكن إلا أن يجعل هذا المجتمع عائقا دون التحول وعاجزا عن التغير والتطور.
إن المشاكل المتقادمة لا يمكن، سواء من لدن الدولة أو الحكومة أو المعارضة، حلها بالإلغاء والإقصاء، ولا بالثناء أو الهجاء، ولا بالشعبوية أو بالعنجهية. إن الارتقاء إلى ما ينتظره المواطن والوطن، وهو يواجه تحديات داخلية وخارجية، مسؤولية يتحملها الجميع، ومطلب استعجالي وحيوي، وأي استهتار بهذه المنتظرات لن يؤدي إلا إلى استمرار لعن السياسة والسياسيين.