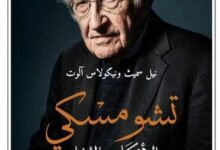« كل بلاغة تتمركز على أشكال محددة في التفكير والأسلوب، ولا تحاول توسيع نطاق تطلعاتها الى اقصى حد ممكن، ولا ان تتعاطى مع الحِجاج البلاغي المعني بالقيّم في مجمله، مصيرها الزوال سريعاً لا محالة».
ش. بيرلمان / مقتبس من النص المترجم
- ملخص:
يعد هذا البحث* أحد النصوص التأسيسية الأولى للفيلسوف ش. بيرلمان والذي لم ينقل إلى اللغة العربية من قبل. وقد نُشر في المجلة الفلسفية الفرنسية في عام 1950. واعتبره بيرلمان بمثابة مدخل أساسي لكتابه العمدة الموسوم بـ (رسالة في الحِجاج) الصادر بجزئيين اثنين عام 1958 –والذي لم يترجم بعد إلى اللغة العربية .
وقد عرض في هذا البحث لأهمّ الخطوط العامة لنظريته في البلاغة الجديدة؛ وجاء على تحديد المفاهيم الرئيسية، وفي مقدمتها الحِجاج البلاغي. فضلاً عن تسليطه الضوء، وللمرة الأولى في تاريخ الفكر الغربي عامة والبلاغي خاصة، على جينالوجيا أحد أبرز المفاهيم المركزية في البلاغة والمعروف خطأ بـ «الجنس البرهاني».
مما أدى الى تراكم مجموعة من القراءات الحرفية/التقليدية التي افتقرت للدقة والصواب في معظم المؤلفات الغربية المعنية بالبلاغة والحِجاج – وهو الخطأ نفسه الذي ما زال مستمراً في المؤلفات البلاغية والحِجاجية العربية –
وذلك يعود لسيادة النزعة الافلاطونية-الارسطية التي تعلي من شأن نظام الفكر المنطقي؛ البرهاني، والوضعي، وتعمل، في الوقت نفسه، على التقليل من شأن البلاغة والحِجاج والحدّ من حرية الكلام والحوار والتعبير.
من هنا، وبعد المراجعة النقدية والتحليلية، استبدلنا مصطلح «الجنس البرهاني» بمصطلح «فصاحة البَيَان». والجدير بالذكر ان الفيلسوفة الفرنسية والمختصة في البلاغة باربارا كاسان كانت قد اشارت الى أهمية هذا التدشين الجديد من نوعه لبيرلمان في تاريخ الفكر البلاغي الغربي، ووصفت هذا البحث «بالكاشف». ولهذه الاعتبارات وغيرها، جاء عنوان هذا النص بـ: «بيان من اجل البلاغة الجديدة».
نأمل ان تمثل الأفكار التي سنعرضها في هذه الدراسة، مقدمة أولية لعمل يبدو لنا مهماً بما يكفي ليستحق ان نبذل كل جهودنا لتحقيقه. انها أفكار لم تتطور ضمن إطار حقل معرفي قائم بذاته؛ له خصائصه المتميزة بجلاء، واشكالاته ومناهجه المحددة تقليدياً.
فليس لديها بهذا السياق أي شيء تعليمي. ولغرض تعيينها، يمكننا القول انها تقع على حدود المنطق والسيكولوجيا. وموضوعها هو دراسة وسائل حِجاجية، على خلاف تلك التابعة للمنطق الصُّوري/الشكلاني، تمكننا من الحصول على تأييد* adhésion الآخر وزيادة تمسكه ودعمه لأفكار؛ آراء؛ أطروحات او لفرضيات نقترحها له للموافقة عليها.
وبقولنا: الحصول على التأييد وزيادته. إنما نشير، في واقع الامر، الى ان ‹‹التأييد›› هو قابل لأن يكون بشدة* intensité ذات درجات متفاوتة، مثلما تكون للموافقة مستويات متباينة، ويمكن لأطروحة تم قبولها سابقاً، ان لا تسود مقابل اطروحات أخرى قد تتعارض معها لاحقاً، عندما تكون شدة تأييدها ضعيفة. فأي تبدل لهذه الشدة يماثله، في وعي الفرد، تسلسل هرمي جديد للأحكام.
وقد يتضح مباشرة، ان دراستنا يمكن ان تشمل حالة شخص يتشاور مع نفسه، كحالة خاصة. بل ويمكن اعتبارها ذات أهمية أساسية. مع ذلك، يبدو من منظورنا الذي نتصور به عملنا البحثي، انها حالة تطرح علينا تحديات أكبر بكثير من تلك المتعلقة بالحِجاج مع الآخر.
لذلك، يجب علينا الاستفادة أكثر من التحليلات التي تتناول هذا الأخير وتمكن بدورها من ان تلقي بمزيد من الضوء على تلك الحالة.
في البداية، لم يكن يظهر لنا موضوع ابحاثنا بهذه الدقة – النسبية نوعاً ما بكل الأحوال – التي سنحاول تقديمه بها هنا. فقد كنا على قناعة راسخة بوجود حقل واسع للغاية، لم يتم استكشافه على نحو جيد، ويستحق دراسة ممنهجة وبمثابَرة. وانشغلنا، في الوقت نفسه، بالإحاطة بحدوده وتعريفه والشروع بتحقيقاتنا فيه. ورأينا ان انجاز هذا النهج الثلاثي الابعاد بشكل متزامن، يتناسب بشكل أفضل مع هدفنا.
كان يدفعنا حرص عالم المنطقٍ المنهمك في النضال مع مشاكل الواقع الاجتماعي. لذلك، كان بحثنا، ويبقى، متمركزاً حول تأييد الآخر الذي نحصل عليه باستخدام وسائل الحِجاج. ولهذا السبب سوف نستبعد منها، عن قصد، مجموعة كاملة من أساليب تعبير* procédés تمكن من الحصول على التأييد دون أن تستعمل الحِجاج بمعناه المناسب تحديداً.
اولاً وقبل كل شيء، سوف يتم استبعاد الدعوة للتجربة، خارجية كانت او داخلية. فمن دون شك، ليس هناك ما هو أكثر فاعلية مؤثرِة من القول للآخر: ‹‹انظر وسترى›› و ‹‹انتبه لنفسك وستشعر بذلك››.
إلا اننا لن نعتبره من الحِجاج البتة. فالتجربة الاوليّة غالباً ما تعتبر وسيلة اثبات غير كافية، ومعرضة للدحض من قبل أحد المتحاورين،
وبالتالي، فأن السؤال الذي سيطرح نفسه هو معرفة فيما إذا كان يجب الإقرار بالإدراك المتصوَّر موضع النقاش، كواقعة ام لا.
وهنا، سوف يلعب الحِجاج دوراً بارزاً فيما يتعلق بتأويلات الخبرة، وبالتأكيد ستكون اساليبه في التعبير التي تحمل الخصم على التثبُّت باليقين العقلاني/المنطقي، جزءًا من مجالنا الدراسي.
فهذا هو حال البائع عندما يزعم الدفاع عما يراه لمعان بياض لسلعة حيث يرى فيها المشتري انعكاسات صفراء؛ وبمجرد ان يعارض الطبيب النفسي حالة الهلوسة لمريضه، وحالما يعرض الفيلسوف أسباب انكاره للخاصية الموضوعية عن مفهوم المظهر.
اذن، سوف لن يتم وضع معيار محدد لما يُشكل الحقائق في الواقع مرة واحدة والى الابد. ولن نتبنى، على طريقة كانط، الفصل الثابت بين ما هو معطى للعقل وما يأتي منه.
وسيتم النظر لمساهمتنا في هذا الموضوع على انها قابلة للتغيير، ويمكن ان تكون موضوعاً لاستقصاء دائم بمقدار ما يتم فيه تحسين أدوات النقد الفلسفي، او ما تستدعيه نتائج البحث العلمي من إعادة مراجعة لمجال بعينه او لمجمل المعارف.
وبالتالي، فأن التمييز بين حقائق الواقع والتأويل بالنسبة الينا سوف ينتج عن الملاحظة، ومعياره سيكون عدم وجود اتفاق كافٍ بين المتحاورين والمناقشة التي تتلو ذلك.
هناك أساليب تعبير أخرى للحصول على التأييد، سوف يتم استبعادها أيضاً من دراستنا، وهي ممن تحدث ما نطلق عليه بالفعل المباشر، كالملاطفة او الصفعة، على سبيل المثال. لكن، بمجرد أن نستدل بالملاطفة او الصفعة، وحالما نتذكرها او نتوعد بها أحد، سنكون عنده بمواجهة أساليب تعبير في الحِجاج تتعلق بتحقيقاتنا.
لا شك ان مجمل هذه الاساليب التي نود دراستها يمكن لها، قد تكون موضوعاً لبحث سيكولوجي، نظراً الى ان النتيجة المرجوة من وراء هذه الحُجَج هي تشكيل حالة خاصة من الوعي، او شدة معينة من التأييد. ولكن ما يهمنا هو ان نتبين الجانب المنطقي،
بالمعنى الواسع للكلمة، لتلك الوسائل المستخدمة كأثبات للحصول على هذه الحالة من الوعي. وبهذا، يكون هدفنا مختلفاً عن الهدف الذي يقترح تحقيقه عالِم سيكولوجي منشغل بظواهر مشابهة.
هناك تمييز كلاسيكي يعارض وسائل التثبُّت باليقين العقلاني/المنطقي convaincre بتلك الخاصة بالإقناع persuader، فالأولى يُنظر اليها كعقلانية؛ والثانية كغير عقلانية، أحدهم يخاطب العقل*، والآخر يخاطب الإرادة.
بالنسبة للمعني بالنتيجة في المقام الأول، فأن الاقناع يزيد أهمية على التثبُّت باليقين، لان من شأن القناعة persuasion ان تضيف على اليقين conviction تلك القوة اللازمة لوحدها للإقدام على فعل عملي.
وعند مطالعتنا للموسوعة الاسبانية، سنجد انها تخبرنا، ان التثبُّت باليقين ليس سوى مرحلة أولى، فالأساس إنما يكون في الاقناع أي في مدى التأثير بالنفس حتى يتصرف المخاطَب بشكل متوافق مع اليقين الذي ننقله في رسالتنا الموجهة اليه.
ولننظر على وجه الخصوص الى الكُتاب الأمريكيين الذين سعوا جاهدين لتقديم نصائح، كانت سديدة في كثير من الاحيان، حول فن التأثير في العموم وكسب المشترين.
فرائد علم النفس التطبيقي والتر ديل سكوت يخبرنا، في كتابه (التأثير بالناس في تجارة الاعمال)، انه لا ينبغي الاجبار على التأييد باستخدام قياس منطقي يعمل كالتهديد بالسلاح. ‹‹فأي انسان سيُمضي على صك بألف دولار، إذا صُوب مسدس نحو رأسه، وجرى تهديده بالقتل في حال عدم امضاءه.
ومع ذلك، لن يكون عرضة للمحاسبة امام القانون للإيفاء بالمبلغ، لان الامضاء بالأساس تم بالإكراه. بالمثل، ان الشخص المحمول على الاقتناع تحت قوة المنطق وحدها، سيتجنب على الأرجح الاقدام على الفعل الذي يبدو انه مجرد نتيجة طبيعية ليقين تم الحصول عليه بهذه الطريقة››.
إن علم النفس المعاصر، بالنسبة لهؤلاء الكُتاب، وعلى خلاف النظرة التقليدية، قد أظهر ان الانسان ليس بكائن منطقي بل هو وجود نحو الإيحاء والتأثر suggestion.
وعلى العكس، بالنسبة لمن نشأ في تقليد يفضل العقلاني على غير العقلاني؛ والدعوة الى العقل على الدعوة الى الإرادة، سيكون التمييز بين التثبُّت باليقين العقلاني/المنطقي عن الاقناع هو امر أساسي. لكن، في الوقت نفسه، ستكون الوسائل، وليس النتائج، في محل تقدير، وسيتم منح الأولوية لليقين.
دعونا نستمع لما يقوله الفيلسوف بليز باسكال في مؤلفه (فن الاقناع): ‹‹لا أحد يجهل ان هناك سبيلين اثنين حيث تتلقى الروح من خلالهما الآراء، وهما قوتان جوهريتان فيها، وهنّ: العقل [مَلَكَة فهم حدسية] entendement والإرادة.
والأكثر طبيعية هي القوة الاولى، لأنه ينبغي على المرء ان لا يرضى ابدا إلا بالحقائق المثبتة بالبرهان، لكن القوة المألوفة أكثر بكثير، وإن كانت ضد الطبيعة، هي تلك المتعلقة بالإرادة؛ … هذا السبيل وضيع؛ مشين وغريب، ولهذا السبب يتبرأ منه الجميع.
فأي أحد لا يجاهر بالاعتقاد بشيء ولا حتى بمحبته إلا إذا كان على علم انه يستحقهما››.
ولنستمع معه أيضا لما قاله الفيلسوف ايمانويل كانط في مؤلفه (نقد العقل المحض): ‹‹الاعتقاد [بمفهوميه المنطقي والابستمولوجي للرأي والقبول] هو واقعة من صنيعة العقل [مَلَكَة فهمٍ حدسية وخطابية]، وقابلة للاستناد على مبادئ موضوعية، لكنه يتطلب كذلك توفر أسباب ذاتية لدى روح من يحكم بشأنه.
وعندما يكون الاعتقاد صالح المفعول عند جميع الناس، على الأقل بمقدار ما فيه من حقّ، يكون مبدأه لازماً من الناحية الموضوعية، وندعوه باليقين. اما إذا كان أساسه قائماً في الطبيعة الخاصة بالموضوع نفسه، نسميه بقناعة.
القناعة هي مجرد مظهر، لان مبدأ الحكم القائم في موضوعه فقط، هو من يكون لازماً موضوعياً. لذلك، هذا النوع من الاحكام لا يحمل سوى قيمة فردية، ولا يمكن ان نتناقل الايمان بها بين بعضنا البعض.
لا أستطيع ان أؤكد، أي، ان اعبر عنه بالقول انه حكم ضروري صالح المفعول للجميع، إلا من كان ناتج عن يقين. واظن انه يمكنني الاحتفاظ لنفسي بالقناعة إذا شعرت بالرضا حيالها، غير انني لا أستطيع، ولا يجب عليّ اظهارها وإن كنت خارج وعيي››.
جعل كانط مفاهيم اليقين؛ الموضوعية؛ العلم؛ العقل والواقع، على النقيض من مفاهيم القناعة؛ الذاتية؛ الرأي؛ الإيحاء والتأثر، والمظهر. بالنسبة اليه، كان اليقين هو، بلا شك، اعلى مرتبة من القناعة، ووحده من يكون قابلاً للتواصل المتبادل.
مع انه لو وضعنا الفرد بذاته في عين الاعتبار، لوجدنا ان القناعة تضفي شيئاً ما الى اليقين، بالاتجاه الذي تستحوذ فيه على وجوده بالكامل.
اذن، كان هناك سُمُوّ في منزلة اليقين عند العقلانيين، ومن وجهة النظر هذه، يمكن اعتبار باسكال عقلانياً. لكن، ما اعترض باسكال، وكانط كذلك فيما بعد، هي مشكلة تتعلق بالمكانة التي يجب ان تُمنح للمعرفة الدينية الغير الممكن، بالنسبة اليهما، ان تقع ضمن نطاق العقل. مما اضطره الى تدارك ازدراءه للقناعة بطريقة ما:
‹‹لا اتحدث هنا عن حقائق ربانية، حرصاً مني على ألا تقع تحت فن الإقناع، لأنها حقائق فوق الطبيعة الى اقصى الحدود، فالرب لوحده من يقدر على ان يهبها لمن يشاء من النفوس، وبالطريقة التي يرضاها. اعلم ان ارادته شاءت لها ان تدخل من القلب الى الروح، وليس من الروح الى القلب، كي تذل كبرياء تلك القوة الرائعة للاستدلال››.
إن قيل ان باسكال قد خفف من لهجة ازدرائه للقناعة. فيمكن للمرء المجادلة بالقول، ان هذا ليس هو الحال وانه، على العكس، أبرزها أكثر باستبعاده للحقائق الربانية من مجال الاقناع بشكل صريح.
أما امر تدخل إرادة الرحمة الربانية فيه، فلم يشكل ذلك الخرق الخطير للتسلسل الهرمي لمراتب اليقين-القناعة. والامر ذاته، لجأ اليه كانط في مكان آخر، وللسبب نفسه.
ويقابل هذه المشكلة التي اصطدم بها العقلاني المؤمن، مشكلة مماثلة امام العقلاني غير المؤمن، وهي تقع في مجال التربية والتعليم، أي في مجال احكام القيمة والمعايير. حيث يبدو من المستحيل فيه ان نقتصر على استخدام وسائل اثبات عقلانية بحتة، وعليه، هناك وسائل أخرى غيرها ينبغي علينا قبولها والاعتراف بها.
مع ذلك، تظل بالنسبة لجميع العقلانيين، حقيقة ان بعض أساليب انجاز عمل ذي مفعول مؤثر، هي أساليب غير لائقة بإنسان يحترم أبناء جنسه، ويجب ألا تستعمل، رغم انه غالباً ما يتم الاستعانة بها، وان ما تحدثه الروح من عمل في آليات التحكم الذاتي automate [لمجمل العمليات السيكولوجية التلقائية وعلاقتها مع التحولات الجسمية] هو الأكثر فاعلية مؤثرِة، كما يخبرنا باسكال.
اذن، إن الحس المشترك، والتقليد الفلسفي كذلك، يفرضان علينا نوعاً من التمييز بين التثبُّت باليقين العقلاني/المنطقي وبين الإقناع، والذي يعادل الفرق القائم بين الاستدلال والايحاء.
لكن، هل يمكن لهذا التمييز ان يرضينا؟ فضبط مواضع التعارض بين اليقين والقناعة، هي مسألة تتطلب تحديد وسائل اثبات نعتبرها يقينية، وأخرى نطلق عليها وسائل إقناعية، مهما كانت الزّخرفة المنطقية التي تتزيّن بها.
وعليه، إذا كنا متشددين في مطالبنا بخصوص طبيعة الاثبات، سوف نزيد من ميدان الإيحاء بنسب غير متوقعة. وهذا ما حصل مع الكاتب الهولندي بيرثهولد ستوكفيس في دراسة حديثة وموثقة على نحو واسع،
كانت مكرسة لسيكولوجيا الإيحاء والتأثر الذاتي، افضت به الى ربط كل حجَّة غير علمية بالإيحاء. وهذا هو الحال أيضا في العديد من الأبحاث المتعلقة بالدعاية البروباغندا حيث يكون الجانب العاطفي؛ الايحائي للظاهرة هو الجانب الجوهري ووحده من يؤخذ بعين الاعتبار.
وفي نهاية المطاف، فان أي مداولة في اجتماع؛ مرافعة؛ خطاب سياسي او ديني، وفي معظم العروض الفلسفية لن يمكنها العمل إلا عن طريق الإيحاء، وسيأخذ نطاق هذا الأخير بالامتداد ليشمل كل ما لا يمكن له الاستناد لا على التجربة؛ ولا على الاستدلال الصُّوري الشكلاني.
وعلى العكس من ذلك، إذا لم نكن متشددين كثيراً بخصوص طبيعة الاثبات، سيتعين علينا ان نصف بـ ‹‹المنطقية›› سلسلة حُجَج لا تلبي على الاطلاق الشروط التي يعدها المتخصصون في المنطق هي الضابطة لقواعد علمهم.
وهذا ما فعله أتباع التخصصات الأخرى في اغلب الأحيان. فرجل القانون الامريكي بنيامين كاردوزو، على سبيل المثال – المثير للشك في عدم رؤية الجانب المتقلِّب المتبدِّل في القانون والدور الذي يلعبه غموض مفاهيمه – يقول في مؤلفه (مفارقات علم القانون)،
ان ‹‹المنطق الاستنباطي›› ينطبق على مجموعات معينة في الاستدلال القانوني، ويبدو، حسب رأيه، ان التحديثات القانونية المبتكرة هي وحدها من تفضي لحُجَج غير منطقية، في حين ان الاستدلالات القائمة على التفسير القانوني التقليدي هي حُجَج منطقية.
بهذه الطريقة، يستعمل العديد من المتخصصين في القانون مصطلح ‹‹منطقي›› بمعنى واسع وغير دقيق. لكن اتساع مجال المنطق هذا، لم يعد منسجماً مع مفاهيم المنطق الحديث. فبدلاً من التركيز على الإيحاء بإفراط، تم التركيز على المنطق بالشكل الذي لم يعد علماء المنطق المعاصرين على استعداد لقبوله.
يقودنا هذا الاستعراض الى نتيجة مفادها ان التعارض بين اليقين – القناعة لا يمكنه ان يكون كافياً عندما نخرج عن اطر العقلانية الضيقة، ونقوم بفحص مختلف وسائل الحصول على تأييد العقول.
فسنلاحظ، عندئذ، ان هذا الاخير يتم الحصول عليه بواسطة طرق اثبات متنوعة لا يمكن اختزالها لا في الطرق المستعملة في المنطق الصُّوري الشكلاني؛ ولا في مجرد إيحاء.
في الواقع، يعود تاريخ تطور المنطق الى تلك اللحظة التي شرع فيها المتخصصون في المنطق بتحليل طريقة الاستدلال عند الرياضيين وذلك لغرض دراسة اساليب الاستدلال،
أي ان المفهوم الحالي للمنطق إنما جاء نتيجة لتحليل الاستدلالات المستعملة في العلوم الشكلانية والعلوم الرياضية، مما فرض على أي حُجَّة غير مستعملة في العلوم الرياضية ألا تظهر كذلك في المنطق الصُّوري الشكلاني.
إذا كان تحليل العلوم الشكلانية هذا مثمراً جداً، ألا يمكننا اجراء تحليل مماثل في حقول الفلسفة والقانون والسياسة وجميع العلوم الإنسانية؟ ألا يؤدي هذا الى تحييد الحِجاج المستعمل في هذه العلوم ودمجه في ظواهر ايحاء – مما يجعله متضمناً على بعض الشك عموماً – او ادماجه بالمنطق الذي يجب عليه بحكم الضرورة، لا سيما في بنيته الحالية، أن يتخلى عن هذا النوع من الاستدلالات؟
ألا يمكننا في تخصصات العلوم الإنسانية، ان نأخذ نصوصاً تعتبر تقليدياً هي نماذج للحِجاج، وان نستخلص منها، وبطريقة تجريبية، طرق استدلال نراها يقينية؟ صحيح ان الاستنتاجات التي توصلت اليها عروض هذه النصوص،
لا تتمتع بنفس القوة الإلزامية التي تحملها استنتاجات الرياضيين، لكن أعلينا، لهذا السبب، القول انها استنتاجات لا تتوفر على شيء من هذه القوة، ولا توجد وسيلة لتمييز قيمة الحُجَج لخطاب جيد او سيء، لمقالة في الفلسفة من الطراز الأول او إنشاء طالب مبتدئ فيها؟ أليس في الامكان تنظيم هذه الملاحظات المقدمة بهذه الطريقة واضفاء الطابع المنهجي عليها؟
بعد ان باشرنا بتحليل الحِجاج في عدة اعمال فلسفية على الخصوص، وفي بعض خطابات معاصرينا، أدركنا، اثناء اشتغالنا، ان الأساليب التي عثرنا عليها كانت في معظمها، هي الأساليب نفسها في كتاب البلاغة لأرسطو. فعلى أيَّة حال، كانت اهتمامات هذا الأخير قريبة بشكل غير مألوف من تلك الخاصة بنا.
وقد مثل هذا بالنسبة لنا مفاجأة مذهلة وكشف جديد على حد سواء. ففي الواقع، اختفت كلمة ‹‹البلاغة›› عن معجم المصطلحات الفلسفية بالكامل. ولم نعثر عليها في موسوعة لالاند الفلسفية في الوقت الذي عرضت فيه، وعلى النحو الواجب، للعديد من المصطلحات المتعلقة بالفلسفة او لتلك التي على وشك الخروج من الاستعمال تقريباً.
بل ان مصطلح ‹‹البلاغة›› في جميع الحقول، يعد مصطلحاً مثيراً للشُّبهة والارتياب، ويقترن عموماً ببعض الازدراء. حتى أن الكاتب الاسباني بيو باروخا عندما أراد وصف النزعة الهزلية المفضَّلة لديه، لم يجد نقيضا آخر ليعارضها به على مدار خواطره المفعمة بالحرارة في روايته (كهف الهزل)، أكثر ملائمة من ‹‹البلاغة›› المُزخْرُفة الجامدة.
على الرغم من اننا لم نفتقر لرسائل في البلاغة خلال المائة عام الماضية. إلا ان مؤلفيها كانوا يعتقدون انه يتعين عليهم الاعتذار في مقدمتهم عن تكريس جهودهم لموضوع لا يستحق ان يُوضع في الحُسْبَان بتاتاً.
ولم يخفى على الدوام انه لا يوجد سبب آخر لتقديمه، سوى أنها مادة تخضع للتدريس. فبدون الحماية الرسمية للقوانين الجامعية لاندثرت البلاغة اليوم، حسب الأكاديمي الفرنسي يوجين ماغني في تصديره لكتابه (البلاغة في القرن التاسع عشر) في عام 1838.
وعلاوة على ذلك، نجد أن مؤلفيها، في معظم الأحيان، لا يعرفون جيداً مِمَّ يتكون موضوع بحثهم، والكثير منهم يخلطون، دون سبب او مبرر، بين دراسة القياس المنطقي وبين تلك المتعلقة بصور الاسلوب التعبيرية figures de style.
هذا لا يعني انهم كانوا جميعاً يفتقرون للذائقة العلمية؛ او للثقافة، او البصيرة، لكن يبدو ان الهدف من مساعيهم كان يفلت من بين أيديهم.
آخر هؤلاء المؤلفين ممن أسهموا بشيء بنّاء في البلاغة، هو رئيس الاساقفة الانجليزي ريتشارد واتلي الذي كان عليه ايضاً تقديم الاعتذار للجمهور في مقدمة كتابه (عناصر البلاغة) الصادر عام 1828.
لكنه اعتذار تضمن على عبارات تدعونا للتأمل والتفكير. وسنرى كيف يمكنها ان تحثنا على المثابرة في ابحاثنا. واليكم كيف عبر عن ذلك واتلي:
‹‹كنت قد اعتقدت انه من الأفضل عموماً الاحتفاظ بعنوان ‹‹البلاغة›› على النحو الذي تم به تعيين مقالنا في موسوعة متروبوليتانا البريطانية في وقت سابق، على الرغم من ان بعض نواحيه تخضع للاعتراض.
فإلى جانب استخدامه الأكثر شيوعاً في الإحالة الى الخِطابة في العامة منفرداً، فمن المرجح أيضا انه يستدعي لدى كثير من العقول فكرة تقترن بادعاء فارغ او بحيلة مضللِة.
في الواقع، لعل موضوع البلاغة يعلو على المنطق لكن ببعض درجات فقط حسب التقدير الشعبي، فأحدهما عادة ما ينظر اليه العاميّ كَفن إرباك المتعلمين بحذلقة طائشة؛ والى الآخر كَفن خداع الجماهير بأكاذيب خادعة››.
لكننا اليوم، أصبحنا على علم بكيفية تطور المنطق خلال المائة عام الأخيرة، وذلك بتوقفه عن ان يكون مجرد تكرار لصيغ قديمة بَطُل استعمالها، وكيف أصبح أحد الفروع الأكثر حيوية وتوقّداً في الفكر الفلسفي.
ألا يحق لنا، اذن، أن نطمح بالاستعانة في دراسة البلاغة بالمنهج نفسه الذي نجح في المنطق، أي بالمنهج التجريبي، من اجل الوصول الى إعادة بناء البلاغة وجعلها مثيرة للاهتمام؟ وسنوضح فيما بعد الأسباب التي تبرر لاعتقادنا في أن الوضع الراهن للأبحاث الفلسفية وما بلورته من مفاهيم جديدة، يساعد بشكل خاص على الشروع بمثل هذا العمل.
لنعد قليلاً لأرسطو ولكتابه البلاغة الذي، وكما قلنا، يقترب فيه لحد كبير من اهتماماتنا الخاصة. فبينما انشغل ارسطو في كتابه التحليلات بالاستدلالات المتعلقة في الما هو صائب، الضروري على الخصوص، نراه يخبرنا أن ‹‹وظيفة البلاغة هي التعامل مع موضوعات علينا ان نتداول بشأنها والتي لا نملك عنها أي تقنيات،
وذلك امام مستمعين لا يتوفرون على مَلَكَة الاستنتاج على عدة مستويات، ولا على مَلَكَة متابعة استدلال من نقطة بعيدة المدى››.
إذن، ان للبلاغة، حسب ارسطو، سبباً للوجود يكمن إما في جهلنا بطريقة الأداء التقنية في معالجة موضوع معين؛ وإما في عدم مقدرة المستمعين على الاصغاء بشكل متواصل لمسار استدلال معقد بعض الشيء.
والغرض منها، في الواقع، هو تمكيننا من دعم آراءنا وجعلها مقبولة من قبل الآخرين. أي ان موضوع البلاغة لا يتعلق فيما هو صائب، وإنما فيما يمكن تصوره opinable [وتبادل الآراء حوله كموضوع غير يقيني؛ قابل للحوار والنقاش ولصياغة تصورات جديدة بناء عليه] الذي خلط ارسطو بينه وبين الما هو محتمل الصواب vraisemblable في مواضع من كتبه البلاغة؛ الطوبيقا والتحليلات الأولى.
لاحظوا على الفور، كيف ان هذا التصور الذي شيد البلاغة على الجهل والاحتمال probable في حال انعدام وجود الصواب واليقين معاً – والذي لم يفسح المجال لحكم القيمة – قد وضعها، منذ البداية، في حالة متدنية ستفسر لنا تقهقرها فيما بعد.
فبدلاً من الانشغال بالبلاغة والآراء المضللة، صار من الأفضل البحث عن الحقيقة بمساعدة الفلسفة؟ إن الصراع بين المنطق والبلاغة هو استبدال، على مستوى آخر، لموضع المعارضة بين الصواب αλήθεια والرأي δσξα التي كانت هي السمة المميزة للقرن الخامس قبل الميلاد.
إن ادخال مفهوم حكم القيمة valeur سوف يؤدي بنا الى تغيير منظور المشكلة نفسها، وهو أحد الأسباب الذي يدفعنا اليوم الى بذل قصارى جهدنا من اجل استئناف دراسة البلاغة من جديد.
علاوة على نزوعنا للاعتقاد انه يمكن لهذه الدراسة ان تسلط الضوء على مفهوم حكم القيمة نفسه الذي اكتسبت معه المدينة اليونانية الحقّ في التفلسف بشكل نهائي، رغم انه كان من المتعذر معه التوفر على سمات مميزة يمكن ان ترجح التوصل لاتفاق نهائي تام.
وفي كل الأحوال، فقد بدَّل هذا المفهوم من معطيات الصلة الهرمية بين المنطق – البلاغة، ولم يعد يسمح بحالة تبعية الثانية للأول. وسنرى ايضاً أن هناك نتائج أخرى مترتبة على إدخال مفهوم حكم القيمة في المداولات.
فهو من سيساعدنا، في المقام الأول، في الكشف عن الصعوبات التي واجهها القدماء وتوضيح مبرراتها التي دعتها مشكلة فهم الاجناس الخطابية.
في الواقع، كان هناك ثلاثة اجناس خطابية للفصاحة عند القدماء، وهي: التشاورية؛ القانونية، وفصاحة البَيَان* épidictique. الأولى تتعامل مع ما هو نافع وتهتم بالحصول على تأييد المجالس السياسية وكسب دعمها؛ والقانونية تتصدى لكل ما يتعلق بالعدل وتُعنى بالحِجاج امام القضاة.
أما فصاحة البَيَان، كما تم عرضها في خطاب المديح عند الاغريق او في خطاب التأبين عند اللاتينيين، فهي تركز على الثناء والذم؛ الجميل والقبيح، لكن ما هو الهدف الذي تسعى اليه؟ وهنا وجد القدماء أنفسهم لا سيما من البلاغيين الرومان، أمثال شيشرون، في حرج كبير.
نلقى صداه عند كوانتيليان. فقد رأى هذا الاخير، خلافاً لأرسطو، ان فصاحة البَيَان لا تقف عند حدود إرضاء المستمعين فقط، لو لم تكن حُجَجها ضعيفة ومحرجة، ورأى على الأخص ان وجود هذا الجنس من الفصاحة ‹‹يُظهر جيداً خطأ الذين يظنون ان الخطيب لا يتحدث ابداً سوى عن قضايا مشكوك فيها››.
بالنسبة للعصور القديمة – باستثناء تقاليد كبار السفسطائيين – فلا شيء، في واقع الامر، أكثر وثوقاً من التقييم بالمعيار الأخلاقي. وفي حين تفترض كل من الفصاحتين التشاورية والقانونية وجود خصم، وبالتالي وجود نزاع، وترمي للحصول على قرار بشأن قضية مثيرة للجدل، وقد سبق وان جرى تبرير استعمال البلاغة فيهما سواء بالجهل او بعدم اليقين.
اذن، كيف يمكننا ان نفهم فصاحة البَيَان التي تُعنى بأشياء يقينية؛ لا جدال فيها، ولا ينكرها اي خصم؟ لم يستطع القدماء أن يروا في هذا الجنس من الفصاحة غير انه جنس لا يركز على الما هو صائب، بل على احكام للقيمة نؤيدها ونتمسك بها بدرجات متفاوتة من الشدة.
لذلك، من المهم دائماً تعزيز هذا التأييد، وإعادة إيجاد صلة التشارك communion حول القيمة المقبولة. هذا التشارك، وإن لم يعين خياراً فورياً، فأنه يحدد خيارات افتراضية كامنة بالقوة.
إن الصراع الذي ينخرط فيه خطيب فصاحة البَيَان هو بالأحرى صراع ضد اعتراضات مستقبلية، انه مجهود يبذله للحفاظ على مكانة بعض احكام القيمة في التسلسل الهرمي او ربما لمنحها وضعاً شرعياً أفضل.
وبهذا الصدد، فأن لخطاب الثناء الطبيعة نفسها للنصح التربوي من أكثر الآباء تواضعاً. لذلك، يعتبر جنس فصاحة البَيَان هو جنس محوري في البلاغة.
ولان القدماء لم يتمكنوا من تمييز هدف واضح لخطاب فصاحة البَيَان، فقد كان لديهم نزوعاً لاعتبارها كنوع من العرض المشهدي يرمي لإمتاع المتفرجين وعُلوّ مجد الخطيب بتسليط الضوء على البراعة التقنية لأسلوبه.
حتى أصبحت هذه الأخيرة، هي الهدف في حد ذاتها. ويبدو أن ارسطو نفسه لم يميز في فصاحة البَيَان سوى الملمح الزّخرفي؛ الفخم.
ولم يدرك أن المقدمات المستنِدة عليها الخطابات التشاورية والقانونية التي كانت تبدو أهدافها بالنسبة له في غاية الأهمية، هي احكام للقيمة. والحال هذا، يجب على خطاب فصاحة البَيَان ان يدعم هذه المقدمات وان يعززها.
وهذا هو دور الثناء والخطابات المعهودة التي تهدف الى التوجيه التربوي للأطفال. فهدفها جميعاً هو نفسه على كل المستويات.
ونعثر على الاحراج ذاته إزاء فصاحة البَيَان عند رئيس الاساقفة الانجليزي ريتشارد واتلي. وهذا ليس مستغرباً. ففي كتابه (عناصر البلاغة)، وجه النقد لأرسطو على إسناده أهمية أكثر مما ينبغي لهذا الجنس من الفصاحة التي ليس لديها هدف سوى اثارة الاعجاب بالخطيب.
وفي هذا الموضع، كان كاتبنا واتلي حريصاً، بالطبع، على عدم الجمع بين الثناء والوعظ الديني.
لا شك في انه يمكن لخطاب فصاحة البَيَان ان يكون عاملاً مؤثراً في إبراز الشخص الذي يُلقيه. فهذا ما يحدث غالباً. لكن، أن نجعل منه الهدف من الخطاب أيضاً، ففي هذا مخاطرة نعرض فيها أنفسنا للسخرية. وهو ما عبر عنه، بوضوح، الاديب جان دو لا برويير في كتابه (الطبائع):
‹‹إن الشخص الذي يستمع لخطبة دينية، يقيم نفسه حَكَمَاً على الشخص الواعظ ليدينه او ليصفق له؛ فلم يعد مهتدياً بالخطاب المفضل لديه بأكثر من ذلك الذي يخالفه›› – ويتابع لا برويير بتهكم كبير– ‹‹ لقد تأثر المستمعون واهتزَّت قلوبهم لموعظته الى حدّ الإقرار من صميم اعماقهم، ان خطبة ثيودور هذه، لعلها أكثر جمالاً من آخر مرة بشر بها››.
ومما لا شك فيه ان الخطيب هو الذي يكون محطَّ الاهتمام اثناء القائه لخطبته، ويمكن له ان يحظى على بعض من المجد. لكن، عندما ننظر عن كثب، سنرى انه لغرض إلقاء خطاب في فصاحة البَيَان يمكن ان تمنح لصاحبه هذا المجد،
يجب على الخطيب ان يكون بالفعل محل اعتبار مُقَيَّم مُسبَّقاً، وهو اعتبار يُعزى لشخصه او لمهنته. أما ان رغب أي أحد كان بهذا، فعليه ان لا يتوقع القاء خطبة ثناء دون ان يكون مثيراً للسخرية او للخزي.
وبينما لا نطلب من شخص تبرير قيامه بالدفاع عن بريء او بالدفاع عن نفسه، لكننا سنسأل الشخص الذي يود القاء خطبة تأبين، ما هي الصفة التي تؤهله لأن يكون جديراً بالقيام بذلك؟ مع انه يكفي، بكل تأكيد، ان تكون الصفة قائمة في نظر المستمعين،
مهما كان صغر الحجم الذي تظهر لهم فيه بشكل موضوعي. بالمثل، فأن الطفل الذي يرغب ان يعطي درساً في الاخلاق لأخوته الأكبر منه، عليه ان يتحمل سخريتهم منه بالكامل.
اذن، إذا كان غالباً ما يؤدي خطاب فصاحة البَيَان الى منح المجد للخطيب، فهذا لأنه يحمل غاية أخرى، تماماً مثلما لا يمكن للبطولة أن تفضي بصاحبها لصيت الشهرة والافتخار إلا لوجود غاية أخرى لهذه البطولة.
وهنا، نقترب من مشكلة عامة تتعلق بالتمييز بين الغاية [ضمن ثنائية الغاية والوسيلة] والنتيجة [ضمن ثنائية السبب والنتيجة]، وهو تمييز أساسي في مجال الحِجاج البلاغي سنعود اليه لاحقاً.
ولقد شجع سوء الفهم هذا لدور فصاحة البَيَان ولطبيعتها – وهو امر، علينا ألا ننسى، انه كان قائماً بالفعل، وما يزال علينا، بالتالي، توجيه الانتباه اليه – على تعزيز اعتبارات أدبية في البلاغة، رجحت، من بين أسباب أخرى، تنازع البلاغة بين اتجاهين اثنين، الأول فلسفي يهدف الى ان يدمج في المنطق تلك المناقشات المتعلقة بالمسائل المثيرة للجدل.
لأنها مسائل غير يقينية يحاول فيها كل واحد من الخصوم ان يظهر ان رأيه فيها هو الصائب او المحتمل الصواب. أما الاتجاه الآخر فهو أدبي يهدف الى تطوير الجانب الفني للخطاب وينشغل خصوصاً بمشاكل التعبير.
يمر الاتجاه الأول عبر بروتاغوراس وارسطو القائل في كتابه (البلاغة): ‹‹الصواب وما يشابهه ينحدران في الواقع عن المَلَكَة نفسها؛ فالطبيعة، على اية حال، قد وهبت البشر بما يكفي من البراعة من اجل البحث عن الصواب، وهم يبلغون الحقيقة في أكثر الأحيان››، وصولاً الى الاسقف الانجليزي ريتشارد واتلي.
اما الاتجاه الثاني فيمر عبر إيسقراط ومعلمونا في الأسلوب وصولاً الى جان بولان في مؤلفه (ورود حديقة الطارب او الرعب في الآداب) والى إيفور آرمسترونغ ريتشاردز في اعماله (منسيوس في العقل) و(فلسفة البلاغة).
واثناء تنازع البلاغة بين هذين الاتجاهيين، نلاحظ، وبطريقة ما، وجود مظهر من مظاهر التجاوزات والتعدي من قبل المنطق والإيحاء والتأثر على مجال الحِجاج الذي نهتم به.
وبعد ان اوضحنا العلاقة القائمة بين اهتماماتنا وبين البلاغة المنشودة عند أرسطو حسب تصورنا – مع انه يميل فيها الى منطق الما هو محتمل الصواب – سوف نلجأ من الان فصاعداً الى استعمال مصطلح ‹‹بلاغة›› لتعيين ما يمكننا ان نطلق عليه ايضاً بمنطق المُفَضَّل.
ونشير، كما ذكرنا في أعلاه، الى اننا لا نرى من المفيد لنا في الوقت الحالي الاهتمام بكل العوامل التي تؤثر في الحصول على الموافقة، والى أن هدفنا سيكون في بعض النواحي محدوداً أكثر من ذلك الهدف المتضمن في كتاب (البلاغة) لأرسطو.
دون أن ننسى أن بعض فصول هذا الكتاب تنتسب بوضوح اليوم الى مجال السيكولوجيا.
أما نحن، نكررها للمرة الثانية، فنريد دراسة الحُجَج المدعوون بواسطتها لتأييد رأي معين والتمسك به دون آخر. ويكفي أن نطالع الأبحاث المعاصرة لنرى أن جميع الذين انشغلوا بالحِجاج في المجال الأخلاقي او الجمالي، لم يمكنهم حصر الحِجاج في طرق إثبات معتمدة في العلوم الاستنباطية او التجريبية.
فأضطرهم هذا الى توسيع نطاق كلمة ‹‹إثبات›› لتشمل ما ندعوه بطرق إثبات بلاغية. وسوف نكتفي بذكر عملين متميزين بهذا الصدد، اخترناهما تحديداً لانهما يتصلان بمشكلة بحثنا بشكل وثيق للغاية.
أحدهما هو كتاب (أسس علم معايير الاخلاق) للسوسيولوجية ماريا اوسواسكا التي حللت فيه بدقة سؤال طرق الإثبات المتعلقة بالمعايير الأخلاقية، دون ان تتمكن من حسم امرها نهائياً في عدم إمكانية بناء هذه المعايير داخل قيمة نظرية مثالية مطلقة، مما جعلها تصطدم بما اعتبرته ‹‹طرق إثبات كاذبة›› او ‹‹طرق إثبات زائفة››.
أما العمل الآخر فهو (الاخلاق واللغة) للفيلسوف تشارلز ستيفنسون الذي رأى فيه ضرورة الاعتراف ‹‹بطرق إثبات بديلة›› التي تكون فيها أنماط النقاش الأخلاقي على صلة مباشرة بموضوع بحثنا.
اذن، لأننا كنا مرغمين على توسيع معنى كلمة ‹‹إثبات›› بمجرد ما أن نتعامل مع علوم إنسانية، حملنا هذا الى تضمينها كل ما هو ليس بإيحاء محض وبسيط، سواء كان الحِجاج المستعمل يقع ضمن نطاق المنطق او البلاغة.
غير انه، ومن خلال جعلها مقابلاً للمنطق، سنكون قادرين بشكل أفضل على تمييز وسائل إثبات بعينها سنطلق عليها طرق إثبات بلاغية. دعونا نشير الى بعض أوجه هذا التعارض.
تختلف البلاغة، بمفهومنا لمعنى الكلمة، عن المنطق من واقع انها لا تهتم بالحقيقة المجردة، سواء كانت حملية قطعية او شرطية افتراضية، وإنما تهتم بالتأييد.
وهي تهدف الى إحداث التأييد أو تعزيزه عند جمهور مخاطَب معين لبعض من الطروحات؛ القضايا؛ الأفكار او الآراء، ونقطة انطلاقها تبدأ عندما يأخذ هذا الجمهور بتأييد طروحات؛ قضايا؛ أفكار؛ اراء أخرى.
(ونشير هنا لآخر مرة، إذا جاء قاموسنا الاصطلاحي على استعمال مصطلحات ‹‹خطيب/متكلم/مخاطِب››؛ ‹‹جمهور مستمع/جمهور مخاطَب››* auditoire، فهو لتيسير الرجوع اليها خلال العرض، فيجب، اذن، أن ندرج تحت هذه المصطلحات جميع نماذج التعبير اللفظي، الشفاهية منها والمكتوبة).
وحتى يمكن تطوير الحِجاج البلاغي، يجب على المتكلم ان يمنح اولوية كبيرة لمسألة تأييد الآخر، ويجب أن يحظى الشخص المتحدث بثقة الذين يخاطبهم، لأنه ينبغي للشخص الذي يقوم بوضع فرضيته وتدعيمها؛ والشخص المراد كسب تأييده، أن يشكلان معاً بالفعل جماعة مشتركة communauté، وهو نابع من واقع انخراط العقول في الاهتمام بنفس المشكلة.
فالدعاية البروباغندا، على سبيل المثال، تستلزم أن نعلق أهمية كبرى على التثبُّت باليقين العقلاني/المنطقي، لكن يمكن لهذا الاهتمام أن يكون من جانب واحد فقط، فليس بالضرورة ان يكون لدى الشخص المستهدف في الدعاية، الرغبة بالاستماع.
وعليه، في المرحلة الأولى، وقبل الانخراط في الحِجاج فعلياً، سيتوجب علينا الاستعانة بالوسائل اللازمة لجذب الانتباه، وعندها سنكون على عتبة البلاغة.
إن مسألة إثارة اهتمام الآخر بموضوع معين، في حد ذاتها، قد تتطلب مسبقاً الى بذل جهود كبيرة في الحِجاج. ولننظر، على سبيل المثال، الى الشذرة الشهيرة في مؤلف (أفكار) التي كان يحمل فيها الفيلسوف باسكال القارئ على اليقين بأهمية مشكلة خلود الروح.
وعندما نتساءل، هل فعلاً يستحق الامر أن نستمع اليه ام لا؟ فهذا موضوع للمناقشة يمكن أن يستدعي نفسه لحِجاج يبرر الشروع فيه، وهكذا، بالانتقال من شرط مسبّق الى شرط مسبّق آخر، يبدو ان على النقاش ان يعود تباعاً الى ما لا نهاية.
لهذا السبب، تكون لدى أي مجتمع منظم بشكل جيد سلسلة من الإجراءات المتبعة بهدف اتاحة المجال للمباشرة في النقاش، أما المؤسسات السياسية والقانونية والتعليمية فهي من تعمل على توفير شروطه الموضوعية المسبّقة.
ولهذه المؤسسات ميزة أخرى، كذلك، تتعلق بكونها تعزز من انخراط المشاركين فيها قدر الإمكان، فالمؤسسات الدبلوماسية، مثلاً، تسمح بتبادل وجهات نظر من شأنها ان تهدد بدرجة كبيرة أولئك الافراد الذين لم يكن تعيينهم فيها على أساس الكفاءة بالوظيفة.
بما إن الحِجاج البلاغي يهدف الى الحصول على التأييد، فهو يعتمد اساساً على الجمهور المخاطَب الذي يتوجه اليه بالخطاب، لأن ما يكون مقبولاً من جمهور معين، لن يكون كذلك من قبل جمهور آخر،
وهذا لا يشمل مقدمات الاستدلال فحسب بل وكل رابط وصل فيه، ويشمل ايضاً الحكم نفسه الذي يتمحور على الحِجاج بأكمله. ونتطرق في هذا المقام الى بعض المسائل الرئيسية.
فغالباً، ما تكون ما يدعوها بعض الكُتاب أمثال السوسيولوجية ماريا اوسواسكا بــ ‹‹حُجَّة زائفة››، هي حُجَج تنتج مفعولاً ولا ينبغي عليها ان تحدثه حسب اعتقاد الباحث الذي يدرسها، لان هذا الاخير ليس جزءاً من الجمهور الذي تقصده تلك الحُجَج بالخطاب.
قد لا يكون المتكلم نفسه جزءاً من هذا الجمهور. غير أنه من الممكن، في الواقع، أن نسعى للحصول على التأييد بالاستناد لمقدمات لا نسلِّم أنفسنا بصلاحية مفعولها.
وهذا لا ينطوي على أي نفاق، لأننا ربما كنا على يقين من حُجَج أخرى غير تلك التي يكون الأشخاص الذين نخاطبهم على يقين بها.
وكوانتيليان نفسه، رجل القانون باحتراف، لم يستطع تجاهل هذا الامر، لكن باعتباره مربٍ حريص على أن يجعل من المؤسسة الخِطابية oratoire مدرسة لإعداد القوى الجسدية/الجمالية/الأخلاقية [وفصاحتها التي تصنع قيمة الانسان] vertu،
كان يعتقد أنه ينبغي عليه أن يبذل قصارى جهده للتوفيق بين هذه المتطلبات الثلاثة التي كان يخشى تناقضها رغم ذلك، وهي: فصاحة القوى الجسدية/الجمالية/الأخلاقية للخطيب؛ الصراحة، ومرونة التأقلم مع طبائع الشخصيات المختلفة للمخاطَبين.
في الحقيقة، يمكن للمفكر الحرّ أن يشيد بالكرامة الإنسانية ببراعة أمام مخاطَبين كاثوليك بمساعدة حُجَج تستند على التقليد الروحي للكنيسة، بينما لم تكن هذه الحُجَج مثيرة لإعجابه هو نفسه. ويمكننا ايضاً، من جانب آخر، أن نكون على يقين مما هو بديهي.
وعليه، إذا لم يكن من الضروري ممارسة البلاغة عندما يبدو ان بداهة الامر الواقع تفرض نفسها على الجميع، فيجب عليها ان تتدخل عندما يعترف واحد من المتحاورين فقط بتلك البداهة، ويستند اليها في تبرير يقينه. وليس في هذا، كذلك، أي نفاق.
ان الجزء المهم في البلاغة، والمستند كلياً على مفهوم الاتفاق المقترن بمفهوم مخاطَبين محددين، سيكون هو الخاص بتلك الأدلة الاثباتية التي يقرّها الخصم صراحة قبل الشروع بالمناقشة.
وانطلاقاً من حقيقة انه هو نفسه من يشترط وجود هذه الأدلة ويطلبها، فالمحاور يوافق، بهذا، على صفتها الثبوتية القاطعة، وعلى منحها قيمة بارزة.
ويمكن للمتكلم الاستفادة من هذا. وهو ما قام به رجل اعمال أمريكي حكيم – حسب الكاتب ديل كارنيجي– عندما طالب خصومه بوضع اعتراضاتهم على السبورة مسبقاً، قبل المباشرة في نقاش هام.
فالمطالبة بحُجَج محددة هو بمثابة منح شروط التأييد. وهنا، نحن نكون داخل مجال مميز في الحِجاج البلاغي.
يوجد نوعين من المخاطبين يستحقان عناية خاصة بسبب اهميتهما الفلسفية. الأول هو الذي يتألف من شخص واحد، والآخر مكوَّن من البشرية جمعاء.
عندما يتعلق الامر بالحصول على موافقة شخص واحد، فلا يمكننا، بحكم الضرورة، استعمال تقنية الحِجاج نفسها التي نستعين بها امام جمهور كبير. ويجب التأكد، في كل خطوة، من اتفاق الشخص المحاوِر بطرح الأسئلة عليه، والإجابة على اعتراضاته؛ فيتحول الخطاب الى محاورة.
هذه هي التقنية السقراطية المتعارضة مع تقنية بروتاغوراس، وهي أيضاً الأسلوب الذي نستعمله عندما نتداول مع أنفسنا بمفردنا، وننظر في إيجابيات الحلول الممكنة وسلبياتها، ونحن في موقف حرج.
يقوم الوهم الذي ينتجه هذا المنهج على حقيقة أن تسليم الشخص المحاوِر بصحة كل رابط وصلٍ في الحِجاج، يجعله يصدق انه لم يعد في مجال الرأي بل في مجال الحقيقة vérité، وانه على يقين من أن العبارات التي يقدمها هي ذات أساس راسخ بقوة أكبر بكثير منه في الحِجاج البلاغي حيث لا يمكن ان يقيم الإثبات على كل حُجَّة فيه.
وقد ساهم فن افلاطون في شيوع هذا الوهم، والى مطابقة الجدل مع المنطق في العصور اللاحقة، أي انه عزز من تقنية تركز على الما هو صائب، وليس على الما هو ظاهر كما تفعل البلاغة.
بهذا الشكل، أصبحت سمة الجمهور المخاطَب الكوني auditoire universel أنه لا يكون ابداً واقعاً موجوداً في الزمن الحاضر، وبالتالي، فهو غير خاضع للشروط الاجتماعية والسيكولوجية للبيئة المحيطة؛ انه بالأحرى مثالي،
ونتاج خيال المؤلف، وأنه لغرض الحصول على تأييد مثل هذا الجمهور، لا يمكننا أن نستعمل معه إلا تلك المقدمات المقبولة من قبل الجميع او على الأقل من قبل هذا الجمع المفرط في النقد؛ والمستقل عن ظروف الزمان والمكان، والذي من المفترض ان نتوجه اليه بخطابنا.
وصار لزاماً على المؤلف نفسه ان يلتحق بهذا الجمهور الذي لن يكون على يقين إلا بحِجاج يدعي الموضوعية؛ ويستند على ‹‹حقائق››؛ على ما يعتبر صائباً، وعلى قيّم مسلَّم بها كلياً.
وهو حِجاج من شأنه ان يسبغ على عرضه طابعاً علمياً وفلسفياً، ولا يتوفر على حُجَج موجهة لمخاطَبين أكثر خصوصية وتحديداً.
لكن، مثلما يحدث في كثير من الأحيان، عندما يكون لدينا العديد من المحاورين في وقت واحد، واثناء نقاشنا مع أحد الخصوم، نحاول ان نجعل الحاضرين في النقاش على يقين من حُجَجِنا أيضاً،
لابد وأن نصادف الجمهور المخاطَب الكوني الذي نفترض التوجه اليه بخطابنا، عند مخاطَب معين نعرفه وذلك لا سيما وهو يتجاوز على عدة اختلافات نعرفها وعلى وعي بها في الوقت الحالي.
لقد عملنا بأنفسنا على تصنيع انموذج لإنسان – هو تجسيد للعقل؛ وللفلسفة، وللعلم بشكله الخاص الذي يعنينا – نسعى لجعله في حالة من اليقين، ولأن يتمكن بالمعرفة التي نصيغه بواسطتها، وبما نسلّم به من وقائع لا تقبل الجدل وحقائق موضوعية،
من أن يكون انساناً مختلفاً عن أناس آخرين، وحضارات أخرى، وعن أنظمة تفكير أخرى. ولهذا السبب، ايضاً، يكون لكل عصر؛ وثقافة؛ وعلم، وحتى لكل فرد جمهوره المخاطَب الكوني.
عندما نزعم مخاطبة مثل هذا الجمهور، يمكننا ان نستبعد منه دائماً بعض الافراد الذين يرفضون التسليم بصحة حِجاجنا، وذلك عن طريق وصفهم بأنهم غير اسوياء او معتوهين وينبغي علينا الكفَّ عن حملهم على اليقين.
فنحن نحكم على الافراد تبعاً لأحكام قيمية تصدر عنهم، ونحتفظ لأنفسنا ايضاً بحق الحكم عليهم وفقاً للقيمة التي ينسبونها لحِجَاجنا.
ومع ارتفاع سقف مطالبنا، تجاوزنا، في الواقع، المخاطَب الكوني ومضينا نحو مخاطَب نخبوي. هكذا، أقرَّ باسكال للناس الصالحين فقط إمكانية فهم النبوءات كما ينبغي، اما: ‹‹الأشرار الذي ظنوا ان خيرات ربهم الموعودة مادية،
فَضَلّوا رغم وضوح زمن النبوءة، اما الاخيار فلم يضلّوا. وذلك لان فهم الخيرات الموعودة إنما يرجع للقلب الذي يدعو ربه ‹‹حقاً›› بما يشاء، أما فهم زمن النبوءة الموعود فلا يرجع للقلب ابداً››.
إذا كانت السمات المميزة لشخصية المخاطَب ذات أهمية رئيسية في الحِجاج البلاغي، فإن رأي المخاطَب في المتكلم يلعب دوراً مماثلاً في الأهمية، بينما في المنطق فهو لا يتدخل من الأساس.
اذ من غير الممكن للحِجاج البلاغي التغافل عن مسألة التفاعل المتبادل interaction بين كل من رأي المخاطَب في شخص المتكلم والرأي الذي لديه في أحكام وحُجَج هذا الأخير.
وما نطلق عليها بكفاءة compétence يتلازم معها تشكل هيبة لسلطة autorité، واعتبار لمكانة prestige، مما تعد من ميزات للمتكلم، فهي لا تلعب بحجم ثابت ابداً، لأنها ستتأثر دائماً، وفي كل لحظة تمر على زمن النقاش، بافتراضات الاحكام assertions نفسها التي يجب عليها اثباتها.
وإذا كان يمكننا في المنطق، كما في العلم، ان نصدق أن افكارنا هي محاكاة للواقع، وتعبير عما هو صائب، ولا تدخل أي عوامل شخصية تتعلق بميولنا وانفعالاتنا واهوائنا في صياغة افتراضات أحكام [متضمنة في عبارة تقوم على الربط بين مسند ومسند اليه، أي بإسناد شيء لشيء ما، وفرض صدق حكم او كذبه]،
فهذا يعود لأن ما تقوم عليها هذه الأخيرة وهي العبارة proposition لم تعيّن بعد كفعل إنجازي acte للمتكلم [يتم اثناء الكلام، ويشمل كل ما يصدر عنه من اساليب تعبير؛ ردود فعل عاطفية؛ تصرفات لاإرادية؛ أحكام قيمية، وما يقدم عليه من اعمال actions].
في حين ان ما يميز البلاغة تحديداً، هو أن الشخص personne [على اعتبار انه مفهوم يشير الى ان طريقة بناء الفرد كشخص هي موضع توافق محدود؛ غير ثابت، ومقتصرة على جماعة معينة، وهو توافق قابل لإعادة المراجعة تحت تأثير تصورات دينية وفلسفية وعلمية جديدة] هو مساهم بالأصل في تشكيل قيمة العبارة من خلال تأييده ذاته لها.
تماماً مثلما يمكن لعبارة مشينة أن تجلب الخزي لمن ينطق بها، وعلى العكس، يمكن للسمعة المشرّفة للناطق بعبارة ما ان تعطي وزناً لهذه الاخيرة. ولأجل هذا السبب، ينصحنا ارسطو في كتابه (البلاغة) لغرض دحض الاتهام عنا، أن: ‹‹نتهم بدورنا كل من يتهمنا، لأنه سيكون من غير المعقول أن يتم الحكم على المتهم بأنه غير جدير بالثقة وأن كلامه هو جدير بها في وقت واحد››.
لا يقتصر التفاعل المتبادل في الحِجاج البلاغي على الأحكام الجمالية او بتلك المتعلقة بمعايير الاخلاق فحسب. بل انه يمتد ليشمل حِجاج المتكلم بأكمله، تماماً مثلما تكون شخصية المتكلم هي الضامن لمدى جدية حِجاجه، على العكس، كلما ضعف الحِجاج او كانت تعوزه المهارة، كلما تضاءلت قوة حضور المتكلم.
أما بالنسبة لاعتبار مكانة المتكلم فهو لا يعمل إلا بالقدر الذي يوافق فيه هذا الأخير على اشراكه في حِجاجه مع محاوره. وقد ترتقي مكانة المتكلم نتيجة لخطابه، لكن مع كل قول له، هناك جزء منها سيكون معرضاً لخطر المجازفة به.
مع ذلك، توجد حالات استثنائية حيث يتوقف هذا التفاعل المتبادل بين تأكيد صدق او كذب حكمٍ affirmation والشخص الذي يصدره، عن العمل كما هو معتاد. وهذا يحدث، عندما يتعلق القول بواقعة عينية موضوعية؛ من ناحية ومن ناحية أخرى.
عندما ننظر للشخص المؤكِد ككائن مثالي كامل. ومثلما يمكن ‹‹لوقوع خطأ غير متعمد، أن يجعل من رجل حكيم مثاراً للسخرية›› حسب جان دي لا برويير، فإن ‹‹الأمر الواقع أكثر مَهَاَبة من عمدة بلدية لندن نفسه›› كما يضرب لنا المثل الإنجليزي.
اذن، ان الأمر الواقع – ونشدد على ان يكون مسلَّماً بالأجماع على هذا النحو – يُملي ارادته دون أي تأثر في المقابل. إنه يمثل أحد الحدود التي لن يعمل فيها التفاعل المتبادل بين الشخص والحكم بعد الآن.
وهو، ايضاً، النقطة التي نخرج فيها عن مجال البلاغة، لان الحِجاج سلَّم بقصوره امام التجربة. ويوجد، كذلك، حدّ آخر يعمل على كبح هذه التفاعل، [وهي تقنية تشتغل عندما توجد حالة عدم انسجام بين ما نتصوره حول شخص ما وبين ما نفكر فيه تجاه فعل كلامه الانجازي، ولأننا نرفض لأنفسنا إحداث التغييرات اللازمة.
إما لمحاولتنا إبقاء الشخص بمنأى عن تأثير فعل كلامه الانجازي؛ او أن نبقي هذا الأخير بمنأى عن تأثير ذلك الشخص. وهذا ما يحدث عندما نسند الفعل الى مُنجِز او موجود كامل سواء بالخير او الشر].
فعند القول: ‹‹كل ما يقوله الرب ويفعله لا يمكنه أن يكون إلا أفضل ما في الإمكان››، لابد وان يتوقف كل من: فعل الكلام الإنجازي والحكم عن إحداث أي تأثير على الشخص. ومع هذا الحدّ ايضاً، نكون خارج مجال البلاغة.
لكن، ماذا يحدث عندما يتعارض ما نصفه بـأمر ‹‹واقع›› مع ما نصفه بـأمر ‹‹إلهي››؟ يجيبنا الفيلسوف ليبنتز من خلال تقديمه لنا لهذه الفرضية في كتابه (مقالات عن العقل)، والتي كان يريد فيها أن يبرهن انه ليس بالضرورة لذاكرة الانسان ان تبقى محتفظة بكل الأشياء التي نسيتها عندما ترتفع الأرواح الى السماء في يوم الحساب، فتصور: ‹‹أنه يمكن أن نؤلف قصة من الخيال، قد لا تتلاءم مع الحقيقة قليلاً، لكنها جائزة على الأقل،
وهي تحكي عن انسان في يوم الحساب، ظنَّ أنه كان شريراً، وان الشيء نفسه كان يبدو صحيحاً لجميع أرواح المخلوقات التي كانت قاب قوسين او ادنى من الحكم بشأنه، من دون أن يكون ثمة صحة في هذا الامر.
فهل سيجرؤ أحد منهم على القول ان القاضي الأعلى والعادل، الذي وحده يعلم ان الحقيقة هي العكس من ذلك، يمكنه ان يلعن ذلك الشخص وان يحكم عليه بالضد مما يعلمه؟ مع هذا، يبدو أنه امر يتبع مفهومنا المعياري عن الشخصية الأخلاقية.
فقد يقول البعض انه إذا قضت مشيئة الرب ان يكون حكمها بالضد من المظاهر، فلن يكون مبجلاً بما فيه الكفاية، ومصدر شقاء للآخرين. وعندها، يمكننا الرد بالقول ان الرب هو القانون الأعلى الواحد لذاته، وفي هذا الحال، يجب الحكم على هؤلاء انهم كانوا مخطئين››.
من هنا، يتضح انه إذا تعارضت مشيئة الرب مع ما نعتبره امر ‹‹واقع››، فلابد من وصف هذا الأخير بـ ‹‹مظهر›› حسب ليبنتز، أي اننا نكون هنا في خضم الحِجاج البلاغي بالكامل.
وبدل تبني حل ليبنتز لهذه المسألة، يمكننا ان نحاجِج في الاتجاه المعاكس بالقول ان صورة الاله في نص فيلسوفنا هي ليست الرب، وإن ما نُسب اليها من صفات الموجود العظيم، كان مجرد اسناد مضلل.
ولاحظوا معي، هنا، مدى الفائدة التي تعود بها على بحثنا دراسة جميع الاستدلالات ذات الصلة بالموجود الكامل Être parfait [بوصفه تجسيد لجميع القيّم المجردة في حضارتنا الغربية]. فهي استدلالات تقع دائماً عند ذلك الحد الأقصى الذي يجعل من الممكن تمييز اتجاه تلك الاستدلالات الأكثر استعمالاً في العادة.
ان التفاعل المتبادل بين المتكلم واحكامه يفسر لنا بجلاء تلك المساعي المبذولة من قبل المتكلم لينال تعاطف المخاطَبين لصالحه.
وبهذا، يمكننا ان نفهم أهمية الاستهلال exorde في البلاغة، لا سيما عندما يتعلق الامر بحِجاج امام جمهور مخاطَب خاص بعينه، بينما – في المنطق – ليس هناك فائدة من الاستهلال.
ان التفاعل المتبادل بين الشخص المتكلم وما يقوله، ليس سوى حالة خاصة لتفاعل متبادل عامٍ بين فعل الكلام الإنجازي والشخص، والذي لا يؤثر بجميع المشاركين في النقاش فحسب، بل ويشكل الأساس الذي تقوم عليه معظم الحُجَج التي يستعملونها.
وهذه الحُجَج نفسها، هي ليست سوى حالة خاصة لحِجاج أكثر عمومية ويركز عادة على التفاعل المتبادل بين فعل الكلام الإنجازي ومفهوم الجوهر essence. وهنا تحديداً، نجد كل الفلسفات التقليدية المعنية بهذه العلاقات الأساسية.
إن التقنيات المستخدمة للفصل بين فعل الكلام الإنجازي والشخص –انفصال هو دائماً محدود ودائماً عرضي–والتي تهدف، بالتالي، الى كبح التفاعل المتبادل بينهما، ستكون من بين الموضوعات المثيرة للاهتمام في دراستنا.
ولقد اتضح لنا، مما سبق، أنه يوجد حديَّن حيث لم يعد بالإمكان للتفاعل المتبادل أن يقوم بدوره المؤثِر، وهما يتمثلان في الامر الواقع والموجود الربّاني.
لكن، ما بين هذين النقيضين توجد حالات تحتل مكاناً حيثما تضعف شدة التفاعل المتبادل وذلك بمساعدة مجموعة من التقنيات الاجتماعية. ومن بين هذه الأخيرة، يمكننا أن ندرج ‹‹الحكم المسبّق›› préjugé.
فبوجه عام، يتم تفسير أفعال الكلام الإنجازية تبعاً لحكم مسبَّق مُفضِّل بالإيجاب او غير مُفضِّل بالسلب، ومن ثمة، فهي أفعال لا تُؤثر كما ينبغي حيِّال التقدير الممنوح للشخص الذي يؤديها.
وهذا ما يترتب عليه ضرورة الاستعانة بالتقنية–المضادة، فمن يريد، على سبيل المثال، إلقاء اللوم على فعل كلام إنجازي ما، يجب عليه أن يثبت أن حكمه لم يتمّ في ضوء حكم او تحيّز سلبي مسبّق.
وهنا، لا يوجد ما هو أكثر فاعلية لهذا الغرض، من اسداء بعض الثناء لمن نريد انتقاده. لنرى، على الفور، ان هذه الكلمات في البلاغة، ليست محض تَنَازُل وتفضُّل كما ستكون عليه لو تم ادراجها في حِجاج صُّوري شكلاني بحت.
بالإضافة الى ذلك، إن ما يميز المنطق عن البلاغة، اننا في الأول نستدل دائماً داخل نظام معطى سلفاً، ومفترض التسليم به مسبّقاً، أما في الحِجاج البلاغي فكل شيء هو قابل دائماً لإعادة النظر والسؤال، ويمكننا دائماً سحب تأييدنا، فما منحناه من تأييد هو واقع قابل للتغيير، وليس حق ثابت.
وبينما يكون الحِجاج في المنطق قَسْريّ إلزاميّ، فإن الحِجاج في البلاغة ليس قَسْريّاً ولا إلزاميّاً. فلا يمكن إجبار المرء على تأييد قضية معينة او إلزامه بالعدول عنها بسبب تناقض قد يترتب عليها.
الحِجاج البلاغي ليس قَسْريّاً ولا إلزاميّاً لأنه لا يسير بحركة دائرية داخل نظام تكون فيه مقدمات الاستنباط وقواعده ذات معنى احادي ثابت راسخ.
بسبب هذه الخصائص المميزة للمناظرة البلاغية، يجب أن يتم فيها استبدال مبدأ التناقض contradiction بمبدأ عدم التوافق incompatibilité. ان هذا التمييز بين التناقض وعدم التوافق يذكرنا، على نحو ما، بتمييز ليبنتز بين الضرورة المنطقية، حيث التعارض معها يقتضي ضمناً الوقوع في تناقض، وبين ضرورة المعيار الأخلاقي.
فالحقائق الضرورية، عند ليبنتز، هي تلك التي لا يمكن لأحد، حتى الاله، تغييرها، إنها نظام معطى سلفاً مرة واحدة وإلى الابد. والامر ليس كذلك مع ضرورة المعيار الأخلاقي حيث لا نقابل إلا حالات عدم توافق، وحيث ما يزال من الممكن تغيير عنصر ما. ولنطالع ما يقوله ليبنتز في كتابه (مقالات ثيوديسيه):
‹‹لكن هذه الضرورة لا تخالف ما هو عرضي احتمالي الوقوع، ولا هي بتلك التي نطلق عليها ضرورة منطقية؛ هندسية، او ميتافيزيقية حيث الشيء المعارض لها لا بد وان ينطوي على تناقض.
وكان اللاهوتي السيد نيكول قد لجأ في موضع ما، لعقد مقارنة لا بأس بها. إذ يحسب المرء أنه من المستحيل لقاضٍ حكيم وَقُور، لم يفقد عقله بعد، ان يقدم على فعل متهور امام الملأ، كأن يجوب الشوارع عارياً، لأجل الضحك››.
غني عن القول، ان الاستحالة التي يتحدث عنها السيد نيكول هي محض استحالة تتعلق بما هو معياري في الاخلاق، أي بحالة من عدم التوافق.
إن أوجه عدم التوافق المميزة للحِجاج البلاغي، تتوقف بشكل صريح على الإرادة. وكما نضعها يمكننا ازالتها ايضاً. فعندما يؤكد رئيس وزراء حكومة انه إذا لم يتم قبول مشروع القانون المقدم، فحكومته سوف تستقيل بالكامل، فهو يقيم بذلك حالة عدم توافق بين رفض المشروع واستمراره في السلطة.
وحالة عدم التوافق هذه إنما جاءت نتيجة لقراره وليس من المستبعد ان يتم ازالتها، بينما لو كنا إزاء تناقض، سيكون علينا الرضوخ فحسب. ان مثل هذا التمييز بين مبدأ التناقض ومبدأ عدم التوافق، لم يكن موجوداً بالطبع عند فلسفة حيث لا يوجد سوى أحكام للقيمة،
كما كانت على الأرجح فلسفة بروتاغوراس، حتى قيل ان ما ميّز السفسطائيون لم يكن هو تركيزهم على البلاغة، بقدر ما كان هو في محاولتهم ردّ المنطق الى البلاغة.
ومثلما رأينا أن هناك مجموعة من تقنيات إزالة الارتباط القائم بين فعل الكلام الإنجازي والشخص، سنتعرف كذلك على سلسلة من تقنيات لرفع أوجه عدم التوافق وأخرى لمنع تلك التي نحاول فرضها على أنفسنا كضرورة.
هذه التقنيات هي تلك التي يجب أن تساعد الفرد في حل ما يواجهه من صراعات نفسية، كما جاء في فصل مهم من كتاب (قوانين علم النفس الاجتماعي) للفيلسوف والسوسيولوجي فلوريان زانينسكي.
وقد عُدّ ذلك المأزق الكلاسيكي لقائد عسكري محتجز عند العدو، ولم يكن هناك سبيل ممكن للفرار والخلاص من مصير الهلاك المحتوم لجيشه، غير الاستسلام واخذ جنوده شريطة ترك أسلحتهم وامتعتهم،
هو من بين تلك التقنيات التي جرى التعليق عليها بإسهاب من قبل القدماء أمثال شيشرون وهيرينيوس، [فهي حُجَج تقع في شكل مأزق او معضلة ليس لها سوى حلين اثنين، كلاهما سيء، مما يستوجب اختيار الحل الأقل سوءاً] وترجع الى عدم توافق يتم صياغته وطرحه على انه ضرورة.
ولكي يمكننا تقديم عدم توافق كضرورة، يجري التأكيد عموماً على انه مفروض علينا من أحد آخر ننسب اليه صفة حكم الامر الواقع الذي لا يمكن للإرادة ان تعترض عليه.
لذلك، إذا كان من الممكن دائماً رفع حالة عدم التوافق، وإذا كان بوسعنا دائماً التطلع نحو تعديل شروط المشكلة، لن نُساق ابداً في البلاغة نحو اللامعقول. وهناك مفهوم في البلاغة يلعب، مع ذلك،
الدور نفسه الذي يلعبه اللامعقول في المنطق، ونقصد به مفهوم السخرية. وفي مثال السيد نيكول الذي استشهد به ليبنتز في أعلاه، لم يكن من غير المعقول ان يجول قاضٍ حكيم وَقُور في شوارع المدينة عارياً لأثارة الضحك، لكنه افتراض يدعو للسخرية.
وعليه، إذا نجح الخصم في إقناعنا بالسخرية من خلال حِجاجه، فهو الرابح تقريباً. ومن يؤكد بالقول انه لن يقتل كائناً حيّاً مهما كان الثمن، مع اننا اوضحنا له ان هذا المبدأ ربما سيؤدي به لتجنب حتى وضع مطهِّر على جرح خوفاً من قتل الميكروبات.
ينبغي عليه حتى لا يترك نفسه مدعاة للسخرية، ان يضع حدوداً لنطاق تأكيده لذلك الحكم، على ان تكون بشكل لا يمكننا تبيَّنه مسبّقاً.
وهكذا هو الحال في مناقشة يمكن ان يرى خصمان يسعيان لإقناع بعضهما البعض، أن آراء كل واحد فيهم قد تغيرت بناء على حِجاج شريكه الآخر. فقد توصلا الى تسوية compromis مختلفة تماماً عن أطروحة الأول مثلما هي عن الثاني، وهو امر لا يمكن حدوثه إذا كنا نستدل داخل نظام استنباطي ثابت كلياً لمرة واحدة وللأبد.
ولا يمكننا التعبير عن هذا المفهوم الدقيق ‹‹للتسوية›› الذي هو ليس عقداً بل هو تحول متبادل لأحكام القيمة المقبولة لدى المتحاورين، بطريقة أفضل مما عبر عنه الشاعر روبرت براونينغ في خاتمة قصيدته (دفاع الاسقف بلوغرام).
في مونولوج طويل هو محاورة في الأصل تعد من روائع الاعمال في الحِجاج، يحاول الاسقف غير المؤمن تبرير موقفه امام نقد محاورِه الاديب الشاب الذي كان يزدريه [لأنه كان يعتبر ان الاسقف لم يكن صادقاً في قناعاته وبما يتفق مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية].
انتهت هذه المواجهة الحاسمة، بإحداث تغيير عميق في كل منهما، رغم ان كل واحد فيهما يبدو منتصراً. يختتم الاسقف، حسب الشاعر، بالقول:
على العموم، كان يظن، انني ابرر لنفسي
حول هذه النقطة بالذات حيث يقصدها المماحكون
للنيل مني، لهذا حاول التهرَّب – والانسحاب –
فأنهزم، وهذا يكفيه
هو على موقفه! حتى ولو كان الأساس غير متين
وانا سأبقى على موقفي، فهناك المزيد من الثبات تحته
قد يحفر كلانا ويصل اليه
نظراً لأن الحِجاج هو قَسْريّ إلزاميّ في المنطق، فمجرد ما يتم إثبات قضية، تصبح الأدلة الأخرى لا لزوم لها. في المقابل، لكون الحِجاج ليس قَسْريّاً ولا إلزاميّاً في البلاغة، هناك مشكلة جدّيّة تطرح نفسها على كل طرف متحاور، وهي تتعلق بنطاق أبعاد الحِجاج.
فمن حيث المبدأ، لا يوجد حد للتراكم المفيد للحُجَج، ولا نستطيع ان نحدد مقدماً ما الأدلة التي ستكون كافية في إحداث التأييد.
وهذا ما سيبرر لنا استعمال حُجَج لن تكون فقط عديمة الجدوى إذا تم قبول واحدة منها، بل وتزيل نفسها بنفسها تقريباً. وبهذا الشكل لجأ، على سبيل المثال، السيد تشرشل لأثنين من الحُجَج المتتالية، اثناء مداولة برلمانية عام 1939 بخصوص الميزانية الحربية لبريطانيا، بالقول:
‹‹يجب على الأحزاب او السياسيين قبول الإطاحة بهم بدلاً من تعريض حياة بلدنا للخطر. فضلاً عن انه لا يوجد مثال في تاريخنا لحكومة منعها البرلمان والرأي العام من اتخاذ التدابير اللازمة في تأمين القدرات الدفاعية››.
مع ذلك، يوجد في البلاغة ضرر أكبر منه في المنطق عند استعمال حُجَج زائفة. في الواقع، لا يغير كذب مقدمة ما في المنطق، بأي حال من الأحوال، من صدق نتيجة إلا إذا تم إثبات هذا الاخير بطرق أخرى. فصدق عبارة النتيجة الأخيرة يبقى مستقل عن كذب مقدماتها.
اما في البلاغة، فعلى العكس، يمكن ان يكون لاستعمال حُجَّة زائفة نتيجة ضارة. فأن نتوجه عن جهل او طيش، لجمهور متحمِّس للثورة ويميل لتأييدها ومتمسك بها، بالقول ان اللجوء الى هذه الوسيلة يقلل من احتمالية حدوث الثورة بالأصل.
قد يكون له مفعول مخالف تماماً لما كنا نأمله. ومن ناحية أخرى، ان التقدم بحُجَّة مشكوك فيها من قبل المخاطَب، كما رأينا سابقاً، يمكن له ان يضرّ بشخص المتكلم، ومن ثمة، يقوض حِجاجه بالكامل.
إذا لم يكن الحِجاج البلاغي قَسْريّاً ولا إلزاميّاً، فهذا لان شروطه اقلّ دقة بكثير من تلك المتعلقة بالحِجاج المنطقي. وبقدر ما لا يكون فيه صُّورياً شكلانياً، فإن الحِجاج البلاغي برمته يفترض الغموض والالتباس في المصطلحات المتعلقة به. ويمكن لهذا الغموض ان يقلَّ كلما اقتربنا من الاستدلال الصُّوري الشكلاني.
لكن، لتعذُّر الوصول الى صياغة لغة صُنْعيّة، كتلك التي تنشأ عن اتفاق مجموعة من العلماء المتخصصين في علم معين، سيبقى الغموض موجوداً على الدوام. وفي حين ان وظيفة الحِجاج القَسْريّ الإلزاميّ نفسها تتمركز على تشريع أحادية التفسير للمعنى univocité، فإنه من غير الممكن للحِجاج الاجتماعي؛ القانوني؛ السياسي، او الفلسفي القضاء على كل الغموض.
لقد بقينا نظن، ولفترة طويلة، ان غموض المفاهيم وتعددية التأويل لمعاني polysémie المصطلحات، كانت من الاشياء المُعيبة. فسوسيولوجي كان منشغلاً ايضاً بمسألة الغموض مثل فيلفريدو باريتو، ورغم انه في كل صفحة من كتابه (رسالة في السوسيولوجيا العامة)، كان ينفي عن نفسه النزوع نحو أي تقييم يتسم بازدراء متحيز.
لم يستطع التصدي لدراسة المفاهيم الملتبسة دون ان يُقدم هو نفسه على السخرية من استعمالها. من هنا، اتسمت المقدرة الإبداعية البناءة لتحليلاته بالضعف خلافاً لقيمتها النقدية التي لا يمكن انكارها.
أما في الوقت الحاضر، فقد أصبحنا في مختلف الحقول ننظر الى عدم دقة المفاهيم والتباسها كأمر لا غنى عنه في استعمالها. وتجري اليوم دراسة مشكلة التأويل في القانون بشكل وثيق مع مشكلات اللغة.
نظراً لأهميته الفلسفية، فأن التحليل الذي قدمه السوسيولوجي اوجين دوبريل للمفهوم الملتبس، في بحثيه، الأول الموسوم بـ (المنطق والسوسيولوجيين) عام 1924، والآخر بـعنوان (التفكير الملتبس) عام 1939، سيكون مثمراً للغاية في موضوع دراستنا.
وسيشكل، مع تحليل حكم القيمة، واحداً من الأدوات الأساسية لدراسة البلاغة. ونعتقد، من جهة أخرى، انه يمكن للتحليل الحِجاجي ان يسلط الضوء حول نشأة وتفكك بعض المفاهيم الملتبسة. ولا نود، في الواقع، ان يتم النظر لتأكيدنا على ان غموض المفهوم هو امر ضروري وغير قابل للاختزال، بمثابة دعوة لاجتنابه في كل بحث وتحقيق.
بل على العكس، إن مساعينا تهدف لفهم كيفية التعامل مع المفهوم الملتبس، وما هو دوره ومدى تأثيره. ونرى انه مسعى سوف يقودنا خصوصاً الى اظهار ان المفاهيم التي نعتبرها، عموماً، واضحة بصورة قطعية، هي لم تكن كذلك دون ان يتم استبعاد بعض أوجه تفسيرات المعنى على التحديد.
فالمسألة ابعد ما تكون عن حالة تقاعس ورضا بالغموض، انها تتعلق بضرورة الدفع بتحليل المفاهيم الى اقصى حد ممكن، مع اليقين انه لا يمكن لهذه الجهود ان تفضي الى اختزال الفكر كله في عناصر واضحة على نحو كلي تام.
ولن تقتصر هذه الجهود على تحديد معنى المفاهيم فحسب، بل وتمتد الى تحديد قصد المتكلم، ودلالة القول وابعاد تأثيره، وغيرها الكثير من المسائل الجوهرية في البلاغة التي لم تشغل المنطق الصُّوري الشكلاني لاستناده على ركيزة أحادية المعنى.
ولنأخذ هذا المثال البسيط والواضح بما فيه الكفاية. وهو يتعلق بفقرة من كتاب (الطبائع) لجان دو لا برويير، يقول فيها:
‹‹إذا عاد بعض الموتى الى عالمنا ثانية، وإذا ما رأوا ان أسماءهم النبيلة التي كانوا يحملونها؛ واراضيهم الكائنة في أفضل المواقع، مع قصورهم ومنازلهم القديمة، أصبحت مملوكة من قبل اناس ربما كان اباءهم مزارعين مستأجرين لديهم، يا تُرى ماذا سيكون رأيهم في عصرنا؟ ››.
لقد فسر الناقد والفيلسوف جوليان بيندا، في تقديمه لطبعة مكتبة لابلياد، ذلك النص أعلاه، أنه اعلان واضح يقع في صالح الركود الطبقي. ربما هو كذلك. لكن، كما هو الحال في أي تأكيد من هذا النوع، أي بتقييم مطروح من قبل الآخر، يمكننا ان نرى فيه إما حكم غير مُفضِّل للعصر حيث ينتصر الأثرياء الجُدد، واما حكم غير مُفضِّل محمول على الموتى الذين سيصدرون حكماً لا يقع في صالح هذا العصر.
ومثال آخر يقدمه قارئ السيد بيندا نفسه، فهو قد يحكم على السيد بيندا بالحكم القطعي نفسه الذي كونه هذا الأخير عن السيد دي لا برويير الذي يحكم على الناس الذين يحكمون على عصرهم، وهكذا دواليك، وذلك بسبب التفاعل المتبادل بين الشخص واحكامه.
تبدو الاعتبارات المذكورة أعلاه كافية لنا، للتأكيد على انه لا يمكن اختزال مجال الحِجاج البلاغي بأي مسعى مهما كان، وردّه لحِجاج منطقي او لمحض إيحاء وتأثر بسيط.
بطبيعة الحال، يقوم المسعى الأول على تحويل الحِجاج البلاغي الى منطق للاحتمال. ولكن، مهما كان التقدم الذي يمكن ان يحرزه حساب الاحتمالات، يبقى تطبيق هذه الاحتمالات مقتصراً على حقل تم تحديد شروطه بدقة عالية. وكما رأينا سابقاً، يجب علينا في البلاغة استبعاد مثل هذه المحددات الحتمية.
اما المسعى الثاني فهو يقوم على دراسة الآثار الايحائية الناتجة عن وسائل تعبير شفوية، ويعزو لهذه الآثار أي فاعلية مؤثرة efficacité لأساليب التعبير للحِجاج غير المنطقية. وهي محاولة قد تكون مثمرة، لكن من شأنها ان تُفلت منا الجانب الحجاجي الذي نريد تسليط الضوء عليه تحديداً.
لكن الاصح، ان من بين أساليب التعبير الحِجاجية التي نقابلها، هناك فئة معينة قريبة من أساليب منطق الاحتمال، لا سيما، الإثبات بالمثال، والحُجَج المستندة على ما هو سويّ normal تبعاً لما هو معياري؛ وعلى الكفاءة.
وفي مقابل ذلك، هناك فئة من أساليب التعبير الحِجاجية مصممة بالأساس لزيادة شدة التأييد بواسطة ما نسميه بأثر الحضور او الحقيقة الواقعة. وسنضع بينها المماثلة analogie بمختلف اشكالها بمن فيها الاستعارة métaphore على وجه الخصوص. فدورهم في البلاغة مركزي وبالغ الأهمية.
ونقابل فيها، كذلك، معظم أساليب التعبير المنضوية تحت اسم ‹‹صور›› figures بلاغية تم تصنيفها وإعادة تصنيفها منذ قرون. وفاعليتها الأدبية المؤثرة لم يتم انكارها ابداً. لكن دلالة أهميتها كعنصر حِجاجي هو ابعد من ان يكون قد تم تحليله بشكل كافٍ.
إن هذه الفئة من الحُجَج تحديداً، والتي نطلق عليها بـ ‹‹حُجَج الحضور›› présence، هي من بين أكثر الحُجَج التي تعرضت لإهمال كبير للغاية من قبل أولئك الذين يحطون من شأن كل ما هو غير عقلاني، وتم التغاضي عنها تماماً من قبل التصورات العقلانية لمفهوم الاستدلال تحديداً.
فدور حُجَج الحضور [الناتجة عن عملية انتقاء المتكلم لمقدمات معينة يقوم بصياغتها بناء على الأشياء المقبولة لدى المخاطَب والمؤثرة فيه بشكل كبير؛ ويعرضها له وفق تقنيات حِجاجية منتقاة ايضاً، ليستدعي انتباهه على عناصر محددة من الواقع والتركيز عليها دون أخرى غيرها] هو دور لا يمكن اختزاله في مجرد استدلالات نتوصل من خلالها لما هو أكثر احتمالاً، وذلك لمجرد اننا نميل عادة الى إضفاء عقلانية مفرطة على التفكير.
ونلاحظ، ان الاختلاف القائم بين مجالي الحضور والاحتمال هو أقرب للمقارنة مع ذلك الفرق الذي عقده الفيلسوف جيرمي بنتام في بعدين اثنين من ابعاد متعة السعادة، وهما: القرب propinquity [المتعة القريبة هي انفع من تلك التي ستتحقق على المدى البعيد]؛ واليقين certainty [المتعة هي انفع بكثير، إذا كنا على يقين من انها سوف تتحقق].
وهو فرق رأى فيه الفيلسوف كلارنس إرفينغ لويس في كتابه (تحليل المعرفة والتقييم) بعض الغرابة، وخشي ألا يريد بنتام بذلك القول ان علينا ان نكون، وعلى نحو معقول، اقلّ انشغالاً بالمستقبل بسبب درجة بعده،
بغض النظر عن الشك الكبير للغاية المصاحب عموماً لكل ما هو بعيد جداً. لقد كان اهمال السيد لويس لعامل الحضور وملائمته لمقاصد سيكولوجية لا يمكن انكارها، هو السبب في دهشته، ووصفه لهذا العامل بـ ‹‹تصور شاذ››.
وبين هاتين الفئتين المتناقضتين تستقر أساليب التعبير التي ننظر اليها كأساليب تعبير بلاغية بالدرجة الأولى، والتي تميز البلاغة وتُعرَّفها كمنطق احكام القيمة. ويوجد، في الواقع، جملة من أساليب التعبير المرشحة لإسناد qualification قيمة معينة او لتحييدها disqualification عن شخص او شيء، وهي تشكل بالفعل ترسانة البلاغة وعدتها اللغوية الحِجاجية لغرض إحداث المفعول اللازم في إنتاج الخطاب.
سوف نقابل في هذه الفئة كل حِجاج فلسفي يقوم على ثنائيات: الواقع والظاهر؛ الغاية والوسيلة؛ الفعل والجوهر؛ الكم والنوع، وأزواج متعارضة أخرى لطالما جرى اعتبارها أساسية. ولا يمكن، حتى الآن، وضع هذه الأساليب التعبيرية في موضع تحليل بوصفها وسائل حِجاجية لان مفاهيم البلاغة السائدة لا تفسح لها مجالاً.
وهذا ما يدعونا للقول، ان دراسة أساليب التعبير هذه يمكن ان تشكل للمساهمة الأكثر حداثة في البلاغة كما نتصورها.
وليس هناك أساليب تعبير يمكن استعمالها فقط بهدف إحداث المفعول المطلوب، بل وتوجد، كذلك، أساليب تعبير يمكن ان تشتغل احياناً بمعزل عن مقصد صاحبها.
بهذا الشكل، يمكننا تحييد قيمة او ترشيحها للإسناد بتأكيدنا على ان ما نرى فيه اختلاف في الطبيعة، ليس سوى اختلاف في الدرجة او العكس. فمنذ فترة قريبة، عارض الجنرال جورج مارشال مشروع قرار للكونغرس الأميركي يقضي بتخفيض قروض الائتمان المدفوعة لأوروبا بنسبة تبلغ 25%، مؤكداً،
انه بذلك لم تعد القضية تتعلق بـ ‹‹إعادة إعمار›› وإنما بـ ‹‹إعانة››، مما يعني ان المبادرة الأميركية ستتغير ليس في درجتها، بل في طبيعتها.
في هذه الحالة، كان نهج تحييد القيمة هو مقصود من قبل صاحبه الجنرال مارشال. وعلى العكس من ذلك، نجد ان تحليل مفهوم التسامح الذي يسعى لإظهار التسامح كمسألة تباين في الدرجة، وان لكل مجتمع معايير خاصة بالأمور المطلوب فيها الخضوع والامتثال، والأخرى موكول امر تقديرها للجميع،
هو تحليل يميل الى تقليل حجم التمايز بين نظامين يُنظر لأحدهما كمتسامح، والأخر كمتعصب. هذا التقليل من حدة الاختلاف قد يحدث حتى في الحالة التي يرى صاحب التحليل شخصياً ان الاختلاف هو كبير ولا يستهان به. لأن آلية أسلوب التعبير هذا يمكن وضعها حيز التفعيل إما بإرادة الشخص الذي قام بتحليل المفهوم وإما بمعزل عنها.
وهناك أسلوب شائع في تحييد القيمة بإبرازها كقيمة نسبية بالقول ان ما تمّ اعتبارها كقيمة في ذاتها، هي ليست سوى مجرد وسيلة. وهنا ايضاً، يمكن ان تلعب آلية أسلوب التعبير دورها بشكل مستقل عن إرادة صاحبه.
وهذه كانت بالضبط هي محنة الانتروبولوجي ليفي-بريل الذي، ورغم نفيه الصريح، تم اتهامه بالحطّ من قيمة ما هو معياري في الاخلاق عندما اظهره في كتابه (معايير الاخلاق وعلم العادات) انه ليس سوى مجرد وسيلة لغاية تحقيق الرفاه الاجتماعي.
يعد تقليل القيمة الناجم عن النظر لأمر ما كمجرد أسلوب procédé تعبير يراد من خلاله الوصول لغرض معين، هو واحد من الاشكال البالغ الاهمية في تحييد القيمة. وبسببه تعرضت البلاغة نفسها لضرر أكبر بكثير من غيرها.
في الأمور الاجتماعية، على سبيل المثال، غالباً ما يكفينا إدراك أمر ما على انه مجرد أسلوب، لنزيل عنه كل فاعلية مؤثرِة. فالإنسان الفاضل هو محترم، لكن إذا لاحظنا ان تصرفه كان فقط بدافع من رغبته في أن يكون محترماً، فلن نصفه بفاضل وإنما بمدَّعٍ.
يخبرنا الكاتب مارسيل بروست في روايته (البحث عن الزمن المفقود)، عما ينبغي وما لا ينبغي القيام به إذا ما تم اعتبار أمر كمجرد أسلوب. فكما هو حال الرجل الذي لطالما كان يبحث عن رضا محبوبته بحرصه المفرط على الاهتمام بمظهره،
دون أن تلتفت اليه، بينما تعلق قلبها برجل آخر كان يظهر امامها كما هو: ‹‹بالمثل، إذا أسف رجل لأنه لم يعد مرغوباً بصحبته بما فيه الكفاية من جميع الناس،
فلن انصحه بالقيام بالمزيد من الزيارات، ولا ان تكون لديه زُمْرة من الرفاق أكثر رُقيَّاً؛ وسأخبره ألا يلبي أي دعوة كانت؛ وأن يبقى في داره حبيساً؛ وألا يسمح لاحد أن يدخلها، ومن بعد، سيرى كيف سيصطف الجميع امام بابه.
او بالأحرى لن أخبره بذلك. لأنها قد تبدو طريقة مضمونة في جعله مطلوباً لكنها لن تنجح معه بقدر ما لم تفلح فيه مع ذاك الرجل الذي أراد ان يكون محبوباً، أي إلا إذا لم يتبناها لأجل هذا الغرض، مثلاً، إذا لازم المرء دائماً داره لأنه كان مريضاً جداً، او لظنَّه انه كذلك، او لأنه كان يحتفظ فيها بمعشوقة يفضِّلها على العالم بأسره››.
بهذا الشكل، صار علينا تقديم تفسير أفضل لتصرفاتنا، وذلك لندفع عنها تهمة انها مجرد أسلوب لتحقيق غرض معين، بالقول انها كانت نتيجة لظرف مستقل عن الارادة، او وسيلة ترمي لتحقيق غاية أخرى غير تلك المعنية.
وبالتالي، اصبحت نزعة تبجيل الطابع العفوي في الفن؛ او تقديم الفن كوسيلة تهدف لتحقيق غايات اجتماعية او دينية، تمثل أنماطاً مختلفة للتأكيد على ان تقنيات الفنان هي ليست بمجرد أساليب تعبير غرضية، هذا الاتهام الذي افضى الى التشكيك بمصداقية خطاب البلاغة نفسه في القرن التاسع عشر.
فقد كانت جميع الفنون معرضة للمراقبة ولتحييد القيمة الفنية عنها، وما بين ضرورة الاستعانة بطريقة معينة وخطورتها؛ وتبرير استعمال الكليشيهات ونبذها، وما بين حملات الترويع للنصوص الأدبية ونقدها، وغيرها من اتجاهات متعارضة لا أحد استطاع ان يعبر عنها بحسّ عميق أفضل من السيد بولان في كتابه (ورود حديقة الطارب او الرعب في الآداب).
وهنا، يبدو ان الامتناع renoncement عن الاستعانة بأساليب معينة في الفن، كان، في جزء كبير منه، هو ضرورة دعتها انعدام الفاعلية المؤثرِة الذي يصيب الأسلوب بمجرد تصورنا له على ذلك النحو السائد، إضافة لأسباب متأصلة أخرى تسهم ايضاً في ذلك، وفقاً لرأي السوسيولوجي اوجين دوبريل في بحثه الموسوم بـ (الامتناع).
مع ذلك، إذا كان نمط ادراكنا السائد عن أسلوب التعبير يقلل من فاعليته المؤثرة، فهو ليس بقاعدة مطلقة، لان صيغة الطقس الشعائري التي يمكن اعتبارها نوعاً من النماذج المُعادة، تستمد هيبتها وكرامتها من تكرارها نفسه، ومن تصورها كأسلوب تعبير ايضاً.
بالمثل، يمكن للشخص الذي يخضع للعلاج النفسي، ان يبتغي الإيحاء المقدم له. ويمكن لجندي ذاهب الى ساحة المعركة، ان يستسلم بإرادته طوعاً للخطابات الوطنية الأقل افتعالاً للحماسة، تماماً مثل متنزِّه مرهق من التعب يترك نفسه تنقاد للسَيْر غناءً.
قد نلاحظ أن الحالة التي لا يفقد فيها الحِجاج البلاغي قدراً كبيراً من فاعليته المؤثرِة عندما يُنظر اليه كأسلوب تعبير لأغراض معينة، إنما تكون في خطاب فصاحة البيَّان او فيما يقاربه، أي في الحالة التي يوجد فيها من الأصل بعض التأييد لاستنتاجات معينة .
ونحتاج فقط لتعزيز هذه الأخيرة. وفي هذا السياق، سيكون هناك مجالاً واسعاً يدعو للبحث والاستقصاء عن الزمن والشروط التي يمكن للحِجاج البلاغي المتصوَّر كأسلوب ان يبقى محافظاً على فاعليته المؤثرِة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى اننا عادة ما ننظر لفعل الكلام الإنجازي كأسلوب عندما لا نعثر له على تفسير آخر، او عندما تكون تفسيراته غير معقولة قليلاً، وعليه، سيكون من الضروري الاستعانة بأساليب البلاغة للتصدي لفكرة ان ذلك الفعل هو محض بلاغة.
الأسلوب الأول – معروف جيداً ومطروق كثيراً، لكنه ذو فاعلية مؤثرِة للغاية – يتلخص، حسب كوانتيليان، في ان يشير المرء بدءاً من الاستهلال الى أنه ليس خطيباً جاء ليخطب في الناس. رغم انه، هنا ايضاً،
علينا توخي الحذر، فليس من دون سبب وجه الكاتب ديل كارنيجي في مؤلفه (الخِطابة العامة) النقد لطلابه الشباب الذين يفتتحون بحرج حديثهم بالقول انهم لا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم.
ربما يمكن ان يتيح تصنيفنا لأساليب التعبير الحِجاجية – بالتدرج من المنطق الى الإيحاء – بتبرير الاختلافات في الرأي التي ترى انه كلما اقتربت هذه الأساليب من المنطق، كلما قل ضرر ادراكنا لها كأسلوب تعبير لأغراض معينة، وكلما اقتربت من الإيحاء، كلما صارت أكثر ضرراً.
ان فقدان أساليب التعبير الحِجاجية لفاعليتها المؤثرِة تكاد تكون ملحوظ كثيراً في النشاط الادبي على وجه خاص. فتعاقب أساليب التعبير فيه هو ليس بتناقض ولا من المفارقات، وما بينهما يوضع بالاعتبار أهمية لما يُسمى بالافتقار للأسلوب.
وللعفوية التي تحلّ محلّ المرتقب حدوثه حالما يفقد هذا الأخير قوته الإقناعية. علماً ان العفوية نفسها تتبدد فاعليتها المؤثرِة بمجرد اعتبارها كأسلوب تعبير لأغراض معينة، وبهذه الحالة علينا استبدالها بشيء اخر.
ان كل بلاغة تتمركز على أشكال محددة في التفكير والأسلوب، ولا تحاول توسيع نطاق تطلعاتها الى اقصى حد ممكن ولا ان تتعاطى مع الحِجاج البلاغي المعني بالقيّم في مجمله، مصيرها الزوال سريعاً لا محالة.
وهذا ما يدعونا للقول انه كما ان التصويب هو معيار لقواعد النحو، وصحة اتساق صيغة الاستدلال هي معيار للمنطق، فإن الفاعلية المؤثرِة هي كذلك بالنسبة للبلاغة.
مع ذلك، لا ينبغي أن يُفهم من كلامنا هذا، أن هدفنا سيتمثل في وصف طرق خداع الخصم، وتحويل انتباهه، وحرمانه من القدرة على التحكم في انفعالاته عن طريق حيَّل بارعة الذكاء بدرجات متفاوتة.
لكن، إذا اخذنا بالاعتبار الفاعلية المؤثرِة لوحدها، فهل هذا يعني اننا سنتوفر على مقياس من شأنه ان يمكننا من التمييز بين نجاح دجَّال، وآخر لفيلسوف بارز؟
بطبيعة الحال، لا يمكن لهذا المقياس ان يزودنا بمعيار مطلق وذلك لان الحِجاج البلاغي، كما ذكرنا أعلاه، هو قابل للنقاش على الدوام.
اذن، ما هو الضامِن لاستدلالاتنا الداعمة لتفكيرنا=واسلوبنا=وكلامنا؟ انه سيكون قائماً في حس الفهم والتمييز للمخاطَب الذي نتوجه إليه بخطابنا الحِجاجي. عندئذ، سنرى مدى الفائدة العائدة على قيمة حُجَج نحرص على توجيهها لجمهور مخاطَب كوني.
فهذا هو الجمهور الذي نطمح اليه في اعلى مستويات الاستدلالات للفلسفة. وكنا قد رأينا سابقاً، أن هذا الجمهور المخاطَب الكوني هو، في حد ذاته، من نتاج خيال المؤلف، ويستمد خصائصه من مفاهيم هذا الأخير.
مع ذلك، فأن مخاطبة مثل هذا الجمهور عند الروح العقلانية النسقية، تمثل المسعى الحِجاجي الأقصى الذي يمكن ان تنادي به. وعليه، فأن الحُجَج التي سنتناولها بالتحليل ستكون هي تلك التي لا يمكن للعقول الأكثر اتساقاً، او التي يقال عنها غالباً الأكثر عقلانية، ألا تستعين بها عندما يتعلق الامر بمجالات معينة مثل الفلسفة والعلوم الإنسانية.
وعلى خلاف افلاطون، وأرسطو وكوانتيليان كذلك، الذين بذلوا قصارى جهدهم من اجل العثور في البلاغة على استدلالات مشابهة لتلك المنطقية، فأننا لا نعتقد ان البلاغة هي مجرد حيلة غير موثوقة، وموجهة لمخاطبة السذَّج والجُهَلاء من الناس.
فهناك مجالات، كتلك المتعلقة بالحِجاج الديني؛ وبالتربية الأخلاقية او الفنية؛ إضافة الى الفلسفة، والقانون حيث لا يمكن للحِجاج فيها إلا ان يكون بلاغياً. فلا يجوز تطبيق الاستدلالات الصائبة في المنطق الصُّوري/الشكلاني في حالة لا تتعلق بأحكام صُّورية شكلية بحتة، ولا بعبارات ذات محتوى مصاغٍ على نحوٍ يكفي للتجربة ان تدعمها.
وهنا ينبغي الإشارة الى انه نظراً لأن الاستقراء induction، وكما نرى، هو استدلال معقد يضم أساليب بلاغية مع استنتاجات منطقية ودعوة للتجربة، ارتأينا ألا ندرجه في تحليلاتنا الأولية هذه، على اعتبار ان البحث فيه لن يكون مثمراً إلا بعد تقديم عرض مفصّل لوسائل الإثبات البلاغية.
ومن جهة أخرى، إن الحياة اليومية؛ العائلية او السياسية يمكن ان تقدم لنا العديد من الأمثلة في الحِجاج البلاغي. وبكل تأكيد، سيكون الاهتمام بهذه الامثلة المتضمنة على مناقشات ومداولات كممارسات شائعة؛ مألوفة ومتكررة، داخل إطار المقاربات التي تسمح بها الأمثلة الواردة في حِجاج الفلاسفة ورجال القانون بأرفع مستوياته.
هكذا، وبعد ان حاولنا وضع ملامح محددة لتعريف حقل الحِجاج البلاغي؛ وللتعرف على هدفه وخصائصه التي تجعله مختلفاً ومتميزاً عن الحِجاج المنطقي، فقد صار بوسعنا ان نفهم، على نحو أفضل، أسباب تدهور خطاب البلاغة.
فمنذ اللحظة التي نعتقد فيها أنه يمكن للعقل؛ للتجربة او للوحي التغلب على جميع المشاكل والفصل في كل النزاعات – على الأقل في القانون، إن لم يكن في الواقع أيضاً – فلا يمكن للبلاغة ان تكون سوى مجموعة من الأساليب لغرض تضليل الجهلاء من الناس.
لقد عانت البلاغة من افلاطون كثيراً جراء حملات هجومه الشعواء، لكنها قاومتها وصمدت امامها. وهي حرب لم تكن، كما كان يعتقد شيشرون، لأن سقراط وافلاطون كانوا أعداء لحُسْن بَيان اللغة، وإنما بدأت بإسم الحقيقة وشرَّعت لصراع طويل.
وفيما بعد، كان من شأن سيادة النزعة الدوغمائية، الافلاطونية اولاً؛ ثم الرواقية، واخيراً الدوغمائية الدينية ان يؤدي لتوجيه ضربة جديدة للبلاغة ولاختزالها على نحو متزايد الى مجرد وسيلة عرض توضيحي صِرف. في الواقع، بالقدر الذي تسود فيه أحادية القيّم، لا يمكن لخطاب البلاغة ان يتقدم ويزدهر.
لان النزعة الأحادية monisme هذه تعمل على إعادة صياغة المشكلات المتعلقة بالقيمة وتعيد هيكلتها ووضعها بالشكل الذي يجعل منها مجرد مشكلات تتعلق بالحقيقة. فمن دون شك، اننا سنعثر في كتابات رجال اللاهوت العقائدية على حِجاج بلاغي أكثر بكثير منه في كتابات أي عصر آخر، لكنه ظل حِجاج لا يمكن النظر فيه إلا من زاوية الحقيقة فقط.
وفيما بعد، كادت النزعة الانسانية في عصر النهضة أن تهيئ لحركة احياء جديدة في خطاب البلاغة بالمعنى الواسع للكلمة. لكن لم يكن لمعيار بداهة الوضوح، سواء كان البداهة الشخصية للنزعة البروتستانتية؛ او البداهة العقلانية للنزعة الديكارتية او البداهة الحسية للتجريبيين، إلا ان يؤدي، في نهاية المطاف، الى استبعاد البلاغة واقصاءها.
ورغم ان الفيلسوف ليبنتز كان قد اعتقد في كتابه (مقالات عن العقل)، أن ‹‹فن التداول والمجادلة هو بحاجة لإعادة صياغة بالكامل››. فإنه رأى في البلاغة أسوء الاحتمالات المقدمة للعقول المحدودة الذكاء والاطلاع.
وهو وإن لم يهمل مفهوم الما هو محتمل الصواب vraisemblable الارسطي، إلا انه انتقد ارسطو لاختزاله هذا المفهوم فيما هو قابل للتصور وان يكون موضوعاً لتبادل الرأي opinable، بينما يوجد مفهوم الاحتمال probable المنحدر عن طبيعة الأشياء. إن ما كان يود ليبنتز العثور عليه هو نوع من حساب الاحتمالات المشابه لتقييم القرائن في مجال القانون. وهذا ليس بمنطق للقيّم ابدا.
بهذه الطريقة افضت النزعة العقلانية الى تضييق البلاغة عن طريق قصرِها على دراسة صور الأسلوب التعبيرية. ولم تستطع انتفاضة الاسقف الانجليزي ريتشارد واتلي ان تفعل شيئاً لصالح البلاغة. فهو نفسه، لارتباطه الوثيق بعقيدته، كان ابعد ما يكون عن الاتجاه النسبي ليمنح بالفعل مكانتها للبلاغة.
وكان قد الحق بالبلاغة التي يُنظر اليها كتعبير، دراسة حُجَج ترقى لمستوى دراسة منطقية. اذن، على الرغم من جهود واتلي، انحسرت البلاغة بشكل متزايد على دراسة أساليب التعبير الأدبية. وعلى هذا النحو، اكملت الرومنطيقية عملية اقصاء البلاغة بالكامل.
لقد كان لدى الفيلسوف شوبنهاور اهتمام كبير بمناهج النقاش في مرحلة معينة. وعلى الرغم من انه كان يرى فيها مجرد حيّل زائفة، فقد شرع بكتابة دراسة عنها عدّها مبتكرة آنذاك. لكنه، تراجع عن ذلك وتخلى عن الفكرة دون حتى ان ينشرها، ونظر لهذا الموضوع بازدراء. فقد كان، في الواقع، موضوعاً غير متناسب تماماً مع تصوراته الفلسفية.
اليوم وقد تخلَّصنا من أوهام العقلانية والوضعية، وتنبهنا لوجود مفاهيم ملتبسة، ولأهمية أحكام القيمة، يجب ان يُعاد احياء البلاغة كمجال بحث فعّال يتصدى لكل ما هو راهن؛ وتقنية حِجاجية تتعلق بالشؤون الإنسانية، ومنطقٍ لأحكام القيمة.
ويجب على هذا المنطق أن يمكننا، على الخصوص، من تحديد مفهوم أحكام القيمة نفسه. ففي الواقع، نحن نعتقد، وبشكل متزايد، انه لا يمكننا فهم مشكلة القيّم وتصورها إلا في ضوء الاستجابة للحِجاج إزاء الآخر.
وإذا قيل لنا ان البلاغة منافية لمعايير الاخلاق، لأنها تجيز دعم حُجَج تقع لصالح أمر وأخرى ضده في آن واحد، والى أي مدى كان هذا النقد محرجاً بالنسبة لكوانتيليان. فإن، وجود حُجَج مؤيدة للأمر وأخرى معارضة له، ليس هو السبب في جعل هذه الحُجج لها قيمة متساوية من حيث الفاعلية المؤثرة.
لأننا نحن من يقع عليه مسؤولية التمعن في الحُجَج التي يتم استعمالها والنظر فيها مليّاً لتقييمها في نهاية الامر، كما يخبرنا كاتب كلاسيكي مثل الفيلسوف جون ستيوارت ميل في كتابه (نظام المنطق):
‹‹يمكن لآراء الناس الأكثر تعارضاً ان تُظهر بداهة معقولة عندما يعرض كل واحد منهم فكرته ويوضحها على حدة، غير انه فقط عند استماعنا ومقارنة ما يمكن لكل منهما قوله ضد الآخر وما يمكن لهذا الأخير قوله للدفاع عن نفسه، يمكن عندئذ اتخاذ القرار بشأن أيهما على حقّ››.
ان القاضي ذو العقل النقدي النيَّر هو الذي يحكم في الامر بعد استماعه ما له وما عليه. وهذا هو دور البلاغة، بمعنى، انها بدل ان تعمل على تشكيل وعينا كخصم مترافِع، عليها ان تكوَّنه بالشكل الذي يجعله قادر على النظر وتقدير الامور كهذا القاضي الواعي.
فما هو مثير للاستياء في موقف الخصم المترافِع وغير مقبول بالمرة، انه يصدر لحساب طرف واحد؛ منغلق على أحكام مسبَّقة معينة؛ يتغاضى عن حُجَج الطرف المعارض، وكل ذلك من اجل دحضها.
فالاستنتاجات معروفة ومفروغ منها بالنسبة للمترافِع، ولا يحتاج الامر سوى العثور على الحُجَج الداعمة له. لكن، مرافعة المتقاضي هذه لا يمكن بالطبع فصلها عن سياقها، وعن مرافعة الطرف المعارض.
وفي مثل هذا المحيط النسبي، لا وجود بعد الآن لحُجَج مؤيدة ومخالفة مستقلة بذاتها، بل هناك تكوين وتشكيل باستمرار لأنظمة جديدة تعمل على إدماج حالات عدم التوافق ما بين هذه الحُجَج.
وهذا هو معنى المسؤولية والحرية في تدبير الشؤون الإنسانية. فإذا لم يتوفر فيها إمكانية للاختيار ولا لبديل آخر، فلا يمكننا ممارسة حرياتنا بكل تأكيد. لأن التحاور هو ما يميز الانسان عن رجل آلي.
وهو تحاور يركز اهتمامه على ما هو أساسي في منجز الإنسان وبنائه الفعَّال؛ وعلى القيّم والمعايير التي يبتكرها ويؤسسها والتي يتحمل النقاش discussion مهمة الارتقاء بها جميعاً. ويمكن لدراسة أساليب التعبير لهذا النقاش أن تساعد الانسان على توسيع نطاق وعيه بتقنيات التفكير ومهاراته التي يستعين بها جميع القائمين على صياغة ثقافته وتطويرها.
لو لم تكن البلاغة هي عمل من ابتكار الانسان ونتاجه حقاً، لما عاشت، برأينا، اقصى مراحل تألقها في عصور سادت فيها النزعة الإنسانية، سواء في عهود الحضارة اليونانية القديمة او في عصر النهضة.
إذا كان ينبغي لعصرنا التخلص نهائياً من النزعة الوضعية، فهو بحاجة الى أدوات تساعده على فهم ما الذي يشكل الواقع الإنساني. وعلى الرغم من ان انشغالنا قد يبدو بعيداً، إلا انه، وبما لديه من دوافع تحركه، يمكن له ان ينضم لمساعي الفيلسوف غاستون باشلار الأخيرة وبأبحاث الوجوديين المعاصرين.
حيث يمكن للمرء ان يقابل فيه على مثيل لذلك الاهتمام بالإنسان، وبما تجنب الخوض فيه كل من اختصاص المنطق الصُّوري الشكلاني البحت والتجربة. ونرى انه من اجل ان تتوافق نظرية المعرفة مع هذا المناخ الجديد للفلسفة المعاصرة،
يجب عليها أن تدمج في بنيتها أساليب التعبير الحِجاجية المستعملة في جميع مجالات الثقافة الإنسانية، ولهذا السبب، سيكون إعادة تجديد البلاغة متلائماً مع الجانب الانساني لتطلعات لعصرنا.
- الهوامش:
*Chaïm Perelman & L. Olbrechts-Tyteca : Rhétorique et Philosophie … pour une théorie de l’argumentation en philosophie, Chap. 1 : Logique et Rhétorique, Paris, P.U.F, 1952, p. 1-43. Ce Chapitre-ci est à l’origine un article paru dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger, Paris, janvier-mars 1950.
[] ما بين القوسين يعود للمترجمة. وفيما يتعلق بمفاهيم بيرلمان تحديداً، تم العودة الى مؤلفه العمدة (رسالة في الحِجاج):
Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca : La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, Paris, P.U.F, 2 vol., 1958.
* رمز النجمة هو رمز مثبت على مفاهيم محددة ضمن متن النص، يُشير إلى إمكانية الاستزادة حولها، بالعودة لقائمة مسرد المصطلحات.
- مسرد المصطلحات:
-adhésion : مصطلح التأييد [وليس التسليم خضوعاً وإذعاناً كما هو شائع خطأ في اغلب الترجمات والمؤلفات العربية في البلاغة والحِجاج] يشير استعماله غالباً إلى الموافقة المعطاة لمبدأ أو لعقيدة أو لأيديولوجيا مسيطرة. وهذا يعني أن التأييد يستدعي المشاركة والانضواء تحت الطريقة نفسها في النظر والإدراك لمعايير الأخلاقيات المتداولة، لهذا يمكن أن تعد صياغة التأييد هي صياغة لتعددية في الايديولوجيات لها من القوة والتأثير المماثلين لتلك الخاصة بسلطة مشيدة وراسخة لكنه يختلف عنها بكونها قابلة على الدوام للسؤال والنقاش والمراجعة والجدال. بعبارة أخرى، أن التأييد هو مشاركة في صناعة الآراء والاعتقادات doxa لان آثار تأييد وتصديق رأي معين ستضع القيّم المحمولة فيه موضع صيرورة دائمة. للمزيد، يُنظر:
ADHÉSION dans : La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, 2 vol.
ADHÉSION dans : Le Dictionnaire du Littéraire, Sous la direction de Paul Aron & Denis Saint-Jacques & Alain Viala, Paris, P.U.F, 2e éd., 2010, p. 6-7.
Intensité- : مفهوم الشدة –يؤكد بيرلمان– انه لا يقتصر على تحصيل نتائج على مستوى التفكير فحسب؛ ولا الى الإعلان فقط عن ترجيح رأي؛ فكرة؛ فرضية او أطروحة واحدة أكثر من غيرها، بل وغالبا ما سوف يفضي تعزيزه الى الدفع نحو انتاج الفعل الذي كان ينبغي عليه اثارته من البداية. للمزيد يُنظر:
La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, Tome 1 : les cadres de l’argumentation.
Procédés- : هذا المفهوم الأساسي في علوم البلاغة والحِجاج عامة؛ وفي نظرية البلاغة الجديدة على وجه الخصوص؛ والاشكالي الذي لطالما جرى التقليل من قيمته، وبالتالي، من قيمة البلاغة على السواء، وذلك من خلال اختزاله على انه مجرد وسيلة او مسلك لغرض الوصول الى غاية في قلب الخطيب والخطاب البلاغي عموماً. فكانت هذه احدى المشاكل التي سعى بيرلمان مع زميلته تيتكا الى تسليط الضوء عليها، ولإعادة مراجعة تاريخ البلاغة والتقليد الحِجاجي في جينالوجيا الفكر الغربي.
يعبر هذا المفهوم عن مجمل عمليات التعبير في الأسلوب style، أي بالأساليب التي نصيغ بها تفكيرنا، وتشكل نماذجه وتوجهاته وميوله التي كثيراً ما تبدل من شكل القول l’énoncé؛ وتؤثر على طريقة القول l’énonciation ومفعوله في انتاج الممارسات الخطابية، وبالتالي، في إعادة صياغة رؤيتنا للواقع برمته.
- للمزيد يُنظر:
La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, Tom 1, p. 204, Tom 2, § 96 La rhétorique comme procédé.
FIGURE & RHÉTORIQUE dans : Le Dictionnaire du Littéraire, p. 291-292 & p. 676-678.
Entendement- : مصطلح Verstand بَطُل استعماله فلسفياً (ويستبدل حاليا بكلمة : عقل؛ روح، ذكاء). وهو باختصار شديد، مصطلح يعيد لنا تاريخ التمييز الأول بين معرفة حدسية intuitive او معرفة مباشرة وبين معرفة خطابية discursive. تنطبق الأولى على الموضوعات السامية العليا حسب افلاطون وارسطو؛ والثانية تستخدم لغرض تشييد المعرفة العلمية التي تستعين بأدوات الاستدلال والقياس.
الأولى هي الأعلى؛ والثانية هي الأدنى. وظل مفهوم مَلَكَة الفهم ملازماً لمعنى الحدس او المعرفة المباشرة المجردة عن الموضوعات الحسية المادية، طوال فترة العصور الوسطى خصوصاً ونحن نتحدث في النص أعلاه عن الفيلسوف بليز باسكال.
اما مع الفيلسوف ايمانويل كانط فقد أصبح يُعرَّف بمَلَكَة تكوين القواعد، فهي من تميز المفاهيم وتركب المعطيات الحسية لغرض صياغة الاحكام، لكن العقل Vernunft هو مَلَكَة المبادئ التي تسمح بتنظيم تلك المعطيات ضمن مقولات ومفاهيم. للمزيد يُنظر:
ENTENDEMENT dans : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Par André Lalande, Paris, PUF, 1926, 16 édition, 1988, p. 286-288.
ENTENDEMENT dans : Vocabulaire Européen des Philosophies, Sous la direction de BARBARA CASSIN, Paris, Le Seuil & Le Robert, 2004, p. 349-353.
Épidictique-: يعود اصل هذا المفهوم الى الكلمة اليونانية epideixis [επίδειξης] التي ميز التقليد الفلسفي والبلاغي بها الممارسة الخطابية السفسطائية discursivité sophistique وذلك منذ محاورات افلاطون وحتى حيوات السفسطائيين لفيلوستراطوس. فكلمة epideixis هي ما وصف به افلاطون باستمرار خطاب السفسطائيين امثال بروديكوس وهيباس وجورجياس القادمون عادة من مدينة سيسيليا او اليونان العظمى للقيام بجولات حيث تكون لهم فيها محافل conférences لإلقاء المحاضرات في المدن اليونانية الكبيرة مثل أثينا وسبارطا، من هنا كانت أفضل ترجمة لهذه الكلمة هي القاء محاضرة lecture بالمعنى الانجلوساكسوني للمصطلح. وبمعنى عام، كلمة epideixis هي الاسم التقليدي لما يطلق عليه بعرض سفسطائي لشخص بمفرده one man show sophistique، ويقع على النقيض من ذلك الحوار القصير القائم على تبادل اسئلة واجوبة، ترمي صعوداً نحو المثل والجواهر العليا، وهو ما ميز الجدل السقراطي.
تنقسم كلمة epideixis الى مقطعين اثنين: deixis فعل القول، acte الإنجاز في القول؛ وهي بذلك تشير الى فن عرض وبَيَان montrer devant قيمة إيجابية او سلبية (مدح او ذم شخص؛ مدينة، او دولة في مناسبات رسمية) امام epi وبحضور جمهور عام، وهي تعتمد على قدرة الخطيب في اظهار مهارته في انتهاز هذه اللحظة الملائمة التي ليس امامه غيرها في الوقت الحاضر. وبذلك فهي تختلف عن كلمة apodeixis التي تعبر عن فن البرهنة انطلاقاً من montrer à partir de مقدمات أولى تبحث في السبب والعلة المتعلقة بالموضوع المبرهن عليه في علوم المنطق والرياضيات والفلسفة. وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه معظم المؤلفات الغربية في البلاغة والحجاج وذلك بالنظر الى هذا الجنس من الفصاحة باعتباره «جنس برهاني» – وهو الخطأ نفسه الذي ما زال مستمراً في المؤلفات البلاغية والحِجاجية العربية – وذلك لسيادة النزعة الافلاطونية-الارسطية التي تعلي من شأن نظام الفكر المنطقي؛ الوضعي، والعقلاني، وتعمل، في الوقت نفسه، على التقليل من شأن البلاغة والحِجاج والحدّ من حرية الكلام والحوار والتعبير.
باختصار، مع فعالية بَيَان الكلام epideixis يمكننا –حسب الفيلسوفة والمختصة في البلاغة باربارا كاسان–ان نتجاوز انموذج فن البرهنة الافلاطوني/الفينومينولوجي الذي يبحث عن الحقيقة بالخضوع لنظام صُّوري شكلاني تابع لخطاب جواهر ثابتة ودلالات راسخة ذات صلاحية وشرعية ذاتية دائمة autolégitimée [من انطولوجيا الوجود الى إعادة قول الوجود]، لننتقل مع السفسطائيين الى انموذج علم الخطاب logologie أي من الكلام الى مفعوله effet، ان فعالية بَيَان الكلام امام العموم مبهرة لدرجة انها تحول بل وتبدل من مفعول الخطاب والعالم المحيط بنا، من خلال إنتاجها لأشياء جديدة ولقيّم جديدة على حد سواء. فما دشنته الممارسة الخطابية البلاغية السفسطائية مع فعالية بَيَان الكلام المتحققة على المستويات الاستيطيقية/الايتيقية والتداولية والانطولوجية عند المخاطِب والمخاطَب والخطاب في آن واحد–إذا اخذنا تعبير اوستن– هو “فن صناعة الأشياء بالكلمات”. وفصاحة البَيَان هي فصاحة سياسية/ثقافية، أي انها تمثل القاعدة التي تشتغل على أساسها كل من الفصاحة القانونية judiciaire (التي تخاطب القاضي إما لغرض المقاضاة او الدفاع امام المحكمة) والتشاورية délibératif (التي تتعلق بشؤون الحكم السياسية؛ وغايتها هي تقديم المشورة لأعضاء المجمع السياسي لغرض اتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على المدينة)، خصوصا وانها خطاب يشتغل على مفعول الاحكام القيّمية –حسب بيرلمان– وعلى إعادة ابتكار تشاركيات متبادلة وتوافقات مختلفة حول قيّم جديدة يمكن لها ان تؤسس لمقدمات جديدة تخدم الفصاحة القانونية والتشاورية في آن واحد. للمزيد يُنظر:
Epideixis & Apodeixis dans : Vocabulaire Européen des Philosophies, Sous la direction de BARBARA CASSIN, Paris, Le Seuil & Le Robert, 2004, p. 306-307, 916-917, 11-21 & p. 727-741, 1023-1029, 1133-1151.
BARBARA CASSIN,: L’EFFET SOPHISTIQUE, Paris, Édition Gallimard, 1995, Orthodoxie et création des valeurs, p. 195-196, 198-199, 201-202.
Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca : La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, 2 vols.
Marc Fumaroli : L’âge de L’éloquence, Paris, Albin Michel, 2e éd., 1994.
Laurent Pernot : La Rhétorique dans l’Antiquité, Librairie Générale Française, 2000.
La Mis En Scène Des Valeurs … La Rhétorique de L’éloge et du blâme, Sous la direction de Marc Dominicy & Madeleine Frédéric, Suisse, Delachaux et Niestlé, 2001.
Emmanuelle Danblon : L’Homme Rhétorique … Culture, raison, action, Paris, CERF, 2013.
– auditoire : يأتي كل من بيرلمان وزميلته تيتكا في هذا الموضع على تحديد معنى استعمال مفهوم جمهور مخاطَب في بحثهما الموسوم بـ (المنطق والبلاغة) المنشور اصلاً في المجلة الفلسفية الفرنسية عام 1950، وهو ما يعتبر تمهيد اصطلاحي ومفاهيمي ومنهجي مبكر لبناء نظريتهم في البلاغة الجديدة التي سيعودان اليهما بشكل موسع ومفصل في مؤلفهما الأساسي (رسالة في الحِجاج) عام 1958 – وكنا قد أشرنا الى مفهوم بيرلمان الخاص بهذا المصطلح في نص ترجمتنا (كراسات في الحِجاج البلاغي) وتحديداً في الهامش المتعلق بمصطلح جمهور مخاطَب – بالتذكير انهما إذا كانا قد احتفظا بفكرة جمهور مستمَع عن البلاغة الارسطية القديمة، فهما لم يقصُرا، مع ذلك، استعماله على معناه التقليدي المتداول في سياق البلاغة اليونانية القديمة أي “جمهور مستمع” [وهو تعبير ساد خطأً وما يزال هو الخطأ السائد في اغلب مؤلفات البلاغة العربية اليوم]، وإنما امتد حسب تعبيره، ليشمل مختلف أشكال الجمهور المخاطَب الذي نتوجه إليه في خطاباتنا المكتوبة والشفاهية على حد سواء. للمزيد يُنظر:
La Nouvelle Rhétorique … Traité de L’Argumentation, tome 1, p. 7, 8-10.