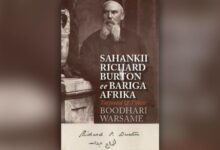“إدوارد سعيد” ومُعضلة الاستشراق
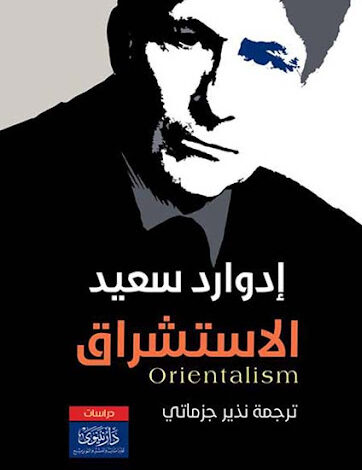
’’هذا الكتاب نما بطرقٍ لم أشهدْ مثيلاً لها، ثم وعلى نحوٍ مفاجئٍ أصبح هذا الكتاب شيئاً أكبر، أصبح التاريخ الكامل لتمثيل الآخر، أعتقد أنه أحد أوائل الكتب التي حاولت القيام بذلك. لم يكن الكتاب مجرد عملٍ فكري بل حوى كذلك القوالب النمطية، التي اتبعتها الدول الاستعمارية لفرض هيمنتها على المستعمرات“.
لم يكن يدرك إدوارد سعيد أن كتابه الاستشراق سيصبح مشروعا يؤسس لحالة من المقاومة الحضارية، وفعلا أكاديميا حاسما في تفكيك الرؤية الاستشراقية الأوروبية، معرضا إياها لخطر الفهم والاستيعاب، استيعاب أساليبها وقوالبها النمطية ونظرياتها التحليلية للمشرق العربي عموما والتي تُقدَّم استنادا لمفهوم رؤيوي مغاير يستشرف المستقبل.
وهو ما كان صادما للوعي الاستشراقي، إذ كشف إدوارد للمرة الأولى والأخيرة على ما يبدو، ذلك النوع المنعزل والمتعالي من الاستشراق، والذي يمعن في انتقاص الآخر الشرقي، تعظيما لذاته، وتفخيما لمجده المادي.
’’هذا الكتاب نما بطرقٍ لم أشهدْ مثيلاً لها، ثم وعلى نحوٍ مفاجئٍ أصبح هذا الكتاب شيئاً أكبر، أصبح التاريخ الكامل لتمثيل الآخر‘‘
- قليلا من إدوارد
ادوارد في محاولة لفهمه، ابن البيئة الغربية وأستاذها الأكاديمي، وهو في الوقت ذاته نسيج الشرق بأكمله، إذ انتهت إليه من رافديها، ثقافتان متدينتان، تنتميان إلى العنصر العربي ذاته، فالإسلام الذي أحاط بوجدانه كفعل تاريخي حاسم، أرخى في قلب ادوارد عاطفة مقاومة للهجمة الاستعمارية على الشرق، والتي كانت تلهب في ذلك الوقت كل أبناء المشرق بلا استثناء، مرسخة في ضمائرهم، توجسا من كل فعل ثقافي استعماري.
وهذا بلا شك هو إرث العلاقة بين الإسلام التاريخي وأوروبا القروسطية، أما المسيحية المشرقية التي تحمل في طياتها شعورا خالصا للشرق، وتنظر بعين الريبة للمسيحية الغربية الطارئة، فقد كان لها ذلك الدور القومي أيضا بصفتها الحاضنة التاريخية للقومية العربية الحديثة.
فادوارد لم يكن قوميا بالمعنى الذي يشتهيه القوميون، إلا أنه كان يحمل وعيا قوميا خاصا، مكنه من أن يكون”الصوت العربي الأبرز في الدفاع عن فلسطين“، وفي سياق فهم خلفية ادوارد، لا يمكننا إغفال ما كان للنكبة من أثر في تشكيل وعيه القومي أساسا.
فادوارد كما ملايين الفلسطينيين، هم نتاج تلك النكبة ووارثوها، وقد حملتهم من المآسي والمعاناة الإنسانية ما تجاوز بكثير ألم فقدان الأرض، فالنكبة كانت أساسا معضلة هوية، وسؤال وجودي مشكِل، ولعل تلك الأسئلة: من أنا؟ ومن نحن؟ ومن هو الآخر؟، التي حملها ادوارد في ضميره، والتي أشعرته دائما كما لو كان”خارج المكان“، وكرسته غريبا حتى عن نفسه، ودفعته إلى كل ذلك الزخم، زخم الفهم والتحليل والمقاومة.
إن الإنخراط في فهم الذات، وسبر أغوارها واستكشافها بشكل كامل، يتطلب نوعا من الفوضى الممارَسة داخل الذات، وداخل أروقة الوعي الإنساني، وتتطلب على نحو مماثل هزات عنيفة وصدمات متتالية، كأنها عملية بحث عن الروح واستكناهها طلبا لحقيقة تتجلى، والباحث كما الشاعر، لا يتوصل إلى حافة الرؤيا إلا عن طريق الإنخراط في تجربة مهولة وطويلة ومُعَقلَنة، كما لو أنها كانت تعطيلا للحواس، أو خلخلة عميقة لها.
هل عانى ادوارد من ذلك؟ لو كان لي أن أقدر الأمور لقلت: نعم، إن الباحث العظيم الذي يؤسس لحالة متقدمة من الوعي، فاتحا باب القلق على مصراعيه، عليه أن يمر بحالة تشبه الرؤيا والنزاع، وأن يمارس توفيقا بين اشتباكاته الذاتية، وبين إرادته ليكون رائيا وملهِما وكونيا، ثم ثائرا معلما في الأوقات كلها.
- ما هو الاستشراق؟
يمثل الاستشراق محاولة غربية لفهم المشرق، وفي مستويات أخرى قولبته وتنميطه وفقا للسياق الثقافي الأوروبي، وقد كان الاستشراق محاولة أكاديمية في البداية ليتحول مع مرور الوقت إلى أداة استعمارية مسلطة على الوعي والحضارة، ووسيلة للهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية.
وهو في نظر الأوروبيين محاولة لإنقاذ الشرق من عزلته وغموضه، وإعانة جادة له في إعادة تعريفه انطلاقا من المركزية الأوروبية، فالشرقي عاجز عن تعريف ذاته وتلمس معالم مدنيته وحضارته،
لذلك يمارس الأوروبيون هذا التعريف وفقا لمنظور استعلائي يتخذ من أوروبا معيارا وأنموذجا، ويكمن خطر الاستشراق في كونه يمثل أفعالا متباينة لا تتلقى أنواعا مشابهة من الإستجابة، فالاستشراق على الصعيد السياسي يمثل حالة استعمارية ترتكز إلى نظرية التفوق السياسي لأوروبا ووجوب الحفاظ على مصالحها،
مما يعني أن على الاستشراق ممارسة تطويع للوعي السياسي الشرقي، وتكريس مفهوم التضاؤل والتلاشي أمام الجبروت الغربي، وهو في هذا الحالة يتلقى استجابة عنيفة بلا شك. أما على الصعيد الثقافي، فالاستشراق حالة حضارية بحتة، تعيد إنتاج تعريفات للآخر الشرقي، باعتباره النقيض المتخلف والهمجي والضعيف،
وهو فيما يبدو يتسق تماما مع نظرية عبء الرجل الأبيض، الذي عليه أن يحمل على كاهله واجب تمدين الآخرين وتحضيرهم، وقد كان على الاستشراق الثقافي أن يكرس حماية للذات الغربية الإستعلائية بوصفها الضامن التاريخي للمدنية، أو كما يعتقد فوكوياما بأنها الشكل النهائي للتاريخ.
وقد كان مهما وموروثا في العقلية الأوروبية، أن يمارس هذا التحقير للشرق، بوصفه عدوا تاريخيا في مجالات حيوية متعددة، يحمل مشروعا روحيا منافسا،
كان يتصدر المشهد السياسي والثقافي لقرون عديدة، ومثل في مراحل طويلة تهديدا مباشرا للوعي الأوروبي، ونوعا من الإنتقاص العسكري والثقافي لتلك الذات، واستنادا لكل ما سبق، فإن الإستجابة لهذا النوع من الفعل الاستشراقي عادة ما يشوبها الحذر، إلا أنها لا تتلقى ردات فعل عنيفة، لالتباس المعاني فيها.
كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد.
- إدوارد، كيف يراه؟
ينتمي ادوارد لمفكري ما بعد الاستعمار أي أنه كان”ما بعد استعماري“، وهم أولئك الذين حملوا على عواتقهم، مهمة ترميم وعي الشعوب المستعمرة، وانتشالهم من مستنقعات الاستعمار ومعالجتهم حضاريا وتنقية سياقاتهم الثقافية من مخلفات الاستعمار، وهي مهمة صعبة فيما يبدو، إذ ترك الاستعمار وراءه نخبا متنفذة، ساهمت في إبقاء الأنساق الاجتماعية كما هي، متوافقة مع المصالح الغربية،
بل وتخدمها في بعض الحالات كما هي في بعض مناطق إفريقيا، وقد كان ادوارد يمارس هذا الدور باقتدار وتأثير، استنادا لرؤيته وتجربته الشخصية والأكاديمية، وإن كان لا بد من الاعتراف أن لإدوارد رؤيته المدفوعة باستعداده النفسي والوجداني، وقد كان ادوارد يقدم الاستشراق كما هو، أي أنه حالة اقتران للثقافة مع الاستعمار وقوالبه، كما لو أنها كانت مشروعا امبرياليا بالأساس،
ينطلق من رؤية أوروبية رومانسية للعلاقة مع الشرق، الحديقة الخلفية لفظاعات أوروبا، ولم يحاول سعيد فك ذلك الاشتباك بين الشعبوية و الأكاديمية في أوروبا، فهو يرى أن الاستشراق الأكاديمي كان ينبثق من رحم الشعبوية تاريخيا، وأنه قدم معرفة هزلية للآخر الشرقي، استندت أساسا لمنظور استعماري بحت.
’’إن آسيا لديها الأنبياء وأوروبا لديها الأطباء‘‘
— ادجار كينيه
- إجابات انتظرها ادوارد
ينقل ادوارد مقولة ادجار كينيه:”إن آسيا لديها الأنبياء، وأوروبا لديها الأطباء“، ثم يعلق على هذه العبارة بقوله:”كانت الدراسة الصحيحة للشرق تنطلق من الدراسة المتقنة للنصوص القديمة، ولا تبدأ إلا عند التهاء من ذلك في تطبيق تلك النصوص على الشرق الحديث“.
يبدو أن ادوارد كان يرى أن هناك اشتباكا في الرؤية لدى الأوروبيين، فالشرق بالنسبة إليهم لا يتعدى كونه مخيالا دينيا، تلتف حوله أساطير النصوص المقدسة، وهو يمثل في مراحله التاريخية، استيلادا إنسانيا للأنبياء بما يمثلونه كأساطير أولا، ومؤسسين للثقافة الشرقية ثانيا.
إلا أن هذه الحركة الشرقية المقدسة لم تستمر لسبب ما، ما يدفع الأوربيين إلى محاولة إنقاذ وعلاج الماضي الشرقي القديم، وهو ما وصفة ادوارد فقال”كان لادجار كينيه وعي غامض بهذه العلاقة العلاجية“،
ويبدو أن الأمر كان مبررا وطريفا في الوقت ذاته بالنسبة لإدوارد، فهو يرى أن هذه الرؤية العلاجية مردها أن الاستشراقيين الأوائل كانوا غالبا من رجال الطب ذوي الميول التبشيرية القوية، وهذا يفسر أمرين: يرى الطبيب من حوله مرضى حتى يثبت العكس، وإن كان عمل الطبيب يتطلب رحمة تامة، فهو أيضا يتطلب رؤية انتقادية تامة، مع ما يشوبها من خطاب استعلائي.
يرى المبشر من حوله بمعنى الكفر والإيمان، الهلاك أو النجاة، مع ما تفترضه الرؤية الدينية ومتلازماتها، كالشعور بالخلاص مقابل الشعور بالشفقة أو الحقد نحو أولئك الهالكين الذي لم يقبلوا طريق النجاة.
في سرده تفسيراته لمغامرة نابليون المصرية، يرى ادوارد سعيد أن نابليون مثل حالة أولى من سلسلة لقاءات أوروبية مع الشرق، تمحورت حول خبرة المستشرق لا خبرة المجرب، إذ أن نابليون كما يرى سعيد، بنى معرفته من خلال أدبيات استشراقية، كانت تمهد لمعرفة كلاسيكية وأسطورية ومتوارثة، تنظر إلى الشرق كساحة بطولات اسكندرية، يستولي عليها الآن دين قاس وعنيف وهمجي،
إلا أن سحرا ما يقبع بين تلك التلال، وهو ما ظهر في تصورات نابليون عن مصر، والتي بناها أساسا من خلال قراءة كتاب الكونت دي فولني’’رحلة في مصر وفي سوريا‘‘،
وهو الكتاب الذي يمثل النموذج الكلاسيكي لكيفية النظر إلى الشرق، وهو أيضا يضمر عداوة للإسلام، باعتباره”دينا ونظاما للمؤسسات السياسية“، وكان فولني -كما أشار نابليون- يعتقد بأنه أي الإسلام أخطر أعداء فرنسا الثلاثة في سبيل السيطرة على مصر،
أما العدو الأول فبريطانيا وأما الثاني فالعثمانيون. جند نابليون في حملته على مصر عشرات العلماء والمؤرخين، لإعداد ما يشبه أرشيفا حيا لحملته، وهو ما يظهر لإدوارد سعيد على أنه محاولة لكسر القالب الذي أحاط بنابليون،
من خلال قراءاته المتكررة للنصوص الكلاسيكية حول الشرق، وهو ما يظهر في أن نابليون أظهر تحررا من تلك العداوة للإسلام، والتي تظهر بتجلّ تام في كتاب الكونت دي فولني، بل وأظهر نوعا من التودد والولاء للسلطان العثماني، كي يكسب رضى المصريين،
وهي على نحو مفاجئ، إحدى الطرائق الجديدة في التعامل مع الشرقيين وصناعة منتفعين محليين، وإن لم يكن نابليون أفاد من هذه الطريقة، فقد فعلت بريطانيا بعده بكل تأكيد، إلا أن ادوارد يرى أن نابليون لم يكن سوى ذلك المستعمر الأوروبي، والذب بنى خططه أساسا على تصورات المستشرقين،
وهنا تظهر لنا اللحظة الحاسمة، وهي اللحظة التي يتحتم فيها على المستشرق أن يحدد الجانب الذي سينحاز إليه، هل سينحاز إلى جانب الشرق الذي يدعي محبته، أم إلى جانب الغربي الذي ينتمي إليه؟
لقد كانت الإجابة واضحة بالنسبة لادوارد، فمنذ عهد نابليون انحاز المستشرقون للغزاة الأوروبيين، ومارسوا أدوارهم المنوطة بهم، وهي اللحظة التاريخية الحاسمة التي يؤسس ادوارد عليها نظريته ونظرته نحو الاستشراق.