“ريجيس بلاشير” .. ترجمة القرآن وحذر المستشرق
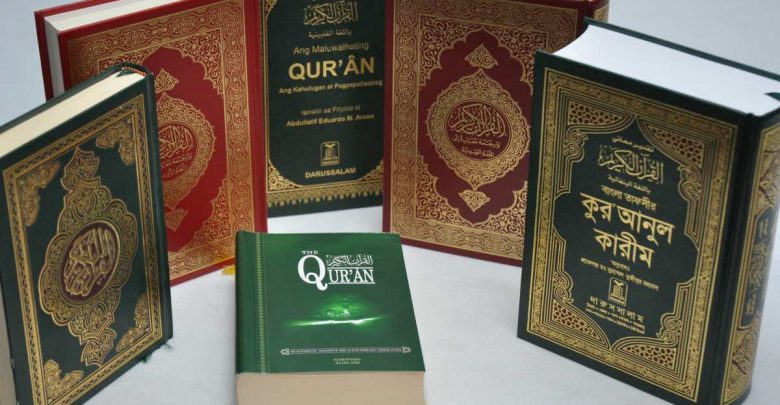
ركّز الاستشراق العلمي، في بداياته، على تفهِّم النص القرآني ترجمةً ودراسةً وتحليلاً نقدياً، وأقام أولى لبناته على استكناه تاريخية هذا النص ورصد تأثيراته في نشوء الحضارة الإسلامية، وتأثر هذه الأخيرة بما فيه من تعاليم، فهماً لأحدهما على ضوء الثاني.
ويشكِّل القرآن، في صيغته المُترجمة، خطاباً عسير الفهم على القارئ الأوروبي نظراً لما يضمُّه من صيغٍ مختلفة للقصص التوراتي والإنجيلي، ومن ملامح لم يألفها في شخصيات الأنبياء المشتركين، ومن تداخل بين قواعد التشريع ونصائح الأخلاق وأحوال الآخرة، فضلاً عن كونه لا يكاد يتذوّق شعريَّةَ النص العربي ونَظمه.
ولذلك، سعى المستشرقون، وعلى رأسهم المدرسة الألمانية، إلى إعادة ترتيب السور حسب التسلسل التاريخي، وهو ما أنجزه تيودور نولدكه (1836-1930) وتلميذه فريدريش شفاللي (1863- 1919).
وفي استمرارية مع هذه الأعمال الهادفة إلى إضفاء معقولية تاريخية على خطاب القرآن، تندرج آثار المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير (1900-1973) المتخصّص في مجال الإسلاميات، بمعناها التقليدي، بما هي درسٌ للنصوص التأسيسية بمنهج تاريخي-نقدي، بعد أن بدأ مسيرته برسالة دكتوراه عن أبي الطيب المتنبي.
وقفاها بتاريخ كامل للأدب العربي في ثلاثة أجزاء، بالإضافة إلى منهجَيْن، مختصر ومطوَّلٍ، لدراسة نَحْو الفُصْحى. لكنه صبّ كل ذلك لاحقاً في مجال الدراسات القرآنية بما اعترضه فيها من رهانات واجهها في مجالَيْ الترجمة والنقد.
أراد صاحب “تاريخ الأدب العربي”، أن تكون ترجمته للقرآن جامعةً لمزيّتَيْن: الاستفادة من الترجمات الأوروبية السابقة، من العصر الوسيط حتى زمانه، بعد أن شكَّلت ما يشبه “التراث الترجمي”، ولذا، كانت ترجمته تَراكميةً بمعنى أنها استخدمت كل التعليقات والتوضيحات والتصويبات التي حققتها تلك الأعمال، ووظّفتها في فهمٍ أدقَّ لمعاني النص ولا سيما المواطن التي حملت، ولا تزال، غموضاً حتى لدى المفسرين القدامى.
فعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى الصعوبات التي تعترض تَرجمة كلمة “كوثر”، وقد ورد في تأويلها في اللغة العربية أكثرُ من خمسة عشر معنًى. هذا بقطع النظر عن التطوّرات الجوهرية التي حصلت في فهم الكلمات ذات الأصول الأجنبية بفضل علم اللغات المقارن، ومكتسبات الألسنية التاريخية.
وهكذا أراد لترجمته أن تستوعب هذا الكمَّ المتزايد من المعلومات الحاصلة بفضل التقدم العلمي في مجال الإنسانيات وتوظيفها في فهم النص الديني، وإفهامه عبر جهاز تحليلي ما انفك بدوره يغتني عبر الأبحاث الاستشراقية المدققة عن الكثير من جزئيات الحضارة الإسلامية وكلياتها.
ومن جهة ثانية، أراد لترجمته أن تكون فيلولوجية، تحترم روح النص المكتوب، وتعيد بناء الدلالات التاريخية للغته القديمة، دون إسقاطٍ للمقابِلات الأجنبية عليها، وهي مقابلات قلما تتوافق مع السمات الدلالية للمُعجم السامي الذي تنتمي إليه العربية.
ومن أمثلة ذلك أنَّ كلمة “ربّ” تحمل في المَتن الفصيح معنى “التربية، والنماء والكثرة”، في حين أنَّ مقابلها الفرنسي (Seigneur) أو الإنكليزي (Lord) أو الألماني (Herr) يقتصر على معاني: السيادة والهَيمَنة. وكذلك كلمة “عقل” ومشتقاتها الفعلية الواردة في القرآن بمعنى أخلاقي محضٍ، فإنها اكتسبت، بعد اغتنائها باليونانية، طبقاتٍ مختلفة تصلها بالمنطق ووَعْي الطبيعة.
وهذا ما جَهد صاحب الترتيب الكرونولوجي للقرآن في إبرازه بمناسبة ترجمة المفردات الإشكالية. فكان من نتائج منهجه الفيلولوجي إدماج تعليقات وإحالات علمية (وكأنها تفسيرٌ للقرآن) توضّح مَناطق الإشكال، وتذكّر بسياقاتها الدلالية، بالاعتماد على التراث الإسلامي وكتابات المستشرقين في ذات الآن.
ومن جهة أخرى، شمل إسهام بلاشير الحقلَ المعرفي الذي اصطُلِح عليه في كتب التراث بـ “علوم القرآن”، والتعريف النقدي بالنص التأسيسي للإسلام، فقد أنجز لذلك مقدمة صدَّر بها ترجمته سنة 1949، ثم ما لبث أن فَصّلها في تأليف مستقل، تتبع فيه تاريخ تدوين النص، وحيثيات جَمعه وترتيبه، منذ كان “وحياً” يُتلقى بشكلٍ شفوي مُنَجَّمٍ إلى أن استقرَّ “مُدَوَّنة رسمية مغلقة” بحسب عبارة محمد أركون (1928-2010)، مروراً بمعضلة القراءات المختلفة وحروفه المتباينة.
وقد تألفت هذه المقدمة من أربعة أجزاء متكاملة، تهدف إلى تتبّعٍ شامل لتاريخية بناء هذا النص فدرس أولاً ظروف تشكل نُسخة القُرآن الرسمية، ووصف ثانياً صيغته الحالية في شكلها المُكتوب والمُرتب دون مراعاة لتاريخ النزول، واستعرض ثالثاً الانتقادات التي أثيرت حول هذا النص في صيغته الرسمية.
وهي انتقادات وجّهتها في القديم بَعض الفرق الإسلامية وقد شككت في صدقيته وشمول استيعابه إلى الكلام الموحى، ولدى المستشرقين الذين انتقدوا أسلوبه المشتت، وخَتم بوصفٍ للمصادر التي توفّرها علوم القرآن للاستشراق.
وفي كل مرحلةٍ من هاته المراحل الوصفية، كان بلاشير يقصي العناصر التي تتصل بدائرة الإيمان أو تنتمي إلى العقائد الذاتية مبيّناً أنه – وفي توافق تامٍ مع علماء الإسلام – من الصعب الاعتماد على المواد التي تقدّمها المصادر التقليدية بسبب كثرة تناقضاتها وثَغراتها وغياب الإجماع حول مسائلها الجوهرية والفرعية (مثل تَرتيب السور، أسمائها، ظروف التدوين…).
ولذلك تحرّك المستشرق الفرنسي بحذر شديد فوق هذه “الأرضية شديدة الانزلاق” واستخرج من تلك المواد المتضاربة خطاباً متجانساً يقنع الباحث الوضعي ولا يلجئه إلى ضرورات التقديس.
وهكذا فإنَّ ما حرَّك بلاشير هو التمييز بين موقف المؤمن وموقف الباحث، فأخضع نص المسلمين الديني إلى مقتضيات العقل وصرامة التحليل التاريخي، دون أن يَعبأ بالمسلمات أو يخضع للتبرير.
على أنه، والحق يقال، ظل شديد الحيطة في سائر أحكامه، حَذِراً في تحليلاته للتشكل التاريخي للمتن القرآني، رابطاً كل مظاهره بتطورات اللغة العربية وتغيراتها وتأثر أنظمتها المعجمية والتركيبية بما احتواه من أفانين الصياغة.
بل إنه لم يُخف إعجابه بتناسق النص ونَظمه الاستدلالي حيث يقول: “يبدو لنا القرآن، في صيغته هذه، في انسجام تام مع التجربة الدينية لمحمد، ومع طبيعة رسالته.
فهو خطابٌ إلهي أودِع في روحٍ مُجاهدةٍ، حيث يَتَظافر المعنى والمبنى على تربية الأرواح، وحيث يخدم سحرُ الكلمة البَرهنَةَ باطرادٍ، وإليها يعود، في نهاية التحليل، فضلُ اعتناق الكفارِ للإسلام”.
يعكف الباحثون اليوم على معضلة ترتيب سور القرآن في مسعى لإضفاء المعقولية التاريخية على تسلسل نزولها. وقد أوْلت هذه الأبحاث أهمية كبرى للخطية الزمنية مفتاحاً لتعقل ليس فقط مضامينِ القرآن، التي تباينت، وَفق الرؤية التقليدية، إلى مكيَّة تتعلق بقواعد الإيمان.
ومَدنية تتصل بتقنين الشرائع وتنظيم المجتمع، وإنما أيضاً لإدراك مباني القرآن وعلاقاته المعجمية ونَظمه البياني. كما تركز هذه الدراسات على قضية الاقتراض اللغوي وتأثيرات النصوص المحيطة بالقرآن في “اقتباساته” لأساطير الأولين وقصصهم.
ويعود الفضل إلى إسهام بلاشير، بعد المدرسة الألمانية، في إثارة جل هذه القضايا وفتح باب التاريخانية في رصد تطور القرآن من كونه تَراتيلَ إعجازٍ تتلى نحو السماء، إلى كونه مُدونة أحكامٍ تقضي بين الناس في نزاعات الأرض.















